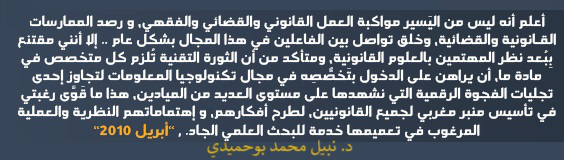إن قرار المحكمة الدستورية رقم 255/25وتاريخ 2025/08/04في الملف عدد 303/25القاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية شكل حدثا قانونيا تاريخيا بامتياز لأنه حسم نقاش دستوري طال انتظاره بين منتقد ومؤيد كل من موقعه لهذا التشريع المسطري الذي يعتبر دستور العدالة أو قانونها الاجرائي العام .
وهكذا قضت المحكمة الدستورية منطوقا بما يلي " بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:" أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور،المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور".
ويستخلص من منطوق القرار أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية بعض المواد حصرا دون حاجة لفحص دستورية باقي المواد التي لم تتم الوقوف عندها بشكل صريح،وهذا يعني أن قانون المسطرة المدنية بهذا القرار افتقد لماهيته كقانون وصار وثيقة تشريعية سابقة مما يحتم على الحكومة وضع مشروع جديد يستجيب لقرار المحكمة الدستورية سواء المعلن عنه أو غير المعلن عنه بإعادة النظر في جميع مواد القانون احتراما للدستور كأسمى قانون في البلاد ،طالما أن المحكمة الدستورية لم تعتبر هذه المواد غير الدستورية يمكن فصلها عن القانون ويمكن الإذن بتنفيذ القانون بمعزل عنها باعتبارها تشكل وحدة متكاملة ومتجانسة ومترابطة من القانون لا يمكن تطبيق مقتضى دون غيره من النصوص أو المواد.
ومن المهم الإشارة أن المحكمة الدستورية عودتنا دوما على قرارات رائدة تراعي فيها أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه باعتبارها أمينة على الشرعية وسيادة القانون وللأمن القانوني والقضائي وحامية لحقوق المتقاضين ولقواعد سير العدالة ولحرمة مؤسسة الدفاع كمرتكز دستوري نحو تحقيق المطالب المنصفة والعادلة والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين لتأمين الدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون والولوج المستنير والآمن للعدالة من خلال قانون مسطرة مدنية منصف ودفاع قوي وقضاء مستقل ونزيه.
والحقيقة أنه لا يمكن ابداء الرأي بشأن تعليلات القرار وتوجهاته إلا بعد طرح المسائل غير الدستورية التي حسمها قرار المحكمة الدستورية،لنعقب بعدئذ على القرار ونقيمه وفق أدوار واختصاصات المحكمة الدستورية ومنهجها الجديد في الرقابة،والمواضيع التي غيبت عن الرقابة بشكل غير مفهوم رغم أن عدم دستوريتها تفقأ العين .
-أولا-قراءة في التوجهات الثمانية للمسائل غير الدستورية .
1- عدم دستورية منح النيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام دون قيد أو شرط
حسم قرار المحكمة الدستورية الانتقادات الموجهة للمادة 17 من هذا القانون وقررت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من قراءة دستورية موفقة مرتكزها الأساسي حماية الأمن القانوني وحجية المقررات القضائية وفق الفصل 126 من الدستور لما اعتبرت "إن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق بيانه؛
وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛"
2- عدم دستورية التبليغ للأغيار دون ضوابط موضوعية تؤكد صحة التبليغ قانونا وواقعا
تنص الفقرة الرابعة من المادة 84 على أنه: " يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم."؛
وحماية لحقوق الدفاع وللأمن القانوني أقرت المحكمة الدستورية بعدم صحة تبليغ الأغيار دون ضوابط موضوعية على تحقق التبليغ واقعا وقانونيا واستنادا لليقين لا الشك لأن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة، أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص أنه وكيل المطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه، سن السادسة عشر، وأناطت بالمكلف بالتبليغ، حال إجرائه، تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه؛
وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية على أن " الصيغة المعروضة، فضلا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناء على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، مما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه :" أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، مخالفا للدستور؛
وحيث إنه بالتالي، فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 في فقرتها الأخيرة و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضا مخالفة للدستور."
وهكذا حماية لحقوق المواطنين ومخافة ضياع حقوقهم وخسارة دعاويهم او طعونهم بسبب تبليغ غير صحيح ولا ينسجم مع الواقع أو القانون يكون قرار المحكمة الدستورية قد أزال كل مسوغات غير دستورية تعصف بالأمن القانوني .
3-عدم دستورية التقاضي عن بعد دون وجود ضمانات تؤطر حقوق الدفاع
عرف التقاضي عن بعد نقاشات قانونية وحقوقية كبيرة خلال أزمة كورونا لاسيما في مجال المحاكمات الجنائية التي تم ربطها ممارسة وقضاء بأخذ قبول المتهم على هذه المسطرة لصحتها وتحصين شرعيها ،ومحاولة قانون المسطرة المدنية الاستفادة من هذه المقتضيات لم يخل من تحفظ أو نقد ،فكانت المناسبة شرط لتعبر المحكمة الدستورية عن مخاوفها وهواجسها من ضرورة حماية حقوق الدفاع وتأطيرها بضمانات تشكل سياج للحق وفقا للفصول 120 و123 و 154 من الدستور ،وهكذا اعتبرت" حيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها علاقة بالضمانة الدستورية لحقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، وبمبدأ علنية الجلسات والاستثناءات التي ترد عليه قانونا، أن الدستور، لا يمنع حضور الأطراف عن بعد في جلسات المحاكم، وفق كيفيات يحددها القانون ولا تتعارض مع الضمانات الدستورية لحق التقاضي؛
وحيث إنه، وإن كان يعود للمشرع وفق سلطته التقديرية، تنظيم حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في جلسات تنعقد عن بعد بغية تجويد مرفق القضاء، فإن ضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، يوجبان التنصيص، في هذه الحالة وبصفة خاصة، على مقتضيات صريحة من شأنها ضمان قبول الطرف المعني بالحضور عن بعد، والتواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور الطرف المعني، وكذا سلامة وتمامية وسرية المعطيات المرسلة، بما في ذلك أمن تبادل وسائل الإثبات والوثائق وباقي أوراق الدعوى، وتنظيم حالات انقطاع التواصل عن بعد، والعودة إلى الشكل الحضوري، ثم يظل المشرع، وفق الدستور، مخيرا بين التصدي للتشريع في كيفية تنظيم الجلسات عن بعد، بما يكفل تحقيق المبادئ المذكورة التي تكتسي صبغة قانون، أو إسناد تحديد تلك الكيفية إلى نص تنظيمي يحيل إليه؛
وحيث إن صيغة الفقرة الأخيرة من المادة 90 المعروضة، اكتفت بالتنصيص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد، دون تحديد الشروط والإجراءات والضمانات المذكورة أعلاه، مما لم يستنفذ معه المشرع صلاحية التشريع في الحالة المعروضة، وبالتالي تكون الفقرة الأخيرة من المادة 90 غير مطابقة للدستور؛"
4-عدم دستورية تحصين مستنتجات المفوض الملكي من تعقيب الأطراف
رغم أن المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية لا يعتبر طرفا في الدعوى الإدارية ،فإن لمستنتجاته القيمة القانونية التي يمكنها التأثير على قناعة المحكمة وعلى موقف أطراف القضية وبالتالي يكون غير مقبول دستوريا تمكين الأطراف من المستنتجات دون حق التعقيب عليها احتراما لحقوق الدفاع وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " حيث إن الفقرتين المعروضتين، حرمتا الأطراف أو دفاعهم أو وكلاءهم من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق قبل حجز القضية للمداولة، وهو ما لا يضمن تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة، مما تكونان معه غير مطابقتين لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور؛".
5-عدم دستورية الإجراءات المتخذة حالة العثور على وصية
اعتبرت المحكمة الدستورية أن وجود خطأ في الإحالة على المادة المعنية بإجراءات العثور على الوصية يجعل المادة 188 لا تتوفر فيها شروط وضوح ومقروئية القوانين ،وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " ؛وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 288 بإحالتها على المادة 284، غير مستوفية لمتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية التي يفرضها المستفاد من مطلع الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، التي تعتبر "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، مما تكون معه مخالفة للدستور".
6-عدم دستورية تحصين أي قرار من التعليل
يعتبر التعليل من مقومات المحاكمة العادلة ومن أسس القضاء الشفاف والمستقل والمحايد والنزيه لعلاقة التعليل بإضفاء الثقة والمصداقية على قرارات السلطة القضائية المؤتمنة على حقوق الدفاع والساهرة على كفالتها وبالتالي لا يقبل أي تقييد او حظر للتعليل في الأحكام والقرارات القضائية،وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " إن الفصل 125 من الدستور أوجب أن "تكون الأحكام معللة..."، على سبيل الإطلاق، وبما لا يحتمل أي استثناء، وأسند إلى القانون تحديد شروط ذلك لا غير، وليس إرساء استثناء على المبدأ العام؛
وحيث إنه، يستفاد من صيغة الفقرة الثانية من المادة 339 المعروضة، بمفهوم المخالفة، أن القرار القاضي بالاستجابة لطلب التجريح لا يستلزم تعليلا، رغم أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على الاستماع لإيضاحات طالب التجريح والمطلوب تجريحه عندما تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، مما تكون معه الفقرة المذكورة غير مطابقة للدستور".
7-عدم دستورية إحالة وزير العدل الطعون أمام محكمة النقض من أجل شطط القضاة في استعمال سلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع
ان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يحتم كأمر بديهي الغاء أي دور لوزير العدل في المساطر القضائية،لذلك فإن المادتين 408 و 410 التي تنظم مساطر خاصة كالشطط في استعمال السلطة وطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع تتعلق بممارسة طعون أو مساطر قضائية ذات طابع قضائي بامتياز تعتبر مشوبة بعيب عدم الدستورية وفقا للفصلين 107 و 109 من الدستور،لأن وزير العدل كسلطة إدارية لا يمكنه أن يتدخل في أي مسطرة قضائية أو يقيم أي طعن ،لاسيما أن هذه المساطر مخولة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض حصرا على غرار ما استقر عليه الان اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من حلول رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في جميع الاختصاصات التي كانت تعود لوزير العدل في اطار المساطر القضائية.
وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية على أنه " يستفاد من أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المستدل بها، علاقة بالفقرتين المعروضتين، أن الوزير المكلف بالعدل عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، و أنه يترتب عن استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها، وهو ما تحقق في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته، وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع."
8-عدم دستورية مسك أو تدبير وزارة العدل للنظام المعلوماتي للمحاكم
الملاحظ أن المتتبعين للشأن القضائي طالما نادوا بإلغاء أي دور لوزارة العدل في مسك أو تدبير النظام المعلوماتي للمحاكم الذي يتعين أن يتبع للسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل باعتبار أن بياناته هي قضائية بامتياز ،وليست ذات طبيعة إدارية وهكذا حسمت المحكمة الدستورية الجدل بتأكيدها وجوب تبعية البرنامج للسلطة القضائية مؤكدة أن " العمل القضائي، في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628 مخالفة للدستور."
ثانيا-قراءة في منهج رقابة المحكمة الدستورية
الملاحظ أنه لأول مرة حسب علمنا أن المحكمة الدستورية تتبنى منهجا جديدا منتقدا في رقابتها على فحص دستورية قانون المسطرة المدنية بحيث اختارت منهج عدم ممارسة الرقابة الواسعة على جميع مواد القانون موضوع الإحالة، وخطت لنفسها رقابة ضيقة لنصوص بعينها دون جميع النصوص ،وهذا ما جعلها في مقدمة القرار تقول أي المحكمة أنها " في إطار مراقبتها لدستورية هذا القانون تراءى لها أن تثير فقط، المواد والمقتضيات التي بدت لها بشكل جلي وبيّن أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له؛"ومن وجهة نظري اعتبر هذا المنهج قاصر ولا يكفل رقابة دستورية حقيقية وفعلية لجميع مواد القانون ويمكن الجزم في أنها مقاربة انتقائية غير سليمة لأن الخرق الدستوري يكون خرقا دستوريا بصرف النظر عن كونه جسيما أو غير جسيم وكأن المحكمة تقول أنها لا تراقب إلا النصوص غير الدستورية البينة دون غيرها تحت ستار نظرية جديدة "نظرية الخرق الدستوري البين"وهذا يتناقض مع وظيفة المحكمة الدستورية وفقا للفصل 132 من الدستور الذي ينص صراحة على "إحالة القوانين للبت في مطابقتها للدستور" أي كلية وليس جزئيا ،وهذا يعني أنها تراقب الخرق الدستوري لجميع المواد بصرف النظر عن أهميته وقوته ودرجته،وذلك لا يدخل في الاختصاص التقديري للمحكمة واختياراتها ومناهجها وانما هو يدخل ضمن الاختصاص المقيد الذي يوجب عليها اعمال سلطتها لتحقيق رقابة دستورية شاملة غير محدودة لعدم وجود "مراقبة بالإهمال والترك" .
وتزداد عيوب أو مساوئ نظرية الخرق الدستوري البين في أنها تحرم المحكمة الدستورية في فحص نصوص متعددة كان يمكن التصريح بعدم دستوريتها ولم يتم التصريح بذلك صراحة لان المراقبة كانت انتقائية ولم تكن شاملة وممددة وغير مفهومة بتاتا .
ويكف أن ندلل على ذلك بعبارة غير موفقة وردت في القرار " من غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال" فهذه الصيغة هي اعلان صريح عن انكار للعدالة ،غير مقبول ويتنافى مع دور واختصاصات المحكمة الدستورية فهي مطالبة بفحص جميع مواد القانون موضوع الإحالة وقول كلمتها بشأنه إيجابا أو سلبا ،وليس صرف النظر وعدم ابداء الراي بشكل مدقق ومفصل في جميع جوانب مواد القانون .
ومن المهم الإشارة أن هذا القرار حاول الاقتباس من وظيفة محكمة النقض بشكل غير سليم لما تقوم بنقض القرارات وتكتفي بعلة واحدة دون باقي العلل،واذا كان لمحكمة النقض غاية أن النقض يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض وتمارس محكمة الإحالة صلاحياتها القانونية من جديد على ضوء وثائق الملف مع التقيد بوسيلة النقض ،فخلاف ذلك قرار المحكمة الدستورية نهائي ولا يمكن ارجاع القانون إليها من جديد لفحصه مرة ثانية طالما أنه قانون عاد وليس قانون تنظيمي،وبالتالي فالاقتباس خاطئ وغير مستساغ ،رغم أن هناك رأي مخالف داخل محكمة النقض نفسها لا يقبل بنظرية الرقابة الجزئية للوسائل وانما بالرقابة الكاملة على الوسائل ،يضاف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية لا تنظر في وسائل وانما في إحالة قانون بكامله وبتمامه.
وأتمنى أن يتاح النظر مستقبلا للمحكمة الدستورية لمراجعة مثل هذا الرأي غير السديد الذي تعتبر عواقبه وخيمة على العدالة والحقوق والحريات وحقوق الإنسان وعلى مكانة المحكمة نفسها في الاطار الدستوري للبلاد،لاسيما أن المحكمة أدخلتنا في مرحلة الشك عوض اليقين ،لكونها لم تقطع في دستورية أو عدم دستورية باقي المواد غير المشمولة بالمخالفة الصريحة للدستور وقصرت في واجبها في حماية حقوق المتقاضين في العديد من النصوص التي علقتها شوائب دستورية ولم يتم فحصها بشكل صريح وواضح وبين بلغة المحكمة الدستورية وبالتالي لم يتم مساعدة الحكومة ولا البرلمان في الاختيارات الدستورية لقانون المسطرة المدنية عقب احالته من جديد على مسطرة التشريع لاسيما وأنه غير محسوم إحالته لاحقا على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى احترام قرارها أو مدى احترام الاختيارات الدستورية بشكل عام،وبالتالي ضيعنا فرصة تاريخية أمام قانون مسطرة مدنية دستوري بمراقبة كاملة قد لا تكتب مستقبلا،لذا يقترح تغيير هذا المنهج غير العقلاني في الرقابة الذي فرض رقابة خجولة وصامتة تفتقد للجرأة والشجاعة اللازمين دعما لمقولة "كم حاجة قضيناها بتركها " وبالتالي فقرارها مشوب بعيب قانوني دقيق يسمى في قانون المسطرة المدنية بعدم الارتكاز على أساس .
ثالثا-حالات تعطيل المراقبة الدستورية في بعض مواد قانون المسطرة المدنية
رغم الإيجابيات المتعرض لها على أهميتها في قرار المحكمة الدستورية ،فإن الرقابة اعترتها مواطن الفراغ التي لم يتم للأسف سدها ومعالجتها رغم خطورة بعض مواد قانون المسطرة المدنية التي لم يتم فحصها بشكل دقيق تحت ستار " بصرف النظر عن فحص مدى دستورية باقي مواد القانون " بما تشكله من مساس جوهري بكل مرتكزات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المضمونة دستوريا من قبيل المسائل غير الدستورية التالية والتي تفقأ العين :
1-مساس قانون المسطرة المدنية بحق التقاضي كحق دستوري مضمون ؟
إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع.
وتأكيدا لذلك نصت المادة 118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون."
ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون أي مصون ومحترم وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام لا يقبل أي افتئات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات.
وتبعا لذلك يتأكد عدم دستورية أي مقتضى ورد في قانون المسطرة المدنية يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين فيما بينهم واحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها وكذا عدم جواز احداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء وتحدث تمييزا بينهم بحسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي ناهيتكم عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة اتجاه المواطنين دون ضابط موضوعي ؟مما سيشكل مخالفة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي،وهو ما ستتصدى له المحكمة الدستورية من خلال:
-احداث حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف -المادة 30 والنقض -المادة 375،ومنع الطعن فيها بحسب مبالغ معينة وهو تمييز للمتقاضين فيما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي وهو أمر مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية .
-احداث حصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية القرارات الإدانة -المادة 375 - بالمنع من نقضها ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الذي يمنع تحصين أي قرار اداري من الطعن.
-احداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الاخلال بواجب احترام المحكمة -المادة 93-بحيث يعتبر القرار نهائي وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته ، وفي ذلك مس بكفالة حق الدفاع ومكنه مراجعة وتصحيح الأحكام إن شابتها تجاوزات لأنه قد تكون إساءة في التفسير ويتعين دائما وضع رقابة على الأحكام لفحص قانونيتها وشرعيتها،لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
2--مساس قانون المسطرة المدنية باستقلال القاضي
نص الفصل 109 من الدستور على حماية استقلال القاضي بحيث يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليه ولو كانت من رئيس المحكمة ذاته ،لكن المادة 97 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 352 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية تنتهكان بشكل جسيم هذا المبدأ وتشكل مخالفة دستورية ،لما سمحت بتغيير القاضي المقرر في الملف سواء ابتدائيا او استئنافيا كلما كان هناك موجب دون أن تحصره بحالات لا يجوز فيها هذا التغيير حتى لا يتم انتقاص من استقلالية القاضي والتأثير عليه في احكامه وفي تدبيره لملفاته ،وهكذا فإن تعيين القاضي المقرر او المكلف يحتم اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية القاضي في اطار هذا التعيين عند تعدد القضاة او الأقسام او الغرف ،كما ان تغييره يجب ان يتم في اطار مراعاة عدم المس باستقلال القاضي.
3-مساس قانون المسطرة المدنية بمجانية القضاء
إذا كان الفصل 121 من الدستور ينص على أنه "يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي."فإنه تم انتهاك هذا الفصل في العديد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية من قبيل ليس فقط فرض رسوم مكلفة للمتقاضين بل اثقال كاهلهم بوضع ضمانات مالية على عدة طعون لا تقبل شكلا إلا ايداعها مع المقال أو الطعن ،وهكذا تم فرض غرامات فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر -المادة 430-والتعرض الخارج عن الخصومة -المادة 347-وتجريح القضاة -المادة 340 -ومخاصمتهم-المادة 425-والتشكك المشروع -المادة 409- ودعوى الزور لمادة 413-مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين الى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليس حق واجب الحماية وفقا للفصل 118 من الدستور.
4--مساس قانون المسطرة المدنية بحقوق الدفاع
ينص الفصل 120 من الدستور على أنه " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."
الملاحظ أن العديد من مقتضيات مواد قانون المسطرة المدنية تتضمن عيوب دستورية لخرقها مبادئ المحاكمة العادلة وحق التقاضي وكفالة حقوق الدفاع
وفي اطار تفعيل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة كان يتعين في اطار المادة 11 تخصيص المحكمة وحدها دون غيرها في اثارة تصحيح المسطرة ،لان اثارة أي طرف لدفع لا يحمل على صحته ومشروعية اثارته ،فالمحكمة وحدها من تملك حق انذار الأطراف او تنبيهم للاخلالات الشكلية والمسطرية وليس الأطراف ،لان بعض الدفوع قد لا تكون جدية او صحيحة .
وهكذا تم حرمان الأطراف في المادة 62 من حقهم في اثارة جميع الدفوع بعدم القبول أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية رغم أن الاستئناف له أثر ناشر ،ورغم أن بعض الدفوع بعدم القبول مرتبطة بحالة الطعن أمام محكمة الاستئناف ولا يمكن حرمان أي طرف من اثارتها لكونها حالة مستجدة تتعلق الأهلية أو انعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي مما يؤكد خرق حقوق الدفاع.
كما أن المادة 77 تنص على وجوب تضمين مقالات الدعوى والطعون بالاستئناف -المادة 216 -والطعن بالنقض -المادة 377- بيان الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ،وبطاقة تعريف المدعي تحت طائلة عدم القبول وهي بيانات لا علاقة لها بموضوع وستمس بجوهر الحق في التقاضي كحق مضمون وكفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة بسبب إجراءات شكلية غير مفيدة ولا أثر لها على الحق المحمي قانونا .
ومن نافلة القول أن المادة 78 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 353 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية ستمسان بحق المحاكمة في أجل معقول وما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تبليغ جميع الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية لمحامي الأطراف وليس لهم شخصيا ،سعيا لاختصار أمد البت في القضايا وصيانة حقوق الدفاع .
وفي نفس الاتجاه فإن المادة 84 ستعرقل حقوق الدفاع لأن الملاحظ من الناحية العملية ان جميع التبليغات للإدارات والأشخاص الاعتبارية تسلم للمكلف بتسيير مكتب ضبطها ولا تسلم للممثل القانوني لذا عوض اعتبار وضع طابع مكتب ضبط الإدارة بمثابة تبليغ قانوني سليم وفق ما يجري به العمل حاليا تم وضع حواجز على التبليغ بهدف عرقلة الحق في التقاضي والمساس بحقوق الدفاع وطلب بطلان التبليغ لأسباب واهية.
كما تم التنصيص في المادة 99 على ان عدم حضور المدعي او محاميه او وكيله في المسطرة الشفوية يرتب عدم قبول الدعوى لكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل ،وهذا يمس بحقوق الدفاع لكون اختيار التعامل الكتابي مع المحكمة يعني صراحة على أنه لا عبرة بحضوره او عدم حضوره على نتيجة الحكم ،فالمحكمة يمكنها اتخاذ إجراءات التحقيق في ولا يمكن ان نحكم بعدم قبول الدعوى نتيجة لعدم الحضور ونهمل الحق موضوع الدعوى ووجوب الحرص على حمايته.
كما أن المادة 101 وضعت جزاء قاس على عدم الادلاء بنسخ كافية من المستنتجات وهو استبعادها من الملف سواء بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية عوض تكليف من له المصلحة في تصويرها على نفقته على غرار تكليف الطرف الاخر بأداء الخبرة عند عدم أدائها ممن حكم عليه بذلك .
وفي نفس الاتجاه اعتبرت المادة 210 على أن عدم الادلاء بالنسخ الكافية لمقالات الطعن بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية -المادة 216 -أو محكمة النقض -المادة 377- يترتب عنه التشطيب على القضية عوض تولي كتابة الضبط تصوير النسخ غير الكافية مع اعتبارها بمثابة مصاريف قضائية لان الجزاءات المقررة قاسية وقد تعصف بالحقوق وذلك قياسا على طلب نسخة من الحكم عند عدم الادلاء بها من المحكمة المصدرة له .
وفضلا عن ذلك فالمادة 604 الناصة على أن اجل الطعن يسري اتجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه ابتداء من تاريخ التبليغ"تعتبر انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة ولحق التقاضي المضمون ولحقوق الدفاع،لأن أجل الطعن من النظام العام ويترتب عنه آثار قانونية خطيرة بترتيب آثار عدم قبول الطعن وحيث إن القاعدة أن تاريخ التبليغ يعتبر منطلقا لمن توصل به أي المواجه بالتبليغ، لأنه علم بتاريخ وساعة التبليغ وليس لمن قام بتحريك مسطرة التبليغ أي طالب التبليغ،لأنه لا يعلم متى تحقق بالضبط يوما وساعة تبليغ خصمه،لأن المبلغ لا يخبر ولا يعلم من سلم إليه التبليغ بتاريخه ولا يتحقق العلم إلا بتاريخ توصله بوثيقة التبليغ التي غالبا ما تكون خلال أيام يكون خلالها أجل الطعن قد انقضى نهائيا.
وتزداد المادة خطورة أمام تعبيرها بالشخص دون استثناء وكيله أو محاميه ،لأنه لا يمكن للمحامي ان يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه ،فتضيع الحقوق والحريات بفوات أجل للطعن لا يمكن العلم بتاريخ تحققه فعليا .
وهكذا فإن العدالة تقتضي نوعا من المساواة في مسطرة التبليغ فكل شخص ملزم بتبليغ خصمه فعليا وقانونيا ،ولا يمكن افتراض ذلك بتاريخ قيامه بتحريك مسطرة التبليغ لأنه قام بالإجراء لفائدة نفسه وليس ضدا على حقوقه.
وهذه المادة لا تخلو من غرابة وتعسف فكيف يعتبر باطلا كل تبليغ للمحامي اذا لم يكن موطنه محلا للمخابرة لموكله؟،وفي المقابل وعلى النقيض يعتبر صحيحا تبليغ المحامي وفق هذه المادة لأنه من أشرف على عملية التبليغ نيابة عن موكله؟ ،فكما لا يسري تبليغ المحامي على موكله ، لا يجب أن يسري القيام بالتبليغ على المحامي .
ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص بأجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
5-مساس قانون المسطرة المدنية بمبدأ المساواة بين المواطن والإدارة
نص الفصل 6 من الدستور على أن" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.."
لكن قانون المسطرة المدنية في المادة أحدث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ في المادة 383 ، بحيث أن الدولة واداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين الا بعد صدور قرار محكمة النقض في حين أن القرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيه، وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقا للفصل السادس من الدستور واحداث تمييز غير مقبول ،وانتهاك أيضا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع لا فرق بين المواطن والإدارة،كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز ،وأيضا انقلابا على قرارات محكمة النقض الحكيمة التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية حتى لا يتم افراغ الاحكام والمقررات القضائية من قيمتها و من الحق الذي تحميه.
6-مساس قانون المسطرة المدنية بتخصص القضاء
نص الفصل 127 من الدستور على أنه "تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون".
والملاحظ أن قانون المسطرة المدنية أحدث بالمخالفة للدستور أقسام هجينة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف العاديتين، وهي القسم الإداري و القسم التجاري وما هي بالعادية ولا بالمتخصصة،فهي خليط ومزيج لهيئات متخصصة شكليا في اطار المحاكم العادية،وهي مسألة غير مقبولة.
ومما لا شك فيه فان احداث اقسام متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية العادية يعتبر تراجع خطير عن المحاكم المتخصصة وخرق دستوري لاسيما بعد النتائج المثمرة التي تحققت بعد طول التجربة ،وان ما يعتبر كحجة من قبيل تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين يمكن تعويضه بالزيادة في عدد المحاكم وليس بالالتفاف على التخصص بأقسام لن تعرف من التخصص الا الاسم لاسيما ان القضاة المشكلين لها قد يمارسون أنواع أخرى من القضاء قد تفرغ التخصص من مضمونه وتعصف بجودة الحماية القضائية وبمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ، أي المواطنين الفقراء أصحاب القضايا ذات القيمة 80 الف درهم لهم الأقسام المتخصصة والمواطنين الأغنياء أصحاب القضايا ذات القيمة الأكبر يتمتعون بالمحاكم المتخصصة،ولعمري إنه عبث ليس بعده عبث .
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت اجتهادا مبدئيا قضت فيه بعدم دستورية نص ورد في قانون التنظيم القضائي يقضي بتعين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائب عنه في المحاكم التجارية في اطار ضمان تخصص القضاة والمحاكم بالنقيض لوحدة القضاة والنيابة العامة . وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية "أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛"قرار تحت عدد 19-89وتاريخ 8-2-2019 في الملف عدد 19-41 منشور بموقع المحكمة الدستورية على الانترنت.
وهكذا قضت المحكمة الدستورية منطوقا بما يلي " بأن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:" أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور،المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور".
ويستخلص من منطوق القرار أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية بعض المواد حصرا دون حاجة لفحص دستورية باقي المواد التي لم تتم الوقوف عندها بشكل صريح،وهذا يعني أن قانون المسطرة المدنية بهذا القرار افتقد لماهيته كقانون وصار وثيقة تشريعية سابقة مما يحتم على الحكومة وضع مشروع جديد يستجيب لقرار المحكمة الدستورية سواء المعلن عنه أو غير المعلن عنه بإعادة النظر في جميع مواد القانون احتراما للدستور كأسمى قانون في البلاد ،طالما أن المحكمة الدستورية لم تعتبر هذه المواد غير الدستورية يمكن فصلها عن القانون ويمكن الإذن بتنفيذ القانون بمعزل عنها باعتبارها تشكل وحدة متكاملة ومتجانسة ومترابطة من القانون لا يمكن تطبيق مقتضى دون غيره من النصوص أو المواد.
ومن المهم الإشارة أن المحكمة الدستورية عودتنا دوما على قرارات رائدة تراعي فيها أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه باعتبارها أمينة على الشرعية وسيادة القانون وللأمن القانوني والقضائي وحامية لحقوق المتقاضين ولقواعد سير العدالة ولحرمة مؤسسة الدفاع كمرتكز دستوري نحو تحقيق المطالب المنصفة والعادلة والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين لتأمين الدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون والولوج المستنير والآمن للعدالة من خلال قانون مسطرة مدنية منصف ودفاع قوي وقضاء مستقل ونزيه.
والحقيقة أنه لا يمكن ابداء الرأي بشأن تعليلات القرار وتوجهاته إلا بعد طرح المسائل غير الدستورية التي حسمها قرار المحكمة الدستورية،لنعقب بعدئذ على القرار ونقيمه وفق أدوار واختصاصات المحكمة الدستورية ومنهجها الجديد في الرقابة،والمواضيع التي غيبت عن الرقابة بشكل غير مفهوم رغم أن عدم دستوريتها تفقأ العين .
-أولا-قراءة في التوجهات الثمانية للمسائل غير الدستورية .
1- عدم دستورية منح النيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام دون قيد أو شرط
حسم قرار المحكمة الدستورية الانتقادات الموجهة للمادة 17 من هذا القانون وقررت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من قراءة دستورية موفقة مرتكزها الأساسي حماية الأمن القانوني وحجية المقررات القضائية وفق الفصل 126 من الدستور لما اعتبرت "إن كانت حماية المشرع للنظام العام في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، تشكل في حد ذاتها، هدفا مشروعا لا يخالف الدستور، فإنه يتعين على المشرع، عند مباشرة ذلك، استنفاذ كامل صلاحيته في التشريع، والموازنة بين الحقوق والمبادئ والأهداف المقررة بموجب أحكام الدستور أو المستفادة منها، على النحو الذي سبق بيانه؛
وحيث إن صيغة الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، خلت من التنصيص على حالات محددة يمكن فيها للنيابة العامة المختصة طلب التصريح ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به التي يكون من شأنها مخالفة النظام العام، واكتفت بتخويل هذه الصلاحية للنيابة العامة المختصة، تأسيسا على هذه العلة، ومنحت، تبعا لذلك، للنيابة العامة، طالبة التصريح بالبطلان، وللجهة القضائية التي تقرره، سلطة تقديرية غير مألوفة تستقل بها دون ضوابط موضوعية يحددها القانون، بما يتجاوز نطاق الاستثناء على حجية المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ويمس بمبدأ الأمن القضائي، فيكون المشرع بذلك، قد أغفل تحديد ما أسنده له الدستور في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، ضمن النطاق الموضوعي للبند التاسع من الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون الفقرة الأولى من المادة 17 المعروضة، غير مطابقة للدستور؛"
2- عدم دستورية التبليغ للأغيار دون ضوابط موضوعية تؤكد صحة التبليغ قانونا وواقعا
تنص الفقرة الرابعة من المادة 84 على أنه: " يجوز للمكلف بالتبليغ، عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم."؛
وحماية لحقوق الدفاع وللأمن القانوني أقرت المحكمة الدستورية بعدم صحة تبليغ الأغيار دون ضوابط موضوعية على تحقق التبليغ واقعا وقانونيا واستنادا لليقين لا الشك لأن الفقرة الرابعة من المادة 84 المعروضة، أقرت صحة تسليم الاستدعاء بمجرد تصريح شخص أنه وكيل المطلوب تبليغه أو أنه يعمل لفائدته، أو بمجرد تقدير المكلف بالتبليغ لظاهر بلوغ الساكنين مع المطلوب تبليغه، سن السادسة عشر، وأناطت بالمكلف بالتبليغ، حال إجرائه، تقدير عدم تعارض مصلحة المعني في التبليغ مع مصلحة الساكنين معه؛
وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية على أن " الصيغة المعروضة، فضلا عن تسويغها صحة تسليم الاستدعاء بناء على الشك والتخمين، لا على الجزم واليقين، ألقت على المكلف بالتبليغ، الذي يعد مخاطبا بالقاعدة القانونية، عبء التصرف في حالات لا يعود أمر تحديدها إلا للقانون، وأخلت بما للمطلوب تبليغهم من ثقة مشروعة في تطبيق قواعد التبليغ التي يعود للمشرع تحديدها، بما يضمن حقوقهم في التقاضي، مما يكون معه ما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 من أنه :" أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، مخالفا للدستور؛
وحيث إنه بالتالي، فإن المقتضيات التي أحالت على المقطع المذكور أعلاه، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 في فقرتها الأخيرة و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، تعد أيضا مخالفة للدستور."
وهكذا حماية لحقوق المواطنين ومخافة ضياع حقوقهم وخسارة دعاويهم او طعونهم بسبب تبليغ غير صحيح ولا ينسجم مع الواقع أو القانون يكون قرار المحكمة الدستورية قد أزال كل مسوغات غير دستورية تعصف بالأمن القانوني .
3-عدم دستورية التقاضي عن بعد دون وجود ضمانات تؤطر حقوق الدفاع
عرف التقاضي عن بعد نقاشات قانونية وحقوقية كبيرة خلال أزمة كورونا لاسيما في مجال المحاكمات الجنائية التي تم ربطها ممارسة وقضاء بأخذ قبول المتهم على هذه المسطرة لصحتها وتحصين شرعيها ،ومحاولة قانون المسطرة المدنية الاستفادة من هذه المقتضيات لم يخل من تحفظ أو نقد ،فكانت المناسبة شرط لتعبر المحكمة الدستورية عن مخاوفها وهواجسها من ضرورة حماية حقوق الدفاع وتأطيرها بضمانات تشكل سياج للحق وفقا للفصول 120 و123 و 154 من الدستور ،وهكذا اعتبرت" حيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها علاقة بالضمانة الدستورية لحقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، وبمبدأ علنية الجلسات والاستثناءات التي ترد عليه قانونا، أن الدستور، لا يمنع حضور الأطراف عن بعد في جلسات المحاكم، وفق كيفيات يحددها القانون ولا تتعارض مع الضمانات الدستورية لحق التقاضي؛
وحيث إنه، وإن كان يعود للمشرع وفق سلطته التقديرية، تنظيم حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في جلسات تنعقد عن بعد بغية تجويد مرفق القضاء، فإن ضمان حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، يوجبان التنصيص، في هذه الحالة وبصفة خاصة، على مقتضيات صريحة من شأنها ضمان قبول الطرف المعني بالحضور عن بعد، والتواصل المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور الطرف المعني، وكذا سلامة وتمامية وسرية المعطيات المرسلة، بما في ذلك أمن تبادل وسائل الإثبات والوثائق وباقي أوراق الدعوى، وتنظيم حالات انقطاع التواصل عن بعد، والعودة إلى الشكل الحضوري، ثم يظل المشرع، وفق الدستور، مخيرا بين التصدي للتشريع في كيفية تنظيم الجلسات عن بعد، بما يكفل تحقيق المبادئ المذكورة التي تكتسي صبغة قانون، أو إسناد تحديد تلك الكيفية إلى نص تنظيمي يحيل إليه؛
وحيث إن صيغة الفقرة الأخيرة من المادة 90 المعروضة، اكتفت بالتنصيص على إمكانية حضور الأطراف أو من ينوب عنهم في الجلسات المنعقدة عن بعد، دون تحديد الشروط والإجراءات والضمانات المذكورة أعلاه، مما لم يستنفذ معه المشرع صلاحية التشريع في الحالة المعروضة، وبالتالي تكون الفقرة الأخيرة من المادة 90 غير مطابقة للدستور؛"
4-عدم دستورية تحصين مستنتجات المفوض الملكي من تعقيب الأطراف
رغم أن المفوض الملكي بالمحاكم الإدارية لا يعتبر طرفا في الدعوى الإدارية ،فإن لمستنتجاته القيمة القانونية التي يمكنها التأثير على قناعة المحكمة وعلى موقف أطراف القضية وبالتالي يكون غير مقبول دستوريا تمكين الأطراف من المستنتجات دون حق التعقيب عليها احتراما لحقوق الدفاع وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " حيث إن الفقرتين المعروضتين، حرمتا الأطراف أو دفاعهم أو وكلاءهم من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق قبل حجز القضية للمداولة، وهو ما لا يضمن تكافؤ وسائل الدفاع بين أطراف المنازعة، مما تكونان معه غير مطابقتين لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور؛".
5-عدم دستورية الإجراءات المتخذة حالة العثور على وصية
اعتبرت المحكمة الدستورية أن وجود خطأ في الإحالة على المادة المعنية بإجراءات العثور على الوصية يجعل المادة 188 لا تتوفر فيها شروط وضوح ومقروئية القوانين ،وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " ؛وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة 288 بإحالتها على المادة 284، غير مستوفية لمتطلبات وضوح ومقروئية القواعد القانونية التي يفرضها المستفاد من مطلع الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، التي تعتبر "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، مما تكون معه مخالفة للدستور".
6-عدم دستورية تحصين أي قرار من التعليل
يعتبر التعليل من مقومات المحاكمة العادلة ومن أسس القضاء الشفاف والمستقل والمحايد والنزيه لعلاقة التعليل بإضفاء الثقة والمصداقية على قرارات السلطة القضائية المؤتمنة على حقوق الدفاع والساهرة على كفالتها وبالتالي لا يقبل أي تقييد او حظر للتعليل في الأحكام والقرارات القضائية،وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية " إن الفصل 125 من الدستور أوجب أن "تكون الأحكام معللة..."، على سبيل الإطلاق، وبما لا يحتمل أي استثناء، وأسند إلى القانون تحديد شروط ذلك لا غير، وليس إرساء استثناء على المبدأ العام؛
وحيث إنه، يستفاد من صيغة الفقرة الثانية من المادة 339 المعروضة، بمفهوم المخالفة، أن القرار القاضي بالاستجابة لطلب التجريح لا يستلزم تعليلا، رغم أن الفقرة الأولى من نفس المادة تنص على الاستماع لإيضاحات طالب التجريح والمطلوب تجريحه عندما تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، مما تكون معه الفقرة المذكورة غير مطابقة للدستور".
7-عدم دستورية إحالة وزير العدل الطعون أمام محكمة النقض من أجل شطط القضاة في استعمال سلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع
ان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يحتم كأمر بديهي الغاء أي دور لوزير العدل في المساطر القضائية،لذلك فإن المادتين 408 و 410 التي تنظم مساطر خاصة كالشطط في استعمال السلطة وطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع تتعلق بممارسة طعون أو مساطر قضائية ذات طابع قضائي بامتياز تعتبر مشوبة بعيب عدم الدستورية وفقا للفصلين 107 و 109 من الدستور،لأن وزير العدل كسلطة إدارية لا يمكنه أن يتدخل في أي مسطرة قضائية أو يقيم أي طعن ،لاسيما أن هذه المساطر مخولة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض حصرا على غرار ما استقر عليه الان اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من حلول رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في جميع الاختصاصات التي كانت تعود لوزير العدل في اطار المساطر القضائية.
وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية على أنه " يستفاد من أحكام الدستور والقوانين التنظيمية المستدل بها، علاقة بالفقرتين المعروضتين، أن الوزير المكلف بالعدل عضو في الحكومة التي تمارس السلطة التنفيذية، والتي تعتبر السلطة القضائية مستقلة عنها، و أنه يترتب عن استقلال السلطة القضائية، في ظل الدستور، عدم إسناد الاختصاصات المتعلقة بحسن سير الدعوى، في مجال التنظيم الإجرائي للدعاوى الخاضعة للمسطرة المدنية، إلا لمن يمارس السلطة القضائية دون سواها، وهو ما تحقق في الفقرتين المعروضتين اللتين أسندتا إلى محكمة النقض البت في طلب الإحالة من أجل تجاوز القضاة لسلطاتهم، أو من أجل التشكك المشروع بناء على طلب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، بوصفه أيضا رئيسا للنيابة العامة، وساهرا على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصها، وعلى حماية النظام العام والعمل على صيانته، وهو ما يجعل هاتين الحالتين تختلفان عن الحالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 411 المعروضة والتي خولت وزير العدل إمكانية تقديم طلبات الإحالة، على سبيل الوقاية، من أجل الأمن العمومي و هو طلب لا يمس باستقلال السلطة القضائية؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن الفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 مخالفتان للدستور فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع."
8-عدم دستورية مسك أو تدبير وزارة العدل للنظام المعلوماتي للمحاكم
الملاحظ أن المتتبعين للشأن القضائي طالما نادوا بإلغاء أي دور لوزارة العدل في مسك أو تدبير النظام المعلوماتي للمحاكم الذي يتعين أن يتبع للسلطة القضائية وليس للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل باعتبار أن بياناته هي قضائية بامتياز ،وليست ذات طبيعة إدارية وهكذا حسمت المحكمة الدستورية الجدل بتأكيدها وجوب تبعية البرنامج للسلطة القضائية مؤكدة أن " العمل القضائي، في كليته، مما تستقل به السلطة القضائية، ويعود معه إلى هذه السلطة لا غيرها مسك وتدبير هذا النظام، دون أن يحول ذلك، وفق ما يستقل المشرع بتقديره، من إمكانية التنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بخصوص النظام المذكور، وفي حدود التعاون بين السلط؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الفقرة الثانية من المادة 624 والفقرتان الثالثة والأخيرة من المادة 628 مخالفة للدستور."
ثانيا-قراءة في منهج رقابة المحكمة الدستورية
الملاحظ أنه لأول مرة حسب علمنا أن المحكمة الدستورية تتبنى منهجا جديدا منتقدا في رقابتها على فحص دستورية قانون المسطرة المدنية بحيث اختارت منهج عدم ممارسة الرقابة الواسعة على جميع مواد القانون موضوع الإحالة، وخطت لنفسها رقابة ضيقة لنصوص بعينها دون جميع النصوص ،وهذا ما جعلها في مقدمة القرار تقول أي المحكمة أنها " في إطار مراقبتها لدستورية هذا القانون تراءى لها أن تثير فقط، المواد والمقتضيات التي بدت لها بشكل جلي وبيّن أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له؛"ومن وجهة نظري اعتبر هذا المنهج قاصر ولا يكفل رقابة دستورية حقيقية وفعلية لجميع مواد القانون ويمكن الجزم في أنها مقاربة انتقائية غير سليمة لأن الخرق الدستوري يكون خرقا دستوريا بصرف النظر عن كونه جسيما أو غير جسيم وكأن المحكمة تقول أنها لا تراقب إلا النصوص غير الدستورية البينة دون غيرها تحت ستار نظرية جديدة "نظرية الخرق الدستوري البين"وهذا يتناقض مع وظيفة المحكمة الدستورية وفقا للفصل 132 من الدستور الذي ينص صراحة على "إحالة القوانين للبت في مطابقتها للدستور" أي كلية وليس جزئيا ،وهذا يعني أنها تراقب الخرق الدستوري لجميع المواد بصرف النظر عن أهميته وقوته ودرجته،وذلك لا يدخل في الاختصاص التقديري للمحكمة واختياراتها ومناهجها وانما هو يدخل ضمن الاختصاص المقيد الذي يوجب عليها اعمال سلطتها لتحقيق رقابة دستورية شاملة غير محدودة لعدم وجود "مراقبة بالإهمال والترك" .
وتزداد عيوب أو مساوئ نظرية الخرق الدستوري البين في أنها تحرم المحكمة الدستورية في فحص نصوص متعددة كان يمكن التصريح بعدم دستوريتها ولم يتم التصريح بذلك صراحة لان المراقبة كانت انتقائية ولم تكن شاملة وممددة وغير مفهومة بتاتا .
ويكف أن ندلل على ذلك بعبارة غير موفقة وردت في القرار " من غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال" فهذه الصيغة هي اعلان صريح عن انكار للعدالة ،غير مقبول ويتنافى مع دور واختصاصات المحكمة الدستورية فهي مطالبة بفحص جميع مواد القانون موضوع الإحالة وقول كلمتها بشأنه إيجابا أو سلبا ،وليس صرف النظر وعدم ابداء الراي بشكل مدقق ومفصل في جميع جوانب مواد القانون .
ومن المهم الإشارة أن هذا القرار حاول الاقتباس من وظيفة محكمة النقض بشكل غير سليم لما تقوم بنقض القرارات وتكتفي بعلة واحدة دون باقي العلل،واذا كان لمحكمة النقض غاية أن النقض يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض وتمارس محكمة الإحالة صلاحياتها القانونية من جديد على ضوء وثائق الملف مع التقيد بوسيلة النقض ،فخلاف ذلك قرار المحكمة الدستورية نهائي ولا يمكن ارجاع القانون إليها من جديد لفحصه مرة ثانية طالما أنه قانون عاد وليس قانون تنظيمي،وبالتالي فالاقتباس خاطئ وغير مستساغ ،رغم أن هناك رأي مخالف داخل محكمة النقض نفسها لا يقبل بنظرية الرقابة الجزئية للوسائل وانما بالرقابة الكاملة على الوسائل ،يضاف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية لا تنظر في وسائل وانما في إحالة قانون بكامله وبتمامه.
وأتمنى أن يتاح النظر مستقبلا للمحكمة الدستورية لمراجعة مثل هذا الرأي غير السديد الذي تعتبر عواقبه وخيمة على العدالة والحقوق والحريات وحقوق الإنسان وعلى مكانة المحكمة نفسها في الاطار الدستوري للبلاد،لاسيما أن المحكمة أدخلتنا في مرحلة الشك عوض اليقين ،لكونها لم تقطع في دستورية أو عدم دستورية باقي المواد غير المشمولة بالمخالفة الصريحة للدستور وقصرت في واجبها في حماية حقوق المتقاضين في العديد من النصوص التي علقتها شوائب دستورية ولم يتم فحصها بشكل صريح وواضح وبين بلغة المحكمة الدستورية وبالتالي لم يتم مساعدة الحكومة ولا البرلمان في الاختيارات الدستورية لقانون المسطرة المدنية عقب احالته من جديد على مسطرة التشريع لاسيما وأنه غير محسوم إحالته لاحقا على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى احترام قرارها أو مدى احترام الاختيارات الدستورية بشكل عام،وبالتالي ضيعنا فرصة تاريخية أمام قانون مسطرة مدنية دستوري بمراقبة كاملة قد لا تكتب مستقبلا،لذا يقترح تغيير هذا المنهج غير العقلاني في الرقابة الذي فرض رقابة خجولة وصامتة تفتقد للجرأة والشجاعة اللازمين دعما لمقولة "كم حاجة قضيناها بتركها " وبالتالي فقرارها مشوب بعيب قانوني دقيق يسمى في قانون المسطرة المدنية بعدم الارتكاز على أساس .
ثالثا-حالات تعطيل المراقبة الدستورية في بعض مواد قانون المسطرة المدنية
رغم الإيجابيات المتعرض لها على أهميتها في قرار المحكمة الدستورية ،فإن الرقابة اعترتها مواطن الفراغ التي لم يتم للأسف سدها ومعالجتها رغم خطورة بعض مواد قانون المسطرة المدنية التي لم يتم فحصها بشكل دقيق تحت ستار " بصرف النظر عن فحص مدى دستورية باقي مواد القانون " بما تشكله من مساس جوهري بكل مرتكزات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المضمونة دستوريا من قبيل المسائل غير الدستورية التالية والتي تفقأ العين :
1-مساس قانون المسطرة المدنية بحق التقاضي كحق دستوري مضمون ؟
إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع.
وتأكيدا لذلك نصت المادة 118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون."
ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون أي مصون ومحترم وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام لا يقبل أي افتئات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات.
وتبعا لذلك يتأكد عدم دستورية أي مقتضى ورد في قانون المسطرة المدنية يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين فيما بينهم واحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها وكذا عدم جواز احداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء وتحدث تمييزا بينهم بحسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي ناهيتكم عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة اتجاه المواطنين دون ضابط موضوعي ؟مما سيشكل مخالفة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي،وهو ما ستتصدى له المحكمة الدستورية من خلال:
-احداث حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف -المادة 30 والنقض -المادة 375،ومنع الطعن فيها بحسب مبالغ معينة وهو تمييز للمتقاضين فيما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي وهو أمر مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية .
-احداث حصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية القرارات الإدانة -المادة 375 - بالمنع من نقضها ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الذي يمنع تحصين أي قرار اداري من الطعن.
-احداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الاخلال بواجب احترام المحكمة -المادة 93-بحيث يعتبر القرار نهائي وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته ، وفي ذلك مس بكفالة حق الدفاع ومكنه مراجعة وتصحيح الأحكام إن شابتها تجاوزات لأنه قد تكون إساءة في التفسير ويتعين دائما وضع رقابة على الأحكام لفحص قانونيتها وشرعيتها،لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
2--مساس قانون المسطرة المدنية باستقلال القاضي
نص الفصل 109 من الدستور على حماية استقلال القاضي بحيث يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليه ولو كانت من رئيس المحكمة ذاته ،لكن المادة 97 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 352 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية تنتهكان بشكل جسيم هذا المبدأ وتشكل مخالفة دستورية ،لما سمحت بتغيير القاضي المقرر في الملف سواء ابتدائيا او استئنافيا كلما كان هناك موجب دون أن تحصره بحالات لا يجوز فيها هذا التغيير حتى لا يتم انتقاص من استقلالية القاضي والتأثير عليه في احكامه وفي تدبيره لملفاته ،وهكذا فإن تعيين القاضي المقرر او المكلف يحتم اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية القاضي في اطار هذا التعيين عند تعدد القضاة او الأقسام او الغرف ،كما ان تغييره يجب ان يتم في اطار مراعاة عدم المس باستقلال القاضي.
3-مساس قانون المسطرة المدنية بمجانية القضاء
إذا كان الفصل 121 من الدستور ينص على أنه "يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي."فإنه تم انتهاك هذا الفصل في العديد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية من قبيل ليس فقط فرض رسوم مكلفة للمتقاضين بل اثقال كاهلهم بوضع ضمانات مالية على عدة طعون لا تقبل شكلا إلا ايداعها مع المقال أو الطعن ،وهكذا تم فرض غرامات فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر -المادة 430-والتعرض الخارج عن الخصومة -المادة 347-وتجريح القضاة -المادة 340 -ومخاصمتهم-المادة 425-والتشكك المشروع -المادة 409- ودعوى الزور لمادة 413-مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين الى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليس حق واجب الحماية وفقا للفصل 118 من الدستور.
4--مساس قانون المسطرة المدنية بحقوق الدفاع
ينص الفصل 120 من الدستور على أنه " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."
الملاحظ أن العديد من مقتضيات مواد قانون المسطرة المدنية تتضمن عيوب دستورية لخرقها مبادئ المحاكمة العادلة وحق التقاضي وكفالة حقوق الدفاع
وفي اطار تفعيل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة كان يتعين في اطار المادة 11 تخصيص المحكمة وحدها دون غيرها في اثارة تصحيح المسطرة ،لان اثارة أي طرف لدفع لا يحمل على صحته ومشروعية اثارته ،فالمحكمة وحدها من تملك حق انذار الأطراف او تنبيهم للاخلالات الشكلية والمسطرية وليس الأطراف ،لان بعض الدفوع قد لا تكون جدية او صحيحة .
وهكذا تم حرمان الأطراف في المادة 62 من حقهم في اثارة جميع الدفوع بعدم القبول أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية رغم أن الاستئناف له أثر ناشر ،ورغم أن بعض الدفوع بعدم القبول مرتبطة بحالة الطعن أمام محكمة الاستئناف ولا يمكن حرمان أي طرف من اثارتها لكونها حالة مستجدة تتعلق الأهلية أو انعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي مما يؤكد خرق حقوق الدفاع.
كما أن المادة 77 تنص على وجوب تضمين مقالات الدعوى والطعون بالاستئناف -المادة 216 -والطعن بالنقض -المادة 377- بيان الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ،وبطاقة تعريف المدعي تحت طائلة عدم القبول وهي بيانات لا علاقة لها بموضوع وستمس بجوهر الحق في التقاضي كحق مضمون وكفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة بسبب إجراءات شكلية غير مفيدة ولا أثر لها على الحق المحمي قانونا .
ومن نافلة القول أن المادة 78 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 353 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية ستمسان بحق المحاكمة في أجل معقول وما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تبليغ جميع الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية لمحامي الأطراف وليس لهم شخصيا ،سعيا لاختصار أمد البت في القضايا وصيانة حقوق الدفاع .
وفي نفس الاتجاه فإن المادة 84 ستعرقل حقوق الدفاع لأن الملاحظ من الناحية العملية ان جميع التبليغات للإدارات والأشخاص الاعتبارية تسلم للمكلف بتسيير مكتب ضبطها ولا تسلم للممثل القانوني لذا عوض اعتبار وضع طابع مكتب ضبط الإدارة بمثابة تبليغ قانوني سليم وفق ما يجري به العمل حاليا تم وضع حواجز على التبليغ بهدف عرقلة الحق في التقاضي والمساس بحقوق الدفاع وطلب بطلان التبليغ لأسباب واهية.
كما تم التنصيص في المادة 99 على ان عدم حضور المدعي او محاميه او وكيله في المسطرة الشفوية يرتب عدم قبول الدعوى لكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل ،وهذا يمس بحقوق الدفاع لكون اختيار التعامل الكتابي مع المحكمة يعني صراحة على أنه لا عبرة بحضوره او عدم حضوره على نتيجة الحكم ،فالمحكمة يمكنها اتخاذ إجراءات التحقيق في ولا يمكن ان نحكم بعدم قبول الدعوى نتيجة لعدم الحضور ونهمل الحق موضوع الدعوى ووجوب الحرص على حمايته.
كما أن المادة 101 وضعت جزاء قاس على عدم الادلاء بنسخ كافية من المستنتجات وهو استبعادها من الملف سواء بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية عوض تكليف من له المصلحة في تصويرها على نفقته على غرار تكليف الطرف الاخر بأداء الخبرة عند عدم أدائها ممن حكم عليه بذلك .
وفي نفس الاتجاه اعتبرت المادة 210 على أن عدم الادلاء بالنسخ الكافية لمقالات الطعن بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية -المادة 216 -أو محكمة النقض -المادة 377- يترتب عنه التشطيب على القضية عوض تولي كتابة الضبط تصوير النسخ غير الكافية مع اعتبارها بمثابة مصاريف قضائية لان الجزاءات المقررة قاسية وقد تعصف بالحقوق وذلك قياسا على طلب نسخة من الحكم عند عدم الادلاء بها من المحكمة المصدرة له .
وفضلا عن ذلك فالمادة 604 الناصة على أن اجل الطعن يسري اتجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه ابتداء من تاريخ التبليغ"تعتبر انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة ولحق التقاضي المضمون ولحقوق الدفاع،لأن أجل الطعن من النظام العام ويترتب عنه آثار قانونية خطيرة بترتيب آثار عدم قبول الطعن وحيث إن القاعدة أن تاريخ التبليغ يعتبر منطلقا لمن توصل به أي المواجه بالتبليغ، لأنه علم بتاريخ وساعة التبليغ وليس لمن قام بتحريك مسطرة التبليغ أي طالب التبليغ،لأنه لا يعلم متى تحقق بالضبط يوما وساعة تبليغ خصمه،لأن المبلغ لا يخبر ولا يعلم من سلم إليه التبليغ بتاريخه ولا يتحقق العلم إلا بتاريخ توصله بوثيقة التبليغ التي غالبا ما تكون خلال أيام يكون خلالها أجل الطعن قد انقضى نهائيا.
وتزداد المادة خطورة أمام تعبيرها بالشخص دون استثناء وكيله أو محاميه ،لأنه لا يمكن للمحامي ان يتعقب آجال التبليغات أمام كثرة القضايا بمكتبه ،فتضيع الحقوق والحريات بفوات أجل للطعن لا يمكن العلم بتاريخ تحققه فعليا .
وهكذا فإن العدالة تقتضي نوعا من المساواة في مسطرة التبليغ فكل شخص ملزم بتبليغ خصمه فعليا وقانونيا ،ولا يمكن افتراض ذلك بتاريخ قيامه بتحريك مسطرة التبليغ لأنه قام بالإجراء لفائدة نفسه وليس ضدا على حقوقه.
وهذه المادة لا تخلو من غرابة وتعسف فكيف يعتبر باطلا كل تبليغ للمحامي اذا لم يكن موطنه محلا للمخابرة لموكله؟،وفي المقابل وعلى النقيض يعتبر صحيحا تبليغ المحامي وفق هذه المادة لأنه من أشرف على عملية التبليغ نيابة عن موكله؟ ،فكما لا يسري تبليغ المحامي على موكله ، لا يجب أن يسري القيام بالتبليغ على المحامي .
ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص بأجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
5-مساس قانون المسطرة المدنية بمبدأ المساواة بين المواطن والإدارة
نص الفصل 6 من الدستور على أن" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.."
لكن قانون المسطرة المدنية في المادة أحدث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ في المادة 383 ، بحيث أن الدولة واداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين الا بعد صدور قرار محكمة النقض في حين أن القرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيه، وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقا للفصل السادس من الدستور واحداث تمييز غير مقبول ،وانتهاك أيضا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع لا فرق بين المواطن والإدارة،كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز ،وأيضا انقلابا على قرارات محكمة النقض الحكيمة التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية حتى لا يتم افراغ الاحكام والمقررات القضائية من قيمتها و من الحق الذي تحميه.
6-مساس قانون المسطرة المدنية بتخصص القضاء
نص الفصل 127 من الدستور على أنه "تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون".
والملاحظ أن قانون المسطرة المدنية أحدث بالمخالفة للدستور أقسام هجينة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف العاديتين، وهي القسم الإداري و القسم التجاري وما هي بالعادية ولا بالمتخصصة،فهي خليط ومزيج لهيئات متخصصة شكليا في اطار المحاكم العادية،وهي مسألة غير مقبولة.
ومما لا شك فيه فان احداث اقسام متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية العادية يعتبر تراجع خطير عن المحاكم المتخصصة وخرق دستوري لاسيما بعد النتائج المثمرة التي تحققت بعد طول التجربة ،وان ما يعتبر كحجة من قبيل تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين يمكن تعويضه بالزيادة في عدد المحاكم وليس بالالتفاف على التخصص بأقسام لن تعرف من التخصص الا الاسم لاسيما ان القضاة المشكلين لها قد يمارسون أنواع أخرى من القضاء قد تفرغ التخصص من مضمونه وتعصف بجودة الحماية القضائية وبمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ، أي المواطنين الفقراء أصحاب القضايا ذات القيمة 80 الف درهم لهم الأقسام المتخصصة والمواطنين الأغنياء أصحاب القضايا ذات القيمة الأكبر يتمتعون بالمحاكم المتخصصة،ولعمري إنه عبث ليس بعده عبث .
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت اجتهادا مبدئيا قضت فيه بعدم دستورية نص ورد في قانون التنظيم القضائي يقضي بتعين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائب عنه في المحاكم التجارية في اطار ضمان تخصص القضاة والمحاكم بالنقيض لوحدة القضاة والنيابة العامة . وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية "أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛"قرار تحت عدد 19-89وتاريخ 8-2-2019 في الملف عدد 19-41 منشور بموقع المحكمة الدستورية على الانترنت.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.
ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.