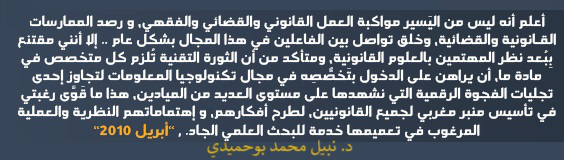إن انعدام الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية في ظل التجربة الأولى للإسلام حيث اعتبر النبي ﷺ رسولا لله ومؤسسا لكيان سياسي جديد، مع وجود قانون إلهي، هو الشريعة، يتسم بالسمو ويهتم بكافة مظاهر الحياة السياسية.. وصالح لكل زمان ومكان، جعل الفكر السياسي الإسلامي خاضعا لإكراهات ومعطيات وجودية لا يمكن تجاوزها بواسطة النظر العقلي الخالص.
لقد بقي الفكر السياسي الإسلامي أسير إشكالية التوفيق بين النظام المثالي لأفلاطون و مستلزمات احترام الشريعة، بيد أن الإقرار بهذه الحقيقة التاريخية لا يعني أن الفكر السياسي الإسلامي في القرون الوسطى متجانس من حيث مضمونه، ومتماثل من حيث اهتماماته، فإذا كان العديد من رجالاته، كالفارابي وابن سينا وابن باجة وابن طفيل قد أجهدوا أنفسهم من أجل استجلاء الشروط الضرورية لضمان سعادة الفرد والجماعة في ظل مجتمع يسوسه الحكماء، فإن البعض الآخر کَرَّسَ کل جهوده من أجل تبرير الحكم السلطاني أو إضفاء المشروعية الدينية على نظام الأمر الواقع، وإذا استثنينا ابن خلدون الذي حاول - لحد ما - تقديم بعض الاجتهادات العقلانية بخصوص قيام السلطة السياسية ومظاهر التغيير الذي تعرفه، فإن جل المفكرين الآخرين كالماوردي والطرطوشي والغزالي وابن تيمية بقوا متشبثين بالصيغ الفقهية الموروثة عند تناولهم للظواهر السياسية .
فإلى أي حد استطاع الفارابي أن يوفق بين الفلسفة والوحي؟
وكيف نظر الما وردي وابن خلدون إلى الدولة؟
المبحث الأول: الفارابي (870 - 950)
يعتبر الفارابي أول من حاول التوفيق بينا التراث السياسي الأفلاطوني والأديان السماوية، فإذا كان الفكر المسيحي في العصر الوسيط الم يستفد كثيراً من كتابات الفارابي السياسية رغم وجاهة النظريات التي تضمنتها، فإن العديد من الفلاسفة المسلمين واليهود اعترفوا بفضله العلمي، ولقبوه بالمعلم الثاني مقارنة بأرسطو.
المطلب الأول: مكانة السياسة المدنية بين العلوم الأخرى:
إن العلم المدني حسب الفارابي ليس رديفا لعلم الفقه الذي تتحد وظيفته في استنباط القواعد الشرعية في الامة التي لها شرع عن طريق الاستنتاج المنطقي فقط، أما مظاهر الاختلاف بين العلم المدني وعلم الكلام فهي ناتجة عن تباين طبيعتهما وتمايز وسائلهما، فإذا كان العلم المدني يسعى إلى استجلاء الشروط الموضوعية التي بها تضبط المدن والرئاسات الفاضلة لئلا تفسد وتستحيل إلى غير فاضلة، فإن صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضعوا الملة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل .
لقد وضع الفارابي العلم المدني في مرتبة أسمى وذلك بحكم طبيعة موضوعه والمناهج العقلية التي يعتمدها، صحيح أنه اعتبر في بعض كتاباته ان السعادة القصوى لا تدرك الا في الاخرة لكن ذلك لم يحل دون اعترافه بأن العلم المدني هو الذي يؤسس الفضيلة التي تفضي إلى السعادة الأبدية.
فالسعادة ممكنة التحقيق في حياة الفرد بشروط محددة معرفية وارادية، تتمثل في جودة التمييز والخلق الجميل، فهو بذلك يقرر بأن السياسة المدنية هي الكفيلة لإدراك السعادة.
المطلب الثاني: المدينة الفاضلة ومضاداتها:
إذا كان الفارابي جعل من الأمة افقا لمعالجة الأمور السياسة بتأثير الدين الإسلامي الذي برز كدعوة كونية موجهة لكافة البشر، فإن ذلك لا يعني استعماله هذا الاصطلاح بمعناه الاعتقادي الشائع، فعندما يتحدث عن المدن الجاهلية فلا يقصد مجتمع ما قبل الإسلام، بل تدل العبارة عن اية مدينة فسدت "آراءها" فالجهل هنا ضد المعرفة.
اما المدينة الفاضلة فهي التي تنال بها السعادة، لذلك فقد شبهها بالبدن الصحيح.
أما رئيس المدينة الفاضلة فهو الذي يقوم بدور المنظم وموزع المراتب الاجتماعية، فإذا كان الله هو الذي يرتب سائر الموجودات في الكون ويجعلها بإرادته الحكيمة تحذو حذوه وتقتفي غرضه باعتبار السبب الاول كما يقول الفارابي، فإن رئيس المدينة هو الذي يحدد تنظيم المجتمع وفق تراتبية هرمية تأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات الطبيعية للأفراد ودرجة تأدبهم بواسطة التدريب المستمر.
إن القاسم المشترك عند كافة المدن الجاهلية منها والفاسقة والضالة هو رفض اهلها رئاسة الرجل الفاضل، في حين أن المدن الفاضلة وحدها تتوفر على رؤساء يتمتعون بخصال حميدة، ومؤهلات استثنائية تجعلهم قادرين على مواجهة كل مظاهر التقهقر والانحلال، فالفيلسوف الملك يشبه النبي المشرع حسب الفارابي، باعتبار أن كلاهما يستند على العقل الفعال الذي يسمح للإنسان بتلقي الوحي، وهذا ما يخول له صلاحية تغيير القوانين في المدينة التي وضعها بنفسه أو تلك التي سنها الحكام السابقون، مع السهر على احترام القوانين الصالحة التي ارتكزت عليها المدينة الفاضلة أصلا.
وبذلك فإن الفارابي يجعل الحاكم في المدينة الفاضلة بمثابة فيلسوف نبي في نفس الوقت.
لقد رفض الفارابي، البقاء سجين الإطارات الشرعية أو إجهاد نفسه من اجل تبرير حكومة الأمر الواقع، كما فعل الماوردي الذي كان فکره يمثل أكمل تمثيل للفكر المتصالح مع الميراث المقر بكل مؤسساته القائمة.
المبحث الثاني: الماوردي وابن خلدون
إذا كان الفارابي قد انحاز إلى الفلسفة عند محاولته تعقل الواقع السياسي الذي عاش في ظله، فإن الماوردي وابن خلدون انطلاقا من العقيدة الدينية للكشف عن القواعد المعيارية التي تصلح شرعا لتأطير السلطة الفعلية وتهذيبها.
المطلب الأول: الماوردي: (974 - 1058)
لقد عايش الماوردي فترة انحلال الخلافة العباسية وبروز دول سلطانية استبدت بالقرار في أطراف الإمبراطورية ثم المركز بغداد، لذلك حاول تجاوز أزمة المشروعية السياسة التي عرفها العالم الإسلامي خلال القرن11، حيث راوده الأمل في تأصيل الخلافة من جديد، ارتكازا على أسس علم الفقه.
لقد كان الماوردي اول من اكتسح فضاء القانون العام وعالج قضياه المتعلقة بالسلطة السياسية وكل الاشكالات المتفرعة عنها، وهذا ما جعل مبادرته هاته رائدة ومحفوفة بالعديد من الصعاب.
لقد اعترف الماوردي بالأمر الواقع الذي فرضه مبدأ الغلبة بالقوة الذي انتهى إليه تطور التجربة العباسية، لكنه كفقيه ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشترط ضرورة خضوع الواقع السلطاني للمرجعية الدينية معتبرا اياه حارسا للشريعة وخاضعا لأحكامها، أما حينما يصعب تحقيق هذا الهدف على صعيد الممارسة الفعلية فإن الماوردي ينحو منحى توفيقيي يسعى أساسا للحفاظ على رموز النظام الشريعي ولو اسميا من خلال إلحاحه على ضرورة وجود "سلطان قاهر" والدعوة إلى الصبر عند ار تكابه للجور.
إن الوسيلة المثلى لتعيين الإمام حسب الماوردي هي بيعة أهل الحل والعقد الذين يراعون في اختيار الامام توفره على سبعة شروط:
1 - العدالة. 2 – العلم. 3 - سلامة الحواس. 4 - سلامة الأعضاء. 5- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية. 6 - الشجاعة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 7 - النسب أن يكون من قريش.
أما الشروط اللازم توفرها في أهل الاختيار فهي ثلاثة :1- العدالة الجامعة لشرو طها. 2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 3 – الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح.
2 - التمييز بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ:
ميز الماوردي بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، فوزارة التفويض التي تعطي صاحبها حق النيابة عن الإمام، فيما لا تخول لصاحبها وزارة التنفيذ سوى مكانة ثانوية بفعل واجب التزامه بتعليمات الإمام وعدم الخروج عليها اعتمادا على اجتهاده الشخصي، فالاستعانة بوزارة يضطلعون بمهام ووظائف الإمام تفرضها استحالة قيام هذا الأخير بمفردة بكل ما يقتضيه تدبير شؤون الأمة.
إن ما كان يهم الماوردي هو ايجاد إطار شكلي تمارس فيه وظيفة الوزارة في انسجام تام مع حقوق الإمام وصلاحياته العامة، أما المشاكل الواقعية التي يمكنها أن تترتب عن تواجد عدة مراكز للقرار السياسي، فإنه يتجاهلها تماما رغم أن تاريخ الإمبراطورية العباسية حافل بمواجهات شرسة بينا الخلفاء والوزراء.
3- تبرير إمارة الاستيلاء:
لقد حرص الماوردي على تأمين الغطاء الشرعي الذي يبرر إمارة الاستيلاء، فالماوردي يعي تماما ان اغتصاب الحكم بالقوة يشكل خروجا على القواعد والأعراف المعمول بها، لكنه يقر بضرورة التعامل الإيجابي مع هذه الظاهرة التي استفحلت في القرن 11، حيث اصبحت القبائل التركية تمارس سلطانها الخاص في العديد من الولايات.
لقد حاول الماوردي في سعيه كفقيه سلطاني إلى تحقيق كل التسويات الممكنة فقد كان لا يركض وراء المستحيل بل يطلب الممكن ادراكا منه أن ذلك يتيح له في النهاية ليس فقط الحفاظ على وحدة المجتمع والامة فحسب، بل دمج التطورات المستجدة في جسم الامة من خلال سيرورة تاريخية متكاملة ومتواصلة.
المطلب الثاني: ابن خلدون: (1332 - 1406)
رغم ان ابن خلدون لم يعش سوى في ظل انظمة سلطانية فإنه بقي مخلصا لطوبى كافة الفقهاء المسلمين، وهذا ما جعل فكره السياسي يتأرجح بين العقل التجريدي الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق التي تفرضها مقاصد الشريعة والعقل التجريبي الذي جعله يكتشف واقع العصبية القبلية ويرصد تأثيرها على عملية تداول السلطة، فابن خلدون يمثل نوعا واحدا من التطور العمراني (من البداوة إلى الحضارة) وبالتالي نوعا واحدا من الدولة (دولة الاستبداد).
إذا كان ابن خلدون يتمسك بالخلافة باعتبارها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإنه اضطر ايضا للاعتراف بمشروعية الملك الطبيعي القائم على " القهر والاستطالة " والذي لا يستهدف سوى تحقيق مصلحة السلطان، وهذا النموذج من ممارسة الحكم الذي يمكن تشبيهه بالطغيان حسب فلاسفة اليونان، لكونه يقوم على اغتصاب السلطة والاستبداد بها أدرجه ابن خلدون في خانة السياسة العقلية واعترف بوجوده في البلدان الإسلامية.
2 - نظرية العصبية:
تحتل نظرية العصبية مكانة مركزية في الفكر السياسي الخلدوني، الذي أبرز الأسباب الواقعية التي تحكم عملية تداول السلطة في المجتمعات الإسلامية إنه حاول تحديد شروط قيام السلطة والأسباب التي تؤدي إلى تدهورها وانهيارها.
فبعد تمييزه بين العمران البدوي الذي يجعل الأفراد أكثر شجاعة وبأسا، والعمران الحضري الذي يحفز على التكاسل والبذخ، اعتبر ابن خلدون ان العصبية تلك الرابطة الدموية أو المفترضة التي تجمع بين أعضاء قبيلة واحدة أو مجموعة من القبائل، والعصبية هي تجمع لجماعة بشرية متضامنة فيما بينها لمواجهة الاعداء، والهدف الأسمى الذي تتطلع إليه كل عصبية هو الوصول إلى الملك، والصراع من اجل السيطرة السياسية، ظاهرة متأصلة حتى داخل القبيلة الواحدة أحيانا.
3 - مفهوم الدولة:
يرتبط مفهوم الدولة عند ابن خلدون بنظريته في العصبية ارتباطا عضويا مما جعله مرادفا للتطورات التي يعرفها الحكم السياسي، فالدولة بالنسبة له تتجسد دائما في شخص أو تكتل من الاشخاص، يرتبط وجودهم في بقائهم في الحكم، وتنقرض بانحلال العصبية التي ينتمون اليها، مما جعله لا يميز بين الدولة ككيان مجرد يتسم الثبات والاستقرار بحكم المواصفات القانونية التي تجعل منه شخصا معنويا لا تخضع استمراريته للتغيير الذي يطرأ على قمة السلطة السياسية الممارسة من طرف فرد أو قبيلة أو عصيبة.
خاتمة:
إن انعدام الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية في ظل التجربة الأولى للإسلام حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لله ومؤسسا لکیان جدید، مع وجود قانون إلهي هو الشريعة، يتسم بالسمو، يهتم بكافة مظاهر الحياة السياسية، وصالح لكل زمان ومكان. جعل الفكر السياسي الإسلامي خاضعا لإكراهات ومعطيات وجودية لا يمكن تجاوزها بواسطة النظر العقلي.
لقد بقي الفكر السياسي الإسلامي أسير إشكالية التوفيق بين النظام المثالي لأفلاطون و مستلزمات احترام الشريعة، بيد أن الإقرار بهذه الحقيقة التاريخية لا يعني أن الفكر السياسي الإسلامي في القرون الوسطى متجانس من حيث مضمونه، ومتماثل من حيث اهتماماته، فإذا كان العديد من رجالاته، كالفارابي وابن سينا وابن باجة وابن طفيل قد أجهدوا أنفسهم من أجل استجلاء الشروط الضرورية لضمان سعادة الفرد والجماعة في ظل مجتمع يسوسه الحكماء، فإن البعض الآخر کَرَّسَ کل جهوده من أجل تبرير الحكم السلطاني أو إضفاء المشروعية الدينية على نظام الأمر الواقع، وإذا استثنينا ابن خلدون الذي حاول - لحد ما - تقديم بعض الاجتهادات العقلانية بخصوص قيام السلطة السياسية ومظاهر التغيير الذي تعرفه، فإن جل المفكرين الآخرين كالماوردي والطرطوشي والغزالي وابن تيمية بقوا متشبثين بالصيغ الفقهية الموروثة عند تناولهم للظواهر السياسية .
فإلى أي حد استطاع الفارابي أن يوفق بين الفلسفة والوحي؟
وكيف نظر الما وردي وابن خلدون إلى الدولة؟
المبحث الأول: الفارابي (870 - 950)
يعتبر الفارابي أول من حاول التوفيق بينا التراث السياسي الأفلاطوني والأديان السماوية، فإذا كان الفكر المسيحي في العصر الوسيط الم يستفد كثيراً من كتابات الفارابي السياسية رغم وجاهة النظريات التي تضمنتها، فإن العديد من الفلاسفة المسلمين واليهود اعترفوا بفضله العلمي، ولقبوه بالمعلم الثاني مقارنة بأرسطو.
المطلب الأول: مكانة السياسة المدنية بين العلوم الأخرى:
إن العلم المدني حسب الفارابي ليس رديفا لعلم الفقه الذي تتحد وظيفته في استنباط القواعد الشرعية في الامة التي لها شرع عن طريق الاستنتاج المنطقي فقط، أما مظاهر الاختلاف بين العلم المدني وعلم الكلام فهي ناتجة عن تباين طبيعتهما وتمايز وسائلهما، فإذا كان العلم المدني يسعى إلى استجلاء الشروط الموضوعية التي بها تضبط المدن والرئاسات الفاضلة لئلا تفسد وتستحيل إلى غير فاضلة، فإن صناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضعوا الملة، وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل .
لقد وضع الفارابي العلم المدني في مرتبة أسمى وذلك بحكم طبيعة موضوعه والمناهج العقلية التي يعتمدها، صحيح أنه اعتبر في بعض كتاباته ان السعادة القصوى لا تدرك الا في الاخرة لكن ذلك لم يحل دون اعترافه بأن العلم المدني هو الذي يؤسس الفضيلة التي تفضي إلى السعادة الأبدية.
فالسعادة ممكنة التحقيق في حياة الفرد بشروط محددة معرفية وارادية، تتمثل في جودة التمييز والخلق الجميل، فهو بذلك يقرر بأن السياسة المدنية هي الكفيلة لإدراك السعادة.
المطلب الثاني: المدينة الفاضلة ومضاداتها:
إذا كان الفارابي جعل من الأمة افقا لمعالجة الأمور السياسة بتأثير الدين الإسلامي الذي برز كدعوة كونية موجهة لكافة البشر، فإن ذلك لا يعني استعماله هذا الاصطلاح بمعناه الاعتقادي الشائع، فعندما يتحدث عن المدن الجاهلية فلا يقصد مجتمع ما قبل الإسلام، بل تدل العبارة عن اية مدينة فسدت "آراءها" فالجهل هنا ضد المعرفة.
اما المدينة الفاضلة فهي التي تنال بها السعادة، لذلك فقد شبهها بالبدن الصحيح.
أما رئيس المدينة الفاضلة فهو الذي يقوم بدور المنظم وموزع المراتب الاجتماعية، فإذا كان الله هو الذي يرتب سائر الموجودات في الكون ويجعلها بإرادته الحكيمة تحذو حذوه وتقتفي غرضه باعتبار السبب الاول كما يقول الفارابي، فإن رئيس المدينة هو الذي يحدد تنظيم المجتمع وفق تراتبية هرمية تأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات الطبيعية للأفراد ودرجة تأدبهم بواسطة التدريب المستمر.
إن القاسم المشترك عند كافة المدن الجاهلية منها والفاسقة والضالة هو رفض اهلها رئاسة الرجل الفاضل، في حين أن المدن الفاضلة وحدها تتوفر على رؤساء يتمتعون بخصال حميدة، ومؤهلات استثنائية تجعلهم قادرين على مواجهة كل مظاهر التقهقر والانحلال، فالفيلسوف الملك يشبه النبي المشرع حسب الفارابي، باعتبار أن كلاهما يستند على العقل الفعال الذي يسمح للإنسان بتلقي الوحي، وهذا ما يخول له صلاحية تغيير القوانين في المدينة التي وضعها بنفسه أو تلك التي سنها الحكام السابقون، مع السهر على احترام القوانين الصالحة التي ارتكزت عليها المدينة الفاضلة أصلا.
وبذلك فإن الفارابي يجعل الحاكم في المدينة الفاضلة بمثابة فيلسوف نبي في نفس الوقت.
لقد رفض الفارابي، البقاء سجين الإطارات الشرعية أو إجهاد نفسه من اجل تبرير حكومة الأمر الواقع، كما فعل الماوردي الذي كان فکره يمثل أكمل تمثيل للفكر المتصالح مع الميراث المقر بكل مؤسساته القائمة.
المبحث الثاني: الماوردي وابن خلدون
إذا كان الفارابي قد انحاز إلى الفلسفة عند محاولته تعقل الواقع السياسي الذي عاش في ظله، فإن الماوردي وابن خلدون انطلاقا من العقيدة الدينية للكشف عن القواعد المعيارية التي تصلح شرعا لتأطير السلطة الفعلية وتهذيبها.
المطلب الأول: الماوردي: (974 - 1058)
لقد عايش الماوردي فترة انحلال الخلافة العباسية وبروز دول سلطانية استبدت بالقرار في أطراف الإمبراطورية ثم المركز بغداد، لذلك حاول تجاوز أزمة المشروعية السياسة التي عرفها العالم الإسلامي خلال القرن11، حيث راوده الأمل في تأصيل الخلافة من جديد، ارتكازا على أسس علم الفقه.
لقد كان الماوردي اول من اكتسح فضاء القانون العام وعالج قضياه المتعلقة بالسلطة السياسية وكل الاشكالات المتفرعة عنها، وهذا ما جعل مبادرته هاته رائدة ومحفوفة بالعديد من الصعاب.
لقد اعترف الماوردي بالأمر الواقع الذي فرضه مبدأ الغلبة بالقوة الذي انتهى إليه تطور التجربة العباسية، لكنه كفقيه ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشترط ضرورة خضوع الواقع السلطاني للمرجعية الدينية معتبرا اياه حارسا للشريعة وخاضعا لأحكامها، أما حينما يصعب تحقيق هذا الهدف على صعيد الممارسة الفعلية فإن الماوردي ينحو منحى توفيقيي يسعى أساسا للحفاظ على رموز النظام الشريعي ولو اسميا من خلال إلحاحه على ضرورة وجود "سلطان قاهر" والدعوة إلى الصبر عند ار تكابه للجور.
- شروط الإمامة:
إن الوسيلة المثلى لتعيين الإمام حسب الماوردي هي بيعة أهل الحل والعقد الذين يراعون في اختيار الامام توفره على سبعة شروط:
1 - العدالة. 2 – العلم. 3 - سلامة الحواس. 4 - سلامة الأعضاء. 5- الرأي المفضي إلى سياسة الرعية. 6 - الشجاعة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. 7 - النسب أن يكون من قريش.
أما الشروط اللازم توفرها في أهل الاختيار فهي ثلاثة :1- العدالة الجامعة لشرو طها. 2- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة. 3 – الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح.
2 - التمييز بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ:
ميز الماوردي بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ، فوزارة التفويض التي تعطي صاحبها حق النيابة عن الإمام، فيما لا تخول لصاحبها وزارة التنفيذ سوى مكانة ثانوية بفعل واجب التزامه بتعليمات الإمام وعدم الخروج عليها اعتمادا على اجتهاده الشخصي، فالاستعانة بوزارة يضطلعون بمهام ووظائف الإمام تفرضها استحالة قيام هذا الأخير بمفردة بكل ما يقتضيه تدبير شؤون الأمة.
إن ما كان يهم الماوردي هو ايجاد إطار شكلي تمارس فيه وظيفة الوزارة في انسجام تام مع حقوق الإمام وصلاحياته العامة، أما المشاكل الواقعية التي يمكنها أن تترتب عن تواجد عدة مراكز للقرار السياسي، فإنه يتجاهلها تماما رغم أن تاريخ الإمبراطورية العباسية حافل بمواجهات شرسة بينا الخلفاء والوزراء.
3- تبرير إمارة الاستيلاء:
لقد حرص الماوردي على تأمين الغطاء الشرعي الذي يبرر إمارة الاستيلاء، فالماوردي يعي تماما ان اغتصاب الحكم بالقوة يشكل خروجا على القواعد والأعراف المعمول بها، لكنه يقر بضرورة التعامل الإيجابي مع هذه الظاهرة التي استفحلت في القرن 11، حيث اصبحت القبائل التركية تمارس سلطانها الخاص في العديد من الولايات.
لقد حاول الماوردي في سعيه كفقيه سلطاني إلى تحقيق كل التسويات الممكنة فقد كان لا يركض وراء المستحيل بل يطلب الممكن ادراكا منه أن ذلك يتيح له في النهاية ليس فقط الحفاظ على وحدة المجتمع والامة فحسب، بل دمج التطورات المستجدة في جسم الامة من خلال سيرورة تاريخية متكاملة ومتواصلة.
المطلب الثاني: ابن خلدون: (1332 - 1406)
رغم ان ابن خلدون لم يعش سوى في ظل انظمة سلطانية فإنه بقي مخلصا لطوبى كافة الفقهاء المسلمين، وهذا ما جعل فكره السياسي يتأرجح بين العقل التجريدي الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق التي تفرضها مقاصد الشريعة والعقل التجريبي الذي جعله يكتشف واقع العصبية القبلية ويرصد تأثيرها على عملية تداول السلطة، فابن خلدون يمثل نوعا واحدا من التطور العمراني (من البداوة إلى الحضارة) وبالتالي نوعا واحدا من الدولة (دولة الاستبداد).
- نقد السياسة المدنية:
إذا كان ابن خلدون يتمسك بالخلافة باعتبارها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، فإنه اضطر ايضا للاعتراف بمشروعية الملك الطبيعي القائم على " القهر والاستطالة " والذي لا يستهدف سوى تحقيق مصلحة السلطان، وهذا النموذج من ممارسة الحكم الذي يمكن تشبيهه بالطغيان حسب فلاسفة اليونان، لكونه يقوم على اغتصاب السلطة والاستبداد بها أدرجه ابن خلدون في خانة السياسة العقلية واعترف بوجوده في البلدان الإسلامية.
2 - نظرية العصبية:
تحتل نظرية العصبية مكانة مركزية في الفكر السياسي الخلدوني، الذي أبرز الأسباب الواقعية التي تحكم عملية تداول السلطة في المجتمعات الإسلامية إنه حاول تحديد شروط قيام السلطة والأسباب التي تؤدي إلى تدهورها وانهيارها.
فبعد تمييزه بين العمران البدوي الذي يجعل الأفراد أكثر شجاعة وبأسا، والعمران الحضري الذي يحفز على التكاسل والبذخ، اعتبر ابن خلدون ان العصبية تلك الرابطة الدموية أو المفترضة التي تجمع بين أعضاء قبيلة واحدة أو مجموعة من القبائل، والعصبية هي تجمع لجماعة بشرية متضامنة فيما بينها لمواجهة الاعداء، والهدف الأسمى الذي تتطلع إليه كل عصبية هو الوصول إلى الملك، والصراع من اجل السيطرة السياسية، ظاهرة متأصلة حتى داخل القبيلة الواحدة أحيانا.
3 - مفهوم الدولة:
يرتبط مفهوم الدولة عند ابن خلدون بنظريته في العصبية ارتباطا عضويا مما جعله مرادفا للتطورات التي يعرفها الحكم السياسي، فالدولة بالنسبة له تتجسد دائما في شخص أو تكتل من الاشخاص، يرتبط وجودهم في بقائهم في الحكم، وتنقرض بانحلال العصبية التي ينتمون اليها، مما جعله لا يميز بين الدولة ككيان مجرد يتسم الثبات والاستقرار بحكم المواصفات القانونية التي تجعل منه شخصا معنويا لا تخضع استمراريته للتغيير الذي يطرأ على قمة السلطة السياسية الممارسة من طرف فرد أو قبيلة أو عصيبة.
خاتمة:
إن انعدام الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية في ظل التجربة الأولى للإسلام حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لله ومؤسسا لکیان جدید، مع وجود قانون إلهي هو الشريعة، يتسم بالسمو، يهتم بكافة مظاهر الحياة السياسية، وصالح لكل زمان ومكان. جعل الفكر السياسي الإسلامي خاضعا لإكراهات ومعطيات وجودية لا يمكن تجاوزها بواسطة النظر العقلي.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 مختصر محاضرات في الفكر السياسي: الفكر السياسي الإسلامي
مختصر محاضرات في الفكر السياسي: الفكر السياسي الإسلامي