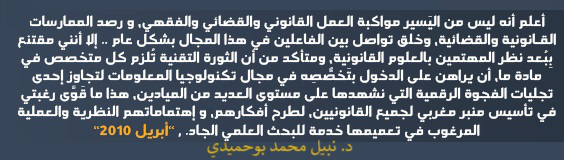يشهد المغرب اليوم مرحلة دقيقة تتسم بتقاطع مجموعة من التحولات الكبرى: تحديات اقتصادية ناتجة عن التقلبات العالمية في الأسواق، وارتفاع كلفة الطاقة والغذاء، وتداعيات التغيرات المناخية، فضلاً عن التحولات الاجتماعية المرتبطة بإصلاح أنظمة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية. وإلى جانب ذلك، يعيش البلد على إيقاع أوراش استراتيجية ضخمة ترتبط بتنظيم كأس العالم 2030، ما يفرض ضغطاً متزايداً على المالية العمومية.
في هذا السياق، يأتي مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كوثيقة مهيكلة تؤطر اختيارات الدولة المالية والاقتصادية في أفق المدى المتوسط، وتسعى إلى توطيد ركائز الاستقرار الماكرو-اقتصادي، من خلال تعزيز الموارد الذاتية، وضبط النفقات، وتحفيز الاستثمار المنتج. فالمشروع لا يكتفي بمجرد إعادة ترتيب أبواب الميزانية، بل يُعيد صياغة الفلسفة المالية للدولة وفق منطق جديد يجعل من العدالة الجبائية والتحول الرقمي مدخلين أساسيين لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والقيود المالية.
ومع ذلك، فإن المشروع يطرح إشكالية جوهرية تتجاوز حدود الأرقام والاعتمادات لتلامس عمق السياسات العمومية، وهي:
كيف يوفق مشروع قانون المالية لسنة 2026 بين هدف الاستدامة المالية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وبين ضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج، في إطار رؤية مالية جديدة قوامها الرقمنة والحكامة الجيدة؟
المحور الأول: إصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة العدالة الضريبية
يشكل الجانب الجبائي في مشروع قانون المالية حجر الزاوية في السياسة المالية الحديثة، إذ تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق الاستدامة الذاتية للموارد العمومية وتقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استمرار استيفاء الضرائب والرسوم وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع التنصيص الصريح على عدم جواز فرض أي ضريبة أو رسم دون سند قانوني، وهو تأكيد لمبدأ المشروعية الضريبية المكرس في الفصل 39 من الدستور، وضمانة للملزم ضد التعسف الإداري. كما أُجيز للحكومة اللجوء إلى الاقتراض في حدود ما تسمح به القوانين المالية، مما يعكس سعياً إلى الحفاظ على توازن بين تمويل النمو والاستقرار المالي.
وعلى صعيد المدونة العامة للضرائب، حمل المشروع تعديلات نوعية شملت عشرات المواد (من المادة 4 إلى 228)، تظهر انتقالا نحو منطق العدالة الجبائية التفاعلية. ومن أبرزها:
• توسيع الوعاء الضريبي ليشمل فئات جديدة من الأنشطة، منها الشركات الرياضية والمؤسسات الاستثمارية الفلاحية، مما يربط الضريبة بمردودية النشاط الاقتصادي الفعلي.
• تشجيع الاستثمار عبر تمديد الإعفاءات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية إلى 36 شهرا بدل 24، مما يعكس وعياً بأن جاذبية الاستثمار تتطلب استقراراً ضريبياً ومرونة في آجال التنفيذ.
• إلزام المقاولات بالتصريح الإلكتروني وتوفير عنوان إلكتروني رسمي للتواصل الضريبي (المادة 145)، وهو إجراء يندرج ضمن منطق الجباية الرقمية الشفافة التي تُمكِّن من تتبع دقيق للمعاملات وتقليص مظاهر الغش والتهرب.
بهذا المعنى، لم يعد الإصلاح الجبائي في المشروع مجرد تعديل تقني، بل تحول إلى مقاربة هيكلية شمولية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الإدارة والمكلف، وتحقيق عدالة جبائية مزدوجة: عدالة رأسية تضمن مساهمة كل فرد حسب قدرته التكليفية، وعدالة أفقية تساوي بين المكلّفين في وضعيات متماثلة.
المحور الثاني: الحكامة المالية والرقمنة كدعامة لتحديث الإدارة العمومية
إذا كان المحور الأول يتعلق بجانب الموارد، فإن المحور الثاني يخص جودة التدبير والشفافية. فقد تميز المشروع بتوجه واضح نحو الحكامة الرقمية وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة، لاسيما في مجال الجمارك والصفقات العمومية.
1. تحديث النظام الجمركي
أدخل المشروع تعديلات جوهرية على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث سمح للأعوان باستعمال التكنولوجيا المتقدمة (كالطائرات بدون طيار والماسحات الضوئية والكاميرات الذكية) في مراقبة حركة السلع، بما يعزز من قدرات الدولة في مكافحة التهريب والاحتيال الجمركي.
كما تم استحداث مفهوم “مقصد البضائع”، الذي يلزم المستوردين بتحديد وجهة السلع المستوردة بشكل دقيق، مع مراقبتها إلكترونيا حتى لحظة تخزينها أو تحويلها. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إدارة جمركية ذكية تتسم بالشفافية وسرعة التتبع.
إلى جانب ذلك، أحدث المشروع منصة إلكترونية مؤمنة لتبسيط إجراءات الاستخلاص الجمركي (الفصل 76 المكرر مرتين)، مما يختصر الزمن الإداري ويُقلل من التكاليف، ويجعل من الرقمنة وسيلة لتحقيق الفعالية الاقتصادية أكثر من كونها مجرد خيار إداري.
2. ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية
ينص المشروع على جملة من الإجراءات التي تُكرّس الرقابة المالية الذاتية وتربطها بمسؤولية الأطراف المعنية. فقد فرضت المادة 139 على الموثقين واجب إطلاع المتعاقدين على النصوص القانونية المتعلقة بالتسجيل، مما يُحمّلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية في ضمان مطابقة العقود للقانون.
كما تم تحديد واجب التسجيل بالنسبة للصفقات العمومية بنسبة 0.1%، مع تحميل المقاولات المنفذة مسؤولية أداء هذه الواجبات. هذه الإجراءات تُؤسس لمنظومة مالية تقوم على التتبع والمساءلة بدل الاكتفاء بالمراقبة اللاحقة.
إلى جانب ذلك، تم التنصيص على عقوبات ضد الموظفين الذين يمنحون إعفاءات غير مشروعة، في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً، وهو ما يجعل من المشروع وثيقة تؤسس لتوازن جديد بين السلطة المالية والمساءلة القانونية.
خاتمة
إن القراءة التحليلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تبرز أنه ليس مجرد إطار محاسبي لتوزيع النفقات وتقدير المداخيل، بل يمثل تحولا في فلسفة التدبير المالي العمومي بالمغرب. فالمشروع يُعيد رسم ملامح العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمع من خلال ثلاث ركائز أساسية:
1. عدالة جبائية أكثر شمولا، تضمن تمويل السياسات العمومية بشكل منصف ومستدام.
2. تحول رقمي مؤسسي يعيد الثقة في الإدارة المالية ويقلص من مظاهر الغش والفساد.
3. حكامة مالية رشيدة ترسخ مبدأ المساءلة وتربط الموارد بالنفقات وفق منطق النتائج.
غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في النصوص بقدر ما يكمن في القدرة على تفعيلها بفعالية وعدالة. فالتنزيل السليم لهذا المشروع يقتضي إرادة سياسية قوية، وإدارة كفؤة، ورقابة مواطنة واعية، حتى تتحول الوثيقة المالية من مجرد قانون سنوي إلى رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة في أفق 2030.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 مشروع قانون المالية لسنة 2026: العدالة الجبائية في خدمة الاستدامة المالية والتنمية الشاملة
مشروع قانون المالية لسنة 2026: العدالة الجبائية في خدمة الاستدامة المالية والتنمية الشاملة