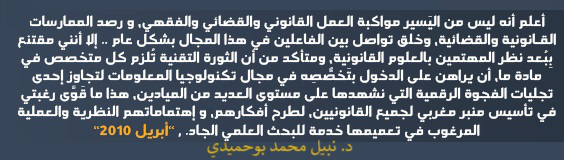أثارت المحكمة الدستورية بإصدارها القرار عدد 25/255 م.د بشأن مدى مطابقة قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، لأحكام الدستور، نقاشًا واسعًا لم يقتصر صداه على الوسط القانوني فحسب، بل امتد ليشمل الفاعلين السياسيين والمهتمين بالشأن التشريعي بوجه عام؛ مما سلط الضوء على أهمية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، ودور المحكمة في تنقية وتطهير المنظومة التشريعية من النصوص المخالفة لأحكام الدستور.
ومن هذا المنطلق فقد تجلى من مختلف التحليلات والقراءات التي رافقت صدور هذا القرار التأكيد على الأهمية المزدوجة للمحكمة الدستورية: من جهة، باعتبارها حارسًا أعلى للدستور يملك صلاحية التصريح بعدم مطابقة النصوص المخالفة لأحكامه وكشف مكامن العوار الدستوري فيها؛ ومن جهة أخرى، كأداة لتعزيز الثقة في المنظومة التشريعية وترسيخ مكانة دولة الحق والقانون، من خلال حماية الحقوق والحريات وصون التوازن بين السلطات.
هذا النقاش لم يكن معزولًا عن سياق أوسع، فقد سبق لرئيس المحكمة الدستورية أن أطلق دعوة لتعزيز ثقافة الإحالة على المحكمة الدستورية، أكد من خلالها أن (اللجوء الى القضاء الدستوري ليس عيبا)، بل هو حق قانوني مشروع يروم ضمان احترام الدستور وصون الحقوق والحريات؛ وهي دعوة تستند إلى حقيقة أن حصيلة الإحالات منذ إحداث الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى إلى اليوم تظل محتشمة، ولا ترقى إلى مستوى ما يفرضه التطور المتسارع للظاهرة التشريعية من ضرورة تكثيف الرقابة القبلية والبعدية على القوانين.
من هنا تبرز أهمية الأبعاد التي حملها القرار 255/25 م.د، سواء من حيث تكريس المحكمة الدستورية لوظيفتها كحارس أعلى للدستور، أو من حيث استحضار الدعوة إلى تعزيز ثقافة الإحالة على المحكمة الدستورية لما يمكن أن تحمله من تحفيز للفاعل البرلماني نحو تبني هذه المنهجية وترسيخها ضمن الممارسة التشريعية.
انطلاقًا من هذه الأفكار التمهيدية، سنتناول بعض الجوانب المرتبطة بالقيود والتحديات التي تواجه القضاء الدستوري المغربي (المحور الأول)، ثم ننتقل بعد ذلك إلى إبراز أهمية القرار موضوع الدراسة في اتجاه تعزيز وتفعيل أكبر لدور القضاء الدستوري ببلادنا (المحور الثاني).
المحور الأول: قيود وتحديات تواجه القضاء الدستوري المغربي
إذا كانت الديموقراطية تُقاس بشكل أساسي وفقًا لثلاثة معايير: سير العمل المنتظم للمؤسسات، تنظيم الانتخابات بانتظام وشفافية، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين من خلال القضاء، فإن القاضي الدستوري يعتبر في قلب النظام الديمقراطي، حيث تعتمد فعاليته بشكل كبير على استقلاليته وشجاعته؛ فمن خلال وظيفته في مراقبة دستورية القوانين وتنظيم سير عمل المؤسسات، يلعب القاضي الدستوري دورا حيويا في الحياة السياسية والمؤسساتية.
في المغرب، يواجه القضاء الدستوري مجموعة من القيود والتحديات التي تحدّ من فعاليته، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، مما يؤثر على قدرته في ضمان دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات؛ خاصة إذا علمنا أن الغالبية العظمى من الأحكام التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية هي جزء من القوانين العادية التي غالبًا ما تكون بعيدة عن رقابة القاضي الدستوري.
وتشمل هذه التحديات ندرة ومحدودية الإحالات خارج نطاق الاحالات الالزامية، حيث يظل اللجوء إلى القضاء الدستوري ضعيفًا مقارنة بحجم التشريعات الصادرة عن المؤسسة التشريعية؛ مما يقلل من فرص مراقبة مدى مطابقتها للدستور.
كما أن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المحكمة الدستورية يفرض بعض القيود، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية الأفراد الدفع بعدم الدستورية؛ حيث يعرف تفعيل الحق في الطعن بعدم الدستورية تأخرا ملحوظا، مما يحول دون تمكين الأفراد من الطعن في القوانين التي قد تمس بحقوقهم الدستورية.
على المستوى المقارن، شهد القضاء الدستوري الفرنسي مسارًا تطوريًا لافتًا، إذ بعدما كان في البداية أحد المكونات الأكثر انتقادًا و"ازدراءً" في النظام الفرنسي في بداية الجمهورية الخامسة، أصبح اليوم أحد عناصر النظام الدستوري والسياسي الفرنسي الأكثر أهمية وأصالة.
غير أن المؤسس والمشرع الفرنسيين إن كانا قد نجحا بفضل هذا التحول في تجاوز الحذر – بل وحتى الشك – الذي كان يميز علاقاتهما مع العدالة الدستورية، فإنه في السياق المغربي، يرى بعض الباحثين أن المشرع يميل إلى فكرة "عُلوية القانون" مقابل عدم تفضيله لإعمال الرقابة الدستورية. أو في أحيان أخرى يمارس القضاء الدستوري نفسه رقابة "الحد الأدنى" إزاء بعض القوانين ذات الحساسية السياسية.
ومن جهة أخرى، -ومن دون التشكيك في دستورية أي نص بعينه- يبدو واضحًا أن بعض القوانين التي دخلت حيز التنفيذ -حسب الفقيه الدستوري محمد أمين بنعبد الله- بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحقوق والحريات، كان من الأجدر إخضاعها لرقابة القاضي الدستوري قبل إصدارها؛ وهذا يؤكد أن آلية الرقابة الدستورية، رغم أهميتها، لا تزال غير موظفة بالشكل الأمثل، وهو ما قد يؤدي إلى تمرير نصوص تشريعية كان من الممكن إعادة النظر فيها لو تم اخضاعها لفحص الدستورية.
ومن هذه الزاوية، يكتسي قرار المحكمة الدستورية أهمية كبرى في إعادة صياغة منهجية جديدة، قائمة على ترسيخ ثقافة الإحالة وتعزيز الرقابة القبلية على القوانين –العادية تحديدا- بما يضمن انسجامها مع الدستور.
المحور الثاني: نحو تفعيل أكبر لدور القضاء الدستوري المغربي
إذ كان القضاء الدستوري المغربي يعمل حاليًا في سياق دستوري يختلف، من حيث الأبعاد والطبيعة، عمّا كان عليه في السابق، فإن حجم الإحالات الواردة من البرلمان على المحكمة الدستورية لم يعرف تطورًا ملحوظًا يواكب هذا التحول، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب محدودية اللجوء إلى هذه الآلية الدستورية وأثر ذلك على تفعيل الرقابة على دستورية القوانين.
ومن هنا تحضر الدعوة التي سبق وأطلقها رئيس المحكمة الدستورية باعتبارها نابعة من نظرة عميقة وفاحصة لوضع هذه المؤسسة بالمغرب، وتعبر عن رؤية مُستشرفة لأفق أفضل قائم على التعاون والاحترام المتبادل بين مكونات السلطات الأساسية بالدولة.
هذا الرأي يعني أن اللجوء إلى القضاء الدستوري “ليس عيبا ولا يعبر عن صراع أو عراكٍ بين السلطات“، -وفق تعبير رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله-؛ بل هو ممارسة تبتغي تطهير القوانين بطريقة دستورية حتى تصير بكاملها تابعة للدستور.
إن الاعتبارات سالفة الذكر تجعل من الضروري إيجاد التوازن بين الاستقلالية القضائية واحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال المؤسسات الديمقراطية. فالقاضي الدستوري سلطة مُؤسَّسة ولا ينصب نفسه كصاحب سيادة، بتعبير الفقيه "ميشل تروبي". فإذا ما انتقد البرلمان أو ألغى قراراته، فهذا ليس لأنه يفرض وجهات نظره الخاصة على ممثل السيادة، بل لأنه يقارن قرارات الممثل (البرلمان) بمقاصد السلطة التأسيسية، أي الشعب نفسه.
وإذا كانت الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة أحياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، إلا أنه باستقراء التجربة المغربية يلاحظ أنه حتى في حالات الجدل والخلافات التي تثيرها بعض النصوص القانونية فإنها لا تحال على المحكمة الدستورية.
ولعل محدودية الإحالات هذه ترجع الى عدة أسباب، الأمر الذي يحد من دور المحكمة كآلية للفصل في القضايا الدستورية وتعزيز سيادة القانون. ويمكن تفسير ضعف اهتمام نواب الأمة بإحالة القوانين على القضاء الدستوري لمراقبة دستوريتها بعدة عوامل متشابكة، أبرزها ضعف الوعي بأهمية الرقابة الدستورية، والاعتقاد السائد بأن التأثير الحقيقي في مجريات الأمور لا يتحقق إلا عبر آليات الرقابة السياسية على الحكومة، باعتبارها الأكثر قدرة على التأثير الفوري والمباشر في التوازنات السياسية.
إلى جانب ذلك، ترسخت لدى الفاعلين البرلمانيين ممارسات تكرّس الاعتماد على الحلول السياسية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الدستوري، حيث يُفضلون التوافقات السياسية أو الاحتكام إلى المؤسسة الملكية في القضايا الخلافية، على اللجوء إلى القضاء الدستوري...؛ ويعزز هذا التوجه ظواهر سياسية أخرى كالغياب عن جلسات مناقشة القوانين، مما يضعف جودة الصياغة القانونية ويفسح المجال لتمرير مقتضيات غير دستورية دون رقابة القاضي الدستوري.
يمثل هذا الوضع جزء من القيود والتحديات التي تحدّ من فعالية القضاء الدستوري ببلادنا، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، مما يؤثر على قدرته في ضمان دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات. وتشمل هذه التحديات –كما سلف الذكر- ندرة ومحدودية الإحالات الاختيارية من قبل الجهات ذات الصفة، حيث يظل اللجوء إلى القضاء الدستوري ضعيفًا مقارنة بحجم التشريعات الصادرة عن المؤسسة التشريعية.
وسيلاحظ المتتبع للحياة السياسية تواتر حالات الجدل والخلاف حول عدد من القوانين، ما يجعل المنظومة التشريعية المغربية المتضرر الأكبر من هذا الوضع، إذ ظلت هذه القوانين بمنأى عن رقابة الدستورية، خاضعة لمنطق الأغلبية دون إيلاء الاعتبار الكافي لمواقف المعارضة، لا سيما وأن هذه الرقابة تعتمد في الأصل على ما تقرره الأغلبية.
من هنا، تبرز الحاجة إلى إصلاحات تضمن استقلالية القضاء الدستوري وتعزز دوره، مثل تسهيل ولوج المواطنين إلى المحكمة الدستورية، وتفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية، وتغيير النظرة إلى المحكمة الدستورية باعتبارها "جزءا أساسيا من الحوار القانوني بين السلطات، وليس كأداة للاعتراض أو المواجهة مع الآخر؛ حيث أن دورها يكمن في تعزيز التوازن والتكامل بين السلطات، وضمان احترام الدستور كمرجعية عليا تحكم العلاقات بين مختلف الفاعلين والمؤسسات"، بتعبير الفقيه الدستوري محمد أمين بنعبد الله.
غير أن الأمر، يقتضي تغييرا في نظرة اللجوء إلى هذه المؤسسة، لكن "هذه الثقافة لا يمكن أن تتطور بين عشية وضحاها، بل تتطلب جهدًا مستمرًا من جميع الأطراف لتشجيع استخدام المحكمة كأداة للمراجعة والتصحيح القانوني". بحيث ينبغي تحسين الوضع الحالي لتمكين المحكمة من أداء مهامها بشكل أكثر فعالية، مما يسمح لها بممارسة دورها بشكل منتظم في فحص دستورية القوانين وتنقية النظام القانوني.
ومن هنا يمكن القول، إنه بصرف النظر عما سُجل من ملاحظات تتعلق بقرار المحكمة الدستورية رقم 255/25 م.د نفسه، والتي تبقى ملاحظات مؤسسة ووجيهة، إلا أنه مع ذلك يمثل القرار في حد ذاته بادرة إيجابية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام تفعيل أوسع لدور القضاء الدستوري المغربي، سواء على مستوى حماية الحقوق والحريات، أو على صعيد ترسيخ مبدأ سمو الدستور وضبط جودة العملية التشريعية.
خاتمة:
إن إحالة قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية بمبادرة من رئيس مجلس النواب تمثل خطوة دالة يمكن أن تسهم في تكريس ثقافة دستورية قائمة على مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسسات الدستورية، في أفق تعزيز قيم الديمقراطية وحماية مقوماتها.
وعلاوة على ذلك، فإن الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الدستوري في صيانة الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور يكتسب كامل فعاليته من خلال التفاعل الإيجابي والبنّاء مع السلطة التشريعية، حيث يشكل البرلمان الحاضنة الأساسية لصياغة التشريعات وانتاج القوانين والمحكمة الدستورية حارساً أعلى للدستور.
هذا يعني أن القاضي الدستوري يعتمد بشكل كبير على حسن نية فاعلين آخرين لممارسة سلطته، الأمر الذي يندرج ضمنه مغزى التساؤل الذي سبق وطرحه للنقاش رئيس المحكمة الدستورية حول عدم مبادرة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، إلى توجيه أي قانون مثير للجدل إلى المحكمة الدستورية، رغم أنهما يمتلكان الحق في ذلك.
ختامًا، بالنظر لحجم وأهمية النقاش الذي خلقه قرار المحكمة الدستورية بخصوص المسطرة المدنية وسط الفاعلين القانونيين والحقوقيين فقد طرح التساؤل حول ما إذا كان سيتم تكريس هذه المنهجية عبر إحالة قانون المسطرة الجنائية بدوره على المحكمة الدستورية، قصد إخضاع مضامينه لاختبار مدى مطابقتها لأحكام الدستور. غير أن ذلك لم يحصل في نهاية المطاف، وهو ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 القرار 255/25 للمحكمة الدستورية: نحو ترسيخ رقابة دستورية ضامنة للحقوق والحريات
القرار 255/25 للمحكمة الدستورية: نحو ترسيخ رقابة دستورية ضامنة للحقوق والحريات