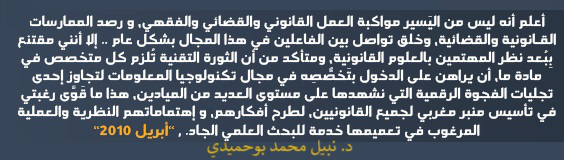رفقته نسخة مجهزة للتحميل
مقدمة:
يعتبر العقد من أهم الآليات الاقتصادية لتبادل الخيرات بين الأفراد والجماعات، حيث لا يمكن لأحد أن يحصل على شيء أو يتخلى عنه في أغلب الأحيان إلا في إطار عقد معين، وقد كان على هذا الأخير حفاظا على كيانه من الإنهيار أن يعيش في تطور مستمر لم يتوقف إلى الآن.
ويقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن الأفراد باستطاعتهم إنشاء قانون خاص بهم، عن طريق التقاء إراداتهم وتطابقها، دون اتباع أي شكلية أو التقيد بقيود معينة، وعليها نشأت القاعدة المعروفة ب"العقد شرية المتعاقدي"، وتتفرع عن مبدأ سلطان الإرادة ثلاثة عناصر تتمثل في الحرية التعاقدية، والقوة الملزمة للعقد، ونسبية آثار العقد.
وبمقتضى الحرية التعاقدية فإن الفرد حر في التعاقد أو عدم التعاقد، وفي حالة الموافقة على العقد، فهو حر في اختيار الشخص المتعاقد معه، والوقت المقرر لذلك، والكيفية التي يحبذها. وهو ما عبر عنه الفقيه الفرنسي "كونو Gonot" قائلا: "أنا لست ملزما بأي تصرف قانوني إلا إذا رغبت في ذلك، وفي الوقت الذي أريد، وبالطريقة التي أريد"، أما القوة الملزمة للعقد فتعني أن العقد الذي تطابقت عليه إرادات الأطراف لا يمكن هدمه بأي شكل من الأشكال إلا باتفاق نفس الإرادات، أو بمقتضى الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، أما العنصر الثالث المتمثل في نسبية آثار العقد، فتعني أن الآثار الناشئة عن العقد لا تلزم إلا الأطراف الذين تطابقت إراداتهم وتوافقت على ذلك العقد.
وقد كانت هذه القواعد ملائمة لتلك الفترة، لأن الأفراد كانوا متساوين نسبيا، وكانت تصرفاتهم ومعاملاتهم بسيطة، ولا تحتاج إلى فطنة عالية أو ذكاء خارق لإنجازها على وجه صحيح. فكانت عقودهم تتضمن في ثناياها قدر كبير من العدالة، ولم يكن الحيف والغبن الفاحش مطروحا إلا في حالات نادرة، وقد عبر عن ذلك الفقيه الفرنسي الكبير "دوما Doumat" بقوله: "من قال عقدا فقد قال عدلا".
وليس غريبا أن يأتي قانون الالتزامات والعقود المغربي لسنة 1913 متأثرا بهذه الأفكار، ما دامت مدونة نابليون هي مصدره التاريخي، حيث تبنى مختلف هذه العناصر في الفصول 2 و19 و21 و128، إضافة إلى الفصل 230 الذي تضمن المبدأ المعروف بـ"العقد شريعة المتعاقدين".
هكذا استقر مبدأ سلطان الإرادة في أغلب القوانين المدنية وصار دعامة تقوم عليها نظرية العقد، حيث للأفراد الحرية الكاملة في إبرام ما يشاؤون من العقود، ولا يحد من هذه الحرية إلا اعتبارات النظام العام، وإرادات الأطراف كافية لإنشاء الالتزامات التعاقدية، دون حاجة إلى إفراغ هذه الإرادة في شكل خاص، وعندما يرتبط الأشخاص بعلاقة تعاقدية، تكون لهم حرية تحديد الآثار التي تترتب على هذه العلاقة، فلا يلتزمون إلا بما أرادوا الالتزام به، وكل ما أرادوه، ويصبح هذا العقد بمثابة قانون ملزم لهم وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يستطيع أي طرف تعديله أو إنهاؤه دون موافقة الآخر، كما لا يمكن ذلك للقاضي، إلا وفق ما اتجهت إليه إرادتهم الصريحة أو الضمنية.
إذن هذه التطورات رغم إيجابياتها الكثيرة، أدت إلى تعقد المعاملات وتشابكها، وبرزت طرف قوي ومسيطر، لأنه صاحب مقومات وإمكانيات، ويحتكر السلع والخدمات في بعض الأحيان، وآخر ضعيف يرزح تحت وطأة الحاجة والضغط. ولا شك أن قدرة هاذين الطرفين على المستوى التعاقدي متباينة، ومنحهما حرية التعامل في إطار مبدأ سلطان الإرادة، غير عادل ولا منصف، لأن الطرف القوي سيبغي على الطرف الضعيف ويجور عليه لا محالة، للحصول على منافع وفوائدأكثر ولو على حساب قواعد الأخلاق وحسن النية.
وترك الحرية التعاقدية مطلقة على افتراض المساواة بين الناس، معناه الرضا بتغليب الطرف القوي على الضعيف في كل العلاقات التعاقدية التي تجمع بينهما، وتكريس عدم المساواة القائم داخل المجتمع، كما أن ترك الطرف الضعيف تحت رحمة الطرف القوي فيه أقصى انواع الظلم، والتستر عليه باسم الرضائية، وهو ما قد لا يتفق مع التوجه الرسمي لأغلب الدول الحديثة التي أصبحت تسعى بدرجة أولى إلى تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد، لأن مقولة دوما التي كانت صالحة إلى بداية القرن العشرين لم تعد كذلك، بل صارت أغلب العلاقات التعاقدية غير عادلة وفاقدة للتوازن.
الشيء الذي أدى إلى انكماش مبدأ سلطان الإرادة، موضوعا وشكلا، وجاء دور القاضي في النزاعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية، تحقيقا للعدالة وتوجيها للاقتصاد فاضطرت العديد من التشريعات من بينها التشريع المغربي أن تتدخل بشكل تدريجي وتضع تعديلات تلطف من حدة هذا المبدأ، بما يراعي العدالة التعاقدية ولا يقصي دور الإرادة في نفس الوقت.
فتوسعت القوانين في مفهوم النظام العام، وفرضت شروطا شكلية لابد من احترامها لإبرام العقد، ومنحت القاضي سلطة إبعاد الحيف عن الطرف الضعيف، من خلال العديد من المؤسسات، كالتفسير وتعديل الشرط الجزائي، ومهلة الميسرة، ونظرية الظروف الطارئة، وغيرها. مرورا بوضع شروط شكلية لحماية المتعاقد الالكتروني من مغبة النصب والاحتيال، وصولا إلى صدور قوانين الاستهلاك التي ضيقت من مبدأ سلطان الإرادة بشكل غير مسبوق، ووضعت قواعد يستعصى تصنيفها ضمن التصنيف التقليدي، وانحازت بشكل واضح للطرف الضعيف الذي نعتته بـ"المستهلك" في مواجهة الطرف القوي الذي سمته بـ"المهني"، كطرف محترف يملك إمكانيات تقنية وفنية هائلة يستغلها لصالحه.
هكذا أصبحت العدالة التعاقدية تكسب حيزا مهما في العلاقات التعاقدية، في مقابل تضييق دائرة الحرية التعاقدية، كعنصر أساسي في مبدأ سلطان الإرادة، وقد نهجت أغلب التشريعات في البداية أسلوب التعديل الجزئي للقواعد العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، فكانت لا تأتي بتعديل أو إضافة إلا بعد مرور مدة مهمة، أو إذا استوجب الأمر ظروف استثنائية غير متوقعة، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت التعديلات متسارعة وواحدة تلوى الأخرى، كما لم يعد المشرع يكتفي بالتعديلات الجزئية للنظرية العامة، بل صار بالإضافة إلى ذلك يأتي بقوانين خاصة ومستقلة، تتضمن تعديلات جوهرية وعميقة، لدرجة أنها تكون عكس القواعد العامة في بعض الأحيان، بشكل ينذر بأزمة حقيقية للنظرية العامة، وينبئ بتشتتها وتوزيع مضامينها على قوانين مختلفة ومتفرقة.
مما سبق قوله تكمن أهمية هذا الموضوع "دور القاضي في النزاعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية" في راهنيته والنقاش الذي ما فتئ يثيره، الذي يجعله موضوع كل ساعة دون أن يتقادم بمرور الزمن، وذلك نظرا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تستدعي مقاربات متتالية، وتبادل وجهات النظر بشكل دائم، وتحليل ودراسة عميقين وشاملين، من أجل الوصول إلى قواعد قانونية تواكب الحياة اليومية وما يستجد بها.
من خلال التوطئة التي افتتحنا بها الموضوع نعتقد أن الإشكالية التي يطرحها باتت واضحة والمتمثل في:
أين يتجلى دور القضاء في الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية؟
وهذا الإشكالية بدورها تتفرع عنها تساؤلات فرعية نوجزها كالتالي:
• ماهو دور القاضي السلبي إزاء العقد الواضح العبارة؟
• ما مدى إمكانية تحقيق التوازن العقدي إذا كانت عبارته غامضة؟
• أين تتجلى الرقابة القضائية على دور القاضي في تفسير بنود العقد؟
• ماهي أساليب القاضي لمواجهة الشروط التعسفية؟
• أين تتجلى المراجعة القضائية للشرط الجزافي؟
• وما تأثير التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي على القوة الملزمة للعقد؟
• هل يمكن للقاضي تخفيف الإلتزامات المرهقة ؟
وعليه، سنتناول في هذا الموضوع في المحث الأول دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال مؤسسة التفسير، على أن نعالج في المبحث الثاني دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال تعديل وتكميل العقد.
المبحت الأول : دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال مؤسسة التفسير
يعتبر التفسير تلك العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي من أجل الوقوف على الإرادة الحقيقة للمتعاقدين، وله الحق أن يستعمل كل الأساليب القانونية التي من شأنها أن تساعده على معرفة قصد المتعاقدين ولا يكون للتفسير موجب من الناحية العملية إلا إذا كانت ألفاظ العقد الغامضة أو مبهمة تحتمل أكثر من معنى إلا أن ذلك لا يمنع من تفسير بعض العقود ولو كانت العبارات المستعملة واضحة متى تطلب الأمر ذلك .
وعموما فإن مؤسسة التفسير تعتبر منفذا مهما للقاضي قصد تحقيق التوازن العقدي (المطلب الأول)، إلا أن القاضي لا تكون لدي سلطة مطلقة، بل يعتبر خاضعا للرقابة القضائية عند تفسيره لبنود العقد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تحقيق التوازن عند تفسير بنود العقد من طرف القاضي
يلعب القاضي دورا إيجابيا بحيت أصبح من سلطته التدخل في معاملات الأفراد و مراجعتها و تفسيرها، فلم يكن دوره في ذلك وليد الصدفة إنما يعود ذلك إلى القانون من خلال تفسير مضمون العقد .
ويستطيع القاضي من خلال مؤسسة التفسير، تعديل العقد بما يوافق إرادات الأطراف، وإذا كان الطرف الضعيف في العقد قد فرضت عليه التزامات غير عادلة، يمكن له تعديلها بما يحقق التوازن العقدي، شرط تعليل الحكم وذكر الأسباب التي جعلته ينحرف عن المعنى الظاهر للعقد.
ومما ينبغي تسجيله في هذا الإطار هو أن سلطة القاضي في تحقيق التوازن من خلال تأويل العقد تكون ضيقة إذا ماكانت عبارته واضحة (الفقرة الأولى ) بينما تكون واسعة كلما كانت عبارته غامضة ( الفقرة الثانية ).
الفقرة الأول : دور القاضي السلبي إزاء العقد الواضح العبارة
حسب مقتضيات الفصل 461 ق.ل.ع.م، الذي جاء فيه "إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها" ، فإن العقد الواضح لا يفسر بل ينفذ، كما ذهب إلى ذلك معظم الفقه ، وسار عليه القضاء الفرنسي منذ زمن ليس بالقريب .
بمعنى أن القاضي يفقد سلطته بشكل شبه مطلق في التفسير - ومن تم لا يستطيع التدخل في مضمون العقد لإيجاد التوازن بين التزامات أطرافه – إذا ما كانت عبارات العقد واضحة، وكانت محكمة النقض الفرنسية تعتبر التفسير في هذه الحالة تحريفا للعقدة، وتؤسس ذلك على المادة 1134 مدني فرنسي - المقابلة للفصل 230 ق.ل.ع.م - لفرض رقابتها على قضاة الموضوع، وهو نفس التصور الذي اعتمدته المحاكم المغربية أثناء الحماية، لتأثرها المباشر بمحكمة النقض الفرنسية، باعتبارها المؤسسة المخول لها البث في الطعن بالنقض الموجه ضد القرارات الصادرة عن محكمة مغربية .
وإذا كان العقد واضحا فإنه لا يفسر كقاعدة ، وإنما ينفذ كما جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى: "يجب على القضاة تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف وليس لهم تغيير شروطها متى كانت واضحة بينة"، فالعبرة إذن بالإرادة الظاهرة عند وضوح العبارة، وكل انحراف عنها في هذه الحالة يعتبر طعنا في المبدأ القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 ق.ل.ع.
لكن رغم وضوح العقد قد يكون في حاجة إلى تفسير متى كان ظاهر العقد مخالفا لقصد المتعاقدين ، كأن تكون العبارات المستعملة لا تعبر عن الاتفاق الحقيقي الذي أراده الأطراف، أو تكون مغلوطة في أصلها، الأمر الذي يتطلب تصحيحها، كحالة الغلط في الحساب التي تتطلب تصحيح العملية الحسابية حسب الفصل 43 من ق.ل.ع ، وهذا الاستثناء في تفسير العقد الواضح تسمح به الفقرة الأولى من الفصل 462 ق.ل.ع التي جاء فيها: "يكون التأويل في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الألفاظ المستعملة لا يتأتى التوفيق بينها وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد".
وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها، حيث جاء في حيثيات أحدها: "لكن حيث إنه حسب الفقرة الأولى من الفصل 462 ق.ل.ع، فإن صراحة ألفاظ العقد لا تحول دون تأويله إذا تعذر التوفيق بينها وبين الغرض المقصود من العقد، وأن المحكمة المخول لها سلطة تقدير الحجج والوقائع قد اعتبرت أن عقد 28 أبريل 1959 هو أول عقد يتعلق بالمحطة المتنازع بشأنها، وأنه عند تحرير العقد المذكور لم يكن بالمحطة لا عمال ولا زبناء ولا نشاط تجاري ولا بضاعة، مستخلصة من ذلك أن الطرفين مرتبطان في الواقع بعقد كراء تجاري لا بعقد تسيير حر لأصل تجاري" .
هكذا يمكن للقاضي أن يستغل هذا الهامش المسموح له فيه بالتدخل، لإعادة التوازن العقدي والوقوف إلى جانب الطرف الضعيف من خلال تفسير العقد رغم وضوح عباراته، إذا كانت هذه الأخيرة لا تتوافق مع قصد المتعاقدين، وما عليه إلا أن يبين الأسباب التي دعته إلى الانحراف عن المعنى الظاهر للعقد، وتبنى هذا التفسير ، كما أكدت على ذلك محكمة النقض في قرار لها جاء فيه: "وحيث إن محكمة الاستئناف أبعدت تطبيق الشرط لعلة أنه أضيف للعقد تعسفيا ودون موافقة الطرف الآخر، ودون أن تبين الأسباب والمستندات التي اعتمدتها لتكوين اقتناعها، هذا الأمر الذي يجعل قرارها غير معلل تعليلا كافيا...".
وإن العقد في ظل الظروف الحالية، وحتى لو كانت عباراته مرصوصة وواضحة، في أجزل بيان، فإن حماية المتعاقد خصوصا، العادي الذي يتمركز في موقع ضعيف في مواجهة متعاقد خبير بفن التعاقد، يقتضي من المشرع، رسم حدود أخرى للتفسير، وإقرار قواعد أخرى للتأويل يكون بمقتضاها القاضي قادرا على إعادة التوازن العقدي، وبالتالي يجب تجاوز هذه النظرة الكلاسيكية للعقد، من حيث التمييز بين العقد الواضح العبارة والذي لا يحتاج إلى تأويل، والعقد الغامض الذي يحتاج إلى تفسير، بل لقد أضحت العقود على درجة واحدة.
الفقرة الثانية : إمكانية تحقيق التوازن العقدي إذا كانت عبارته غامضة .
يكون العقد غامضا عندما تكون العبارات المستعملة غير معبرة عن النية المشتركة للمتعاقدين، وقد ارتأى المشرع المغربي تحديد بعض الحالات التي يعتبر فيها العقد غامضا بمقتضى الفصل 462 من ق.ل.ع، حيث يكون كذلك إذا كانت الألفاظ المستعملة في صياغته غير واضحة بنفسها، أو كانت لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها، أو إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد المختلفة بحيث تثير المقارنة الشك حول مدلول تلك البنود ، وهي حالات واردة على سبيل المثال لا الحصر، مادام العقد يكون غامضا كلما كانت عباراته سببا في حجب النية المشتركة لإرادة المتعاقدين.
والغموض هو عدم صلاحية العبارت لنقل الارادة الباطنة الى العالم الخارجي، رغم وضوحها الذاتي، أو عدم كفاءة التعبير مما يولد اللبس والإبهام في الوصول إلى معرفة قصد المتعاقدين من العبارات، وبالتالي القطاع الصلة ما بين التعبير والنية، وتعتبر سلطة القاضي في تفسير شروط العقد الغامضة من أهم الوسائل الجمة التي يتمتع بها، وذلك لتحقيق قدر من التوازن بين المتعاقدين عن طريق تعديل شروط العقد المفتقد للتوازن، لا سيما وأن أغلب هذه العقود تأتي في شكل غامين وغير محدد المعادي.
وفي الحالات التي يكون للتأويل موجب، يجب على القاضي البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل، من خلال تفسير العقد في إطار الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه، والشروط التي تقتضيها طبيعته، وغيرها من قواعد التفسير.
وعلى عكس العقد الواضح فإن القاضي يتمتع بسلطة واسعة إزاء تفسير العقد الغامض، وهي وسيلة مهمة لتحقيق قدر من التوازن لصالح الطرف الضعيف، عن طريق تعديل شروط العقد الفاقد للتوازن، سيما وأن غالبية هذه العقود تأتي في شكل غامض وغير محدد المعاني .
وقد وضع المشرع المغربي القواعد التي يجب على المحكمة التقيد بها عند استعمال التفسير، في الفصول من 463 إلى 473 من ق.ل.ع وبعض المواد الواردة في قانون حماية المستهلك. وإن كان الفقه والقضاء قد اختلف حول طبيعة هذه القواعد، وما إذا كانت ملزمة للقضاء أم أنها مجرد نصائح للاستئناس، حيث يذهب الاتجاه الذي يقدس مبدأ سلطان الإرادة إلى اعتبارها ملزمة لا يمكن للقاضي أن يخالفها، في حين يذهب الاتجاه الآخر إلى القول بأنها مجرد نصائح لا تلزم القاضي، وإنما يمكنه مخالفتها إذا ما اقتضت ذلك العدالة التعاقدية، لأنها فقط للاستئناس ، وهذا الأخير هو الرأي الذي توصل إليه الفقه الفرنسي منذ سنة 1908، وسارت عليه محكمة النقض الفرنسية من قبل.
وتكمن أهمية هذا الاختلاف في أن القول بإلزامية قواعد التفسير للقاضي، من شأنه أن يكرس مبدأ سلطان الإرادة ويعطي له الأولية، ويضيق في نفس الوقت من نطاق السلطة المسموح بها لهذا الأخير في الوقوف إلى جانب الطرف الضعيف وإعادة التوازن العقدي، إذا كان العقد قد تضمن بنودا مجحفة في حق أحد الأطراف. وهو أمر خطير لا مراعاة فيه للعدالة التعاقدية بتاتا.
وبالعودة إلى القضاء المغربي وجدنا أنه يعتبر هذه القواعد ملزمة للقاضي ولا يمكنه الحياد عنها، حيث لا يمكنه مخالفة القانون -فصول التفسير-، وعلى الرغم من كون التفسير من مسائل الواقع التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن ذلك لا يعني أنها لا تراقب حتى التعليل الذي على أساسه تم بناء الحكم، وبالتالي فإن مخالفة محكمة الموضوع لقاعدة من قواعد التفسير، كتفسير الفصل 473 ق.ل.ع لغير صالح الملتزم، أو تجريد العقد من أي أثر خلافا لروح الفصل 308 من ق.ل.ع ، يجعل محكمة النقض ترده لعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، على اعتبار أن هذا الأخير أحد أسباب النقض المنصوص عليها في الفصل 359 من ق.م.م.
على خلاف القضاء الفرنسي الذي استغل هذه السلطة الواسعة في التفسير، لإضافة بعض الالتزامات للطرف القوي تحقيقا للعدالة، حيث اعتمد التفسير المكمل سنة 1911 من أجل القول بالتزام الناقل بضمان سلامة الركاب، إضافة إلى التزامه بإيصالهم إلى المكان المتفق عليه، إذ جاء في قرار شهير لمحكمة النقض الفرنسية أن: "تنفيذ عقد النقل يوجب التزام الناقل بوصول الراكب سالما إلى جهة الوصول، وأن مسؤولية الناقل في حالة الاخلال بهذا الالتزام مسؤولية عقدية".
وقد كان حريا بالمشرع المغربي أن ينص على اعتماد هذه القواعد مجرد نصائح يهتدي بها القاضي ولا تلزمه، تاركا له سلطة أوسع لإعادة التوازن العقدي، آخذا بعين الاعتبار العدالة التعاقدية التي يفتقد إليها أغلب العقود التي تجمع بين أطراف غير متساوية.
ومن قواعد التفسير التي كانت لا تساعد على تحقيق التوازن العقدي، ما تم النص عليه في الفصل 473 من ق.ل.ع الذي جاء فيه: :"عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم"، حيث إن الملتزم في العقد قد يكون الطرف الضعيف وقد يكون الطرف القوي، واعتماد القاضي لهذا النص قد يؤدي إلى حماية الطرف القوي في العقد. وهو أمر غير منطقي على اعتبار أن الحماية يحتاجها الطرف الضعيف، لكن إذا ما قام القاضي بمنحه هذه الحماية يتعرض حكمه للنقض لمخالفة القانون -الفصل 473-.
وهو ما جعل المشرع المغربي يستغل صدور القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، من أجل النص في المادة 9 منه على أنه: "فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك".
وبهذه المادة يكون المشرع قد قرر الحماية للطرف الذي يستحقها وهو المستهلك، على خلاف ما كان واردا في الفصل 473 ق.ل.ع الذي يمنح هذه الحماية للملتزم الذي قد يكون مهنيا. وقد كان أولى بالمشرع المغربي أن يمنح هذه المكنة للقاضي بنص عام، يقرر فيه أحقية الطرف الضعيف بالحماية عندما يجمعه عقد مع طرف محترف، لأن اعتماد التدخل التشريعي في إرساء مظاهر الحماية كل مرة ليس كافيا، على اعتبار أن التشريع عموما يتسم بشيء من الاستقرار والثبات، في حين أصبحت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية تتطور باستمرار، حيث يصعب ملاحقتها بتدخلات تشريعية.
وقد وجدنا بعض الفقه يذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث ينادي بإضافة مصدر جديد إلى مصادر الالتزام يسمى بالالتزام القضائي Jurisprudentielle، الذي صكه لأول مرة الفقية الفرنسي جوسران سنة 1933، وينشأ الالتزام القضائي ببساطة عن القضاء حينما يفسر العقد ويكمله أو ينقص من التزاماته، بما يوافق حسن النية ومبادئ العدالة، وهو يختلف تماما عن الالتزام القضائي Judiciare الصادر عن الحكم، في كون هذا الأخير ينشأ عن حكم فردي، بينما الالتزام القضائي الناشئ عن القضاء ينشأ عنه باعتباره أحد مصادر الالتزام، لأن هذا الأخير يفترض فيه التكرار والإقرار كلما استوجبت ذلك العدالة التعاقدية.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دور القاضي في تفسير بنود العقد
لقد ثار جدل فقهي كبير في إطار تحديد مدى رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في تفسير العقد حول معرفة ما إذا كانت مسألة تفسير العقد من المسائل التي تدخل ضمن الواقع التي تندرج ضمن النشاط الواقعي الذي يباشره قاضي الموضوع ويخضع لسلطته الواسعة التقديرية، أم أن تفسير العقد من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة النقض.
وإن القاضي وهو يقوم بعملية التفسير لا يكون حرا في ذلك، بل قيده المشرع بمجموعة من الضوابط تعتبر بمثابة قواعد لتفسير القانون والعقد، يجب عليه الاهتداء بها باعتباره خاضعا لرقابة محكمة النقض سواء عند تفسيره العقد الواضح (الفقرة الأولى)، أو تفسيره العقد الغامض (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد الواضح
إذا كانت العبارات العقد واضحة وبينة لقصد المتعاقدين المتوخى منها فإن قاضي الموضوع يفقد سلطته التقديرية بشكل شبه مطلق في التفسير، ومن ثم لا يستطيع التدخل في مضمون العقد بالتعديل أو الإضافة أو الحذف أو التغيير لإيجاد التوازن بين التزامات أطرافه، لأن الأصل هو أن إعمال الشروط الواضحة المضمنة بالعقد تعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، ولا يجوز الانحراف عن مدلولها الصريح والحقيقي إلى معنى مغاير، وذلك تحت غطاء تفسير العقد، وإلا تعرض الحكم للنقض بسبب التحريف.
وإن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده جملتها.
ثم أن محكمة الموضوع لها سلطة تفسير العقود واستظهار نية طرفيها ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وما دامت لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية طرفيه عن المعنى الظاهر لعباراته.
وقد ذهبت محكمة النقض في نفس الاتجاه بحيث جاء في أحد قرارتها التأكيد على أن قضاة الموضوع مكلفون بتطبيق الاتفاقات المبرمة وليس من الجائز لهم تغييرها إذا كانت شروطها واضحة وبينة، وعليه إذا كانت في العقد المبرم بين المالك والمكتري فقرة تنص على أن المالك لا يتحمل إلا ضريبة المباني الواجبة على الملاكين، ينتج عن ذلك أن المكري يكون ملزما بتحمل ضريبة رفع الأزبال، إلا أنه في قرار آخر اعترف لمحكمة الموضوع بسلطة واسعة في تقدير عناصر الواقع، وعليه فإن المحكمة لما صرحت أن العقد المتنازع في شأنه لا يمكن اعتباره منشئا لشركة قرض لعدم استيفائه للشروط الأساسية المتطلبة قانونا في هذا الشأن وأنه يكون ذا طبيعة خاصة، تكون أولت لما لها من كامل السلطة ذلك العقد الذي لم توضح ماهيته.
وإن قاضي في كثير من الحالات لا يعمل على البحث عن النية المشتركة، وإنما عن إرادة مفترضة، ما دام أن المشرع قد خوله مراعاة مبدأ العدالة عند تفسير الشك، وهو ما يعني أن بإمكانه أن يقف بجانب الطرف الضعيف، محاولة منه لتحقيق التوازن بين الإلتزامات الأطراف.
فالأصل إذن إعمال الشروط الواضحة المضمنة بالعقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض فلا يزيغ قاضي الموضوع عن العبارات الواضحة والمعنى الظاهر للعقود دون غيرها إلا إذا بين أسبابا مقنعة لذلك وإلا اعتبر خرقا للعقد الواضح وعرض حكمه للنقض، والفكرة بسيطة لأن تفسير عقد واضح ومحدد يعرضه للخرق من طرف القاضي، كون العقد ليس محلا لذلك ومعه يكون خرق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود؛ ونكون أمام تحريف للعقد هذا الأخير الذي يقال عنه مخالفة المعنى الظاهر من الوثيقة أو تجاهل المعنى الواضح والمحدد للتعبير من أجل أن يستند إليه معنى مغاير للمعنى الحقيقي.
فالتحريف إذن هو تغيير طبيعة المعنى المحدد للتعبير المستعمل في العقد، والذي يبين النية الحقيقية للأطراف المتعاقدة، فالتحريف يكون له محل كلما كان هناك تجاوز أو تنكر من لدن قاضي الموضوع للمعنى الواضح والصريح لبنود العقد، مما يؤدي إلى القول أن سلطة محكمة الموضوع في مباشرة عملية التفسير محصورة في الحالات التي يكون فيها التعبير غامضا أو مبهما، أما إذا كان التعبير واضحا فإنه يمنع اللجوء إلى التفسير، وعندئذ يتعين الاكتفاء بتكريس المعنى الظاهر المستخلص من ألفاظ العقد. أو يبين في حكمه الأسباب التي تبرر عدوله عن المعنى الواضح.
بمعنى آخر؛ فلا يجوز لقاضي الموضوع تحت حجة تفسير العقد أن يستبدل بهذه الإرادة إرادة وهمية لا دليل لها، معدلا بذلك الآثار القانونية للعقد، الأمر الذي يؤثر على مصالح الأفراد واستقرار المعاملات، وخصوصا بالنسبة للعقود التي لا تهم الأفراد فقط، وإنما تهم أيضا المجتمع، وكذلك عقود الصلح والعقود النموذجية باعتبارها بمثابة قوانين خاصة من طراز معين يهم المجتمع أمرها ويهمها بالدرجة الأولى توحيد تفسير شروطها المماثلة، خاصة لتتبين مدى اتفاق شروطها مع قواعد النظام العام والآداب.
اعتبرت التشريعات المقارنة ومن ضمنها التشريع المغربي الذي نص في الفصل 461 من قانون الإلتزامات و العقود على مايلي :” إذا كانت ألفاظ العقد صريحة ،امتنع البحث عن قصد صاحبها “و إن المقصود بوضوح العبارة ليس وضوح معناها الحرفي و إنما مدى مطابقتها لقصد الأطراف المتعاقدة منها، و يمكن تعريفها بأنها هي التي يحسن الأطراف اختيارها و استعمالها بإثقان في موضعها للدلالة عن المعنى المقصود من وضعها، فلا يحتمل التشابه ولا التأويل وقد كرس هذا المقتضى القانوني القضاء المغربي في عدد من قراراته نذكر منها :
قرار محكمة النقض المغربية :” حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان ، ذلك أنه يتضح من تعليل القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد استنتجت جدية النزاع المؤدية إلى المساس بأصل الحق من تأويل الرسالة المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 المتضمنة للالتزام بإفراغ المحل المكرى في متم دجنبر 1981، و مما دفع المطلوب من تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لتاريخ لاحق لتاريخ الرسالة المتضمنة للالتزام، في حين أنه يتجلى بالرجوع إلى الرسالة المشار إليها و التي جاءت ألفاظها واضحة فيما تدل عليه من التزام المطلوب في النقض بمحض إرادتها و رضاها بإفراغ المحل المكترى من طرفها في متم دجنبر 1981 أنها لا تقبل أي تأويل مما يمنع معه عن قضاة الموضوع البحث عن القصد منها، و أن مجرد الدفع بتجديد عقد الكراء دون الإدلاء بما يفيد هذا التجديد ، لا تنشأ عنه جدية النزاع طالما أن الالتزام المطالب بتنفيذه مكتوب بالرسالة المؤرخة في 25 أبريل 1980 ، مما ينتج عنه أن التعديلات الواردة في القرار المطعون فيه التي أبرزت جدية النزاع بما ذكر ، غير مرتكزة على أساس قانوني صحيح استثناء من مقتضيات الفصول 230 و 231 و 461 المشار إليها، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس صحيح ومعرض للنقض” وهو ما معمول به في القضاء المصري.
وتراقب محكمة النقض خطأ التحريف لأن مسخ العقد يؤدي إلى تحريف القانون الواجب تطبيقه على العقد من خلال تكييفه، والذي تسهر محكمة النقض على مراعاة تطبيقه وتوحيده وتفسيره.
وعموما؛ فإن غالبية التشريعات أقرت رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في تفسير العقد الواضح، إلا أن هذا الإقرار تقلب بين قبول ورفض الرقابة، مع العلم أن هذا القضاء ما لبث أن تبت فأكدت محكمة النقض الفرنسية بسط رقابتها على تفسير قاضي الموضوع للعقد، فنقضت الأحكام لمخالفتها قانون العقد.
ومنه؛ فإن العقد الواضح لا يفسر بل ينفذ، وفي حالة التعسف في تفسيره فإن ذلك يرتب رقابة عليه من طرف محكمة النقض، نظرا لمخالفة القواعد التفسيرية المنصوص عليها قانونا والتي يستعين بها تحت رقابة مطلقة.
ونود أن نختم في هذه الفقرة بالتأكيد على أن العقد شريعة المتعاقدين، والتدخل القضائي ما هو إلا استثناء لهذه القاعدة، وخروج عن القوة الملزمة للعقد، وذلك تحقيقا للعدالة؛ عن طريق منح المشرع للقاضي سلطة التدخل في العلاقات العقدية لمواجهة الظروف المتغيرة التي ينشأ عنها اختلال التوازن العقدي، كما منحه هذه السلطة بموجب نصوص أخرى، وذلك بالنص على حق القاضي في تعديل العقد في حالة ورود شرط جزائي وكذلك حق القاضي في منح أجل للوفاء، فالقاضي لا ينحصر دوره في تفسير العقد فقط، بل يتعداه إلى تفسير النصوص القانونية وخاصة منها ما يتعلق بنظرة الميسرة، والتي وضع لها الفقه والتشريعات المقارنة عدة ضوابط للأخذ بها، خاصة وأنه تظل للقاضي سلطة تقديرية مطلقة في منح المدين نظرة الميسرة، فهو حر أن يمنحه أو يمنعه من ذلك، وكذلك هو حر في تحديد مدة نظرة الميسرة بشرط أن تكون معقولة كما أن له الحرية في أن يمنح المدين أجلا واحدا يسدد في خلاله أو آجال يسدد فيها.
الثانية: رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد الغامض
تعتبر سلطة القاضي في تفسير العقود الغامضة سلطة واسعة باعتماده على القواعد التي حددها المشرع في الفصول من 461 إلى 473 من قانون الالتزامات والعقود وبالاهتداء كذلك بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، ولا رقابة عليه من طرف محكمة النقض، وهذا ما قررته محكمة النقض المغربية في قرارها المؤرخ في 12 ابريل 1961(48) الذي جاء فيه: “إن تقدير الشروط الغامضة أو المتعارضة لإتفاقات الأطراف لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى”.
وهو موقف استحسنه الفقه حيث ذهب الأستاذ محمد الكشبور إلى القول: ” أن تفسير العقد الغامض مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض، ويبدو أن السبب في ذلك هو أن التفسير في هذه الحالة يقتضي تقصي النية الحقيقية أو المفترضة للأطراف و الوقوف على ظروف التعاقد و ظروف التعامل و ما تقضي به قواعد حسن النية و عادات التجار فيما بينهم ، وقد يستدعي الأمر الاستعانة بإجراءات التحقيق، كالمعاينة و الخبرة، فالمسألة إذن مسألة واقع لأن قاضي الموضوع يبحث في عالم النية والضمير ليقتنع في النهاية بأن إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تحقيق غرض معين .”
يجمع الفقه والقضاء على أن تفسير العقد الغامض يخضع للسلطة المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك، على اعتبار أن مسألة تفسير العقد الغامض تبقى من أمور الواقع وتدخل في مجال السلطان النهائي لقاضي الموضوع، وهذا ما كرسه المجلس الأعلى سابقا في مجموعة من قراراته كالقرار الصادر عنه بتاريخ 24 يناير 1968 والذي جاء فيه:" عقد البيع الذي أولته المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى".
فمن الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض تقديره للواقع المعنوي والمتعلق بالتغلغل في أعماق الخصوم والكشف عن نيتهم، وهذا البحث من الأمور الشاقة والتي تتطلب جهدا من قاضي الموضوع، حيث يقوم بتقدير أمور داخلية، وذلك باستخلاص نية المتعاقدين في العقد لتحديد مضمونه وأثره وذلك عن طريق الشروط الواردة في العقد.
غير أن ذلك، لا يعني أن قاضي الموضوع لا يخضع نهائيا لرقابة محكمة النقض في حالة العقد الغامض، بل توجد هناك حالات يعتبر عدم امتثال قاضي الموضوع لها خرقا للقانون، وتحريفا للعقد، ومنها تجريد العقد من كل أثر قانوني، وفي ذلك ذهبت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 1 دجنبر 1982: أن الشك الذي ينتج عن مقاربة شروط العقد، لا يجرد هذا الأخير من أي أثر، فمن الأولى تنفيذ العقد على تجريده من كل أثر عند تفسيره، وتنفيذ العقد يفرض تفسيره من طرف المحكمة، التي تكون ملزمة بالبحث عن إرادة الأطراف دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل، وعليه يخالف القانون ويتعرض للنقض الحكم الذي يجرد العقد من كل أثر، في حين كان من الممكن موافقة الشروط فيما بينهما عبر التفسير. ومن الاستثناءات التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض عند تفسيره للعقد الغامض العبارة، حالة تفسير الشك بشكل مخالف لروح الفصل 473 من ق.ل.ع.م.
ولا يعني بسط رقابة محكمة النقض على محاكم الموضوع في هذه الحالات، أن هناك تضييق من سلطة القاضي في خلق توازن بين أطراف العقد، بل على العكس من ذلك، فبمجرد إلقاء نظرة على بعض قرارات محكمة النقض، يتبين لنا أن هذه الأخيرة، ومن خلال تمديدها لرقابتها إلى هذا النوع من العقود إنما تهدف بالعكس من ذلك إلى حماية مصالح الطرف الضعيف، وفي نفس الاتجاه ذهب موقف القضاء الفرنسي إلى اعتماد ما يسمى بالتفسير المكمل، الأمر الذي يترتب عليه إضافة العديد من الالتزامات إلى العقد، من أهمها ما أطلق عليه في بداية القرن الماضي بضمان السلامة. وهو الأمر الذي أكد عليه القضاء المغربي في العديد من قراراته، من بينها قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 21 يناير 1959، الذي جاء فيه: “إن وثيقة التأمين تتضمن ضمان مسؤولية الشركة المؤمنة لها عن الآفات التي يمكن أن تلحق بأرواح المسافرين وأمتعتهم من طرف المؤمنة لها أو مستخدميها أو أجهزتها، فإن للمحكمة الحق في أن تستخلص أن حريق الحافلة كان شبيها بعارض أصيب به الغير بسبب التنقل وبالتالي اعتبار خطر الحريق من بين الأخطار المؤمنة والمنتظر وقوعها ودون اعتبار لما ادعته الشركة المؤمنة من أن المتضرر هو المؤمن وحده بالوثيقة ولا يشمل ضرر الحريق”.
ونود أن نشير في هذا المقال أنه قد طرحت مسألة القوة الالزامية لقواعد التفسير وما إذا كان للقاضي إمكانية التخلي عنها، أم أن هذه القواعد جاءت على سبيل الحصر.
فقد جرى الفقه والقضاء الفرنسي على تجريد هذه القواعد من كل قوة إلزامية تجاه القضاء، وأنها مجرد توصيات ونصائح يستهدي بها القضاء، وهو الموقف الذي تبناه بعض الفقه المغربي، في حين ذهب البعض الاخر إلى تبني موقف مختلف واعتبر القواعد المتعلقة بالتفسير الواردة في الفصول 466 و 468 و 471 و 572 قواعد قانونية بالمعنى المضبوط على قاضي الموضوع أن يتقيد بها وإلا وجب عليه أن يورد ما يكفي من الأسباب المعقولة في نظر محكمة النقض لتبرير خروجه عن الفهم الذي تقتضي به هذه القواعد.
و نخلص من كل ما سبق أن القضاء المغربي شأنه شأن القضاء في معظم الدول استقر على عدم تفسير العقد الواضح تطبيقا للفصلين 230 و461 من قانون الالتزامات و العقود إلا إذا كانت ألفاظه لا تعبر عن المعنى الحقيقي للمتعاقدين حيث خول لقضاة الموضوع سلطة تفسيره و لا رقابة عليهم إلا من حيث التعليل، بخلاف ما إذا كانت ألفاظ العقد غامضة حيث منحهم سلطة تقديرية واسعة في تفسيره اعتمادا على القواعد المحددة في قانون الالتزامات و العقود و بالاستناد إلى مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية عن العقد، ولا رقابة عليهم من طرفه لأن السلطة التقديرية الممنوحة لهم هي من المسائل الواقعية.
المبحث الثاني: دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال تعديل وتكميل العقد
لاشك أن النظرية العامة للعقد تيسر بشكل واضح سبل الاستغلال والتسلط في العلاقات التعاقدية التي تجمع بين أطراف غير متساوين في مراكزهم القانونية، فعلى مستوى القانون المغربي مثلا، لا يعتد في العموم بالغبن، ولا ينهض فيه التدليس سببا لإبطال العقد مالم يتخذ وسائل احتيالية توقع المتعاقد معه في غلط يدفعه إلى التعاقد، وهي وسائل أصبحت متجاوزة ولا تتصور إلا في المعاملات الفردية المحدودة فلا تطال بالتالي الصيغ الجديدة للتعاقد، من قبيل عقود الإذعان والعقود النمطية، وهي إذ يتولى إعدادها مسبقا مختصون يتمتعون بالتفوق الاقتصادي والكفاءة الفنية، لا تسلم في الغالب من شروط قد تبدو وفقا للقواعد العامة شروطا عادية لا تنال من سلامة الرضا، ولكنها في حقيقتها مجحفة ظالمة، ترهق المتعاقد وتثقل من التزاماته، وما كان ليقبل بها لو لم يكن تحت ضغط الحاجة، أو لو توافر بديل أفضل منها. لذلك منح المشرع المغربي أسوة بالتشريعات الحديثة، للقاضي سلطة التعامل القاضي للتدخل في العقد مع هذه الشروط حسب طبيعها من أجل إعادة العقد توازنه (المطلب الأول).
هذا الدور الإيجابي الذي يقوم به القاضي في تحديد مضمون العقد، لا يقتصر على استبعاد الشروط التعسفية، بل يملك سلطة مهمة أيضا لتحديد تكميل العقد، حيث يمكنه استغلال هذه السلطة من أجل إعادة التوازن العقدي، بالوقوف إلى جانب الطرف الضعيف، الذي يقبل بشروط غير عادلة تحت وطأة الحاجة، أو لعدم إدراكه لحقائق تتعلق بالعقد قبل الإقدام عليه. وفي هذه الحالة يمكن للقاضي توزيع الالتزامات بشكل أكثر عدالة، لاسيما وأنه يمكن تخفيف الإلتزامات الناشئة في العلاقات التعاقدية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التدخل القضائي لتعديل العقد
الشروط التعسفية قد ترد عامة تخول لأحد الأطراف مصلحة فاحشة على حساب الطرف الآخر، حيث يمكن للقاضي استبعادها، بعد تبني المشرع قانون 31.08 الذي نظم هذه الشروط بالتفصيل وهو ما سنتطرق إليه في (الفقرة الأولى)، وقد ترد على شكل شرط جزائي، يمكن للقاضي تعديله بمقتضى الفصل 264 من ظهير الالتزامات والعقود، الذي عدله المشرع وضمن فيه هذا المستجد، بعدما شاع استعمال هذه المؤسسة من أجل فرض شروط جزائية فاحشة ومرهقة، وهو ما سنبدأ بتناوله في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أساليب القاضي لمواجهة الشروط التعسفية
كما هو الشأن بالنسبة للشرط الجزائي الذي قد يستغله الطرف القوي من أجل فرض فائدة مجحفة، يستطيع أيضا وضع بنود لنفس الغرض، سواء بشكل مستقل أو تضمينها في العقد نفسه، ونظرا لعدم قدرة الطرف الآخر على التفاوض، فلا يملك سوى قبولها تحت ضغوط شتى، ولا يبقى له سوى اللجوء إلى القضاء والاحتماء به، وذلك بطلب استبعاد هذه الشروط التعسفية، وسنحاول الوقوف على مفهوم الشروط التعسفية (أولا)، ثم سلطة القاضي في التعامل معها (ثانيا).
أولا: مفهوم الشرط التعسفي
إذا كانت القوانين الاستهلاكية تستهدف أساسا حماية المستهلكمن الشروط التعسفية، فإنها تواجه مع ذلك إشكالا يتعلق بتحديد مفهومها ورصد مختلف مظاهرها وتجلياتها، فقد كانت المادة 35 من قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر بتاريخ 10 يناير 1978، تعتبر الشروط تعسفية إذا اتضح أنها مفروضة من المهني على المستهلك عن طريق استغلال تفوقه الاقتصادي للحصول على امتيازات مبالغ فيها.
غير أن هذا التعريف كان موضوعا لانتقادات متعددة، لأنه بعيد عن تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك، فهو من جهة يحمله واجب إثبات أن المهني قد تعسف في استعمال سلطته وتفوقه الاقتصاديين بالرغم من صعوبة هذا الإثبات من الناحية العملية، ومن جهة أخرى يعتبر التفوق الاقتصادي مناط التعسف، وهو بذلك يهمل أو يتجاهل التفوق قي الخبرة الفنية والكفاءة التقنية التي تتيح للمهني تضمين بنود العقد ما يخفف التزاماته، أو يضخم التزامات المستهلك حتى ولو كان هذا الأخير أقوى من الأول اقتصاديا .
ولذلك فإن المشرع الفرنسي قد عدل عن هذا التعريف بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 من قانون الاستهلاك الصادر بتاريخ 1 فبراير 1995 حيث ورد فيها أنه: "في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهلكين، وتعتبر تعسفية الشروط التي يكون موضوعها أو أثرها هو خلق اختلال مبالغ فيه بين حقوق والتزامات أطراف العقد على حساب الطرف المستهلك" .
أما في المغرب فقد عرف تعريف الشرط التعسفي تطورا ملحوظا نحو التوسع في مفهومه ونطاقه، حيث كان مشروع قانون حماية المستهلك ينص في الفصل 24 على أنه: "يعتبر تعسفيا كل شرط في العقد لم يكن محلا لمفاوضة فردية ولم تراع في التنصيص عليه متطلبات حسن النية، والذي يترتب عنه من جانب المستهلك عدم توازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد".
وقد حددت الفقرة الثانية من نفس الفصل المقصود بالشرط غير الخاضع للمفاوضة الفردية بقولها: "يعتبر شرطا غير خاضع للمفاوضة الفردية، كل شرط تمت كتابته مسبقا دون أن يكون للمستهلك أي تأثير على محتوى العقد، وخصوصا في إطار عقد الإذعان".
ومن ثم فإن المشرع كان يقتضي شروطا متعددة تحدد في مجملها مميزات الشرط التعسفي:
- ألا يكون خاضعا للمفاوضة الفردية.
- أن يترتب عن الشرط عدم توازن أو تكافؤ بين الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة التعاقدية.
ورغم أن المشرع كان قد وسع من مفهوم الشرط التعسفي بشكل ملحوظ، وأحال على مبدأ حسن النية الثابت في النظرية العامة للعقد، بل وألزم المهني بإثبات كون الشرط متفاوضا عليه، وهي مسألة جد إيجابية، إلا أن ما أثار التساؤل في حينه هو هل من الضروري أن يكون الشرط مكتوبا ليكون تعسفيا. وهل الشروط المتفاوض بشأنها لا يمكن أن تكون تعسفية مهما كانت مجحفة؟
ولذلك فإن المادة 15 من القانون 31.08 جاءت تنص على أنه: "يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.
دون المساس بمقتضيات الفصول 39 إلى 56 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو وسيلة إبرام العقد، وتطبق كذلك بوجه خاص على سندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان والقوائم أو أذون التسليم والأوراق أو التذاكر والتي تتضمن شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا".
في حين يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف القوي، ويمنح له ميزة فاحشة على حساب الطرف الآخر .
أما الأستاذ محمد المسلومي فيعرفه بأنه كل شرط يفرض على المستهلك من طرف المهنين نتيجة تعسف هذا الأخير في استعمال سلطته الاقتصادية بهدف الحصول على ميزة مجحفة .
كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه ذلك الشرط الذي يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في استعمال الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة.
ويندرج في ذلك أكيد، الشرط الذي يجعل تكوين العقد وقيامه معلقا على محض إرادة المورد، كما كان معتادا في عقود القرض على الخصوص، أو ذلك الذي يترك له حرية تحديد الثمن أو الذي يترك له حرية إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
عموما فقد وضع الفقه عدة تعاريف للشرط التعسفي، تصب كلها في كونه ذلك الشرط الذي يترتب عليه عدم توازن تعاقدي لصالح المهني الذي يفرضه على حساب المستهلك، لكونه لا خبرة له أو أنه وجد في مركز غير مساو له فنيا أو قانونيا أو اقتصاديا.
ويبقى تهرب المورد من التزامه بالضمان من أبرز الشروط التعسفية التي كانت العقود المسماة نفسها تتيحها ، حيث إن الفصل 571 من ق.ل.ع وهو بصدد تحديد آثار عقد البيع ينص على أنه لا يسأل البائع أيضا عن عيوب الشيء أو خلوه من الصفات المتطلبة فيه في حالتين:
1- إذا صرح بها.
2- إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان.
وكان المهني يستغل هذا الحكم القانوني، فيضمن العقود شروطا تعسفيه أو تقلص من مجالات الضمان، ما دام هو الذي ينفرد بإعداد العقد وصياغته، وذلك من دون أن ينتبه المستهلك للشرط، أو يقبل به صاغرا تحت ضغط الحاجة. وهذا ما تجاوزه قانون حماية المستهلك، حين نص في المادة 65 منه على أنه: "تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع الواردة في الفصول من 549 إلى 575 ... من قانون الالتزامات والعقود.
غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلك والمورد". ومدد المشرع في الفقرة الأخيرة من نفس المادة آجال الضمان بشأن كل دعوى تتعلق بالعيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، إذ أصبحت لا تسقط رغم أي اتفاق مخالف، إلا بمضي سنتين بالنسبة للعقارات، وسنة بالنسبة للمنقولات بعد التسليم.
ثانيا: سلطة القاضي في مواجهة الشرط التعسفي
كما توقفنا على ذلك سابقا فإن الشرط التعسفي يترتب عنه اختلال التوازن العقدي بين أطرافه، لصالح الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف، ولذلك سمح المشرع للقاضي بالتدخل لاستبعاد هذا الشرط وإعادة العقد توازنه، كما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 19 من قانون حماية المستهلك: "يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك".
وقد اعتمدت التشريعات أساليب مختلفة في تحديد الشروط التعسفية، حيث انتهجت البعض "الأسلوب التقديري"، حيث يبادر القاضي فيه إلى إبطال الشروط التعسفية استنادا إلى تعريفها القانوني، بينما تبنت بعض التشريعات الأخرى "أسلوب القائمة"، الذي يتمثل في إعداد لائحة بالشروط التي يمكن اعتبارها تعسفية، وعلى القاضي أن يستجيب لطلب إبطالها إذا تضمنها عقدا استهلاكيا. وهو الأسلوب الذي اعتمده المشرع الفرنسي في كل من قانون 1978 المتعلق بالاستهلاك وقانون 1993، الذي جاء في مادته 132/2 أن الشروط التعسفية يتم نحديدها بمرسوم يصدر عن مجلس الدولة .
ونظرا للانتقادات الموجهة لهذين الأسلوبين اعتمدت تشريعات أخرى "الأسلوب االمختلط"، الذي يهدف إلى العمل بهما معا، إذ يتم وضع تعريف قانوني للشرط التعسفي، مع تخصيص لائحة تتضمن بعض هذه الشروط، والتي يتم ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر، فيقوم القاضي بإبطال الشرط إذا كان مذكورا في اللائحة، أو كان يماثل أحد الشروط اعتمادا على التعريف المعطى لها، ويترتب عنه اختلالا واضحا بين التزامات الأطراف لصالح المهني على حساب المستهلك، وقد أخذت بهذا الأسلوب العديد من التشريعات الأوربية، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإنجليزي لسنة 1977 المعروف بقانون البنود المجحفة ، كما تم اعتماده من طرف المشرع الفرنسي بمقتضى تعديل 1 فبراير 1995.
وهو الأسلوب الذي اعتمده المشرع المغربي أيضا، حيث وضع تعريفا للشرط التعسفي في الفصل 15 من قانون حماية المستهلك، وعمد إلى وضع لائحة تضمنت 18 شرطا تعسفيا، تم ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر كما جاء في بداية الفصل 18 من نفس الفانون: "مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تعتبر الشروط تعسفية إذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 15، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي: ...".
وللقاضي سلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لرقابة محمكة النقض في تقدير مدى توافر التعسف في أي شرط ورد في العقد ، من خلال مماثلته مع الشروط المذكورة في الفصل 18، وقياسه على التعريف الذي وضعه في الفصل 15، وذلك بالرجوع إلى وقت إبرام العقد، وإلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه، وباقي الشروط الأخرى الواردة في العقد، حسب ما جاء في الفصل 16 من نفس القانون. وحسب بعض الفقه يمكن للقاضي كذلك النظر في الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية . وهو يلغي ويبطل الشرط التعسفي فقط دون العقد الذي يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره إذا كان بإمكانه البقاء دون هذا الشرط، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 19 من قانون 31.08 التي تنص على أنه: "تطبق مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور".
فلو أبرم عقد بين مورد ومستهلك، يشترط فيه الأول عدم مسؤوليته عند الاخلال بالتزاماته التعاقدية، أو أدرج شرطا يحد من هذه المسؤولية أو ينقص منها، أو احتفظ لنفسه بسلطة تغيير خصائص السلعة أو الخدمة بإرادته المنفردة، أو أعطى لنفسه حق فسخ العقد متى أراد ذلك في الوقت الذي لا يتمتع المستهلك بنفس الحق، أو فرض على هذا الأخير تعويضا مبالغا فيه أو جمع بين عدة تعويضات في حالة عدم الوفاء بالتزاماته، أو أنقص حقه في الحصول على التعويض عند عدم الوفاء بالتزاماته ، أو جعل تنفيذ التزاماته متوقفة على محض إرادته في حين حدد التزامات المستهلك النهائية وكيف ومتى تنفيذها، ...الخ، ففي مثل هذه الحالات التي يتحقق فيها إخلال كبير وملموس بتوازن العقد لصالح المهني ، يتدخل القاضي لاستبعاد الشرط التعسفي، مع الإبقاء على باقي مقتضيات العقد التي يجب أن تنفذ بطريقة عادلة للطرفين.
ومن خلال هذه السلطة يستطيع القاضي تقرير الطابع التعسفي للشرط إذا اتضح له ذلك، ويعطله من خلال إعفاء الطرف الذي فرض عليه منه، مخالفا بذلك إحدى أهم القواعد المتأصلة في القوانين المدنية، وهي كون العقد شريعة المتعاقدين .
لفقرة الثانية: المراجعة القضائية للشرط الجزافي
لم يتدخل المشرع للسماح للقاضي بتعديل الشرط الجزائي، إلا بعد انحراف هذا الأخير عن وظيفته الحقيقية، لذلك سنتوقف مع مفهوم الشرط الجزائي، والانحراف الذي استدعى هذا التدخل التشريعي (أولا)، ومدى السلطة التي يتمتع بها القاضي في مواجهة الشرط الجزائي المجحف (ثانيا).
أولا: أحكام الشرط الجزائي
لم يعرف المشرع المغربي كالعديد من التشريعات المقارنة مؤسسة الشرط الجزائي، وقد أصاب في ذلك على اعتبار أن وضع التعاريف ليس من مهامه بل من همام الفقه والقضاء. وبالفعل فقد بادر الفقه إلى إعطاء مجموعة من التعاريف لهذه المؤسسة، وإن كان المصطلح الذي يستعملونه هو التعويض الاتفاقي وليس الشرط الجزائي للتعبير عن هذا الأخير.
ويعرف الاستاذ السنهوري الشرط الجزائي بأنه التعويض الذي يقوم بتقديره المتعاقدان مقدما بدلا من تركه للقاضي، والذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وهذا هو التعويض عن التأخير.
وقد كانت المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي قبل تعديل 2016 تعرف الشرط الجزائي بأنه شرط يلتزم بمقتضاه شخص بضمان تنفيذ العقد من خلال تقديم شيء في حالة عدم تنفيذه. بينما كانت المادة 1229 من نفس القانون تعرفه بأنه تعويض الدائن عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم تنفيذ الالتزام الأصلي.
بالوقوف على هذه التعاريف نجد أنها تركز على الهدف والغاية من التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي، التي تكمن في ضمان تنفيذ الالتزام الأصلي أو ضمان الحصول على تعويض في حالة الاخلال.
لذلك فإن الشرط الجزائي له وظيفتين، الأولى تهديدية تكمن في تنبيه المدين إلى الجزاء الذي سيتعرض له لو أقدم على خرق العقد، سواء من خلال عدم تنفيذ التزاماته أو من خلال التأخير في ذلك، خصوصا وأن هذا الشرط يتمتع بالقوة الملزمة كونه ناشئ عن إرادات الإطراف، الشيء الذي يساهم في احترام كل طرف لالتزاماته. ونجد صدى هذه الوظيفة في تعريف الدكتور السنهوري، والمادة 1226 من القانون المدني الفرنسي.
أما الوظيفة الثانية فتعويضية تهدف إلى تعويض الأضرار التي تصيب الدائن جراء عدم تنفيذ الالتزام الأصلي، وهو ما ركزت عليه التعاريف الأخرى التي أوردناها.
وقد استغل المتعاقدان القوة الملزمة للشرط الجزائي من أجل فرض فوائد مفرطة لا تعادل الأضرار الناتجة عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، حيث انحرف عن وظيفته المتمثلة في احترام الامن التعاقدي وأصبح أداة لجني الطرف القوي منفعة فاحشة ومجحفة في حق الطرف الآخر، ومن هنا كان لابد على التشريعات أن تتدخل من أجل حماية هذه الفئة من هذا الإجحاف، وهو ما سنتوقف عليه في النقطة الموالية.
ثانيا: سلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي
قبل التدخل التشريعي من أجل تمكين القاضي من تعديل الشرط الجزائي، ظلت القوانين وفية لمبدأ سلطان الإرادة، وإن كان الفقه والقضاء قد حاولا التخفيف من وطأة هذه القوة الملزمة، حيث قام بالعديد من المحاولات لتكريس سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي المجحف ، والتخفيف من قدسية المواد المؤطرة لإطلاقية لمبدأ سلطان الإرادة.
وتعود أولى هذه المحاولات في فرنسا إلى الفقيه الكبير "بوتييه"،الذي نادى بإمكانية مراجعة القاضي للشرط الجزائي عند عدم تنفيذ الالتزام، متى كان مبالغا فيه. ثم توالت المحاولات الفقهية والقضائية من أجل تكريس هذا الاستثناء، غير أن محاولات القضاء تصدت لها محكمة النقض التي ظلت وفية للقوة الملزمة لبنود العقد ، وكان المشرع الفرنس لا يسمح بتعديل الشرط الجزائي إلا في حالة واحدة، وهي حالة التنفيذ الجزئي للالتزام، وظلت الحال هكذا إلى تدخل المشرع الفرنسي بتاريخ 9 يوليوز 1975 ليقرر إمكانية تعديل الشرط الجزائي إذا كان مجحفا، بمقتضى القانون رقم 597.75، وأصبح من الجائز للقاضي أن يعدل الشرط الجزائي بما يتفق مع الضرر الذي أصاب الدائن .
أما في المغرب فعلى عكس محكمة النقض الفرنسية جاءت أحكام محكمة النقض ومحاكم الموضوع متضاربة، بين تلك القاضية باحترام سلطان الإرادة والرافضة لأي تعديل في بنود العقد، على اعتبار أن هذه الشروط لم تكن مبالغ في تقديرها كما شاع مؤخرا، ولخلو القانون المغربي من السند القانوني الذي يسمح بهذا التعديل، وبين تلك التي تهدف إلى إزالة التعسف عن الشروط الجزائية، مكسرة بذلك الحجية المطلقة التي تكتسيها هذه الشروط، وهي التي ساهمت في التكريس التشريعي لهذا المبدأ.
وفي سنة 1995 تدخل المشرع المغربي لإقرار تعديل الشرط الجزائي، بمقتضى القانون رقم 27.95 المعدل للفصل 264 من ق.ل.ع حيث أقر الشرط الجزائي في الفقرة الثانية التي جاء فيها: "يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه". وسمح للقاضي بإمكانية تعديله في الفقرة الثالثة التي تنص على أنه: "يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي".
ومن الواضح أن المشرع بهذه المقتضيات أراد كبح الحرية التعاقدية التي يتيحها مبدأ سلطان الإرادة، المنصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع. ولم يشأ المشرع المغربي بطلان العقود التي تتضمن شروط جزائية، لوعيه بأهميتها ودورها الكبير في الضغط على الملتزم ودفعه إلى الوفاء بالتزاماته، في حين أعطى للقاضي تعديل التهويض الذي يكون مجحفا وملاءمته مع الضرر الذي يصيب الدائن جراء اخلال المدين بتنفيذ التزاماته.
وهذا النهج الذي سلكه المشرع المغربي على اعتبار أنه يضمن العدالة التعاقدية من خلال تحييد الشروط المطبوعة بالغلو أو الزهد وتعديلها، وبالتالي إعادة التوازن العقدي من حيث مراكز أطرافه، كما أنه لا حاجة لإبطال العقد برمته ما دام أنه في السلطة التقديرية الممنوحة للمحكة ما يغني عن البطلان، حفاظا على العقد ما أمكن بقصد الوصول به إلى الهدف الذي أنشأ من أجله وهو تنفيذه كالتزام إرادي، وهنا تكمن العدالة التعاقدية في أسمى مراميها .
وقد أحسن المشرع المغربي إذ جعل هذه المقتضيات من النظام العام التي لا يمكن الاتفاق على خلافها، حيث جعلت الفقرة الأخيرة من الفصل 264 من ق.ل.ع باطلا كل شرط على خلاف ذلك، على اعتبار أن السماح بالاتفاق على خلاف مقتضيات الفصل 264 المذكور أعلاه يفرغه من محتواه، لأن الطرف القوي لن يتوانى عن اشتراط عدم امكانية تعديل التعويض الذي يتفق عليه مع الطرف الآخر مهما كان مجحفا، وبالتالي فالمشرع قيد حرية الأطراف بما لا يخالف هذه المقتضيات، ولم يعد ذلك مسموحا لهم به استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة.
وقد لاحظ أحد الباحثين أنه على الرغم من الإيجابية التي قد تحظى بها عدم جواز مخالفة هذه المقتضيات، فإن هذه الإيجابية سرعان ما تصبح محل نظر، على اعتبار أن المخاطب بها هو المتعاقدين، في حين كلن عليه أن يخاطب بها القضاء، لأن هذا الأخير هو الملزم باستعمال تلك السلطة .
وهو ما يمكن أن يشكل بعض التراجع عن هذا المكتسب المهم بالنسبة للطرف الضعيف أو على الأقل تردد المشرع في إقرار هذه الحماية، خصوصا إذا ربطنا ذلك مع ما افتتح به الفقرة الثالثة من الفصل 264 ق.ل.ع حيث ورد فيه: "يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه...أو الرفع من قيمته..."، وهو ما يعني أنها مجرد رخصة تتمتع بها المحكمة تعملها إذا ما طلب منها ذلك، ولم يلزمها بتفعيلها تلقائيا إذا تبين الحاجة إليها ، وبالتالي تدخل القاضي لتعديل الشرط الجزائي ليس من النظام.
وقد كان المشرع الفرنسي بمقتضى القانون 597.75 هو الآخر يعطي للمحكمة هذا الحق إذا طلبه منها صاحب المصلحة في ذلك، قبل أن يتدخل مرة أخرى ويسمح لها بتعديل الشرط الجزائي تلقائيا بمقتضى القانون رقم 1097.85 لسنة 1985، وكان على المشرع المغربي أن يسلك نفس النهج لما فيه من حماية للطرف الضعيف.
المطلب الثاني: التدخل القضائي لتكميل العقد
تعتبر أغلب القواعد القانونية الواردة في قانون الإتزامات والعقود الصادر 1913 قواعدد مكملة وليست آمرة، أي أنها لا ترتب أي جزاء على مخالفتها، بل وتسمح بهذه المخالفة عندما تعطي الاولوية لإرادة المتعاقدين، حيث يمكنهم اعتماد مقتضيات أكثر فائدة لهم وأجدى نفعا، فتصبح بمثابة القانون الواجب التطبيق فيما بينهم، لا يمكن مخالفتها دون أن تترتب على ذلك مسؤولية تستوجب تعويض الطرف المتضرر.
الشيء الذي يعني أن الإرادة تأتي في المرتبة الأولى من حيث إنشاء القاعدة الواجبة التطبيق على منشئيها، ولا يمكن أن تكون هذه القاعدة سليمة إذا كانت الإرادة بدورها غير سليمة أو معيبة، وقد انتبهت التشريعات إلى هذه النقطة وأوجبت أن تكون الإرادات صحيحة، وأعطت المتعاقد الذي وقعت إرادته ضحية عيب من العيوب المحددة قانونا ، الحق في طلب استبعاد مقتضيات العقد وعدم تطبيقها عليه، وخولت له كذلك طلب التعويض عن الضرر الذي قد يصيبه جراء ذلك.
وكما سبق القول أن العقد يكون غير كامل أو ما يعبر عنه بحالة سكوت العقد، فعبارات العقد هنا غير واضحة أو غير كاملة أو هناك كذلك بعض الهقوات حول نقطة معينة هي نقط الاختلاف ،حيث أن الأطراف العقد إما أنهم لم يفكروا فيها، وإما لأن كل واحد من الأطراف العقد ،فكر فيها ،ولكنه خشي عن حسن نية، أن يخلق سوء نية قد يعيق مسيرة التعاقد و منه نجد على أن ما يقرره ميد أحسن النية أو العرف أو ترشد له القواعد العدالة من التزامات تبعية يعدها القاضي من مستلزمات العقد تم يقوم هذا الأخير بإضافتها إلى مضمونه وذلك من أجل استكمال العقد نطاقه، وحيث أن موضوع تكميل الذي نحن بصدده يكتسي أهمية بالغة وذلك من خلال الجهود القضائية المبدولة لتوسيع هذا الموضوع العقد وذلك استناد إلى كل من مبدأ حسن النية، أو استنادا إلى العرف، أو استنادا إلى مبادئ العدالة، او استنادا الى القانون (الفقرة الأولى).
ولأن العيب قد يكون ناتجا عن تسرع المتعاقد في قبول عقد لم يستوعب تداعياته بعد، فقد سمح المشرع للقاضي أيضا مع مراعاة حالة الأطراف بتخفيف القاضي من التزامات المدين المرهقة التي ازدادت جراء ظروف طرأت في الفترة الممتدة بين إبرام العقد وفترة تنفيذه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ماهية تكميل العقد
يقصد بتكملة العقد سلطة القاضي بإضافة بعض الالتزامات التكميلية التي لم ينص عليها العقد إلى الالتزامات المنصوص عليها فيه، باعتبار ان تلك الالتزامات التي أضافها القاضي هي مما يستلزمه العقد من حيث طبيعته والغرض من ابرامه حتى ولو لم يتفق عليها الطرفان استجابة لدواعي العدالة أو العرف أو مقتضيات القانون.
ويمارس القاضي هذه السلطة اثناء تحديده لنطاق العقد، وتحديد الآثار المترتبة عليه وهي مرحلة تالية لقيام القاضي بتفسير العقد تمهيداً لتنفيذه ، فبعد أن يفرغ القاضي من تفسير العقد وتكييفه ببيان طبيعته القانونية ، ينتقل الى مرحلة أخرى تتمثل بتحديد نطاقه من حيث مضمونه، فتكييف العقد عملية قانونية يتولاها القاضي بموجبها يتم تحديد ماهية العقد أو تحديد الوصف القانوني له ، تأسيساً على الهدف الذي قصد المتعاقدان تحقيقه ، بعد استخلاصه من واقع شروط العقد المعروض عليه وما أتجهت اليه الأرادة المشتركة للطرفين، وهذا يعني أن عملية التكييف تقتضي أولاً تفسير إرادة المتعاقدين لتحديد ما قصداه.
وعلى هذا، فتكملة العقد وتحديد نطاقه تقتضي أولاً تحديد نوعه وطبيعته بالاستناد الى تفسير الارادة المشتركة للطرفين وبعد أن ينتهي القاضي من كل ذلك، يقوم بتحديد نطاق العقد من حيث مضمونه،أي تحديد الآثار المترتبة عليه والملزمة للطرفين ، ولايقتصر ذلك على ماورد فيه من حقوق والتزامات نشأت عن اتفاق الارادة المشتركة للمتعاقدين بل يتناول أيضا ما يعد من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام.
فالقاعدة في هذا الصدد، تتمثل بامتداد العقد في آثاره ليُلزِم المتعاقدان بآثار لم يرد ذكرها في العقد، ولكن تعد من مستلزماته، فالمتعاقد يلتزم بما ورد في العقد من التزامات أشار اليها صراحة، وكذلك يتحدد مضمونه بالألتزامات التبعية التي تستلزمها طبيعة العقد والغرض من أبرامه ولو لم يتفق الطرفان عليها، إذ يكفي لتمام العقد اتفاق المتعاقدين على العناصر الجوهرية للعقد، تاركين المسائل التفصيلية والثانوية دون الاتفاق عليها، فلابد للقاضي في هذه الحالات من تكملة ما نقص من العقد، بما تقتضي طبيعته وبما تقضي به قواعد القانون والقواعد العرفية، وبما تمليه قواعد العدالة.
ويتم تحديد نطاق العقد بتكملة ما نقص فيه بوسائل عديدة، منها الأعتماد على طبيعة العقد ومايرتبه من التزامات أشار اليها صراحة، أو تكون إرادة المتعاقدين قد اتجهت اليها ضمناً، فكل عقد يهدف الى تحقيق غرض معين، لذا يفرض على كل متعاقد ما يلزم من التزامات لتحقيق هذا الهدف ولو لم ينص عليها في العقد ، فعقد البيع يلزم البائع بتسليم ملحقات المبيع الضرورية ، وكل ما أُعِّد بصفة دائمة لاستعماله.
وكذلك يمكن للقاضي أن يضيف الى العقد التزامات لم ينص عليها المتعاقد صراحة ، ولكنها تقتضيها طبيعة العقد كالإلتزام بضمان السلامة في عقد العمل، وعقد نقل الأشخاص، وكذلك يستكمل ما نقص من العقد وفقا لقواعد القانون التي تحكمه ، فأذا كنا أمام عقد بيع سرت أحكام عقد البيع التي نص عليها القانون، والمقصود بالقواعد القانونية القواعد الآمرة والقواعد المكملة للأرادة فكلا منهما يستعين بها القاضي لسد النقص الذي يشوب العقد، إذ يسد النقص بما جاءت به القواعد القانونية.
فعلى سبيل المثال يستعين بالقواعد القانونية المكملة للإرادة في حالة عدم ذكر مكان تسليم المبيع في عقد البيع، وكذلك اذا لم يعين مكان اداء الثمن في العقد وجب تكملة العقد وذلك بألزام المشتري بأداء الثمن في المكان الذي يُسلم فيه المبيع، أما إذا لم يكن الثمن مستحقاً عند تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الأستحقاق، مالم يوجد عرف او قانون يقضي بغير ذلك.
وقد يستعين القاضي في اكمال ما نقص من العقد بالقواعد القانونية الآمرة ، كما هو الحال في ضمان البائع للتعرض للمبيع ، إذ لايستطيع البائع أن يعفي نفسه من هذا الضمان لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم ، يلتزم بهذا الضمان حتى لو لم يذكر ذلك في العقد، أما اذا لم يجد القاضي حلا للنزاع المتعلق بالعقد، في قواعد القانون الآمرة والمكملة للارادة ، إتجه صوب قواعد العرف، والعرف الذي يلجأ اليه القاضي لتكملة ما نقص من العقد هو العرف المكمل لأراده المتعاقدين لا العرف المفسر، اذ ان الأخير يرجع اليه القاضي في حالة غموض عبارة العقد ، أما العرف المكمل فهو الذي يرجع اليه القاضي لتكملة عقد ناقص، ويتصل بالعرف الشروط المألوفة ، فعلى القاضي أن يكمل العقد بما هو مألوف من الشروط وإنْ لم تدرج فيه ، مادامت قد جرت العادة بأدراجها في مثل هذا العقد ، حتى أصبح وجودها مفروضاً ولو لم تدرج فيه.
وفي حالة تعذر اكمال ما نقص من العقد وفقا لما تقدم، قد يلجأ القاضي الى الوسيلة الأخيرة لتكملة العقد، وهي قواعد العدالة فوفقا لذلك يتضمن عقد البيع التزاما في ذمة بائع المتجر بعدم منافسة المشتري، وكذلك التزام العامل في مصنع بعد البوح بأسرار العمل الصناعية لمصنع منافس، وغير ذلك مما يُلزمَ به المتعاقد من غير ذكر في العقد طالما أن العدالة تقتضي ذلك.
ويتضح مما تقدم، بأن العقد الذي يخضع لسلطة القاضي في تكميله، لايعد عقدا موقوفا على اتفاق المتعاقدين بشأن المسائل التفصيلية، وإنما يعد عقداً صحيحا نافذا،و إن تصحيح العقد لايرد إلا على عقد مشوب بعيب يبطله او يجعله مهددا بالبطلان، يهدف إلى انقاذه مما يتهدده، بينما تكملة العقد ترد على عقد صحيح نافذ غير مشوب بمثل هذا العيب، لذا فأن تدخل القاضي في تكملة العقد لم يكن هدفه انقاذ العقد من البطلان، وأنما الهدف هو تحديد نطاق عقد يكون محلاً للنزاع ، وفي حالة إستكمال ما نقص منه ينتهي النزاع ويستقر العقد، إلا ان هذا لايعني تصحيحاً للعقد ، كما اعتقد بذلك احد الفقهاء، فالمحافظة على العقد في هذه الحالة لم تكن نتيجة لانقاذ العقد من البطلان المهدد به، بل نتيجة لأستكمال ما نقص من العقد ، أما المحافظة على العقد وبقاؤه مصححاً في حالة تصحيح العقد فقد كان بسبب زوال البطلان الذي يتهدد العقد، فالعقد قبل تصحيحه كان مشوباً بعيب يهدده بالبطلان أو يبطله، وعلى هذا، فأن كلاًّ من تصحيح العقد وتكملته وتعديله يهدف الى الإبقاء على العقد والمحافظة عليه مما يتهدده، إلا ان هذا لايعني أن هذه النظم القانونية متشابهة ولا يوجد بينها اختلاف، فأن تكملة العقد وتعديله لايمكن ان يرد إلا على عقد صحيح ونافذ، إلا انه يكون مهدداً بالزوال لأسباب مختلفة غير البطلان أو التهديد به ، إذ يعمل التعديل على المحافظة على العقد عن طريق تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل من الطرفين أي تحقيق العدالة التعاقدية، بينما تهدف التكملة الى المحافظة على العقد نتيجة استكمال ما نقص منه، أما تصحيح العقد فأنه لايرد إلا على العقود المعيبة بعيب يبطلها أو يهددها بالبطلان، إذ يترتب على التصحيح المحافظة على العقد والأبقاء عليه نتيجة زوال البطلان أو التهديد به ومن جهة أخرى قد يزول البطلان دون الأبقاء على العقد، بل نكون أمام عقد آخر يحل محل العقد الذي تقرر بطلانه، طبقا لنظرية تحول العقد الباطل .
وتنشأ مسالة تكميل العقد في الحالة التي يتفق فيها المتعاقدين على الشروط الجوهرية دون تحديد الشروط التفصيلية للعقد دون تنظيم والتي كان ، المفروض تنظيمها او الاتفاق بشأنها، للقاضي دور حيث يجد نفسه محل الطرفين لمتعاقدين لإيجاد حل لهذه المسالة عن طريق النقص في تنظيم العقد محل النزاع طبقا لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون و العرف وفقا للفصل 231 من ق.ل.ع. ويعتبر من بين أسباب تكميل العقد كالنقص في تنظيم العقد من قبل المتعاقدين و الهدف من التكميل الذي هو سد هذا النقص عن طريق ما تتضمنه هذه القواعد الموضوعية من احكام دون ان يتطلب ذلك من القاضي البحث عن إرادة الطرفين ، وايضا تعتبر بعض أسباب تكميل العقد في الهيمنة الاقتصادية و كذلك الاختلاف المعرفي للأفراد حيث لاحظ في السنوات الأخيرة على ان مفهوم العقد قد تغير نتيجة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي يعرفه عالمنا اليوم مما اثر بدوره على اللامساواة بين أطراف العلاقة العقدية وان وجدت مساواة قانونية فإنها مساواة ظاهرية لا تستطيع ان تخفي عدم المساواة الواقعية بين المتعاقدين فمهوم المساواة لا يمكننا الحديث عنه الا في حالة تساوي الطرفين في كل من القابلية للتفاوض و كذلك الخبرة أو المركز القانوني أو الاجتماعي .
الفقرة الثانية: تخفيف القاضي من الالتزامات المرهقة للعلاقات التعاقدية
صحيح أن العقود المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يمكن تعديلها أو إلغائها إلا برضا أطرافها، أو في الحالات التي يسمح بها القانون، وعلى كل واحد تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه جراء ذلك، نظرا للقوة الملزمة التي تتمتع بها، وكل طرف أخل بما التزم به يكون عرضة للمسؤولية وتعويض الطرف المتضرر جراء هذا الإخلال.
وحسب قانون الالتزامات والعقود كما تمت صياغته سنة 1913، فإن السبب الذي يكمن وراء إخلال المدين بالتزاماته لا يهم كثيرا، ما لم يكن وراء ذلك قوة قاهرة، لا يملك اتجاهها فعل أي شيء، فيعفى من المسؤولية (ف 268 ق.ل.ع)، وتنتهي تلك الالتزامات لاستحالة تنفيذها حسب الفصل 269 من ق.ل.ع.
لكن هذه القاعدة لم تعد على إطلاقها، بل أدخلت عليها بعض الاستثناءات نظرا لتأثير التطورات الاقتصادية على حالة المدين، حيث قد تحدث تغيرات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، تؤدي إلى الرفع من التزامات المدين وعدم بقائها كما كانت أثناء التعاقد، فيصبح تنفيذها خارج قدرته وإمكانيانته.
ومن أهم هذه الاستثناءات التي لقيت انتشارا واسعا بين التشريعات المقارنة، ما يعرف بمهلة الميسرة التي أخذ بها المشرع المغربي في الفصل 243 من ق.ل.ع (أولا).
وإذا كان المشرع المغربي أخذ بمهلة الميسرة، فإن نظرية الظروف الطارئة التي تهدف هي الأخرى إلى التخفيف على المدين، لم تحظى بأي قبول عنده، على خلاف العديد من التشريعات الحديثة التي تأخذ بها (ثانيا).
أولا: مهلة الميسرة
سمح المشرع المغربي للمدين الذي لا يملك القدرة على تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أن يطلب من القاضي منحه أجلا إضافيا لتدبر حالته المادية، والوفاء بما ترتب عليه. وبصدور قانون حماية المستهلك ارتأى المشرع تنظيم هذه المؤسسة فيما يتعلق بالقروض البنكية، حيث يمكن للمدين الذي أصبح يرهقه تنفيذ التزاماته لأسباب معينة، استصدار أمر قضائي من المحكمة يقضي بإيقاف تنفيذ الأقساط الشهرية، إلى حين التمكن من استئناف تسديدها.
وللقاضي كامل السلطة التقديرية في تحديد المدة الكافية لإصلاح المدين حاله، شرط أن تكون هذه المدة معقولة وأن تتوافر باقي الشروط المتطلبة لمنح مهلة الميسرة .
يعرف الفقه مهلة الميسرة أو الإمهال القضائي بأنه الأجل الممنوح من القضاء للمدين الذي استحق دينه، وأصبح خاضعا لملاحقة دائنه. وهي ذات طابع أخلاقي وديني، يتمثل في الوقوف إلى جانب المدين الذي ساءت أحواله، يمنحه أجلا إضافيا ومعقولا لتنفيذ التزاماته. وعلى الرغم من تناول المشرع المغربي لمهلة الميسرة في ق.ل.ع، فإنه بصدور قانون حماية المستهلك آثر التطرق لها وتنظيمها من جديد.
ومن المعروف أن قانون الالتزامات والعقود في صيغة 1913 جاء مكرسا لمبدأ سلطان الإرادة بشكل كبير، تأثرا منه بمدونة نابليون لسنة 1804، لذلك لم يتضمن أي إشارة تسمح للقاضي بمنح المدين مهلة للوفاء، على اعتبار أن ذلك يشكل كسرا للقوة الملزمة للعقد، وعليه جاء في الفصل 128 من ق.ل.ع: "لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلا أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون.
إذا كان الأجل محددا بمقتضى الاتفاق أو القانون، لم يسغ للقاضي أن يمدده، ما لم يسمح له القانون بذلك".
لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى وما خلفه من اضطرابات اقتصادية، وبعدما قامت ألمانيا بحصار المغرب سنة 1917، انتبه المشرع المغربي إلى الآثار المرهقة للمدين جراء الزيادة في التزاماته الناتجة عن التغيرات الاقتصادية، حيث بادر إلى إضافة الفقرة الأخيرة من الفصل 243 من ق.ل.ع التي تنص على أنه: "ومع ذلك، يسوغ للقضاة، مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة في نطاق ضيق، أن يمنحوه آجالا معتدلة للوفاء، وأن يوقفوا إجراءات المطالبة، مع إبقاء الأشياء على حالها".
ويقصد بمهلة الميسرة المهلة التي يمنحها القاضي للمدين للوفاء بدينه إذا توافرت شروطها. وقد عرفها الدكتور عبد القادر العرعاري بأنها منح المدين فرصة إضافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها إذا اعترضته بعض الصعوبات القانونية أو الواقعية وحالت دون تنفيذه لهذه الالتزامات في وقتها المحدد لها.
ولقد تناول المشرع مهلة الميسرة في المادة 149 من قانون حماية المستهلك، حيث نصت هذه الأخيرة على أنه: "بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين. غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ".
ونظرا للظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد-كوفيد 19، وأثر ذلك على تنفيذ الالتزامات الذي صار صعبا إن لم يكن مرهقا، خصوصا بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، فقد تقدمت إحدى الفرق البرلمانية بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم عنوان الفرع الرابع من الباب الثالث، وأحكام المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، من خلال إضافة الفقرة التالية: "يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أية فائدة طيلة هاته المدة، كما يمدد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تساوي سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
وإن الهدف من هذا التعديل المقترح والمتمثل في إمهال المدين خلال مدة الطوارئ، يمكن تحقيقة اعتمادا على مضمون المادة 149 من القانون 31.08، ولن يضيف هذا التعديل شيئا إلا إذا كانت هناك ظروفا استثنائية استمرت أكثر من سنتين.
وبصدور قانون حماية المستهلك سنة 2011 بادر القضاء إلى تفعيل هذه المؤسسة وتمتيع المدين بهذا الحق، حيث صدر أمر عن رئيس محكمة الاستئناف التجارية بمراكش سنة 2014 يمكن أحد المدينين بمهلة للوفاء بناء على المادة 149، وقد أيدت محكمة النقض هذا الأمر بقرار ورد فيه: "يحق للمدين إيقاف تنفيذ التزاماته بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة والاستفادة من المهلة القضائية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مع عدم ترتيب أي فائدة أثناء سريان المهلة القضائية في حالة حرمانه من أجرة بسبب فصله عن العمل، أو حالة اجتماعية غير متوقعة.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، وأن عبارة يجوز للقاضي الواردة في الفقرة الثانية من المادة المذكورة تعود على رئيس المحكمة باعتباره هو من يصدر الأوامر وليست محكمة الموضوع".
ورغبة من المشرع المغربي في توفير الحماية للمستهلك -المقترض- إذا كان هذا الأخير قد وقع على كمبيالة أو سند لأمر -الأوراق التجارية- كضمان احتياطي لتسديد دينه، وتفاديا لتعارض أحكام الإمهال القضائي في قانون حماية المستهلك، مع قواعد القانون التجاري التي تمنع أي مهلة في المعاملات التجارية إلا في حدود ضيقة ، فقد نصت المادة 150 من قانون حماية المستهلك على بطلان هذه الأوراق، حيث جا فيها: "تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم" .
وتناول المشرع المغربي مهلة الميسرة في قانون حماية المستهلك رغم تناولها بشكل مسبق في قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الشريعة العامة، وبشكل يستوعب حتى القروض البنكية، دليل على أهميتها ودورها الكبير في التخفيف على الطرف الضعيف، من خلال منحه أجلا يساعده على تحسين وضعيته الصعبة، دون أن تترتب عليه أي فائدة. كما أن من بين حسنات المادة 149 أعلاه أنها ذكرت الحالات التي يسمح فيها للمحكمة إعطاء المستهلك المقترض مهلة لتنفيذ التزاماته، على سبيل المثال وليس الحصر كما يتضح ذلك من عباراتها.
ولكن ما يؤاخذ به المشرع المغربي في هذه الحالة وأخر مشابهة، أن هذه الطريقة في تناول المواضيع ذات العلاقة بالشريعة العامة، تؤدي إلى إفراغ هذه الأخيرة من محتواها، وتساهم في تشتيتها، من خلال إخراج مضامينها في قوانين خاصة. والصواب من وجهة نظرنا أنه كان على المشرع المغربي أن يصيغ مثل هذه الأمور في ق.ل.ع سواء من خلال إضافة نصوص جديدة أو من خلال تعديل الفصول ذات الصلة وإدماج هذه الإضافات في صلبها.
واختلف الفقه في تحديد طبيعة هذه النظرية، حيث يرى الأستاذ محمد الكشبور أنها ليست إلا تطبيقا من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة . وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه الفقيه السنهوري، مركزا على الهدف الأساسي من النظريتين، الذي يتمثل في التخفيف على المدين، حيث تخفف عنه مهلة الميسرة من خلال الإفساح في أجل الوفاء، بينما تفعل نظرية الظروف الطارئة ذلك من خلال التخفيف في مقدار الدين .
في حين ذهب الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي هذه الآراء، معتبرا إياها مجرد محاولات فقهية ترمي إلى تليين موقف القضاء المغربي، لمسايرة التغيرات العميقة التي تشهدها العلاقات التعاقدية، في ظل الفوارق الاجتماعية التي تزداد بشكل ينذر بأزمة حقيقية للعقد .
وعلى كل حال فإن مهلة الميسرة إن كانت تشترك مع نظرية الظروف الطارئة في هدفها الأساسي الذي يكمن في السعي نحو تخفيف التزامات المدين كما يقول الفقيه السنهوري، فإنها تختلف عنها من حيث شروطها، ومن حيث الآلية التي تخفف بها التزامات المدين، حيث تمنحه أجلا للوفاء دون أي تغيير في موضوع الالتزامات، على عكس الظروف الطارئة التي تسمح للقاضي بإيقاف التنفيذ لأجل معين، أو بالزيادة أو إنقاص الالتزامات وإرجاعها إلى حدها المعقول، وهنا تكون سلطة القاضي أوسع نطاقا في تعامله مع التغيرات الناشئة عن الظروف الاستثنائية، بينما تكون هذه السلطة أضيق عندما يتدخل في إطار مهلة الميسرة، التي تمنحه فقط إمكانية تأجيل الوفاء إلى أجل معقول.
كما أن مهلة الميسرة تساعد على استقرار العلاقة التعاقدية التي أنشأها الأطراف، وبالتالي تعزيز مبدأ سلطان الإرادة لأن عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته في الأجل المحدد، يخول للطرف الأخر حق المطالبة بالفسخ مع طلب التعويض إن كان له محل (الفصلين 259 و263 ق.ل)، وانحلال العقد تبعا لذلك دون أن تحصل المصلحة التي أبرم من أجلها. وعليه فإن تدخل القاضي لتمديد أجل الوفاء يؤدي إلى الحفاظ على العلاقة التعاقدية، خصوصا وأن مبدأ سلطان الإرادة يسمح بمثل هذا التدخل، دون أن يكون ذلك خروجا أو استثناء عليه، كما هو واضح من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون". وكما هو واضح فإن مهلة الميسرة من الحالات التي يسمح فيها القانون -ف 230 نفسه- بإلغاء الالتزامات أو تعديلها، دون أن تشكل أي خطر على مبدأ سلطان الإرادة.
ثانيا: نظرية الظروف الطارئة
تبقى الفترة الممتدة بين لحظة إبرام العقد ولحظة تنفيذه، إذا لم يكن هذا الأخير فوريا، عرضة للعديد من التقلبات والأحداث المفاجأة، التي إن لم تجعل تنفيذ المدين لالتزاماته مستحيلا أو مرهقا، فقد تجعله صعبا ومكلفا، وهو ما يسنى بتحطيم اقتصاديات العقد، كما عبر عن ذلك بعض الفقه .
وهنا يأتي دور نظرية الظروف الطارئة للتخفيف من التزامات المدين، أو الرفع من الالتزامات المقابلة، أو إيقاف تنفيذها إلى حين زوال ما طرأ من ظروف وأحوال مفاجأة.
ولأهمية هذه النظرية ودورها الفعال في التخفيف على المدين، فإن التشريعات قد اختلفت في مدى اعتمادها، خصوصا تلك التي تعطي الأولوية لمبدأ سلطان الإرادة.
وتعرف نظرية الظروف الطارئة بأنها كل حادث عام، لاحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول، ينجم عنه اختلال في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه، ويصبح معه تنفيذ المدين لالتزامه كما أوجبه العقد مرهقا، ومهددا إياه بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في التجارة، أو هي تلك الحوادث الاستثنائية العامة التي لم يكن في الوسع توقعها، ومن شأن حدوثها أن يترتب عليه جعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف ولم تكن قائمة وقت نشوء العقد . ويترتب على تحقق هذه النظرية بالنسبة للقوانين التي تأخذ بها السماح للقاضي بتعديل بنود العقد بالطريقة التي يزول معها هذا الإرهاق.
إن القضاء الفرنسي في شقه الإداري كان شجاعا حينما أقر بتطبيق هذه النظرية سنة 1916 في قراره الشهير المعروف بقضية غاز بوردو Bordeaux، حيث خرج هذا الحكم عن القواعد القانونية التقليدية، بهدف إعادة التوازن العقدي مجاريا في ذلك التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت بعد نشوب الحرب العالمية الأولى .
عموما يتضح مما سبق أن نظرية الظروف الطارئة أصبحت أمرا مقررا في أغلب القوانين المدنية الحديثة، حتى من طرف القانين التي كانت ستبعدها في البداية، لما لها من دور في تحقيق العدالة التعاقدية، وقيدا على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي بكون العقد شريعة المتعاقدين.
ولم يقم المشرع المغربي في ق.ل.ع بتنظيم نظرية الظروف الطارئة، شأنه في ذلك شأن مدونة نابلبون، حيث آثر الانتصار لمبدأ سلطان الإرادة، الذي من خلاله تصبح اتفاقات المتعاقدين بمثابة قانون بالسبة لهم، كما ينص على ذلك الفصل 230 من نفس القانون، وقد سار القضاء المغربي في الاتجاه الذي سار عليه القضاء الفرنسي، حيث يرفض تعديل العقد المرهق، ما لم تكن التزاماته مستحيلة فتنقضي لاستحالة تنفيذها. في حين كان القضاء الإداري بالمغرب كما هو الشأن بالنسبة للقضاء الإداري الفرنسي شجاعا، إذ أخذ بهذه النظرية منذ سنة 1941، وأقر تعديل الالتزام المرهق وإرجاعه إلى الحد المعقول .
غير أن هذا لا يعني أن التشريع المغربي برمته جاء خاليا من تأثير هذه النظرية، بل مراجعتنا لبعض القوانين الخاصة أثبتت أنها تتضمن تطبيقات عديدة لها، فمدونة الأسرة في إطار تنظيمها للشروط الاتفاقية التي يمكن للأطراف اشتراطها أثناء إبرام عقد الزاج، نصت في المادة 48 على أن: "الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين...إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله مادامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة...".
كما تضمن القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، مقتضيات قريبة لهذه النظرية، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الوجيبة الكرائية. حيث يمكن للأطراف حسب المادتين 31 و32 من هذا القانون الاتفاق على طريقة المراجعة بعد كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام العقد أو من آخر مراجعة اتفاقية أو قضائية. والعلة في قولنا أن هذه المقتضيات تعتبر تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة تكمن في كون هذه المراجعة التي يمكن أن تكون عن طريق القضاء، سمح بها المشرع لتعديل بنود العقد -خصوصا ما يتعلق بالثمن- تبعا للتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ خلال هذه المدة، من أجل رفع الالتزام البخس إلى الحد المعقول أو العكس. إذ ليس من المعقول أن تبقى الوجيبة الكرائية نفسها التي كانت مناسبة قبل سنوات، في حين ارتعفت أثمان الكراء داخل هذا المحيط.
وقد تضمن القانون رقم 07.03 المقتضيات نفسها فيما يخص مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للاستعمال أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، بعد نسخ مقتضياتها فيما كان يتعلق بسريانها على المحلات السكنية والمهنية بمقتضى المادة 75 من القانون 67.12.
عموما فإن تناولنا لهذه التطبيقات لا يعني أنها كافية لتغطية الفراغ الذي تركه خلو ق.ل.ع كشريعة عامة من هذه النظرية، كما لا يمكن لها أن تؤدي وظيفتها نيابة عنها. لذلك ننادي بضرورة تقنين نظرية الظروف الطارئة في ق.ل.ع، لما لها من دور في التخفيف على الطرف المرهق جراء حدوث ظروف خارجية لا يد له فيها، ولا قبل له بدفعها.
وللإشارة فإن عدم تنظيم المشرع المغربي لنظرية الظروف الطارئة، جعل الباحثين يستلهمون مؤسسات أخرى قريبة، كاعتماد القوة الفاهرة من أجل التعامل مع بعض الظروف الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة للتناول القانوني لوباء كورونا كوفيد-19 المستجد، حيث أصبحت معه العديد من العقود مستحيلة التنفيذ، وبعضها الآخر صار تنفيذها مرهقا للعديد من المتعاقدين، سواء لارتفاع تكلفتها، أو لكون مباشرته يشكل تهديدا على صحته .
على كل حال فإنه على الرغم من فعالية نظرية القوة القاهرة في بعض الحالات –عندما يصبح العقد مستحيل التنفيذ-، إلا أنها تبقى غير قادرة على أداء الوظيفة والدور المنوط بنظرية الظروف الطارئة، خصوصا حينما يكون الالتزام مرهقا فقط ولم يصل حد الاستحالة، مادامت القوة القاهرة تستوجب الاستحالة المطلقة لاعفاء المدين من التزاماته، وطالما لهذا الأخير إمكانية للتنفيذ فلا يهم قدر التضحيات التي سيتحملها في سبيل ذلك . وهو ما يعني أن التكييف القانوني لوباء كورونا على أنها تدخل ضمن القوة القاهرة غير دقيق، لأن التزامات المدين ليست مستحيلة التنفيذ دائما، بل تبقى ممكنة في العديد من الأحيان، لكنها صارت مكلفة، أو أصبح ذلك تحت طائلة التعرض لمخاطر صحية.
والصحيح إذن هو أن هذا الوباء يدخل ضمن القوة القاهرة بالنسبة لمن أصبحت التزاماتهم مستحيلة، ويدخل في إطار نظرية الظروف الطارئة بالنسبةلمن أصبحت التزاماتهم مرهقة ومكلفة .
خاتمة:
ختاما لما سبق فإنه مادام القانون يسعى إلى تحقيق العدل بالدرجة الأولى، فقد اضطرت العديد من التشريعات إلى إيجاد قيود أخرى على عناصر سلطان الإرادة، لصالح العدالة التعاقدية التي أصبح يتسع نطاقها باستمرار، وكانت البداية مع إيجاد آلية لحماية المدين من آثار الظروف الاستثنائية التي تحدث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه، فأخذت العديد من التشريعات بمهلة الميسرة، كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي في الفصل 243 ق.ل.ع المغربي، كما أخذت تشريعات أخرى بنظرية الظروف الطارئة، التي لم يقننها المشرع المغربي في قاعدة عامة، على الرغم من أن أهميتها الكبيرة، وانتشارها الواسع.
كما أصبحت الشكلية متطلبة لإنشاء العديد من العقود، ولم يعد يكتفى فيها بالرضائية، وتم تكريسها في القانون المنظم للتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، الذي جاءت أغلب إجراءاته شكلية واتسعت دائرة النظام العام، وانتقل هذا الأخير من المفهوم السلبي الذي يكتفي بتحديد بعض الشروط التي لا يجب أن يتضمنها العقد، إلى المفهوم الإيجابي الذي من خلاله يفرض بنودا أن تأتي في العقد ليكون صحيحا.
حيث أوجدت آليات لحماية هذا الطرف قبل إبرام العلاقة التعاقدية، فألزمت المهني بإعلام المستهلك وتبصيره بخصائص السلع والخدمات التي يقدمها، كي يتعاقد بإرادة صحيحة ومتنورة، كما منعت الإشهار الكاذب والمضلل، لحمايته من الوقوع في الغلط والتعاقد على أساس معطيات مغلوطة.
أما أثناء التعاقد فقد حددت الثمن للعديد من المواد الغذائية والسلع الضورية، كي لا يغالي المهني في أثمانها، كما منحته مهلة للتفكير في بنود العرض المقدم إليه قبل الإعراب عن قبوله، وألزمت من جانب آخر أن يبقي المهني على الشروط التي أوردها في العرض المسبق طيلة مدة التفكير دون أي تغيير، لكي تجنبه عواقب التسرع في إبرام عقد لم يستوعب كل تداعياته. لكن إذا حصل هذا التسرع وتعاقد، ثم تبين له أن العقد لم يحقق له المنفعة التي من أجلها أبرم، فقد سمح له المشرع بالتراجع عن هذا العقد خلال مدة حددها، ويرجع الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد.
أما أثناء التنفيذ فقد اعتمد المشرع على القضاء لبسط هذه الحماية، من خلال منحه سلطة مهمة لإعادة التوازن للعقد الذي يفتقده، بإيجاد مؤسسات عديدة كتعديل الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه أو زهيدا، وإبطال الشروط التعسفية التي تكسب المهني ربحا فاحشا على حساب المستهلك، وتفسير العبارات المشكوك في مدلولها لصالح امستهلك، عوض الملتزم كما ينص على ذلك الفصل 473 ق.ل.ع.
عموما فإن هذه اقيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية،أصبحت تتزايد باستمرار، وذلك من أجل حماية الطرف الضعيف وتحقيق العدالة التعاقدية، التي تغيب في معظم العقود التي تكون بين أطراف غير متساوية.
لكن من خلال هذا البحث المتواضع توصلنا إلى أن هذه الحماية في التشريع المغربي ليس كافية، وكان لابد من تدخل الدور الكبير للقاضي في تحقيق التوازن العقدي.
مما سبق ارتأينا صياغة بعض المقترحات بشأنها على الشكل التالي:
- النص على شكلية الكتابة تحت طائلة البطلان في كل المعاملات التي بلغت قيمتها حدا مهما.
- منح المستهلك حق التفكير في كل العقود التي تتم بينه وبين المهني، عدا الاقتصار على القروض العقارية والاستهلاكية.
- منح المستهلك حق الرجوع في جميع العلاقات التي تتم بينه وبين المهني، عوض الاقتصار على البيع الذي يتم خارج المحلات التجارية والذي يتم عن بعد فقط.
- النص على وجوب منح القاضي لأجل للوفاء في إطار مهلة الميسرة إذا استدعت ذلك حالة المدين، وعدم الاكتفاء بجعلها رخصة يتمتع بها القاضي ولا يلزم بتفعيلها.
- تقنين نظرية الظروف الطارئة ضمن القواعد العامة.
- النص على أن قواعد التفسير مجرد نصائح يستهدي بها القاضي، لتبقى له سلطة أوسع لإعادة التوازن العقدي.
المراجع:
الكتب:
الدولة والقانون في زمن كورونا، مؤلف جماعي، مجلة مغرب القانون، سلسلة إحياء علوم القانون، عدد خاص، ماي 2020، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى.
محمد الكشبور، نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة، ط: 1، 1993.
محمد الكشبور: "رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية (محاولة للتمييز بين الواقع و القانون)،سنة 2001.
مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الجزء الأول-مصادر الالتزامات، الطبعة الثانية، 1962.
عبد القادر العرعاري: " مصادر الإلتزام"،الكتاب الأول، نظرية العقد، الطبعة السابعة، 2021، ص:204.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2015.
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ج2، الإثبات-آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 1998.
عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني: الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، نهضة مصر.
عبد الرحمان الشرقاوي، القانون المدني، الكتاب الأول، مصادر الالتزام،الجزء الأول، الرباط سنة 2018.
عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ط: 2016.
عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، دراسة في قانون الالتزامات والعقود وفي القوانين الأخرى، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، ط: 2016.
سمير عبد السيد تناغو، مصارد الالتزام، العقد-الارادة المنفردة-العمل غير المشروع-الاثراء بلا سبب- القانون (مصدران جديدان للالتزام: الحكم-القرار الإداري)، مكتبة الوفاء القانونية-الاسكندرية، طبعة الأولى، 2009.
سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي ومالك علي حمزة الغريري، أثر تغير ظروف المقترض على عقد القرض العقاري، مجلة القانون والاعمال الدولية، ع: 24، أكتوبر 2019.
زهير بنخودة، تفسير عقد الإذعان في القضاء المغربي والمقارن، مجلة المحاكم-مراكش، العدد الأول 2007.
رمزي بيد الله علي حجازي، الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد الالكتروني-دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2016.
خالد عبد حسين الحديثي: تكميل العقد – دراسة مقارنة- الطبعة الأولى 2012.
خالد الفكاري، تأملات في أثر الجائحة على تنفيذ الإلتزامات التعاقدية بين القوة القاهرة والظروف الطارئة، الطبعة الأولى سنة 2020.
الحسين بلحساني، الوجيز في العقود الخاصة، العقود الاستهلاكية-البيوع العقارية-الأكرية السكنية، وجدة، سنة 2015.
حسن عبد الباسط اجميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد-ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات التعاقدية في ظل انتشار الشروط التعسفية، دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الأوربية مع الإشارة للقوانين الأنجلوأمريكية، دار النهضة العربية-القاهرة، 1990.
الأطاريح:
ماجدة عبد المجيد عبد المهدي المخاترة، سلطة القاضي في تحقيق التوازن العقدي-دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الموسم الجامعي: 2013/2014.
جميلة العماري، أبعاد الإرادة العقدية في التشريعين المغربي والمقارن، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عيم الشق-الدار البيضاء، الموسم الجامعي: 2001/2002.
خالد الفكاني، أثر تغير الظروف الاقتصادية على العقد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال-الرباط، الموسم الجامعي: 2013/2014.
الرسائل:
عبد الرحمان الشرقاوي : دور القضاء في تحقيق التوازن العقدي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس السويسي-الرباط، الموسم الجامعي: 2002/2003.
عبد الإله هريش، دور القضاء المدني في حماية أطراف العقد رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم الاقنونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي-طنجة، الموسم الجامعي: 2019/2018.
مراد بوزيد، دور القضاء في حماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي-طنجة، الموسم الجامعي: 2015/2016.
فاطمة الزهراء الصيدي: تفسير العقد في العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بكلية الحقوق طنجة، السنة الجامعية 2010/2009.
مريم المريني: القضاء المدني والقوة الملزمة للعقد، بحث لنيل دبلوم الماستز في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية: 2015/2014، ص: 32 .
سرية المساوي، الحماية القانونية للمستهلك على ضوء قانون 31.08، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي-طنجة، الموسم الجامعي: 2012/2013.
مراد بوزيد، دور القضاء في حماية المستهلك، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي-طنجة، الموسم الجامعي: 2015/2016.
فرح بن موسى، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول-وجدة، الموسم الجامعي: 2013/2014.
المجلات:
مجلة المحاكم المغربية،عدد: 100، يناير/فبراير 2006.
المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، عذذ: 5، 2013.
مجلة القانون والأعمال الدولية، ع: 27، أبريل 2020.
القوانين:
ظهير شريف صادر بتاريخ 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزانات والعقود، الجريدة الرسمية لم تصدر الصيغة العربية لهذا النص وإنما وقع تعريبه ووزعته وزارة العدل منذ 1965 على جميع المحاكم المغربية، أما الصيغة الفرنسية منه فقد صدرت في ج.ر، ع: 46 بتاريخ 12/09/1913.
ظهير شريف رثم 1.13.111 صادر في 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ج.ر، ع: 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013).
ظهير شريف رقم 1.07.134 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 03.07 التعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ج,ر، ع: 5586 بتاريخ 13 دجنبر 2007.
المقالات و المواقع الإلكترونية:
جمال أمدوري، مقترح قانون يطالب بإيقاف تنفيذ التزامات المدين خلال حالة الطوارئ، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://m.al3omk.com/528080.html تاريخ الاطلاع: 11/02/2022، على الساعة 14 :11.
القرار ع: 366 الصادر بتاريخ 19 يونيو 2014 في الملف التجاري عدد 2014/1/3/520، نشرته مجلة القانون والأعمال الدولية على الموقع الالكتروني التالي: https://www.droitetentreprise/com/?p=9876 تاريخ الاطلاع: 11/02/2022 على الساعة 08 :12.
إبراهيم أحطاب، فيروس كورونا-كوفيد 19، بين القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.marocdroit.com/D تاريخ الاطلاع 20/02/2022 على الساعة: 45 :15.
مقال أمينة رضوان، حدود سلطة القاضي في التفسير النصوص القانونين، قاضية بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، منشور في موقع مجلة القانون والأعمال الدولية https://www.droitetentreprise.com/. تاريخ الإطلاع 2022/02/19 على الساعة: 09:10.
الفهرس:
مقدمة: 1
المبحت الأول : دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال مؤسسة التفسير 4
المطلب الأول: تحقيق التوازن عند تفسير بنود العقد من طرف القاضي 4
الفقرة الأول : دور القاضي السلبي إزاء العقد الواضح العبارة 5
الفقرة الثانية : إمكانية تحقيق التوازن العقدي إذا كانت عبارته غامضة . 7
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دور القاضي في تفسير بنود العقد 10
الفقرة الأولى: رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد الواضح 10
الفقرة الثانية: رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في تفسير العقد الغامض 14
المبحث الثاني: دور القاضي في تحقيق التوازن العقدي من خلال تعديل وتكميل العقد 17
المطلب الأول: التدخل القضائي لتعديل العقد 17
الفقرة الأولى: أساليب القاضي لمواجهة الشروط التعسفية 17
الفقرة الثانية: المراجعة القضائية للشرط الجزافي 23
المطلب الثاني: التدخل القضائي لتكميل العقد 27
الفقرة الأولى: ماهية تكميل العقد 28
الفقرة الثانية: تخفيف القاضي من الالتزامات المرهقة للعلاقات التعاقدية 31
خاتمة: 39
لائحة المراجع: 41
الفهرس: 45



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 دور القاضي في النزاعات الناشئة عن العلاقات التعاقد
دور القاضي في النزاعات الناشئة عن العلاقات التعاقد