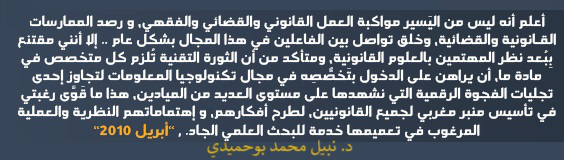مقدمة:
تعتبر الجماعات الترابية إحدى الركائز الأساسية لتدبير الشأن العام المحلي، حيث تضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسات العمومية المحلية وتنزيل برامج التنمية، ومع توسع اختصاصاتها في ضوء اللامركزية، أصبحت الجماعات الترابية فاعلا مباشرا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى زيادة حجم وطبيعة المنازعات القضائية التي تجد هذه الوحدات نفسها طرفا فيها، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.وفي هذا السياق، فإن المنازعات القضائية للجماعات الترابية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها على المستويين الإداري والمالي، فهي لا تقتصر على كونها منازعات قانونية فحسب، بل تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الجماعات واستمرارية مرافقها العمومية، كما تلقي بظلالها على المشاريع التنموية المحلية. هذه المنازعات، التي تتنوع بين نزع الملكية، العقود الإدارية، والصفقات العمومية...، تؤدي في كثير من الأحيان إلى اختلالات مالية وإدارية قد تعيق تحقيق التنمية المنشودة. في ظل هذه التحديات، يبرز التدبير العمومي الحديث كخيار استراتيجي للتغلب على أوجه القصور التي تعاني منها الجماعات الترابية. فهو "علم محكم ومعقلن وفعال" ينطوي على مجموعة من المفاهيم التي يمكن أن تلعب دور هام في عقلنة التدبير الإداري، مثل الفعالية، التخطيط، إدارة الأهداف، الجودة، والتدقيق. هذا التوجه لا يعد مجرد وصفة علاجية لعيوب البيروقراطية التقليدية، بل يقدم نفسه كبديل جذري للنظام القديم[[1]]url:#_ftn1 ، قادر على إرساء نموذج تدبيري جديد يعزز الحكامة الجيدة ويحقق تنمية مستدامة.
ومن جهة أخرى، يفرض السياق الدستوري والقانوني الحالي ضرورة اعتماد مقاربة تدبيرية محكمة للتعامل مع المنازعات القضائية، تستند إلى مبادئ الحكامة الجيدة، والاستباقية في ضبط المخاطر القانونية، والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، فالتدبير الفعال لهذه المنازعات أصبح مطلب ملح لتمكين الجماعات الترابية من مواجهة التحديات المرتبطة بتنفيذ برامجها التنموية، وضمان استمرارية الخدمات التي تقدمها للمواطنين، إن دراسة تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية تستدعي تسليط الضوء على واقع هذه المنازعات من حيث أسبابها وآثارها، مع تحليل الإشكالات التدبيرية التي تعاني منها هذه الوحدات، وسبل تجاوزها في إطار التوجهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي. كما تبرز أهمية استثمار الاجتهادات القضائية، وتجارب الدول المقارنة، في بلورة رؤية متكاملة تستهدف تحسين حكامة التدبير القضائي، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي للجماعات الترابية، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية.
ومن هذا المنطلق، يسعى هذا الموضوع إلى معالجة إشكالية محورية مفادها: إلى أي حد يمكن لتدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية أن يسهم في تعزيز الحكامة وتحقيق التنمية المحلية، في ظل التوجهات الحديثة للقضاء الإداري؟ وللإجابة على هذا التساؤل، سيتم تناول الموضوع عبر محاور رئيسية تجمع بين الإطار النظري والتشخيص العملي، مع التركيز على الاستراتيجيات المقترحة لتعزيز نجاعة التدبير القضائي للجماعات الترابية وتحقيق أهداف التنمية.
المطلب الأول: واقع المنازعات القضائية للجماعات الترابية: إشكالات تدبيرية وتحديات تنموية
نقدم في بداية هذا المطلب الخطاطة التالية التي تلخص مسار المنازعات القضائية للجماعات الترابية، تمهيدا لتقديم تشخيص متكامل لواقع هذه المنازعات ولتحقيق ذلك يتطلب فهما جيدا لمسار اللامركزية وما عرفته من محطات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المحلية، لأن المنازعات القضائية بصفة عامة هي نتيجة طبيعية لتطور دولة الحق والقانون وخصوصا ذات الصبغة الإدارية.

| الآليات التعاقدية |
| خصومات تدخل بسببها في منازعات قضائية مع الأغيار سواء كمدعية أو كمدعى عليها. |
| آليات السلطة العامة |
لقد بدأ مؤشر ارتفاع هذه المنازعات بإحداث المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى ظهور الجماعات الترابية كوحدة ترابية أخذت على عاتقها ما كانت تتحمله الدولة سابقا من صلاحيات واختصاصات بحيث منحها المشرع اختصاصات جديدة جعلتها تدخل في شراكات استراتيجية مع شركاء مؤسساتيين وشركاء خواص، كما ولجت ميادين التنمية للمجالات الترابية الشيء الذي فرض عليها تفعيل أليات التدخل من أجل تحقيق مضامين التنمية بكل مقتضياتها وتتحدد أليات التدخل في مستويين الأول أليات السلطة العامة من قبيل (نزع الملكية وممارسة الشرطة الإدارية ...) ثم المستوى الثاني الأليات التعاقدية التي تسمح لها أن تمضي في شراكات مثل (الصفاقات العمومية وعقود الكراء [[3]]url:#_ftn3 ...)، هذا التحول الجدري الناتج عن توسيع الاختصاصات أدى في غالب الأحيان إلى نشوء خصومات ومنازعات قضائية بين الأغيار وتكون الجماعات الترابية هنا إما مدعية أو مدعى عليها الأهم هو أن هناك نزاع قضائي ويجب التعامل معه بطريقة إيجابية واحترافية في نفس الآن احتراما لسيادة واستقلالية القضاء.
المنازعات على المستوى الترابي في شق الممارسة العملية يتبن أنها أضحت أخطر المحطات على مستوى التدبير لكونها تثقل كاهل الجماعات الترابية وهذا يؤثر على الوضعية السليمة بطريقة سلبية حيث يؤثر على الميزانية وعلى سير وديمومة المرافق العمومية، ولمحاولة فهم وضعية هذه المنازعات الموجهة ضد الجماعات الترابية علينا أولا رصد واقعها ومدى آثارها على التنمية المحلية، على اعتبار أن الجماعات الترابية اليوم هي من تسهر على حسن سير واستمرارية كل المرافق العمومية المحلية القريبة من المواطنين وحتى المرافق الخاصة ذات الطابع العمومي التي تدخل كشريك فيها، وبالتالي عليها أن تكون في مستوى التدبير الجيد لترابها بغية كسب رهان التنمية المحلية.
الفرع الأول: وضعية المنازعات القضائية للجماعات الترابية: قراءة في الواقع وأبعاده القانونية.
استنادا إلى المعطيات التي توفرها مصالح وزارة الداخلية وكذا مصالح وزارة العدل ومختلف الهيئات الرقابية، كالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، سنحاول دراسة وتحليل وضعية المنازعات القضائية للجماعات الترابية، بحيث يلاحظ الارتفاع البين والمستمر لعدد قضايا الجماعات الترابية أمام القضاء، سواء مدعية أم مدعى عليها، وكذا تعاطيها السلبي مع تلك الوضعية، سواء لعدم قدرتها المالية والبشرية والتدبيرية، أو لتقاعس منها في تدبير المال العام الذي تتولى التصرف فيه ويكون له بالغ الأثر على التنمية المحلية برمتها، لقد أشار الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى ضرورة تطبيق القانون من قبل الجماعات الترابية وأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، حيث جاء في نص الخطاب الملكي السامي'' [4] بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل، فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن" ، ونظرا لكون المقتطف من الخطاب الملكي السامي قد أشار بشكل خاص وصريح إلى الجماعات الترابية فإن عدم وفاء هذه الجماعات بالتزاماتها، سيما المالية منها، وعدم تنفيذها للأحكام الصادرة ضدها يؤدي بالضرورة إلى تزايد وارتفاع عدد القضايا المعروضة على القضاء في مواجهتها.[[5]]url:#_ftn5
الفقرة الأولى: تصاعد المنازعات القضائية للجماعات الترابية: واقع مقلق.
تمارس الجماعات الترابية اختصاصات عديدة، وقد أناط بها المشرع القيام بوظائف كثيرة ذات صلة بالحاجيات اليومية للسكان، كما أنها تقوم بتنفيذ جزء كبير من الاستثمارات العمومية، وهو ما يتطلب منها تهيئة الأوعية العقارية لتلك الاستثمارات عبر مسطرة نزع الملكية، وكذا التعاقد مع الغير من أجل إنجازها وتدبيرها، غير أنه في ظل ما تعانيه من ضعف على مستوى مواردها البشرية وآلياتها التدبيرية، لوحظ أن هناك أخطاء كثيرة ترتكب تتسبب في قيام منازعات مختلفة غالبا ما تعرض على المحاكم الإدارية وتقدم خلالها الجماعات الترابية كمدعى عليها مطالبة بتقديم التعويض للمطالبين به، وهو ما يؤثر سلبا على وضعها المالي الخاص وعلى التنمية الترابية بشكل عام.
وتم ذلك من خلال محطات متعددة، فلقد أصدرت وزارة الداخلية تقريرا حول المنازعات القضائية للجماعات الترابية ما بين سنة 1997 و2003 الصادر سنة 2005[6]، فخلال هذه المرحلة كان يميز المنازعات القضائية للجماعات الترابية هو التزايد المضطرد للأحكام الصادرة ضدها، مقارنة بتزايد الدعاوى كما هو مبين من خلال الجدول التالي:
الجدول رقم (1): مجموع الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات الترابية سنوات 2003 إلى 2008[7].
| مجموع الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجماعات المحلية Jugements Prononcés A L’encontre Des Collectivités Locales برسم سنوات 2003-2008 Au Titre Années |
| السنوات | مآل الحكم Etat du jugement | Années | |||
| عدد الأحكام Nombre de jugements | المنفذة Exécutés | الغير المنفذة Non exécutés | نسبة الأحكام المنفذة Pourcentage des jugements exécutés | ||
| 2003 | 218 | 35 | 183 | 16% | 2003 |
| 2004 | 266 | 48 | 218 | 18% | 2004 |
| 2005 | 302 | 61 | 241 | 20% | 2005 |
| 2006 | 404 | 151 | 253 | 37% | 2006 |
| 2008 | 817 | 389 | 428 | 40% | 2008 |
| المجموع | 2007 | 684 | 1323 | 34% | Total |
يستخلص بهذا الصدد، أن الأحكام النهائية التي لم يتم تنفيذها يفوق عدد الأحكام المنفذة بعدة أضعاف، ويمكن القول أن أكبر عدد من الأحكام صدرت في القضايا المطالبة بالديون المترتبة في ذمة الجماعات الترابية، كما يلاحظ أن عدد الأحكام المنفذة تنصب في موضوع الديون المستحقة، وبالتالي حتى هذا العدد من الأحكام المنفذة، الذي يظل متواضعا أمام الأحكام غير المنفذة والذي ما كان ليتم لولا تدخل سلطة الوصاية (المراقبة الإدارية) من خلال مجموعة من الإجراءات كان من أهمها فتح اعتمادات مالية من أجل أداء المبالغ المحكوم بها على الجماعات الترابية بناء على طلب هذه الأخيرة، إضافة لمجموعة من الدوريات والمناشير التي طالبت فيها سلطة الوصاية الجماعات بضبط منازعاتها[8].
وفي نفس السياق، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أنجز تقريرا حول تدبير منازعات الجماعات الترابية، كمرحلة أخرى شملت الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2016، رسم من خلاله صورة مقلقة عن حجم منازعات الجماعات الترابية، وعن كيفية تعاطيها معها، وهي في عمومها سلبية، حيث جاء في هذا التقرير أن عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات قد عرف تطورا مهما في الفترة المذكورة، حيث بلغ 831 حكم أو قرار خلال سنة 2016، مقابل 539 في سنة 2011، بزيادة نسبتها %54، كما يوضح ذلك الرسم البياني التالي:
 الرسم البياني (1): عدد الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية من 2011 إلى [9] 2016.
الرسم البياني (1): عدد الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية من 2011 إلى [9] 2016. المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص 166.
واللافت للانتباه في المعطيات التي تضمنها التقرير، هو ارتفاع مبالغ الأحكام والقرارات النهائية غير المنفذة من قبل الجماعات الترابية، والتي وصلت إلى 2.6 مليار درهم، مع عدد قضايا رائجة يصل إلى 6999 قضية بمبالغ مطالب بها تقارب 2.7 مليار درهم ويتضمن الرسم البياني الآتي تطور مبالغ الأحكام والقرارات النهائية المنفذة من قبل الجماعات الترابية:
 الرسم البياني رقم (2): تطور مبالغ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية والمبالغ المنفذة منها من سنة 2011 إلى 2016.
الرسم البياني رقم (2): تطور مبالغ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية والمبالغ المنفذة منها من سنة 2011 إلى 2016. المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 169 الجزء الأول، ص 167.
وبعد مرور ما يناهز سبعة سنوات عن هذه الإحصائيات الأخيرة فإن وضعية المنازعات القضائية للجماعات الترابية اليوم لا زالت تعرف نفس المنحى وهذا يتبين من خلال الاحصائيات المنجزة في السنوات الأخيرة (2021- 2022)، سواء من حيث الكم والمضمون، أو من حيث الأحكام الصادرة بشأنها من مختلف المحاكم والتي غالبا ما تصدر في غير صالح الجماعات الترابية وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات التأخير الذي يؤثر سلبا على ميزانياتها وعلى السير العادي لمرافقها وعلى مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التنمية الترابية، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تزايد هذه المنازعات والأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية، هو عدم التقيد التام لهذه الأخيرة بمبدأ المشروعية في بعض أعمالها، علما بأن تدبير شؤون الجماعات الترابية هو مؤطر بمقتضيات قانونية ملزمة وجب عليها احترامها تحت طائلة المساءلة القانونية، وفيما يلي توزيع الملفات الرائجة والمحكومة خلال سنوات 2019، 2020، 2021.
| 3845 |
| 3064 |

الرسم البياني رقم (3): [10]
إذا ما أمعنا النظر في توزيع الملفات الرائجة والمحكومة المدخل فيها الوكيل القضائي كطرف خلال سنوات 2019/2021 حسب نوع القضايا يتبين أن المد الكمي لنوع المنازعات في تطور وهذا مؤشر خطير ويقلق، هناك المسؤولية الإدارية تليه قضايا الوضعية الفردية ثم قضاء الإلغاء ثم العقود الإدارية والصفاقات الشيء الذي يعطي مؤشرا بنسبة مئوية فيما يخص المسؤولية الإدارية ما يقارب 50%، بالنسبة للوضعية الإدارية 19%، أما قضاء الإلغاء 11%، والعقود الإدارية 9%، هذه المعطيات حقيقية ومحينة ومتقاسمة بين الوكيل القضائي للجماعات الترابية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وهي مؤشرات تقلق كثيرا، أما فيما يخص الملفات المفتوحة للتنفيذ لدى المحاكم الإدارية في مواجهة الجماعات الترابية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 فقد بلغت، إلى حدود متم يوليوز،2017 حوالي 1268 ملف تنفيذ مفتوح بمبلغ إجمالي يناهز 1.5 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات المقدمة من طرف وزارة العدل والحريات لوزارة الداخلية، وتهم هاته الملفات قضايا أداء ديون والاعتداء المادي ونزع الملكية والصفقات العمومية والمسؤولية الإدارية.
 الرسم البياني رقم (4):[11]
الرسم البياني رقم (4):[11] وعند متم شهر دجنبر 2021 بلغ عدد الملفات المنفذة ما مجموعه 408 ملفا تنفيذيا من أصل 1935 ملف بمبلغ إجمالي وصل إلى 287 689 305,38 من أصل حوالي 03 مليار درهم، موزعة على مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة، والمبيان أعلاه يوضح بالملموس المؤشرات الإحصائية والمالية للملفات التنفيذية المنفذة في مواجهة الجماعات الترابية نهاية دجنبر 2021، ومن بين أهم الملاحظات السلبية المستنبطة من تقرير المجلس الأعلى للحسابات كذلك، هو ضعف نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية لصالح الجماعات الترابية (أولا)، واستخلاصا لما سبق يمكننا أن نحدد المخاطر التي تسبب المنازعات القضائية للجماعات الترابية (ثانيا) من خلال العناصر الأتية
أولا: ضعف نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالح الجماعات الترابية.
إن نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية لصالح الجماعات الترابية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 20 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة خلال سنة 2016 مقابل 34 في المائة خلال سنة 2011 كما هو مبين في الجدول أسفله:
جدول رقم (2): نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية لصالح الجماعات الترابية من سنة 2011 الى [12]2016:
| السنة | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| عدد الأحكام والقرارات النهائية لصالح الجماعات الترابية. | 172 | 223 | 336 | 383 | 319 | 390 |
| عدد الأحكام والقرارات النهائية المنفذة. | 58 | 61 | 86 | 92 | 67 | 79 |
| نسبة التنفيذ (%) | 34 | 27 | 26 | 24 | 21 | 20 |
من خلال الجدول رقم 6، يتبين أن الجماعات الترابية لا تولي الاهتمام الكافي لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها لصالحها، وهو ما يترجم ضعف تتبعها لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لفائدتها، بحيث إنها لم تتجاوز نسبة 20% من مجموع الأحكام الصادرة خلال سنة 2016، مقابل 34% خلال سنة 2011، وهو ما يشكل تراجعا وإن كان طفيفا فهو له تأثير سلبي على مالية الجماعات الترابية، كما أنه يكشف عن تعاملها السلبي وعدم اكتراثها بتدبير الأمثل للمال العام، وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الأحكام الصادرة لصالحها بصفتها مدعية تتعلق بدعاوى الترامي على الأملاك الجماعية وعدم أداء المداخيل المستحقة لها.
الرسم البياني رقم (5):[13]

المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 169 الجزء الأول، ص 171.
لقد بلغ مجموع مبالغ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالحها 44.3 مليون درهم خلال سنة 2016 مقابل 14 مليون درهم خلال سنة 2011، كما عرفت نسبة تنفيذ هذه الأحكام والقرارات، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، من حيث المبالغ تطورا متباينا من سنة إلى أخرى، إذ سجلت هذه النسبة عدة تغيرات تتراوح ما بين 0.2 في المائة سنة 2011 و7.2 في المائة سنة 2013 ثم 25 في المائة سنة 2016 كما هو مبين في الرسم البياني أعلاه[14]، وفي ظل هذه الأرقام والمعطيات، يسجل على الجماعات الترابية كذلك سوء تدبيرها لهذه المنازعات، وهنا تطرح إشكالات تدبيرية أخرى مرتبطة بغياب ذلك الفكر الشمولي في التعامل مع التنمية الترابية، لا يستقيم التأكيد على الاستقلال المالي للجماعات الترابية دون التأكيد على ضرورة حسن تصرفها فيه[15].
ثانيا: المخاطر التي تسبب المنازعات القضائية للجماعات الترابية.
أهم المخاطر المسببة للمنازعات القضائية للجماعات الترابية تنقسم بين دوافع موضوعية وأخرى ذاتية، الموضوعية تنطلق من كون الحقيبة القانونية التي تحتكم تسيير الشأن العام المحلي فهي جد غنية، ومتشابكة ومتداخلة فيما بينها بالإضافة إلى عدم تملك المنظومة القانونية من قبل المدبرين فهما واستيعابا وهذا يؤدي مباشرة إلى الإفراط في ممارسة امتيازات السلطة العامة وبهذا تقع اختلالات بالالتزامات أثناء مباشرة المشاريع التنموية التي فرضت الدخول في مخاطر مرتبطة بطبيعة التدبير، وهناك دوافع ذاتية ناتجة عن التقاضي بسوء النية والتي تعبر حقيقة عن شخصية المتنازعين.

| دوافع موضوعية |
| دوافع ذاتيـــة |
| شخصية المتنازعين |
| مخاطر التدبير |
| التقاضي بسوء نية |
منازعات الجماعات الترابية تشترك في مجموعة من الإشكاليات التي تتار بشأن منازعات القضاء الإداري للدولة والمؤسسات العمومية، لكنها تتميز بمجموعة من الخصوصيات التي يجب أخدها بعين الاعتبار عند البث في منازعات هذه الأخيرة بحيث هذه الخصوصية مستمدة من طبيعة الجماعات الترابية كشخص اعتباري عام، ونشاطها يخضع لمنظومة قانونية متميزة ويتم تدبير شؤون هذه المنظومة جهازين (المجلس - والرئيس) هذا الأخير الذي يمتاز بسلطات واسعة بمقتضى الدستور، وهناك كذلك جهات إدارية أخرى تتدخل في مجال عمل الجماعات الترابية.
عند تكيف الموقف القانوني لتصرفات الجماعات الترابية كشخص اعتباري يتبين من خلال استقراء العمل القضائي أن هناك عدم الاستقرار على معيار موحد لتحديد مسؤولية الجماعات الترابية خلال عملها الذي يؤدي إلى منازعة فهناك، معيار الاختصاص – معيار التمويل أو الانتساب المالي – معيار الإشراف على الأشغال -معيار الاستفادة من الأشغال ... ليس هناك معيار موحد تم الاستقرار عليه.
عدم التمييز بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة في تحديد المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية، ففي إطار ممارسة الاختصاصات الذاتية التي تتم من خلال صلاحيات موزعة بين الرئيس والمجلس، وتكون الجماعات الترابية مسؤولة مسؤولية تامة حتى ولو تمت هذه الممارسة في إطار اتفاقية شراكة مع أطراف آخرين، أما عندما يتعلق الأمر باختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية، فإن ممارسة هذا الصنف من الاختصاص لا يمكن أن تتم إلا في إطار تعاقدي بين الأطراف المعنية ويبقى العقد في هذه الحالة شريعة المتعاقدين ويجب الاحتكام إلى بنوده، الجماعات مسؤولة عن تقديم خدمات القرب لفائدة المرتفقين تواجه في حالات كثيرة تعقد المساطر القانونية التي كانت في الأصل موضوعة للدولة والإدارات العمومية (نزع الملكية نموذجا) وهو ما يعتبر أحد أبرز الأسباب المباشرة لارتفاع منازعات الجماعات (الاعتداء المادي).
الفقرة الثانية: التعاطي السلبي للجماعات الترابية مع منازعاتها.
استنادا إلى التقرير ذاته (التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017)، الذي يمكن اعتباره وثيقة مرجعية مهمة على الجماعات الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة فيه، يظهر التعاطي السلبي للجماعات الترابية مع تدبير منازعاتها، ويتجلى ذلك في مجموعة من الصور لعل أبرزها[17]:
أولا: غياب خريطة للمخاطر القانونية من أجل ضبط نوعية وأهمية أسباب إثارة المنازعات والعمل على تفاديها أو البحث عن حلول بديلة ومناسبة لتقليصها.
ثانيا: عدم لجوء أغلبية مصالح الجماعات لطلب الاستشارة القانونية من المصلحة المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات، سواء تلك التابعة لها، أم التابعة للعمالات والأقاليم.
ثالثا: عدم إشراك أغلبية الجماعات التي تتوفر على مصلحة للشؤون القانونية والمنازعات، لهذه الأخيرة في صياغة العقود والاتفاقيات.
رابعا: عدم توفر مجموعة من الجماعات الترابية على مصلحة خاصة بتدبير الشؤون القانونية والمنازعات، بحيث تبين أن 836 جماعة ترابية من بين 1189 لا تتوفر على وحدة إدارية مكلفة بالمنازعات والتتبع القضائي، حيث غالبا ما يتم تكليف مصالح أخرى غير مختصة بتدبير المنازعات كمصلحة الممتلكات أو مصلحة التعمير أو مصلحة الشرطة الإدارية أو وكالة المداخيل، وحتى إن وجدت فإن الموارد البشرية تكون غير متخصصة.
خامسا: عدم استثمار الأحكام والقرارات القضائية السابقة من أجل تنبيه المصالح الجماعية بهدف تفادي الأفعال الموجبة للمساءلة القضائية مستقبلا.
سادسا: بالرغم من الإمكانيات القانونية المتاحة لتفعيل الصيغة التوافقية لتفادي عدم المنازعات القضائية، عبر تمكين الولاة والعمال من إمكانية البت في الشكايات، تبين أنه نادرا ما يتم عقد لقاءات صلح بين المشتكين والجماعات الترابية المعنية وتدوين محاضر بشأنها، علما أنه بإمكان هذه المسطرة أن تمكن من تفادي إقامة الدعاوى أمام القضاء وتفادي مصاريف مواجهتها.
سابعا: عدم اللجوء إلى مساطر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية، ذلك أن هذه الأخيرة لا تباشر مسطرة الاستئناف أو النقض فيها في الآجال المحددة قانونا وتصبح حائزة على قوة الشيء المقضي به، فما يزيد عن 840 حكما ابتدائيا، صادرة ضد 1189 جماعة ترابية بقيمة 481 مليون درهم و2572 قرارا استئنافيا بقيمة 3.56 مليار درهم اكتسب قوة الشيء المقضي به خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، وذلك بعد أن أصبحت هذه الأحكام والقرارات ذات طبيعة نهائية.
ثامنا: يسجل ضعف في تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالح الجماعات الترابية والتي بلغت 44.3 مليون درهم خلال سنة 2016 مقابل 14 مليون درهم خلال سنة 2011، وهي غالبا ما ترتبت عن دعاوى الترامي على الأملاك الجماعية وعدم أداء المداخيل المرتبطة بها.
تاسعا: يسجل ضعف في الاعتمادات المالية المبرمجة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، فرغم أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد نصت على وجوب إدراج النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية باعتبارها نفقات إجبارية، كما تضمنت ذلك مقتضيات المادة 196 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 112.14 بالنسبة للعمالات والأقاليم، والمادة 181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات، غير أن الصبغة الطارئة لهذه النفقات وعدم إمكانية توقعها وتحديد وتيرة صرفها، يجعل إجباريتها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وفي هذا السياق يوصي المجلس الأعلى للحسابات، في ظل غياب اعتمادات مالية مخصصة مباشرة لصرف مبالغ التعويض المحكوم بها، بفتح اعتمادات مخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية وإدراجها ضمن النفقات القابلة للتسديد دون أمر سابق.
عاشرا: رغم وجود مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية (المساعد القضائي سابقا)، غير أنه حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات دائما 88% من الجماعات الترابية (1054 من بين 1189 جماعة ترابية) لم يسبق لها الاستعانة بخدمات المساعد أو الوكيل القضائي علما أن تدخله غالبا ما كان له أثر إيجابي لصالح الجماعة الترابية، كما هو الأمر بالنسبة لجل القضايا التي أشرف عليها خلال سنتي 2012 و2013 بطلب أو تفويض من الجماعات الترابية أو مجموعاتها فيما يقارب 26 ملف[18].
بعد القيام بتشخيص شامل لجميع الجوانب التي تخص منازعات الجماعات الترابية، من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة بشأنها للوقوف على مكامن الخلل واقتراح الآليات القانونية والعملية للتصدي لها. وحيث تبين من دراسة هذه الأحكام وخاصة الصادرة ضد الإدارة أن السبب يعود إلى أخطاء مرفقية منسوبة للمدبر المحلي سواء تعلق الأمر باتخاذ قرار غير مشروع، أو خطأ في تدبير صفقة عمومية أو خطأ مرفقي ترتبت عنه مسؤولية إدارية او اعتداء مادي على حق الملكية. وقد تم اعتماد خلاصات هذا التشخيص لتحديد الإنتظارات والحاجيات وخصوصا في مجال تأهيل الموارد البشرية المكلفة بتسيير الشأن العام المحلي وكذا المشرفة على تدبير المنازعات.
الفرع الثاني: آثار المنازعات القضائية للجماعات الترابية على مسار التنمية المحلية.
تشكل المنازعات القضائية التي تواجهها الجماعات الترابية تحديًا مزدوجًا، يتمثل في تأثيرها السلبي على مصداقية العدالة عند عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وعلى استدامة التنمية المحلية عند تنفيذها. فرغم أهمية احترام الأحكام القضائية لضمان سيادة القانون، فإن التنفيذ الفوري لهذه الأحكام، خصوصًا تلك الحائزة لقوة الشيء المقضي به، غالبًا ما يثقل كاهل ميزانيات الجماعات الترابية بشكل كبير.
إن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا، بل يمتد ليصبح عبئًا ماليًا يعطل السير العادي للمرافق العمومية، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما أن هذه الأعباء المالية تقوض جهود الجماعات الترابية في تخصيص الاعتمادات اللازمة لتمويل مشاريعها التنموية، مما يعرقل تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وفي هذا الإطار، نتساءل: كيف يؤثر تنفيذ الأحكام القضائية على ميزانيات الجماعات الترابية، وما هي انعكاساته على التنمية المحلية؟ الإجابة عن هذا السؤال تستدعي الوقوف على واقع هذه الأحكام، تحليل تداعياتها المالية والإدارية، واستشراف الحلول الممكنة لتجاوز هذه الإشكالات.
الفقرة الأولى: تداعيات المنازعات القضائية على استمرارية عمل المرافق العمومية المحلية.
نص الدستور المغربي الصادر في 29 يوليوز 2011 [19]على مجموعة من المبادئ والآليات المؤطرة لتدبير المرافق العمومية[20]، بعضها يكتسي طابعا تقليديا، نشأ مع ظهور مفهوم المرفق العمومي وتطور مع تطور وظائف الدولة وتدخلاتها، والبعض الآخر، ارتبط بالاتجاهات الجديدة في ميدان تحديث التدبير العمومي وتعزيز أداء المرافق العمومية والرفع من جودتها.
ولا شك في أن تكريس المبادئ التقليدية المؤطرة لسير المرافق العمومية، إلى جانب الارتقاء بعدد من المبادئ والمعايير "الحديثة" الأخرى عبر تضمينها في الوثيقة الدستورية، يؤشر على أن المرفق العمومي كان ومازال يشكل أحد الأسس المهمة التي تستمد منها الدولة مبرر وجودها وشرعية استمراريتها. إن الرهان لم يعد يقتصر على ضرورة توفير المرافق العمومية وتغطيتها لكافة المجالات، بل أصبح يُطرح وبإلحاح على مستوى نجاعة هذه المرافق في إشباع احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم، هذا التحول في المطالب والإنتظارات انعكس بشكل أوضح في علاقة المواطنين (الشعب) بالسلطات العمومية (الحكام)، فأصبحت هذه العلاقة في العادة، إيجابية ومبنية على الثقة حينما تودي المرافق العمومية وظائفها على نحو جيد ينال حدا أدنى من رضا المواطن، وفي المقابل، متشنجة ومرتكزة على التسلط تعاني من ضعف منسوب الثقة عندما تعجز المرافق العمومية عن خدمة المواطن بالكيفية المطلوبة. وبالتالي فمستوى جودة الخدمة العمومية بدولة ما يشكل معيارا حاسما في تكريس شرعية نظامها الحاكم وتحديد طبيعة العلاقة بين الحكام والشعب داخل هذه الدولة. ووعيا بأهمية هذا المعطى الذي تتجاوز أبعاده ما هو إداري واجتماعي إلى ما هو سياسي وأمني، عمل المشرع الدستوري خلال سنة 2011 التي تميزت بسياق وطني وإقليمي خاص، على تقوية التأطير الدستوري لمبادئ وقواعد تدبير المرافق العمومية وتعزيز حكامتها، بغاية خلق دينامية جديدة في ميدان النشاط الإداري على مستوى الممارسة، في أفق تجاوز الاختلالات والأعطاب المتعددة التي ظلت عصية عن الإصلاح على امتداد عقود من الزمن[21].
تأسيسا على ما سبق، تعالج هذه المساهمة إشكالية محورية يثيرها البحث في هذا الموضوع، تتمثل في التالي، إلى أي حد انعكست الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية في أداء المرافق العمومية المحلية مهامها بانتظام واضطراد؟ في ظل تخلف الممارسة الإدارية في ميدان تدبير المرافق العمومية التي تهم الجماعات الترابية، فيما يتعلق بخدمات القرب فإن الجماعات تختص بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم هذه الخدمات، كما يتخذ رؤساء مجالسها الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة لها[22]. وتقدم هذه المرافق مجموعة من الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين كالنقل، والماء والكهرباء والتطهير السائل والنظافة... وتدار وفقا لأسلوب تدبير معين، التدبير المباشر من طرف الجماعة، وكالات مستقلة، شركات للتنمية المحلية أو من خلال إسناد التدبير والاستغلال إلى القطاع الخاص عن طريق عقود التدبير المفوض أو اتفاقيات الشراكة والتعاون، على أن يتم تدبيرها وفق المعايير الأساسية التي تطبع سيرها من قبيل:
- معيار الجودة: يفيد بتأدية الخدمة بجودة، مع ما يقتضيه ذلك من توفير للإمكانيات وتبني الطريقة المثلى في تدبير المرفق.
- معيار الشفافية: يقتضي اشتغال هذه المرافق في إطار يتسم بالشفافية وأن قواعد تسييرها معلومة للجميع مع الانفتاح على المرتفقين وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتظلماتهم[23].
- معيار ربط المسؤولية بالمحاسبة: تقديم المرافق للحساب عن تدبير الأموال العمومية وخضوعها للمراقبة والتقييم والتدقيق[24].
وذلك بهدف إشباع الحاجيات الحيوية والخدمات الأساسية للجمهور، وأي توقف أو اضطراب في سير هذه المرافق يؤدي إلى عدم قيامها بدورها مما يترتب عليه آثار تنعكس سلبا على الأفراد والمجتمع وذلك بتعطيل مصالحهم فقد تصل إلى حد الإخلال بالنظام العام، والمنازعات القضائية الموجهة ضد الجماعات الترابية لها تأثير كبير على السير العام للمرافق العمومية المحلية، ومن بين التأثيرات الحاصلة في هذا الشأن هو أن الحجز على أموال الجماعات الترابية المعنية بالمرفق بسبب أحكام قضائية صادرة ضدها، يحدث ارتباكا كبيرا على مستوى تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي تقتطع من الميزانية المحلية وتخلف عدة إشكالات على مستوى التزامات الجماعات الترابية اتجاه الشركاء ومنهم شركات التدبير المفوض، ومن الجماعات من تعيش تراكم مهول للديون المترتبة بخصوص آداء فواتير الماء والكهرباء[26].
أولا: الحجز وأثاره على سير المرافق العمومية.
يعتبر الحجز على الأموال أحد أنواع التنفيذ الجبري التي تطبق في إطار القانون الخاص، والتي يتعذر ممارستها في مواجهة الإدارة إلا إذا تعلق الأمر بالملك الخاص لهذه الأخيرة. وإذا كان المبدأ العام يقضي بعدم جواز الحجز على الأموال العمومية حفاظا على مبدأ سير المرفق العمومي بانتظام واطراد، فإن ذلك لم يمنع القضاء الإداري المغربي من اعمال مسطرة الحجز على أموال الدولة الخاصة، وهذا ما أكده العمل الفقهي والاجتهاد القضائي الذي يسمح بإمكانية الحجز على أموال الدولة الخاصة بهدف فصلها عن الأموال العامة، إذ يعد الحجز من الوسائل التنفيذية الجبرية التي يمكن اللجوء إليها من أجل تنفيذ أحكام القضاء في حق الملزمين بها، وباعتباره كذلك فلا يمكن اللجوء إليه إلا بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة طبقا للفصل 491 من ق.م.م ويمكن اللجوء إليه في مواجهة الإدارة ما دام لا يوجد أي نص قانوني صريح يمنع ذلك، فالمشرع لم يستثني الإدارة من الحجز على كل أموالها بنص صريح كما لم يخضعها في هذا الصدد لنظام خاص يضمن الحماية لجميع أموالها وكيفما كانت طبيعتها، وبما أنه أحالنا من خلال المادة 7 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية إلى قواعد المسطرة المدنية فيما يخص مسألة تنفيذ أحكام القضاء الإداري[27].
لهذا يمكن اعتبار أن الإدارة شأنها في ذلك شأن باقي أشخاص القانون الآخرين لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات وبذلك عليها الإذعان لهذه الأحكام، لكن استمرار الإدارة في إمتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بطواعية لأداء ما عليها من التزامات مالية أو أداء التعويضات المحكوم بها عليها، أدى إلى لجوء المتنازعين معها من أصحاب الحقوق إلى اتباع مساطر الحجز على أموال وممتلكات الإدارة من أجل تنفيذ تلك الأحكام، وهو ما كان يضعها في موقف محرج عندما تصبح أموالها المنقولة والعقارية مهددة بالبيع في المزاد العلني، وخاصة أموالها الخاصة التي أقر الإجتهاد القضائي المغربي إمكانية الحجز عليها دون أموالها العامة التي لا يمكن الحجز عليها كما هو معلوم قانونا وفقها وقضاء[28].
يعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية مسا صريحا وسافرا في صميم استقلال السلطة القضائية، كما أن الامتناع عن التنفيذ لحجة استمرار سير المرافق العامة سيتسبب في إختلال مرفق حيوي ومهم ولا يقل أهمية وهو مرفق القضاء وسيمس بسيره العادي من خلال عدم تنفيذ الاحكام التي يعد سبب وجود القضاء أساسا وليس الحصول على أحكام شرفية والاحتفاظ بها بدون تفعيل لحجيتها وقوتها.
الفقرة الثانية: آثار المنازعات القضائية على ميزانية الجماعات الترابية.
تمثل المنازعات القضائية التي تواجهها الجماعات الترابية تحديًا حقيقيًا ينعكس بشكل مباشر على توازنها المالي واستقرارها التنموي. إذ تفرض الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ولا سيما تلك الحائزة لقوة الشيء المقضي به، ضغوطًا مالية كبيرة تؤدي إلى إرهاق ميزانياتها، حيث تصبح ملزمة بتخصيص اعتمادات مالية لتغطية المبالغ المحكوم بها، هذا الأمر يتسبب في تحويل الموارد المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية إلى تسديد ديون الأحكام، مما يعيق تحقيق الأهداف التنموية ويزيد من معاناة هذه الجماعات في الوفاء بالتزاماتها، إن تأثير هذه المنازعات لا يقتصر فقط على الميزانية، بل يمتد إلى تعطيل عمل المرافق العمومية المحلية، فعندما يتم الحجز على أموال الجماعات بناءً على أحكام قضائية، تجد هذه الوحدات نفسها عاجزة عن تمويل النفقات التشغيلية أو الاستثمارية، مما يؤدي إلى توقف بعض الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والنقل. هذه التداعيات المالية الخطيرة تعطل مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية وتضعف من مستوى جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
علاوة على ذلك، تفتقر الجماعات الترابية إلى آليات تخطيط مالي فعالة لمواجهة الآثار المحتملة للمنازعات القضائية، غالبًا ما تُدرج هذه الأحكام في خانة المصاريف الطارئة دون تخصيص اعتمادات مالية كافية في الميزانية للتعامل معها، هذا النقص في التخطيط يؤدي إلى اضطراب تنفيذ المشاريع التنموية، ويدفع الجماعات إلى اتخاذ تدابير استثنائية مثل تأجيل المشاريع أو طلب دعم مالي إضافي من الدولة، مما يعمق تبعيتها المالية ويقلل من استقلاليتها، ولهذا جاء المشرع بالبرمجة المتعددة السنوات والتي تهدف بالأساس إلى عقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية من جهة، وتحسين تدخلاتها التنموية من جهة أخرى[29]. ولا يتوقف تأثير المنازعات القضائية عند حدود الجماعة الترابية نفسها، بل يمتد إلى شركائها الاقتصاديين. فعندما تعجز الجماعات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المقاولات والشركات المتعاقدة معها، تتضرر سمعتها وثقة المستثمرين فيها، هذا الوضع ينعكس سلبًا على فرص إقامة شراكات مستقبلية ويضعف قدرتها على جذب الاستثمارات التي تحتاجها لتحقيق التنمية.
وفي هذا الصدد فقد سبق للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية أن أوردت الأحكام النهائية ضمن النفقات الإجبارية التي يجب أن تتضمنها الميزانية وجوبا، كما يتم العمل سنويا على حث رؤساء الجماعات الترابية على رصد الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ هذه الأحكام النهائية من جهة وذلك بمناسبة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية، ومن جهة أخرى تعمل المصالح المختصة بوزارة الداخلية من خلال إجتماعات تنسيقية دورية مع وزارة العدل على حصر الملفات التنفيذية المفتوحة لدى المحاكم الإدارية في مواجهة الجماعات الترابية قصد تتبع تنفيذها، بحيث يتم مراسلة جميع الجماعات الترابية المعنية بهذه الملفات قصد الوقوف على مآل التنفيذ وموافاة المصالح المعنية بالوثائق المثبتة لذلك مع التذكير بإمكانية بحث التنفيذ بالتراضي لهذه الأحكام بما يحفظ مصالح الأطراف.
وبالتالي فإن تنفيذ الأحكام القضائية يمتص مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعات الترابية، بحيث بلغ عدد الملفات المنفذة عند متم شهر دجنبر 2021 بجهة مراكش – أسفي، لوحدها ما مجموعه 53 ملف بمبلغ إجمالي وصل إلى64 728 337,31، من مجموع 408 ملف تنفيذي على الصعيد الوطني بمبلغ إجمالي كلي 287 689 305,38 من أصل حوالي 03 مليار درهم، موزعة على مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة[30].
وفيما يتعلق بمواكبة الجماعات الترابية في أداء النفقات الإجبارية، لاسيما تنفيذ الأحكام القضائية، قال السيد لفتيت وزير الداخلية إن الوزارة حرصت على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لمالية هذه الجماعات خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تعرفها المملكة، مضيفا أنه تم تذكير الجماعات الترابية، من خلال دورية إعداد وتنفيذ الميزانية لسنة 2023، بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية، خصوصا الإجبارية منها، والتي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية، وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن الوزارة استجابت لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، مبرزا أنه تم تقديم الدعم المالي خلال سنة 2022، لتمويل النفقات الإجبارية وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، إذ بلغ سنة 2022، عدد الجماعات المستفيدة حوالي 370 جماعة ترابية، وهذا يعكس بشكل جلي الأثار المالية التي تنتجها الأحكام والقرارات الصادرة ضد الوحدات الترابية، ودعا السيد وزير الداخلية الجماعات الترابية، التي تعاني صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القاضية النهائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية على اتفاقات بالتراضي من أجل تقسيم أداء هذه الأحكام على مجموعة من الأشطر، لافتا إلى أن مصالح الوزارة تبقى رهن إشارة الآمرين بالصرف من أجل مواكبتهم لتدبير أمثل لمالية الجماعات الترابية.[31]
فإذا كانت الجماعات الترابية ملزمة ببرمجة الاعتمادات اللازمة سنويا لأداء المبالغ المالية التي تكون بذمتها، فإن في غالب الأحوال تكون ميزانياتها لا تسمح بتغطية المبالغ الهائلة المحكومة ضدها فإنها تصبح عاجزة عن أداء ولو جزء يسير من قيمة ومبالغ هذه الأحكام، وعلى إثر ذلك، يلجأ بعض الدائنين في استصدار أحكام بالحجز على أموال أو ممتلكات الجماعات الترابية، وهي مسألة خطيرة تهدد السير العادي لهذه الجماعات وتهدد استمرارية المرافق العامة المحلية من أساسه.
جدول رقم (2): بيان تنفيذ ميزانية جماعة أسفي لسنة 2022 فيما يخص تنفيذ الأحكام.
| بيان | مجموع الاعتمادات المفتوحة | المصاريف الملتزم بها | الحوالات الصادرة والمؤشر عنها | الاعتمادات المرحلة | الاعتمادات الملغاة |
| نفقات تنفيذ الأحكام | 3 711 016.55 | 3 652 215.11 | 3 652 215.11 | 0.00 | 58 801.44 |
| صوائر المسطرة وإقامة الدعاوى | 26 552.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 0.00 | 19 052.00 |
الملاحظ أن هناك تطور هام في عدد الأحكام النهائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية، بالمقابل هناك محدودية في تنفيذها لها، خصوصا الأحكام ذات المبالغ الهامة التي يثير تنفيذها صعوبات كبيرة بالنظر إلى محدودية ميزانيات الجماعات الترابية ومخصصات تنفيذ الأحكام النهائية بها، ولهذا يجب رصد اعتمادات مالية كافية بالسطر المتعلق بتنفيذ الأحكام بالميزانيات الفرعية يكون غير قابل للتحويل، ويؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الاعتمادات المرصودة فيه بحجم المبالغ المحكوم بها في مواجهة الجماعات الترابية والدعاوى الجارية ضدها أمام القضاء، ويجب أن تكون تلك الاعتمادات مبنية على تقديرات حقيقية وواقعية تشكل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية على ضوء قواعد المحاسبة العمومية وحث الجماعات الترابية و الإدارات العمومية على تخصيص فائض الميزانية لتنفيذ الأحكام القضائية، إذ من غير المستساغ اعتبار وجود فائض بالميزانية والحال أن الإدارة المعنية مدينة لطالبي التنفيذ[32]. مع الأسف هذا ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة أن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 4,4 مليار درهم عند متم أبريل 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة 3,2 مليار درهم سجلت خلال السنة الفارطة، وأوضحت الخزينة، كذلك في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر أبريل 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 369 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022[33]، وهذا في اعتقادي لا يستقيم، ففي ظل هذه المعطيات، أصبح من الضروري تحسين حكامة الجماعات الترابية وتعزيز الكفاءة الإدارية والقانونية لتقليل المخاطر المرتبطة بالمنازعات القضائية، يتطلب ذلك تبني استراتيجيات استباقية تعتمد على تخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ الأحكام القضائية، وتعزيز اللجوء إلى الآليات البديلة لتسوية النزاعات، مثل الصلح والوساطة. كما ينبغي تطوير خريطة للمخاطر القانونية تساعد في ضبط النزاعات المحتملة وتقليل تداعياتها المالية والإدارية.
إن معالجة آثار المنازعات القضائية على ميزانية الجماعات الترابية تتطلب توازناً دقيقًا بين احترام الأحكام القضائية وضمان الاستدامة المالية والتنموية لهذه الوحدات. تحقيق هذا التوازن يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة بين الجماعات الترابية ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وضمان قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المحلية بشكل مستدام وفعال.
الفقرة الثالثة: آثار المنازعات القضائية على تنزيل البرامج التنموية الترابية.
تؤثر المنازعات القضائية بشكل كبير على قدرة الجماعات الترابية على تنزيل برامجها التنموية، مما ينعكس سلبًا على تحقيق أهداف التنمية المحلية، يعد التخطيط الاستراتيجي أحد الأعمدة الرئيسية للتدبير الترابي، حيث تعتمد الجماعات الترابية على هذا التخطيط لتحديد أولوياتها وإعداد برامجها التنموية. غير أن المنازعات القضائية، خاصة تلك المرتبطة بالأملاك الجماعية أو الصفقات العمومية، تُحدث اختلالات في هذا التخطيط، إذ تُلزم الجماعات بتوجيه مواردها المالية نحو تغطية الالتزامات الناشئة عن الأحكام القضائية، مما يؤدي إلى تقليص الموارد المخصصة للمشاريع التنموية وتأجيل تنفيذها أو إلغائها في بعض الأحيان.إن تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا التي تتضمن تعويضات مالية كبيرة، يستهلك جزءًا كبيرًا من ميزانية الجماعات الترابية، هذا الاستنزاف المالي يفرض على الجماعات إعادة ترتيب أولوياتها، ما يؤدي غالبًا إلى تعطيل أو إلغاء مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحجز على أموال الجماعات نتيجة هذه الأحكام يضاعف من حجم التأثير السلبي، إذ يعرقل سير المشاريع المبرمجة ويوقفها في مراحلها الأولى، مما يخلق فجوة بين ما يتم التخطيط له وما يتم تحقيقه على أرض الواقع. إلى جانب التأثير المالي المباشر، تؤثر المنازعات القضائية على علاقات الجماعات الترابية بشركائها الاقتصاديين، فعدم قدرة الجماعات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولات أو الشركات المتعاقدة يضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى تردد المستثمرين في الدخول في شراكات جديدة. هذا الوضع يُفقد الجماعات الترابية فرصًا مهمة لتمويل وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، ويحد من قدرتها على تحقيق التنمية المنشودة.
علاوة على ذلك، فإن تراكم الالتزامات المالية الناتجة عن الأحكام القضائية يهدد الاستدامة المالية للجماعات الترابية. ففي العديد من الحالات، يتم توجيه الفوائض المالية، التي كان من المفترض أن تُستخدم في تمويل مشاريع جديدة أو تطوير خدمات محلية، نحو تغطية الأحكام القضائية. هذا الأمر يقيد قدرة الجماعات على تمويل مشاريع طويلة الأمد، ويحد من إمكانياتها في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
إن آثار المنازعات القضائية على تنزيل البرامج التنموية للجماعات الترابية تمثل تحديًا حقيقيًا يستدعي تبني حلول استباقية وفعالة. من الضروري تحسين حكامة الجماعات الترابية عبر تعزيز الكفاءة القانونية والإدارية لتقليل النزاعات وتفاديها. كما يتطلب الوضع تطوير آليات مالية تستوعب المخاطر المرتبطة بالمنازعات، مع اعتماد حلول بديلة لتسوية النزاعات مثل الصلح والتحكيم. تحقيق التوازن بين الوفاء بالالتزامات القضائية وتنفيذ البرامج التنموية يعد خطوة محورية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز الثقة بين الجماعات الترابية ومحيطها الاقتصادي والاجتماع
الفقرة الرابعة: آثار المنازعات القضائية على الأمن القانوني والقضائي.
إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالا جسيما لمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء وضرب للأمن القانوني والقضائي، كما أن استمرار عدم تنفيذ أشخاص القانون العام بما فيهم الجماعات الترابية للأحكام الحائزة قوة الشيء المقضي به الصادرة ضدهم أصبح يؤثر سلبا وبكيفية مباشرة حتى على الاستثمارات الأجنبية داخل الكثير من الدول، إذ أصبح المستثمر الأجنبي يتساءل عن طبيعة وقيمة الضمانات القانونية الممنوحة له إذا كانت تلك الجهات المفروض فيها قبل غيرها الانصياع إلى القانون وقوة الشيء المقضي به ترى نفسها غير ملزمة فعليا بالالتزام لقرارات محاكم البلاد. لا شك في أن القضاء يعتبر رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات، فلا يمكن الحديث عن جلب الاستثمار دون الحديث عن دور القضاء في حمايته، فتوفير البيئة القضائية الآمنة شرط لبعث الثقة لدى المستثمر وتبديد مخاوفه من عدم قدرته على الدفاع عن مصالحه الاقتصادية، بحيث يعتبر مقياسا حقيقيا لنجاح الخطط التنموية للدولة.
وفي هذا السياق، يعتبر تقرير النموذج التنموي الجديد الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بتنزيله إطارا مرجعيا مناسبا لتحقيق التوازن بين شروط الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال رؤية واضحة ومتكاملة تضع المواطن في صلب الاهتمامات اليومية.
إن تحقيق عدالة منصفة وسريعة، عدالة تضمن سيادة القانون مطلب أساسي لكل مستثمر يتعين على الجميع التعبئة لبلوغه، وهو ما فتئ جلالة الملك يلح عليه في خطبه الشريفة، حيث قال جلالته في كلمة وجهت للمشاركين بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي عقد بمدينة مراكش يوم 21 أكتوبر 2019 والتي جاء فيها: (وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع "العدالة والاستثمار التحديات والرهانات" لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة)[34]،
فالقضاء الإداري يعتبر دعامة أساسية للمجتمع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وممارسة الحريات الأساسية وتوفير الثقة واطمئنان المواطنين، وترسيخ لسيادة الشرعية، وتثبيت دولة الحق والقانون والمؤسسات وحافزا مهما لتشجيع الاستثمار وتطوير الاقتصاد ومكونا فاعلا في التنمية في جميع المجالات، ولن يتأتى ذلك إلا بالاحترام للسلطة القضائية والأحكام الصادرة عنها والإطمئنان إليها والثقة فيها من لدن الجميع بما في ذلك الدولة ومؤسساتها، لأن أحكام القضاء ما هي إلا تطبيق للقانون على أرض الواقع، فإن الذي يحكم ويسود هو القانون وليس القضاء ومن ثم فالكل مخاطب بأحكام القانون حكاما ومحكومين، إلا أن الأحكام قد تبقي مجرد شرح نظري للقانون ما لم يتم تنفيذها، فإذا كانت حصيلة الدعوى ونتيجتها هي الحكم القضائي، فإن هذا الحكم لا قيمة له إن لم يترجم عن طريق تنفيذه، ولو عن طريق القوة والإكراه لفرض هيبة القضاء ونجاعته، فإذا كانت العدالة تكمن في قوة قضائها فإن قوة القضاء تكمن في تنفيذ أحكامه[35].
خاتمة
تعتبر المنازعات القضائية للجماعات الترابية معضلة قانونية ومالية تؤثر بعمق على أداء هذه الوحدات الترابية وقدرتها على تحقيق التنمية المحلية المستدامة. فمن جهة، يفرض احترام الأحكام القضائية وتنفيذها التزامات مالية كبيرة تضعف ميزانية الجماعات الترابية، ومن جهة أخرى، تعطل هذه المنازعات المشاريع التنموية المبرمجة، مما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وثقة الشركاء والمستثمرين في الجماعات.
إن مواجهة هذه الإشكالات تستدعي تبني سياسات شمولية تعتمد على الاستباقية في تدبير المنازعات القضائية والحد من آثارها السلبية. ويُوصى بتعزيز الكفاءة الإدارية والقانونية للجماعات من خلال تكوين الموارد البشرية المتخصصة في تدبير المنازعات، مع ضرورة إنشاء مصالح قانونية داخل الجماعات تكون مسؤولة عن تقديم الاستشارات ومتابعة القضايا. كما يجب تحسين الحكامة المالية من خلال تخصيص اعتمادات مالية كافية في الميزانيات لمواجهة الآثار المالية للأحكام القضائية، واعتماد آليات تخطيط مالي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر القانونية.
وفي ظل التوجهات الحديثة في القضاء الإداري، ينبغي للجماعات الترابية تعزيز اللجوء إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات، مثل الصلح والوساطة والتحكيم، لتقليل اللجوء إلى القضاء وخفض التكاليف المرتبطة بالنزاعات القضائية. كما أن بناء خريطة للمخاطر القانونية والمالية يمكن أن يساعد في تقليص أسباب النزاعات، خاصة تلك المتعلقة بنزع الملكية أو الصفقات العمومية.
وعلى المستوى الوطني، يُستحسن تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجالس الجهوية للحسابات لوضع استراتيجيات موحدة لدعم الجماعات الترابية في تدبير منازعاتها. كما يمكن تطوير سياسات تشجيعية تستقطب الاستثمارات وتعزز الشراكات الاقتصادية، ما يساهم في تحسين الوضع المالي للجماعات وتخفيف تأثير المنازعات على برامجها التنموية.
ختامًا، يبقى تحقيق التوازن بين احترام سيادة القانون وضمان التنمية المحلية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وشركائها. وإذا ما تم اعتماد هذه التوصيات ضمن رؤية شاملة ومتكاملة، فإن الجماعات الترابية ستكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات المنازعات القضائية وتعزيز دورها في تحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الساكنة وتحترم مبادئ الحكامة الجيدة.
المراجع المعتمدة
- حليمة الهادف، التحديث الإداري بالمغرب واقع وأفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2002/2003.
- سكينة القرواوي، دور المساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية، منشورات مجلة الفقه والقانون، العدد 15، يناير 2014.
- رشيد عدنان، خصوصيات تدبير منازعات الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري، منشورات مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع، العدد المزدوج 4-5 نونبر -دجنبر 2021.
- محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 94، 2015.
- عصام القرني، أسس تدبير المرافق العمومية بالمغرب، زخم دستوري وتعترضه صعوبة التفعيل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 156، يناير – فبراير 2021.
- عبد الله مخلوق، الأليات الحديثة للقاضي الإداري في ضمان تنفيذ أحكامه دراسة تقييمية وتقويمية، منشورات سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 35، المنازعات الإدارية مؤلف جماعي محكم، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية الرباط، 2023.
- عبد الهادي الخياطي، مسؤولية الدولة عن قيود تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها، مشورات سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 35، المنازعات الإدارية – مؤلف جماعي، الجزء الثاني سنة 2023.
- الحسن الرشدي، الآمرون بالصرف: جدلية الصلاحيات والمسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 159-160، يوليوز – أكتوبر 2021.
- حكبم رمضان محمد بن ضؤ، الضمانات القانونية لتنفيذ أحكام القضاء الإداري دراسو مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2021.
- http://www.mapexpress.ma/ تاريخ الاطلاع 19 يونيو 2023، على الساعة 21:39.
- نسرين بوخيزو، منازعات الجماعات الترابية وأثارها على التنمية المحلية، الطبعة الأولى 2022، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط.
- https://fondafip.tgr.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 22 يونيو 2023.
- الجماعات المحلية في أرقام، طبعة 2009، ص 138، منشور بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية https://collectivites-territoriales.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 07/06/2023.
- التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص 166.
- تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة، سنة 2018.
- عرض الوكيل القضائي للجماعة الترابية بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، بتاريخ 27 ماي 2022.
- مقتطف من نص كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، المنعقد بالداخلة في الفترة الممتدة من 08 إلى 10 مارس 2022، ص 5. للمزيد من الاطلاع أنظر الرابط الرسمي لموقع رئاسة النيابة العامة، https://www.pmp.ma/، تاريخ الاطلاع 20 يونيو 2023.
- مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة عيد العرش الرباط يوم 30/07/2000.
- مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، المؤرخ في 20 غشت 2018.
[1] - حليمة الهادف، التحديث الإداري بالمغرب واقع وأفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2002/2003، ص 59.
[2] - المصدر، عرض الوكيل القضائي للجماعة الترابية بمناسبة الندوة الوطنية حول موضوع دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، بتاريخ 27 ماي 2022.
[3] - مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة عيد العرش الرباط يوم 30/07/2000.
[4] - مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الموجه الى الأمة بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، المؤرخ في 20 غشت 2018.
[5] - تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة، سنة 2018، ص 71.
[6] - سكينة القرواوي، دور المساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية، منشورات مجلة الفقه والقانون، العدد 15، يناير 2014، ص 277.
[7] - المصدر: الجماعات المحلية في أرقام، طبعة 2009، ص 138، منشور بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية https://collectivites-territoriales.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 07/06/2023، على الساعة 21:46.
[8] - سكينة القرواوي، دور المساعد القضائي في تدبير منازعات الجماعات الترابية، مرجع سابق، ص 284.
[9] - المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، الجزء الأول، ص 166.
[10] - أنظر الإحصائيات المتضمنة بالعرض الدي قدمه الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمناسبة الندوة الوطنية المقامة بتاريخ 27 ماي 2022، حول موضوع دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات القضائية، والمنشور بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 07/06/2023، على الساعة 22:18.
[11] - أنظر الإحصائيات المتضمنة بالعرض الدي قدمه الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمناسبة الندوة الوطنية المقامة بتاريخ 27 ماي 2022، مرجع سابق.
[12] - المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، مرجع سابق، ص 168.
[13] - المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، نفس المرجع، ص 171.
[14] - المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، نفس المرجع، ص 171.
[15] - رشيد عدنان، خصوصيات تدبير منازعات الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري، منشورات مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع، العدد المزدوج 4-5 نونبر -دجنبر 2021، ص 400.
[16] - أنظر الإحصائيات المتضمنة بالعرض الدي قدمه الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمناسبة الندوة الوطنية المقامة بتاريخ 27 ماي 2022، مرجع سابق.
[17] - راجع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017.
[18] - المصدر، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017، نفس المرجع، ص 169.
[19] - صادر بتنفيذه الظهير رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[20] - المرفق العام هو نشاط تقوم به الأشخاص العامة، إما بصفة مباشرة أو تحت إشرافها، ذلك من أجل إشباع حاجات عامة ذات منفعة عامة، أنظر محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 94، 2015، ص 374.
[21] - عصام القرني، أسس تدبير المرافق العمومية بالمغرب، زخم دستوري وتعترضه صعوبة التفعيل، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 156، يناير – فبراير 2021، ص 312.
[22] - مقتطف من المادتين 83 و94 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
[23] - الفصل 154 و155 من الدستور المغربي.
[24] - الفصل 156 من الدستور.
[25] - المادة 243 من القانون التنظيمي 11.14 المتعلق بالجهات، والمادة 213 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 269 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
[26] - يمكن الإحالة هنا على تجربة جماعة طنجة بحيث عجزت الجماعة عن إتمام التزاماتها بأداء ديونها وكذا التزاماتها مع شركات التدبير المفوض كشركة الماء والكهرباء امانديس وشركات النظافة – سولمطا - سيطا –.
[27] - عبد الله مخلوق، الأليات الحديثة للقاضي الإداري في ضمان تنفيذ أحكامه دراسة تقييمية وتقويمية، منشورات سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 35، المنازعات الإدارية مؤلف جماعي محكم، الجزء الثاني، مطبعة الأمنية الرباط، 2023، ص 83.
[28] - عبد الهادي الخياطي، مسؤولية الدولة عن قيود تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها، مشورات سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 35، المنازعات الإدارية – مؤلف جماعي، الجزء الثاني سنة 2023، ص 223.
[29] -الحسن الرشدي، الآمرون بالصرف: جدلية الصلاحيات والمسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 159-160، يوليوز – أكتوبر 2021، ص 87.
[30] - المصدر، المديرية العامة للجماعات الترابية، مديرية المؤسسات المحلية.
[31] - مقتطف من جواب السيد وزير الداخلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، على سؤال محوري حول مآل إصلاح منظومة الجبايات المحلية، أنظر الموقع الرسمي لوكالة المغرب العربي للأنباء على الرابط http://www.mapexpress.ma/ تاريخ الاطلاع 19 يونيو 2023، على الساعة 21:39.
[32] - نسرين بوخيزو، منازعات الجماعات الترابية وأثارها على التنمية المحلية، الطبعة الأولى 2022، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط، ص170.
[33] - أنظر بهذا الشأن إلى النشرة الشهرية للإحصائيات المالية المحلية برسم شهر أبريل 2022، على الموقع الرسمي للخزينة العامة للمملكة على الرابط https://fondafip.tgr.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 22 يونيو 2023، على الساعة 22:21.
[34] - مقتطف من نص كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، المنعقد بالداخلة في الفترة الممتدة من 08 إلى 10 مارس 2022، ص 5. للمزيد من الاطلاع أنظر الرابط الرسمي لموقع رئاسة النيابة العامة، https://www.pmp.ma/، تاريخ الاطلاع 20 يونيو 2023، على الساعة 19:55.
[35] - حكبم رمضان محمد بن ضؤ، الضمانات القانونية لتنفيذ أحكام القضاء الإداري دراسو مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2021، ص12.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية وآثارها على التنمية المحلية
تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية وآثارها على التنمية المحلية