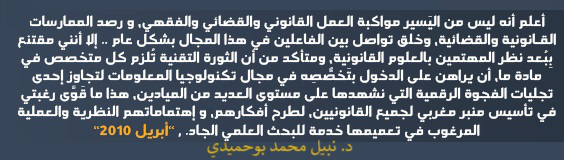2 - نظرية العقد الاجتماعي
لكي يتم تفسير نشوء الدولة لجأ العديد من الفلاسفة إلى افتراض فكرة العقد الاجتماعي الذي يعتبر عقدا صريحا أو ضمنيا بموجبه يتخلى الأفراد عن جزء من حرياتهم لصالح إرادة عليا تحمي ما تبقى من حقوق.
ويعتبر توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو أبرز من كتب في العقد الاجتماعي، فما هو مفهوم الدولة عند هؤلاء الفلاسفة؟
المطلب الأول: الدولة الاستبدادية (توماس هوبر):
يعتبر توماس هوبز (1588 – 1679) من أبرز الفلاسفة الذين آمنوا بالمذهب العقلي واستبعاد المسلمات، الشيء الذي دفعه إلى شن حملات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية، وكان لانغماسه في الأوساط السياسية تأثير كبير على فلسفته السياسية المناهضة للديمقراطية.
الفقرة الأولى: نشأة الدولة وحالة الطبيعة:
يفترض الفيلسوف الإنجليزي هوبز أن الانسان كان يتمتع بالحرية المطلقة في حالة الطبيعة، وما دام كل إنسان يسعى إلى تحقيق مصالحه وأهدافه ويتمتع هو الآخر بحريته فإن النتيجة المترتبة عن ذلك هو نشوب حرب الجميع ضد الجميع، فأهواء الناس وميولاتهم المتناقضة المتضاربة من شأنها أن تؤدي بالمجتمع الإنساني إلى الفوضى والاقتتال، فكان لابد من التنازل عن الحرية المطلقة لصالح إرادة عامة لكي يتعايش الانسان مع غيره حفاظا على سلامته وأمنه في إطار توافق اجتماعي أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي.
فالحياة في حالة الطبيعة حسب هوبز لا تطاق ووضع الناس في هذه الحالة يمتاز بوجود حرية مطلقة و حقوق مطلقة متساوية وبالتالي تنشأ عنه أنانية مفرطة مما يؤدي إلى صراع وحرب الجميع ضد الجميع، ويصبح الانسان في هذه الوضعية ذئب لأخيه الإنسان، وبالتالي كان لابد من الخروج من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية وأن يتم التنازل عبر عقد اجتماعي عن حرياتهم لصالح إرادة عليا سماها "اللفيتان" أي الدولة كي يحصلوا على السلم والأمن، فالإنسان في نظر هوبز غير اجتماعي بطبعه لذا لا بد ان تكون الدولة تحت سيادة حكومة متسلطة تكبح جموحه وأطماعه.
الفقرة الثانية: طبيعة الدولة:
إن طبيعة الدولة حسب مفهوم العقد الاجتماعي تقود إلى دولة استبدادية، ذلك أن هوبز يمنح للدولة السلطة المطلقة
وشبهها باللفيتان أي ذلك التنين أو التمساح الذي يقضي على الكل، فسلطه مطلقة يحق له بموجب العقد يد على أن يفعل م يريد ولا أحد يتدخل في سياسته أو تقييمها، وله حق اصدار القانون وإلغائه، كما له الحق في توزيع الأموال فهو المالك الفعلي والأفراد لا يملكون إلا حق التمتع والانتفاع بهذه الملكية الفردية وهي رخصة يمنحها الحاكم للأفراد فقط.
وبذلك يعطي هوبز للحاكم والدولة سلطة ممارسة الرقابة على الأفكار والإيديولوجيات وفرض إيديولوجية الدولة بشكل رسمي.
وبخصوص أشكال الدولة فقد رفض هوبز أي نوع من أشكال الدولة المختلطة، فالسيادة عنده لا تتجزأ وبالتالي فهو يفضل النظام الملكي لأن مصلحته الشخصية تختلط مع المصلحة العامة، فليس هناك ملك غني وممجد إذا كان رعاياه فقراء، والأسوأ عنده هو النظام الديمقراطي.
المطلب الثاني: مفهوم العقد الاجتماعي عند جون لوك وجون جاك روسو
يعتبر جون لوك وجون جاك روسو من الفلاسفة افترضوا فكرة العقد الاجتماعي لتفسير نشوء الدولة، فما هو مفهوم العقد الاجتماعي عند لوك وروسو؟
الفقرة الأولى: مفهوم العقد الاجتماعي عند لوك:
على خلاف هوبز الذي كان يرى أن الانسان في حالة الطبيعة كان يعيش في حرب مستمرة وأنه شرير بطبعه، فإن لوك يعتبر أن حالة ما قبل الاجتماع هي حالة خير و سلام وتعاون، وتتميز بالحرية والمساواة المطلقة، والمِلْكِيّة كانت حق طبيعي ومِلْكِية مشاعة، فكل فرد كان له الحق في أن يمتلك ما شاء وما يستطيع أن يحافظ به على حياته، والمِلْكِيّة الخاصة هي حق سابق على المجتمع الذي عليه حماية الملكية الخاصة، لكن السؤال المطروح لماذا يلزم الإنسان نفسه بعقد اجتماعي إذا كان في حالة الطبيعة يتمتع بحرية مطلقة، وخَيِّراً بطبعه؟
يرى لوك أن انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة هو من أجل حماية حقوق الافراد وحرياتهم وليس العكس كما ذهب إلى ذلك هوبز، فالدولة ماهي إلا خادمة وحامية لحقوق الأفراد، فعندما تطورت الأمور وتعقدت وأصبح الانسان يبحث عن الغنى وتملك عدة اشياء في حالة الطبيعة، فنشأت عن ذلك نزاعات كان من الضروري أن يتنازل عن جزء من حريته وأملاكه، ليحمي ما تبقى من حرياته وأملاكه، لذلك فكر في الانضمام إلى مجتمع يتحد فيه مع الآخرين من أجل حماية هذه الحريات، والحفاظ على حياته، فاتفقوا على تكوين مجتمع سياسي طرفاه هما الحاكم والمحكوم، وتنازلوا وفقا لهذا العقد على جزء فقط من حرياتهم، عكس هوبز (التنازل المطلق ) ، فهدف الحاكم هو مصلحة المحكومين وليس العكس.
وهذا يقودنا إلى نوع من الحكم الديموقراطي باعتبار أن الحاكم ما هو إلا نائب يحصل على ثقة الشعب الذي يخدم مصالحه، وفي حال عدم الوفاء بالعقد فإن من حق الشعب عزله ومقاومته، فالسلطة أنشأها الناس والسيادة تعود الشعب.
إن العقد الاجتماعي حسب روسو مكّن الانسان من الانتقال من حالة الطبيعة التي كانت تعرف حقوقا وحريات طبيعية فوضوية إلى حالة المدنية حيث الحقوق المدنية المنظمة والتي جعلت من الانسان متحضرا ومدنيا، وبذلك فإن العقد الاجتماعي جاء ليحمي حقوق الأفراد وحرياتهم وليس القضاء عليها، وذلك عبر تولُّد إرادة عامة من خلال اتحاد إرادة كل الأفراد، هذه الإرادة العامة المتمثلة في جهاز الدولة الذي يستمد سيادته من الشعب وليس من ذاته.
العقد الاجتماعي الذي افترضه روسو يختلف عن طبيعة العقد عند هوبز ولوك، فهو ليس عقدا اتحاديا بين الافراد والحاكم كما عند لوك، ولا عقدا بين الافراد والدولة وإنما هو عقد بين الفرد من جهة والمجموعة من جهة ثانية، كما أن الافراد لم يتخلوا عن جزء من حرياتهم كما هو الشأن عند لوك وإنما عن كل حقوقهم واستعاضوا عنها بحقوق مدنية وضعتها الجماعة، كما أن المِلكية مستمدة من حق طبيعي عند لوك بينما روسو يعتبر أن المِلكية هي سبب النزاعات وهي التي أدت إلى وجود مجتمع سياسي
إن روسو لا يعير أدنى اهتمام للحكومة وإنما للشعب صاحب السيادة، وهذه الأخيرة حسب روسو لا تقبل التصرف أي لا تنتقل بالوكالة كما أنها لا تتجزأ، أي لا مجال للفصل بين السلطات، فالشعب هو صاحب السلطة وهو الذي يؤسس الحكومة، وقد انتقد مونتسكيو بفكرته حول فصل السلطات.
لكي يتم تفسير نشوء الدولة لجأ العديد من الفلاسفة إلى افتراض فكرة العقد الاجتماعي الذي يعتبر عقدا صريحا أو ضمنيا بموجبه يتخلى الأفراد عن جزء من حرياتهم لصالح إرادة عليا تحمي ما تبقى من حقوق.
ويعتبر توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو أبرز من كتب في العقد الاجتماعي، فما هو مفهوم الدولة عند هؤلاء الفلاسفة؟
المطلب الأول: الدولة الاستبدادية (توماس هوبر):
يعتبر توماس هوبز (1588 – 1679) من أبرز الفلاسفة الذين آمنوا بالمذهب العقلي واستبعاد المسلمات، الشيء الذي دفعه إلى شن حملات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية، وكان لانغماسه في الأوساط السياسية تأثير كبير على فلسفته السياسية المناهضة للديمقراطية.
الفقرة الأولى: نشأة الدولة وحالة الطبيعة:
يفترض الفيلسوف الإنجليزي هوبز أن الانسان كان يتمتع بالحرية المطلقة في حالة الطبيعة، وما دام كل إنسان يسعى إلى تحقيق مصالحه وأهدافه ويتمتع هو الآخر بحريته فإن النتيجة المترتبة عن ذلك هو نشوب حرب الجميع ضد الجميع، فأهواء الناس وميولاتهم المتناقضة المتضاربة من شأنها أن تؤدي بالمجتمع الإنساني إلى الفوضى والاقتتال، فكان لابد من التنازل عن الحرية المطلقة لصالح إرادة عامة لكي يتعايش الانسان مع غيره حفاظا على سلامته وأمنه في إطار توافق اجتماعي أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي.
فالحياة في حالة الطبيعة حسب هوبز لا تطاق ووضع الناس في هذه الحالة يمتاز بوجود حرية مطلقة و حقوق مطلقة متساوية وبالتالي تنشأ عنه أنانية مفرطة مما يؤدي إلى صراع وحرب الجميع ضد الجميع، ويصبح الانسان في هذه الوضعية ذئب لأخيه الإنسان، وبالتالي كان لابد من الخروج من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية وأن يتم التنازل عبر عقد اجتماعي عن حرياتهم لصالح إرادة عليا سماها "اللفيتان" أي الدولة كي يحصلوا على السلم والأمن، فالإنسان في نظر هوبز غير اجتماعي بطبعه لذا لا بد ان تكون الدولة تحت سيادة حكومة متسلطة تكبح جموحه وأطماعه.
الفقرة الثانية: طبيعة الدولة:
إن طبيعة الدولة حسب مفهوم العقد الاجتماعي تقود إلى دولة استبدادية، ذلك أن هوبز يمنح للدولة السلطة المطلقة
وشبهها باللفيتان أي ذلك التنين أو التمساح الذي يقضي على الكل، فسلطه مطلقة يحق له بموجب العقد يد على أن يفعل م يريد ولا أحد يتدخل في سياسته أو تقييمها، وله حق اصدار القانون وإلغائه، كما له الحق في توزيع الأموال فهو المالك الفعلي والأفراد لا يملكون إلا حق التمتع والانتفاع بهذه الملكية الفردية وهي رخصة يمنحها الحاكم للأفراد فقط.
وبذلك يعطي هوبز للحاكم والدولة سلطة ممارسة الرقابة على الأفكار والإيديولوجيات وفرض إيديولوجية الدولة بشكل رسمي.
وبخصوص أشكال الدولة فقد رفض هوبز أي نوع من أشكال الدولة المختلطة، فالسيادة عنده لا تتجزأ وبالتالي فهو يفضل النظام الملكي لأن مصلحته الشخصية تختلط مع المصلحة العامة، فليس هناك ملك غني وممجد إذا كان رعاياه فقراء، والأسوأ عنده هو النظام الديمقراطي.
المطلب الثاني: مفهوم العقد الاجتماعي عند جون لوك وجون جاك روسو
يعتبر جون لوك وجون جاك روسو من الفلاسفة افترضوا فكرة العقد الاجتماعي لتفسير نشوء الدولة، فما هو مفهوم العقد الاجتماعي عند لوك وروسو؟
الفقرة الأولى: مفهوم العقد الاجتماعي عند لوك:
على خلاف هوبز الذي كان يرى أن الانسان في حالة الطبيعة كان يعيش في حرب مستمرة وأنه شرير بطبعه، فإن لوك يعتبر أن حالة ما قبل الاجتماع هي حالة خير و سلام وتعاون، وتتميز بالحرية والمساواة المطلقة، والمِلْكِيّة كانت حق طبيعي ومِلْكِية مشاعة، فكل فرد كان له الحق في أن يمتلك ما شاء وما يستطيع أن يحافظ به على حياته، والمِلْكِيّة الخاصة هي حق سابق على المجتمع الذي عليه حماية الملكية الخاصة، لكن السؤال المطروح لماذا يلزم الإنسان نفسه بعقد اجتماعي إذا كان في حالة الطبيعة يتمتع بحرية مطلقة، وخَيِّراً بطبعه؟
يرى لوك أن انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة المدينة هو من أجل حماية حقوق الافراد وحرياتهم وليس العكس كما ذهب إلى ذلك هوبز، فالدولة ماهي إلا خادمة وحامية لحقوق الأفراد، فعندما تطورت الأمور وتعقدت وأصبح الانسان يبحث عن الغنى وتملك عدة اشياء في حالة الطبيعة، فنشأت عن ذلك نزاعات كان من الضروري أن يتنازل عن جزء من حريته وأملاكه، ليحمي ما تبقى من حرياته وأملاكه، لذلك فكر في الانضمام إلى مجتمع يتحد فيه مع الآخرين من أجل حماية هذه الحريات، والحفاظ على حياته، فاتفقوا على تكوين مجتمع سياسي طرفاه هما الحاكم والمحكوم، وتنازلوا وفقا لهذا العقد على جزء فقط من حرياتهم، عكس هوبز (التنازل المطلق ) ، فهدف الحاكم هو مصلحة المحكومين وليس العكس.
وهذا يقودنا إلى نوع من الحكم الديموقراطي باعتبار أن الحاكم ما هو إلا نائب يحصل على ثقة الشعب الذي يخدم مصالحه، وفي حال عدم الوفاء بالعقد فإن من حق الشعب عزله ومقاومته، فالسلطة أنشأها الناس والسيادة تعود الشعب.
- أنواع السلط عند لوك:
- السلطة التشريعية: هي التي تختص بوضع القوانين لحماية الأفراد والحفاظ على حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم، وهي أعلى سلطات الدولة عند لوك ومن الضروري فصلها عن السلطة التنفيذية وإقرار سيادتها السامية، والقانون فوق الجميع، والحاكم لا يجب عليه التعالي على القانون وإلا تحول إلى مستبد.
- السلطة التنفيذية: تقوم بالسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين وهي ترتكز في ايدي أشخاص غير المشرع، فمبدأ الفصل بين السلطات هو الضامن الوحيد للحرية عكس تركزها في ايدي واحدة حيث يؤدي إلى الاستبداد.
- السلطة الفدرالية: هي سلطة ممارسة الشؤون الخارجية بما في ذلك إبرام المعاهدات والاتفاقيات واعلان الحرب وعقد السلام.
- مفهوم العقد الاجتماعي:
إن العقد الاجتماعي حسب روسو مكّن الانسان من الانتقال من حالة الطبيعة التي كانت تعرف حقوقا وحريات طبيعية فوضوية إلى حالة المدنية حيث الحقوق المدنية المنظمة والتي جعلت من الانسان متحضرا ومدنيا، وبذلك فإن العقد الاجتماعي جاء ليحمي حقوق الأفراد وحرياتهم وليس القضاء عليها، وذلك عبر تولُّد إرادة عامة من خلال اتحاد إرادة كل الأفراد، هذه الإرادة العامة المتمثلة في جهاز الدولة الذي يستمد سيادته من الشعب وليس من ذاته.
العقد الاجتماعي الذي افترضه روسو يختلف عن طبيعة العقد عند هوبز ولوك، فهو ليس عقدا اتحاديا بين الافراد والحاكم كما عند لوك، ولا عقدا بين الافراد والدولة وإنما هو عقد بين الفرد من جهة والمجموعة من جهة ثانية، كما أن الافراد لم يتخلوا عن جزء من حرياتهم كما هو الشأن عند لوك وإنما عن كل حقوقهم واستعاضوا عنها بحقوق مدنية وضعتها الجماعة، كما أن المِلكية مستمدة من حق طبيعي عند لوك بينما روسو يعتبر أن المِلكية هي سبب النزاعات وهي التي أدت إلى وجود مجتمع سياسي
- الفرد والمجتمع:
إن روسو لا يعير أدنى اهتمام للحكومة وإنما للشعب صاحب السيادة، وهذه الأخيرة حسب روسو لا تقبل التصرف أي لا تنتقل بالوكالة كما أنها لا تتجزأ، أي لا مجال للفصل بين السلطات، فالشعب هو صاحب السلطة وهو الذي يؤسس الحكومة، وقد انتقد مونتسكيو بفكرته حول فصل السلطات.
- أشكال الحكومات:
- المَلَكِيّة: يعتبرها روسو نظاما قويا ولكنها لا تهدف إلى سعادة الشعب وإنما سعادة الحكام، غير أنه يشترط على الملك التقيد ببنود العقد الاجتماعي.
- الأرستقراطية: وهي إما أن تكون وراثية وهي الأسوأ، أو انتخابية وهو الأفضل بشرط أن يحكم الحكماء لصالح منفعة الشعب وليس منفعتهم هم.
- الديمقراطية: يعتبرها روسو لا تتناسب مع الطبيعة البشرية، إذ لا يوجد في التاريخ ديمقراطية تامة.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 مختصر محاضرات في الفكر السياسي
مختصر محاضرات في الفكر السياسي