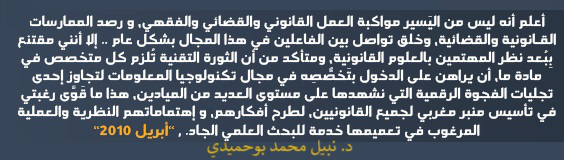تقديم:
يعد موضوع إثبات النسب من القضايا القانونية والاجتماعية الحساسة، التي حظيت باهتمام المشرع الأسري نظرا لما لها من أثر مباشر على هوية الفرد وحقوقه المدنية ووضعه الاجتماعي، وتزداد حساسية هذه المسألة وتعقيدها عندما يتعلق الأمر بالطفل الطبيعي، أي الطفل المولود نتيجة علاقة خارج إطار الزواج، إذ تتقاطع في هذه الحالة الضوابط الشرعية مع الاعتبارات الحقوقية الحديثة، بما يشمل حماية المصلحة الفضلى للطفل وضمان حقوقه الأساسية، ويشكل هذا التداخل بين البعد الديني والبعد الحقوقي تحديا أمام المشرع المغربي في محاولة وضع إطار قانوني متوازن يحمي الطفل ويضمن له الاعتراف القانوني والمكانة الاجتماعية، دون الإخلال بالقيم المجتمعية والأحكام الشرعية المعمول بها.
حتى وقت قريب، لم يكن الطفل الناتج عن علاقة خارج إطار الزواج، المعروف بالطفل الطبيعي، يشكل محور اهتمام المجتمعات القانونية أو العامة، ولم تكن حقوقه وواجبات المجتمع تجاهه موضع اعتبار فعلي، ومع تعقد الحياة الاجتماعية وتغير أنماطها، وازدياد أعداد هؤلاء الأطفال بشكل ملحوظ، ظهرت الحاجة الملحة لحماية هذه الفئة الهشة.
لقد تعالت أصوات الجمعيات الحقوقية المغربية والدولية المختصة بحقوق الطفل، مطالبة بضمان حماية قانونية واجتماعية لهؤلاء الأطفال، باعتبارهم الطرف الأضعف في المجتمع، وتجسد هذا الاهتمام في التطور القانوني المغربي الذي كفل للطفل الطبيعي مجموعة من الحقوق الأساسية، خاصة في مجالات النفقة، الميراث، والحماية من الإهمال أو الاستغلال، كما وردت نصوصه في مدونة الأسرة المغربية، والتي تسعى لتحقيق مبدأ المساواة بين الأطفال جميعهم دون تمييز على أساس الحالة الاجتماعية للأبوين.
يمكن تعريف الطفل الطبيعي أو الطفل الناتج خارج مؤسسة الزواج، هو ذلك الطفل الذي نتج عن علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج باعتباره الإطار الشرعي الوحيد للعلاقات الجنسية، ومهما اختلفت التسمية فإن ذلك لن يغير شيئا من وضعيته، فكل طفل ثمرة علاقة جنسية خارج إطارها الشرعي، يعد طفلا غير شرعيا لا يعترف به الشرع ولا القانون.
وإذا كانت البنوة الشرعية هي التي يتبع فيها الولد أباه في النسب، فإن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب تتحقق بتنسل الولد منه خارج إطار الزواج ودون أن تكون لديه شبهة تلحق نسب الولد به([1]).
والمغرب باعتباره دولة إسلامية، فإن تشريعه الأسري ينطلق أساسا من الشريعة الغراء، ونظرا للتطور الدائم والمستمر الذي عرفه المجتمع المغربي في كل ميادين الحياة والذي واكبه التغيير والتطور والنظام الأسري، كان من الضروري أن يصحب ذلك تغييرا على المستوى التشريعي أيضا وبالرغم من أن الأنظمة القانونية في الدول العربية والإسلامية ومنها بلادنا لا تزال تقاوم ضد التطبيع مع الظواهر الأسرية الشاذة والمختلفة عن ديننا وهويتنا كالعلاقات الحرة وعلاقات السفاح، والشذوذ وغيرها[2].
يعد إثبات نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج موضوعا حساسا يمس أحد أركان النظام الأسري والاجتماعي، لما له من ارتباط مباشر بهوية الفرد وحقوقه المدنية والاجتماعية، وتكتسب هذه المسألة أهمية نظرية باعتبارها تتقاطع مع القواعد الشرعية والأحكام القانونية والتشريعات المقارنة، مما يسمح بفهم التطور التاريخي والفكري لمؤسسة النسب في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، كما يبرزالبحث التشتت القانوني بين مدونة الأسرة والقوانين الأخرى، مثل القانون الجنائي، قانون كفالة الأطفال المهملين، قانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية، ما يجعله مرجعا لفهم الإطار القانوني المغربي وإبراز الثغرات القائمة.
أما الأهمية العملية فتتمثل في مساهمة البحث في حماية الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، فئة هشة تحتاج إلى حماية قانونية واجتماعية، ولحاجة المشرع والقضاء إلى تطوير التشريعات بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل، مستفيدين من التجارب المقارنة.
وبناء على ذلك، تطرح إشكالية البحث التالية: إلى أي حد تمكن التشريعات المغربية، خاصة مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، من التوفيق بين الضوابط الشرعية ومبادئ العدالة الحديثة لضمان المصلحة الفضلى للطفل المولود خارج مؤسسة الزواج في ظل التطور الاجتماعي والقانوني المعاصر؟.
ومن أبرز الحالات التي تجسد هذا المفهوم، تلك العلاقة الجنسية القائمة بين رجل وامرأة وهما على علم بعدم وجود رابطة زواج شرعية بينهما، ويترتب عن هذه العلاقات ولادة أطفال تنقسم حالاتهم إلى:
-المطلب الأول: التحديات القانونية لإثبات نسب الطفل المولود من الزنا
-المطلب الثاني: التدابير القانونية المتعلقة بنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب
المطلب الأول: التحديات القانونية لإثبات نسب الطفل المولود من الزنا
تعتبر جريمة الزنا من أبشع وأفظع الجرائم التي تقع مساسا بكيان الأسرة التي هي المرتكز الأساسي لبناء المجتمع وهي من الجرائم الاجتماعية التي حرمتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والأعراف الاجتماعية لمنفاتها لأبسط المبادئ الأخلاقية لأنها تتضمن انتهاكا للأعراض وتؤدي إلى هدم الأسرة وانحلال المجتمع وفساده وبالتالي تزايد عدد الأطفال المولودين من عملية الزنا، وهو ما يجعلنا نتساءل عن موقف الفقه الإسلامي (الفقرة الأولى) والتشريع المغربي (الفقرة الثانية) والتشريع المقارن من نسب ابن الزنا (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الموقف الفقهي الإسلامي من نسب الطفل المولود من الزنا
تباينت آراء الفقهاء المسلمين حول مسألة نسب الطفل الناتج عن الزنا، فانبثقت عنها ثلاثة اتجاهات رئيسية:
أولاً: مذهب جمهور الفقهاء:
يذهب جمهور الفقهاء من الحنفية([3])والمالكية([4])والشافعية([5]) والحنابلة([6]) والظاهرية([7]) إلى أن الزاني لا يمكن أن يلحق به الولد حتى ولواستلحقه، وإنما يلحق بالمرأة التي أتت به، وهو يرثها وترثه حتى إن الإمام السرخسي([8])قد قال:"إذا أقر أنه زنى بامرأة حرة وأن هذا الولد إبنه من الزنى وصدقته المرأة، فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ولا فراش للزاني فإن شهدت القابلة ثبت بذلك نسب الولد من المرأة دون الرجل، لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة، لأن انفصال الولد عنها معاين، فلهذا أثبت النسب منها".
وقال الكساني([9])"إذا ادعى رجل صبيا في يد امرأة فقال: هو ابني من الزنا، وقالت المرأة: هو من النكاح لا يثبت نسبه من الرجل ولا من المرأة، لأن الرجل أقر أنه ابنه من الزنا، والزنا لا يوجب النسب والمرأة تدعي النكاح والنكاح لا بد من حجة".
واستدل الجمهور على قطع نسب ولد الزنا من أبيه الزاني بالمنقول والمعقول:
*فمن المنقول: ما ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر"([10]) والحديث أصل في قصر النسب على الفراش، فلا ولد لمن لا فراش له، والزاني لا فراش له، وروي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث[11].
*أما من المعقول فهم يستدلون بما يلي، وقالوا:
- إن ماء الزنا هدر، ولا حرمة له فلا يترتب عليه أثر([12]).
- لأن قطع النسب شرعا لمعنى الزجر عن الزنا، فإنه إذا علم أن ما يضيع بالزنا يتحرر عن فعل الزنا([13]).
- إن إثبات النسب من الزاني موجب لظهور الفاحشة فهو حرام لقوله تعالى:"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون"([14]).
- الزاني تعدى حدود الله في طريق المعاشرة الحلال، فلو ألحق الولد به لكان ذريعة لكل متفحش لم يصل إلى المرأة برضاها ورضا أهلها أن يصيبها ويكون الولد له، فكان لابد أن يعامل بنقيض قصده([15]).
- إن الانتساب لا يثبت، لأنه المقصود الشرف به ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني([16]).
بالرغم من هذا الإجماع على عدم لحوق ابن الزنا بنسب أبيه فإنهم اختلفوا بعد ذلك حول بعض الآثار عن هذه العلاقة فانقسموا إلى رأيين:
- ففريق منهم (كالظاهرية وابن حزم[17]) شدد على انقطاع جميع الروابط بين الزاني وولده من الزنا، حتى أجاز الزواج بين الزاني وبنته من الزنا باعتبارهما أجنبيين.
- بينما ذهب فريق آخر (كالقرطبي وبعض المالكية[18]) إلى أن علاقة الزنا تُنتج بعض الآثار الجزئية كتحريم المصاهرة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في صون الأنساب ومنع الفتنة
يرى أصحاب هذا الرأي أن ولد الزنا يجب أن ينسب إلى الزاني بشرط إذا تزوج بالمزني بها وهي حامل، أما إذا لم يتزوجها حتى وضعت، أو كان الحمل ليس منه فلا ينسب إلى أبيه، وإنما ينسب لأمه التي ولدته، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد وعليه الفتوى في المذهب وبه قال ابن عباس([19]).
وحجتهم من القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين"([20]).
ويجب لتحقق نكاح الزاني من الزانية أن يستبرئ رحمها من ماء غيره مصداقا لقوله علية الصلاة والسلام:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء زرعه غيره"([21]).
وحجتهم من المأثور ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها؟ فقال: أول أمرها سفاح وأخره نكاح ، وفي رواية أخرى: "إن تابا فإنه ينكحها"([22]).
ثالثاً: مذهب يقر بلحوق النسب بالزاني مطلقاً عند الاستلحاق
ذهب عدد من التابعين والفقهاء، مثل إبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، إلى أن الولد الناتج عن الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم ينازعه فيه صاحب فراش صحيح ولو لم تكن هناك علاقة زواج.
وقد روى إسحاق بن راهويه عن الحسن البصري [23]أنه قال:" يجلد ويلزمه الولد"، كما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
فقد استدل هؤلاء من السنة النبوية بحديث أنس([24]) في المتلاعنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به"، فجاءت به على العنت المكروه فقال: " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن".
واعتبروا أن الحديث يدل على مراعاة الشبه في النسب، أي علاقة الولد بصاحب الماء.
أما من المعقول، فاحتجوا بأن:
- إلحاق الولد بصاحب الماء أولى من تركه بلا نسب.
- القياس على وطء الشبهة، حيث يُثبت النسب فيه رغم عدم قيام العقد الصحيح.
- أن نفي النسب عن الزاني يؤدي إلى ضياع الأطفال وتركهم بلا هوية، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشريعة في حماية النسب والطفولة.
الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي تجاه نسب الطفل الناتج عن الزنا
يعتبر الطفل مولودا من الزنا متى ثبت نشوءه خارج مؤسسة الزواج ودون أن تكون لديه شبهة يلحق نسبه بالأب، فمتى ثبت نشوءه من علاقة غير شرعية مع توفر الأب على شبهة يكون شرعيا ويثبت نسبه([25])، وعليه فإن الولد يعتبر ابن زنا وغير شرعي إذا نشأ من:
- زواج مجمع على فساده مع ثبوت سوء نية الأب.
- الزنا الصريح: أي العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة اللذان يعلمان انعدام الرابطة الزوجية بينهما.
- أخذ الحيوان المنوي من الرجل بأية وسيلة من الوسائل وتلقيح بويضة امرأة أجنبية عنه، وما يجب تأكيده هو أن البنوة غير الشرعية موجودة واقعا بالرغم من تجريم الزنا، وأن هؤلاء الأطفال لا يد لهم في ما ارتكبه أصولهم من جرائم، وأن وصفهم بالأبناء غير الشرعيين لا ينزع عنهم براءتهم ولا يبرر اعتبارهم مذنبين ولا يصادر حقهم في حماية مصالحهم وضمان حقوقهم خاصة مع تواجد اتجاه فقهي يقضي بثبوت نسبهم، غير أن المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة([26]) يأخذ بالاتجاه الفقهي القائل بانتفاء النسب وهو ما يعني حرمان الطفل الناتج عن زنا من الحق في النسب بصفة صريحة وما يترتب عنه من حقوق أخرى، وهذا ما نص عليه في المادة 148 من مدونة الأسرة حيث جاء فيها: "لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، فعلى عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للأم حيث تستوي آثار البنوة شرعية كانت أو غير شرعية([27])، فبمقتضى هذه المادة فإن كل ولادة خارج نطاق الزواج غير شرعية ينسب فيها المولود إلى أمه فقط ويبقى نسب أبيه مجهولا في نظر المدونة حتى ولو كان الأب معلوما لدى الأم وربما عند عامة الناس.
وفي قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى([29]) بتاريخ 13 أبريل 2005 جاء فيه: "... لما كان مقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة تنص على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد، وكان البين من أوراق الملف أن الطالبة وضعت حملها بتاريخ 16 دجنبر 2000 ولأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2000، فإن المحكمة لما اعتبرت أن الولد غير لاحق بنسب المطلوب في النقض الذي ينفيه عنه تكون قد طبقت الفصل المحتج به تطبيقا صحيحا، ولم تكن في حاجة لإجراء خبرة طبية في هذا الشأن".
كما قضى المجلس الأعلى([30]) في قرار آخر بأن "البنت لا تلحق بنسب المدعى عليه ولو أقر ببنوتها ولو كانت من مائه لأنها بنت زنا، وابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول الشيخ خليل: إنما يستلحق الابن مجهول النسب، قال العلامة الزرقاني: لا مقطوعة كولد الزنا لأن المشرع قطع نسبه...".
من خلال استعراض موقف التشريع والقضاء المغربيين بشأن نسب ابن الزنا، يمكن التوصل إلى أن هذا الموقف يتوافق مع المذهب الأول الذي تبناه جمهور الفقهاء المسلمين، القائل بعدم إمكان نسب ابن الزنا إلى الزاني، وبالتالي فإن الخبرة الجينية لا تؤثر في مسألة لحوق النسب من عدمه، سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية.
الفقرة الثالثة: الموقف التشريعي المقارن لنسب الطفل المولود من الزنا
إذا كانت مدونة الأسرة قد أفردت للبنوة غير الشرعية نصوصا خاصة واعتبرتها شرعية بالنسبة للأم، فإن بعض التشريعات العربية المقارنة لم تتعرض للبنوة غير الشرعية إلا بصورة محتشمة جدا([31]) حيث نجدها تنظم أحكام النسب من حيث إثباته ونفيه دون الإشارة إلى البنوة الطبيعية، غير أن ما يستفاد من هذا التنظيم القانوني لأحكام النسب فإن القوانين العربية([32]) المقارنة قد أخذت أيضا برأي جمهور الفقهاء القائل بانتفاء نسب الطفل الناتج عن علاقة زنا.
وقد سار التشريع التونسي في نفس الاتجاه الذي توخاه الاتجاه الفقهي القائل بعدم إلحاق ابن الزنا لنسب أبيه الزاني سواء أكانت أمه متزوجة أم غير ذلك، عملا بما جاء به الحديث النبوي الشهير:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وفي المقابل نجد القضاء التونسي قد خرج عن هذه القاعدة في عدة قرارات اعتبرها بعض أساتذة القانون والشريعة في تونس من نوع القرارات الشاذة وأبرزها القرار الصادر عن محكمة التعقيب التونسية([33]ا التي بعدما أن سلمت بوجود علاقة جنسية آثمة بين الطرفين تمت محاكمة مقترفها القائم بدعوى نفي النسب بالسجن لثبوت تهمة المواقعة ضده، اعتمدت نفس هذه العلاقة لإثبات نسب المولودة مستدلة على ذلك بشهادة شهود شهدوا لدى القضاء الزجري في نفس تلك التهمة بالخلطة والخلوة بين الطرفين، حيث قضت بثبوت نسب تلك المولودة بالرغم من أنها كانت على يقين أنها ثمرة سفاح لوجود حكم جزائي بات قد جرم ذلك الفعل الآثم.
وفي نفس السياق نجد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة التونسية([34])حيث جاء في حيثياته أنه:"إذا اتصل رجل بامرأة وثبت إدانتها جزائيا من أجل ارتكاب جريمة الزنا والمشاركة فيها، وقام الرجل ضد العام وتلك المرأة يذكر أن ذلك الاتصال الواقع بينهما أنتج ابنا وهو يطلب إلحاق ذلك الطفل بنسبه، وقررت المحكمة على الطرفين فاعترف المدعي بأن الابن من صلبه وأكدت الأم ذلك وطالبت بدورها بإلحاق الابن بنسب والده، فإن الإقرار المعتمد يعتبر إحدى وسائل الإثبات الأساسية المعتمدة في مادة النسب إذا جاء صريحا وواضحا بما أنه ثمة أمام القاضي المقرر، ويعتبر إقرارا حكميا حسب الفصل 428 من م.إ.ع ولذلك فإن هذا الإقرار الصريح والناتج عن إرادة واعية يكتفي لثبوت نسب الابن المذكور، ويتجه والحالة تلك الحكم لصالح الدعوى".
وبهذا يتضح أنه بالرغم من كون التشريع التونسي يسير في الاتجاه الفقهي القائل بانتفاء النسب عن ابن الزنا، إلا أن القضاء أحيانا يخرج عن هذا الاتجاه محكوما في ذلك بحماية مصالح الطفل الفضلى وذلك من خلال حفظ نسبه وعدم ضياعه.
وفي مقابل ذلك نجد القوانين الأوربية اللائكية تسوي بين الطفل الشرعي والطبيعي ولا تميز بينهما من حيث الحقوق والواجبات([35])، حيث سوي التقنين المدني الاسباني الصادر بتاريخ 13 ماي 1981 بين الأبناء بغض النظر عن نسبهم، هل هو ناتج عن زواج أم لا([36])؟،. كما أدخل المقنن الفرنسي عدة تعديلات على قانون الأسرة بهدف التوفيق بين التقنين المدني ومبادئ التصريح العالمي لحقوق الطفل لسنة 1989 الذي يقضي بالمساواة بين الأطفال في الحقوق وإلغاء كل تفرقة بينهم بغض النظر عن أصل نسبهم([37]) وبذلك أصبح النسب الناتج عن الزنا يحتل مكانة هامة في قانون الأسرة الفرنسي المطبوع بمبادئ الحرية والمساواة حيت لم يعد ينظر لابن الزنا نظرة احتقار ومهانة بل أصبح مرغوبا فيه ما دام يوجد على قدم المساواة مع الطفل الشرعي في الحقوق والالتزامات([38]) وذلك بموجب قانون 3 يناير 1972 ([39])بما في ذلك الحق في الإرث.
كما أجاز المشرع الفرنسي، بمقتضى قانون 3 دجنبر 2001، للأطفال المولودين خارج إطار الزواج (الأطفال الطبيعيين) إمكانية رفع دعوى لإثبات نسبهم إلى آبائهم، وذلك عن طريق إضفاء الشرعية على علاقتهم في الحالات التي يتعذر فيها إبرام عقد الزواج بسبب وجود مانع قانوني من موانع الزواج، طبقاً
لمقتضيات المادة 333 من القانون المدني الفرنسي.
وبذلك أقر المشرع مبدأ المساواة الكاملة بين الطفل الطبيعي والطفل الشرعي في الحقوق، ولا سيما في ما يتعلق بالنسب وآثاره القانونية، وقد كرست محكمة النقض الفرنسية([40]) هدا التوجه من خلال أحد قراراتها، الذي جاء فيه: "إن الأمر بالخضوع لفحص طبي للدم كشف عن الأبوة الطبيعية للطالب المدعي للطفل لذلك تعين تأكيد الحكم الاستئنافي الذي اعتبر هذا الطالب الأب الطبيعي للطفل".
وفي نفس الإطار ذهب قرار عن محكمة النقض الفرنسية([41]) إذ جاء فيه: "أنه ليس من المعقول حرمان الطفل الطبيعي من حقوقه بدعوى حماية الأسرة التقليدية، فهذا يتعارض مع الفصل الثامن من اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر مصلحة الطفل فوق كل اعتبار".
بل أكثر من ذلك فالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تعتبر أن التمييز بين الطفل الطبيعي والشرعي مسا خطيرا بالمصلحة الفضلى للطفل.
هكذا فإن قوانين الأسرة في البلاد الأوربية المطبوعة بمبادئ الحرية والمساواة أفرزت تعايشا بين نماذج مختلفة من المؤسسات الأسرية، وعليه فإن النسب غير الشرعي أضحى يحتل مكانة مهمة داخل هاته المجتمعات، حيث ثمة الاعتراف لابن الزنا بنفس حقوق الطفل الشرعي سواء تعلق الأمر بحقه في الاسم والجنسية أو النفقة أو الإرث([42]).
و إجمالا يمكن القول أنه إذا كان كل من المشرع والقضاء المغربي قد تبنيا توجها مغايرا لما استقر عليه كل من التشريع والقضاء الفرنسيين على وجه الخصوص، والأوروبيين على وجه العموم، في مسألة إلحاق نسب الطفل المولود من علاقة غير شرعية، وذلك استنادا إلى اعتبارات دينية وأخلاقية واجتماعية راسخة، فإن هذا الموقف يهدف أساسا إلى صون مؤسسة الأسرة الزواجية الشرعية باعتبارها إحدى الركائز الجوهرية للنظام العام والاستقرار الاجتماعي.
غير أنه، وبالنظر إلى المصلحة الفضلى للطفل، التي تعد مبدأً ساميا في المنظومة الحقوقية الوطنية والدولية، يطرح التساؤل حول إمكانية تمتيع هذه الفئة من الأطفال على الأقل بحقوقهم المادية الأساسية، دون أن يفهم من ذلك إقرار للعلاقة غير الشرعية.
فإذا كان حرمان الطفل من نسبه، بالرغم من كونه غير مسؤول عن وضعه غير المشروع، يؤدي عمليا إلى إعفاء الأب من أي التزام، فإن مقتضيات العدالة والإنصاف تقتضي تحميله مسؤولية مدنية قائمة على أساس أحكام الفصول 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك عن طريق إلزامه بأداء تعويض يضمن الحد الأدنى من الحماية المادية والمعيشية للطفل.
المطلب الثاني: التدابير القانونية المتعلقة بنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب
يعد الاغتصاب من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تواجه المجتمعات، وقد سعى القانون إلى مكافحتها وردعها بكل الوسائل القانونية المتاحة، ترى ما موقف المشرع المغربي من نسب الطفل الناشئ عن الاغتصاب؟ (الفقرة الأولى) وكذا ما موقف القضاء المغربي من هذه الظاهرة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: موقف التشريع المغربي تجاه نسب الأطفال الناتجين عن الاغتصاب
صنف المشرع الجنائي المغربي جريمة الاغتصاب ضمن فرع انتهاك الآداب (الفصول 483 إلى 496 من ق.ج)، كما اعتبرها من أشد جرائم الاعتداء على العرض، وخصص لها الفصول 486 و 487 و 488 و 114 من القانون الجنائي، وعرف جريمة الاغتصاب في الفصل 486 من نفس القانون بأنه:"مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات"، وقد استثنى المشرع الإكراه على المواقعة الذي قد يقع على الرجل، مما يعني أن ذلك الفعل لا يعد جريمة بمفهوم النص السابق، كما أن جريمة الاغتصاب لا تقوم إلا إذا توفر ركنيها المادي والمعنوي([43]).
وعليه، إذا نتج عن هذا الاغتصاب حمل المرأة المغتصبة، فهل فرض المشرع نوعا من الحماية للطفل الذي يأتي نتيجة اغتصاب أمه بما فيها حماية نسبه ؟.
بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أنه لم يتضمن أي مقتضى يوحي على أن المشرع قد تفطن لحالة الحمل الناتج عن الاغتصاب، وإنما أولى الاهتمام للافتضاض وشدد العقوبة بمقتضى الفصل 488 من القانون الجنائي([44])، حيث نلاحظ أن المشرع عاقب المغتصب جنائيا وبقسوة، والعقوبة هنا هي حق خالص للمجتمع، ولكن أين حق المرأة المغتصبة والمتمثل في حفظ عرضها؟ وأين حق الولد المتمثل في حفظ نسبه؟.
وبالعودة إلى مقتضيات مدونة الأسرة، ولاسيما منها أحكام البنوة والنسب، نلاحظ أنها لم تولي أي اهتمام لنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، إنما اكتفت فقط في المادة 147 منها بوصف هذا الطفل شرعيا للمجني عليها وحدها دون من اغتصبها، فبالرغم من أنه الأب البيولوجي لذلك الحمل أو الولد، وخاصة أن المشرع لم يرتب أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب في حالة الاغتصاب الناتج عنه حمل([45])، وعكس ذلك نجد الأم المغتصبة حملها المشرع جميع الآثار المترتبة عن هذا الاغتصاب من رعاية ونفقة وحضانة وإرث... وغيرها، وهذا ما أكده في المادة 146 من مدونة الأسرة والتي ورد فيها: "تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية."
وهكذا، إذا كانت مدونة الأسرة قد أوجبت مسؤولية الأم في حالات الاغتصاب على أساس واقعة الولادة، أي على أساس الرابطة البيولوجية بين الطفل وأمه، يطرح التساؤل القانوني: هل من الممكن، أم من اليقين، تأكيد أو نفي العلاقة البيولوجية بين الطفل وأبيه في هذه الحالة؟
ويستند الجواب على أن القانون المغربي، إلى جانب تطور وسائل الإثبات العلمية الحديثة مثل تحاليل ADN، يتيح للقضاء إمكانية تحديد النسب البيولوجي للطفل للأب بدقة كبيرة، سواء لإثبات الحقوق أو لإبرام الواجبات القانونية، مع مراعاة حماية الطفل ومصلحته الفضلى، وعدم تحميله تبعات الجرائم المرتكبة من قبل الآخرين.
أمام التقدم البحث العلمي في مجال الهندسة الوراثية وخاصة بعد اكتشاف جزيئة الحمض النووي ADN أمكن القول باعتماد هذه التقنية الحديثة في إثبات أو نفي العلاقة البيولوجية بين الطفل وأبويه، خاصة وأن الإنجاب بالمفهوم العلمي هو ثمرة تزاوج بين ذكر وأنثى بالغين([46])، فلقد أتاحت دراسة توافق الصفات المميزة الموجودة في الحمض النووي للأم، وتلك الموجودة في الحمض النووي للطفل إلى تخريج تركيبة لا توجد إلا عند شخص واحد فقط، هذا الشخص هو الأب البيولوجي للطفل([47]).
لكن إذا افترضنا استحالة نسب الطفل غير الشرعي الناتج عن الاغتصاب للأب المغتصب من الناحية الشرعية والقانونية، لعدم تحقق شرط الفراش، يطرح التساؤل حول إمكانية التخفيف من حدة هذا الحكم في إطار قضاء متفتح يحترم الضوابط الشرعية الثابتة من جهة، ويأخذ بعين الاعتبار أدبيات الواقع الحياتي من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يمكن للقضاء أن يلزم المغتصب، إذا أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل، بالنفقة لصالح هذا الأخير، باعتباره ضحية لا دخل لها في طبيعة العلاقة أو الاتصال الجنسي الذي أدى إلى ولادته، ويأتي هذا الالتزام استنادا إلى حقوق الطفل المنصوص عليها في المادة 54 من مدونة الأسرة([48]) والفقرة الثالثة من دستور المملكة[49] فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادق عليها المغرب، بما يضمن حماية مصالح الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له دون انتقاص من الأحكام الشرعية المتعلقة بالنسب.
وبالرغم من أن الاغتصاب لا يدخل ضمن أسباب وجوب النفقة المحددة في المادة 187 من مدونة الأسرة وهي الزوجية والقرابة والالتزام، فإنه يمكن معالجة الموضوع في إطار المسؤولية المدنية، وذلك بإجراء تحليل طبي على المولود إذا أثبت أنه من ماء المتهم فإنه يمكن إلزامه بالإنفاق عليه في حالة اغتصاب أمه إلى أن يبلغ قادرا على الكسب كما في حالة التكفل، وكذلك في حالة ازدياد مولود نتيجة جريمة فساد وثبت أنه من ماء الذي ساهم مع أمه في الفساد فإنه يتعين إلزامهما معا بالإنفاق عليه إلى أن يبلغ قادرا على الكسب وذلك استنادا لقواعد المسؤولية المدنية بناء على مقتضيات الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات والعقود،([50]) إلا أن ذلك لا يمنعنا من الاعتراف بأن التشريع الأسري لا زال يعرف تحديات تتعلق أساسا بنسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، فإذا كان الفقه لم يجمع على رأي قاطع بخصوص قطع نسبه أو لحوقه بمن كان سببا في وجوده، فإن مصلحته الفضلى تستدعي التعمق في البحث والتصدي لهذا الإشكال.
الفقرة الثانية: التأويلات القضائية لنسب الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب
إذا كان موقف المشرع المغربي واضحا فيما يخص عدم إلحاق الطفل الناتج عن الاغتصاب بالأب الطبيعي، وعدم ترتيب أي أثر من آثار النسب اتجاه هذا الأب، فإنه في مقابل ذلك جعله وسيلة من وسائل إثبات البنوة الشرعية بالنسبة للأم من خلال المادة 147 من مدونة الأسرة، وهو ما أكد عليه حكم([51]) صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث جاء فيه: "لئن كانت المادة 147 من مدونة الأسرة اعتبرت بنوة الأمومة شرعية في حالة الاغتصاب، إلا أنها في المادة 144 من مدونة الأسرة جعلت البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب، ورتبت عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
فأسباب لحوق النسب محددة على سبيل الحصر في المادة 152 مدونة الأسرة وهي الفراش والإقرار والشبهة، وليس من بينها الاغتصاب الذي لا يعتبر سببا للحوق النسب للأب ولو أثبتت الخبرة البيولوجية نسبه إليه".
وعليه فإن البنوة تعتبر غير شرعية بالنسبة للأب حسب المادة 148 من مدونة الأسرة، وذلك خلاف الأم التي تستوي عندها البنوة الشرعية مع غير الشرعية، خصوصا على مستوى الآثار، وهو ما تنص عليه المادة 146 من مدونة الأسرة، فالنتيجة أن العبء المادي للأولاد يلقى على عاتق المرأة، والمشكل يدق في حالة الحمل الناتج عن عملية الاغتصاب، وبالرغم من أن المشرع اعتبر أن بنوتها في هذه الحالة شرعية بالنسبة لها فإنه لم يرتب عليها بالنسبة للزوج أي مسؤولية،([52]) حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا ما يلي: "حيث إنه صح ما عابه الطاعن عن القرار المطعون فيه ذلك أن المادة 152 من مدونة الأسرة تنص على أن أسباب لحوق النسب وهي: الفراش أو الإقرار أو الشبهة، أما الزنا والاغتصاب فلا يلحق بهما النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان.([53])
واستقر عليه قضاء محكمة النقض([54]) من خلال قرارها الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 والذي جاء فيه: "يعتبر النسب لحمة شرعية بين الأب وولده ولا ينال بالمحظور وإذا كانت الخبرة القضائية حسب المادة 158 من مدونة الأسرة من وسائل إثبات النسب فإن المقصود بالنسب الشرعي الناشئ بعقد زواج صحيح أو فاسد أو باطل مع وجود حسن النية أو بشبهة الفعل أو العقد أو الحل، أما الاغتصاب فلا يعتبر سببا من أسباب لحوق النسب لأن الحد والنسب لا يجتمعان".
وهذه المسألة سبق للمجلس الأعلى أن قررها منذ مدة، وتسير عليها محاكم الموضوع([55])، وقد سبق للقضاء المغربي أن حكم على شخص التزم بالإنفاق على حمل امرأة كانت معه في علاقة فساد ثم حاول التخلص من التزامه بعلة أن الولد غير شرعي، لكن القضاء أجابه بأنه بمقتضى المادة 205 من مدونة الأسرة فإن من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به وإن كانت لمدة غير محدودة، وقد اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها، ولم تتطرق المحكمة لشرعية البنوة لأن سبب النفقة في هذه الحالة هو الالتزام، وهو ما أكده المجلس الأعلى إذا جاء في قراره([56])أن: "التزام الطاعن بنفقة الحمل البين من المطلوب يلزمه وقد سكت المجلس عن شرعية الحمل".
وقد أخذ القضاء اللبناني بهذا الحل في حالة مماثلة، حيث جاء في قرار([57])صادر عن محكمة التمييز اللبنانية الثالثة تحت عنوان: تعويض الوالد لابنته غير الشرعية على أنه: "في حالة علاقة جنسية غير مبنية على عقد الزواج، فإن الوالد ملزم بالتعويض بالاستناد إلى التبعية الناجمة عن الخطأ الشخصي (المادة 122-123 موجبات وعقود).
وأن محكمة الاستئناف تركيزا على هذه المبادئ قدرت التعويضات السابقة للحكم بمبلغ شهري قدره مائة ليرة لبنانية حتى بلوغ الابنة سن الرشد".
ومما يجب الإشارة إليه أن المحكمة عندما تحكم بالتعويض تولي الاهتمام للافتضاض الناتج عن الاغتصاب، بل أكثر من ذلك لا تطلب المحكمة إثبات واقعة الحمل ولو بخبرة جينية، مما يظهر الفراغ التشريعي حيال الحمل الناتج عن عملية الاغتصاب ومن ثمة تبرئة الغاصب من أي مسؤولية تجاه هذا الحمل أو الطفل.
وعلى عكس ذلك نجد محكمة النقض الفرنسية أنها أقرت للطفل المزداد نتيجة اغتصاب أمه الحق في التعويض وقبوله طرفا مدنيا ضد مرتكب فعل الاغتصاب، حيث جاء في حيثياته([58])ما يلي: "إن الطفل المزداد نتيجة عملية اغتصاب أمه يقبل طرفا مطالبا بالحق المدني ضد مرتكب فعل الاغتصاب".
وفي نفس الصدد ذهبت محكمة النقض (Caen) بفرنسا([59]) إلى تقرير حق كل من المغتصبة وطفلها في التعويض وتحميل المسؤولية كاملة للغاصب بناء على الفصل 706 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسية الذي ينص على أنه: "حق كل ضحية في أي جريمة أن تطالب بالتعويض على الضرر اللاحق بها، وكذا كل شخص كان ضحية الأفعال الإجرامية هذه، له الحق في طلب التعويض".
وفي الأخير، نحبذ لو طبق القضاء المغربي الفقرة الأخيرة من المادة 147 من مدونة الأسرة بكيفية يسوي من خلالها بخصوص مشروعية النسب بين الفراش والشبهة والاغتصاب بالنسبة للطرفين معا الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة تغليبا لحق المغتصبة وحق الولد وسدا لذريعة الاغتصاب([60]).
وبقي لنا أن نشير وخاصة أمام عظمة المسؤولية التي ألقاها المشرع المغربي على الأمومة وأمام الفراغ التشريعي، حيث أصبح لزاما على التشريع والاجتهاد القضائي المغربيين بأن يولي الاهتمام اللازم للحمل أو الطفل الناتج عن عملية الاغتصاب وتحمل المسؤولية كاملة للغاصب كما فعل نظيره التشريع المقارن، كما نأمل من القضاء أن يفعل مقتضيات الخبرة الجينية في هذا المجال على اعتبار أن الأمر يتعلق بمصير مولود لا ذنب له.
خاتمة
يتضح من خلال هذا المقال، أن مسألة إثبات نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج تمثل إحدى أكثر القضايا تعقيدا التي تواجه المشرع المغربي، نظرا لتقاطع الضوابط الشرعية مع المطالب الحقوقية والاعتبارات الاجتماعية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة عبر مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، فإن الإطار التشريعي المغربي لا يزال يواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين حماية مؤسسة الأسرة وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وقد أظهرت الدراسة أن التشريع المغربي يقتصر في الغالب على إسناد النسب للأم فقط، في حين تسعى التشريعات المقارنة إلى منح الطفل الطبيعي كامل الحقوق المترتبة على النسب، بما فيها الحق في النسب والحقوق المرتبطة به، ولهذا أصبح تطوير النصوص القانونية والاجتهاد القضائي أمرا ضروريا لتعزيز الحماية الفعلية لهذه الفئة الهشة، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب ويكفل للطفل مكانة قانونية واجتماعية تحترم كرامته الإنسانية.
[1]- أحمد الخمليشي: "التعليق على قانون الأحوال الشخصية"، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، نشر دار المعرفة، الطبعة الأولى 1994، ص: 86.
[2] -عمر بنهيش:"تطور قواعد النسب في القانون المغربي"، بدون اسم المطبعة، الطبعة الأولى1434ه/2013م، ص:7
[3]- علاء الدين الكساني: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "،الجزء السادس، مطبعة دار الكتاب العربي- بيروت - الطبعة الثانية 1974، ص:242.
[4]- أحمد بن محمد الصاوي: "بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك "،الجزء الثاني، مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1995، ص: 259.
[5]- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني:" مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج "، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى 1994، ص: 159.
[6]- بن قدامة: "المغني"، الجزء الخامس، مطبعة دار الفكر، الطبعة الأولى 1984، ص:328.
[7]- ابن حزمة: "المحلى"، الجزء العاشر، مطبعة دار المعرفة- بيروت- طبعة 1989 ، ص:154.
[8]- شمس الدين السرخسي: " المبسوط"، الجزء السابع ، مطبعة دار المعرفة -بيروت -طبعة 1989، ص: 154.
[9]- علاء الدين الكساني:"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،الجزء السادس ، مرجع سابق، ص: 243.
[10]- أبو داود: "سنن أبي داود"، كتاب الطلاق- باب الولد للفراش- حديث رقم 2273، الجزء الثاني، مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج
الطبعة الأولى 1989، ص: 429.
الطبعة الأولى 1989، ص: 429.
[11]- أبو داود:" سنن أبي داود"، كتاب الطلاق – باب في ادعاء ولد الزنا- حديث رقم 2264، الجزء الثاني، ص:299.
[12]- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني: " مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج "،الجزء الثالث، مطبعة دار الكتب العلمية- بيروت - الطبعة الأولى 1994، ص:175.
[13]- شمس الدين السرخسي: " المبسوط"، الجزء الرابع، مطبعة دار المعرفة بيروت- طبعة 1989، ص: 207.
[14]- سورة النور الآية: 19.
[15]- سعد الدين مسعد هلالي: " البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية" دراسة فقهية مقارنة ، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، الطبعة الأولى 2001، ص: 356.
[16]- شمس الدين السرخسي:" المبسوط"، الجزء الرابع، مرجع سابق، ص: 204.
[17] - أبي محمد علي بن أحمد بن حزم: "المحلي"، الجزء التاسع، مطبعة دار الفكر، بدون تاريخ الطبع، ص: 302.
[18] - أبو أحمد عبد الله ابن أحمد الأنصاري القرطبي:"الجامع الأحكام القرآن (تفسير القرطبي) " الجزء الخامس، مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1938، ص: 115.
[19]- سعد الدين مسعد هلالي:"البصمة الوراثية وعلاقتهما الشرعية"، مرجع سابق، ص: 361.
[20]- سورة النور الآية: 3.
[21]- سنن أبي داوود: "كتاب النكاح" - باب في وطء السبايا- الجزء الثالث، حديث رقم 2158، ص: 485.
[22]- سعد الدين مسعد هلالي: " البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية "، م س، ص: 361 وما بعدها.
[23] - إبن القيم الجوزية:" زاد المعاد في هدى خير العباد"، الجزء الخامس، مطبعة دار الفكر- بيروت - الطبعة الثالثة 2001، ص:425.
[24]- النسائي في سننه:" سنن النسائي في شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي"، الجزء السادس ، كتاب الطلاق - باب بدء اللعان- مطبعة دار الفكر- بيروت - الطبعة الأولى 1930 ص: 172.
[25]- أحمد الخمليشي:" التعليق على مدونة الأحوال الشخصية"، الجزء الثاني، آثار الولادة والأهلية والنيابة القانونية، مطبعة المعارف الجديدة، نشر دار المعرفة، الطبعة الأولى 1994، ص: 86.
[26]- المواد من 144 إلى 148 من مدونة الأسرة.
[27]- تنص المادة 146 من مدونة الأسرة على أنه: "تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية".
[28]- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 11 يونيو 2008 منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى، الجزء الأول السلسلة الأولى 2009، ص: 94.
[29]- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 أبريل 2005 عدد 213 ملف شرعي عدد 356/1/2004، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد مزدوج 64-65 سنة 2006، ص: 160 وما بعدها.
[30]- قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 30 مارس 1983 عدد 44، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 السنة 11 نوفمبر 1986، ص: 109.
[31]- ينص الفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على أنه:" يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها".
[32]- انظر الفصول من 68 إلى 76 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، وكذلك المواد من 40 إلى 46 من قانون الأسرة الجزائري".
[33]- قرار صادر عن محكمة التعقيب التونسية بتاريخ 13 يناير 1972، عدد 63341، أورد حيثياته وعلق عليه علي الفطناسي: "إثبات النسب بالبينة"، مقال منشور بمجلة القضاء والتشريع ،عدد 9، نوفمبر 1975،ص: 20 وما بعدها.
[34]- حكم إبتدائية قفصة التونسية الصادر بتاريخ 21 فبراير 1994، عدد 43979، أورده ساسي بن حليمة: مجلة دراسات قانونية، عدد 8 ، السنة 2001، ص:55.
[35]- خالد برجاوي:" القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية "دراسة مقارنة تطبيقية في الروابط الدولية الخاصة المغربية"، مطبعة دار القلم الرباط ، الطبعة الأولى 2001، ص: 215.
[36]- عبد المنعم فلوس:" أحكام الأسرة للجالية المغربية بإسبانيا"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق السويسي- الرباط -السنة الجامعية 1995-1996، ص: 15.
[37]- محمد الشافعي:" الأسرة في فرنسا"، دراسات قانونية وحالات شاذة، مطبعة الوراقة الوطنية- مراكش - الطبعة الأولى 2001، ص: 110.
[38]- Marie Pierre Baudin – Maurin: l’établissement de la filiation naturelle notoire d’un personne hors de reconnaitre, revue de recherche juridique n° : 4,2001, p :1313.
[39]- ابتداء من هذا التاريخ أصبح القانون الفرنسي يستعمل لفظ الطفل الطبيعي بدل الطفل غير الشرعي أو ابن الزنا (الفصول من 334 إلى 341 من القانون المدني الفرنسي).
[40]- Cour de cassation 2ème chambre civil 7 mars 2002 la semaine juridique j,c,p, n° 16-17/2002, p : 797.
[41]- Marjorie bouvier : L’égalité des filiations, S, Gazette de palais, recueil bimestrielle septembre – octobre 2002, ° 5, p : 1390-01391.
[42]- هشام أصنيب:" ضابط الإرادة في الأحوال الشخصية وآثاره على الجالية المغربية بأوربا الغربية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون خاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- فاس- السنة الجامعية :2002 -2003، ص:55.
[43]- سناء المغراوي:" دعاوي البنوة من خلال العمل القضائي،" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- طنجة - السنة الجامعية: 2009- 2010، ص: 41.
[44]- ينص الفصل 488 من القانون الجنائي على أنه:" في الحالات المشار إليها في الفصول من 484 إلى 487 إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها فإن العقوبة تكون على التفصيل التالي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
[45]- تنص المادة 148 من مدونة الأسرة على أنه: "لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
[46]- الحسين بلحساني:" قواعد إثبات النسب والتقنيات الحديثة"، مقال منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد- 6 سنة 2002، ص: 96.
[47]- محمد أبو زيد: "دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب"، مقال منشورات بمجلة الحقوق الكويتية ، العدد الأول، السنة العشرون مارس 1996، ص: 224.
[48]- نزهة الخلدي: "الخبرة الجينية والعلاقة خارج مؤسسة الزواج"، مجلة القانون المغربي ، العدد 15 مارس 2010، ص: 60.
[49] - فقد نصت الفقرة الثالثة من الدستور على أن:" تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية
متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".
[50]- إبراهيم بحماني:"نسب الأبناء في الزواج الفاسد"، مجلة القضاء والقانون ، العدد 149 ، السنة 2004، ص: 58.
[51]- حكم المحكمة الابتدائية بتطوان ملف رقم 1437/07/13، حكم رقم 536 مؤرخ في 31/03/2008 منشور في سلسلة دراسات وأبحاث 2، قضايا الأسرة وإشكاليات راهنة ومقاربات متعددة ج 1، ص:242.
[52]- عمر بنعيش: "تطور قواعد النسب في القانون المغربي"، مكتبة دار الأمان الرباط ، طبعة 1434 ه / 2013م، ص: 23.
[53]- أحمد الخمليشي:"التعليق على قانون الأحوال الشخصية" الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط - الطبعة الأولى 1994، ص: 86.
[54]- قرار محكمة النقض، عدد 215 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2011 في الملف الشرعي عدد 754/ 2/1/2009 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد: 74 لسنة 2012، ص: 179.
[55]- قرار المجلس الأعلى عدد481 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2007 في الملف الشرعي عدد 06/ 2/1/2007، أورده إبراهيم بحماني:"العمل القضائي في قضايا الأسرة مرتكزات ومستجدات في مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة"، مكتبة دار السلام – الرباط- طبعة 2008، ص: 527.
[56]- قرار المجلس الأعلى رقم 381 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005 في الملف عدد 29/ 2/1/2005، أورده إبراهيم
بحماني:"العمل القضائي في قضايا الأسرة"، م.س، ص: 47.
بحماني:"العمل القضائي في قضايا الأسرة"، م.س، ص: 47.
[57]- قرار محكمة التميز اللبنانية الثالثة عدد 51 الصادر في 14 نيسان 1967، أورده إبراهيم بحماني:"العمل القضائي في
قضايا الاسرة "م.س، ص: 77وما بعدها.
قضايا الاسرة "م.س، ص: 77وما بعدها.
[58]- قرار محكمة النقض، الصادر بتاريخ 4 فبراير 1998 منشور بمجلة الإشعاع عدد 17، لسنة 1998، ص: 276.
[59]-la cassation caen, 1erch, sect.civ 7 nov. 2000m fonds de garantie des victimes d’arts de terrorisme et autres infractions, le semaine juridique n° 12 janvier 2002, p : 31.
[60]-محمد الكشبور:"البنوة والنسب في مدونة الأسرة"، قراءة في المستجدات البيولوجية، "دراسة قانونية وشرعية مقارنة"، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- طبعة 1428- 2007، ص: 26.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 حق الطفل الطبيعي في النسب بين المرجعية الشرعية والمقتضيات القانونية المغربية
حق الطفل الطبيعي في النسب بين المرجعية الشرعية والمقتضيات القانونية المغربية