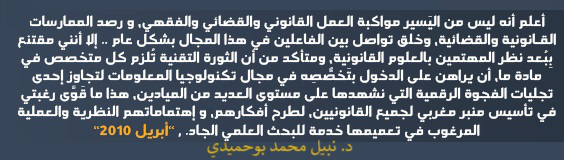الحقيقة أن إحالة قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف البرلمان شكل حدثا تاريخيا ودستوريا بامتياز يحسب لمجلس النواب ولرئيسه وسيؤرخ لسابقة في تاريخ المغرب ،لكون قانون المسطرة المدنية يعتبر الشريعة العامة لكل الإجراءات القضائية في بلدنا وهو القانون الأم ،ويمكن القول أنه دستور الإجراءات القضائية أو العدالة بشكل عام،كما أن ممارسة الرقابة الدستورية في اطار دستور 2011 باعتباره دستور حداثي وديمقراطي سيزيدها أهمية وسموا لأنه وضع لأول مرة أبوابا للحقوق والحريات وقواعد سير العدالة واستقلال السلطة القضائية ،ومكن المحكمة الدستورية من مكانة قوية في هرم التنظيم الدستوري ، ينضاف إلى ذلك أنه لم يسبق أن أحيل قانون بهذا الحجم والأهمية والأثر على المحكمة الدستورية على مر تاريخ المغرب ،وتشكل الإحالة هاته عمل مؤسساتي ودستوري جريء وشجاع لاندراج إحالة القوانين قبل نشرها بالجريدة الرسمية على المحكمة الدستورية ضمن اختصاصات رئيس مجلس النواب الدستورية وفقا للفصل 132من الدستور ،وهو مؤشر إيجابي على دور المؤسسة التشريعية ولاسيما الغرفة الأولى في صون أحكام الدستور وتنزيله بشكل أمثل ،لأن هذا القانون يفترض فيه أن يكون تعبيرا عن الإرادة العامة أولا وثانيا قاطرة للعمل القضائي وللحق في التقاضي يقتضي بلورة اجماع وطني ومؤسساتي حوله .
ومما لاشك فيه فإن المحكمة الدستورية عودتنا دوما على قرارات رائدة تراعي فيها أهمية صيانة أحكام الدستور وعلوه باعتبارها أمينة على الشرعية وسيادة القانون وللأمن القانوني والقضائي وحامية لحقوق المتقاضين ولقواعد سير العدالة ولحرمة مؤسسة الدفاع كمرتكز دستوري نحو تحقيق المطالب المنصفة والعادلة والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين لتأمين الدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون والولوج المستنير والآمن للعدالة من خلال قانون مسطرة مدنية منصف ودفاع قوي وقضاء مستقل ونزيه،وهو ما ليس مستحيل تحقيقه من خلال قرار المحكمة الدستورية المنتظر للفصل في مدى دستوريته.
ويجب الاعتراف أن قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف البرلمان يشكل تقدما اجرائيا عن القانون الساري النفاذ حاليا في العديد من المقتضيات ،وأتى بمستجدات مهمة تعكس تحديث وعصرنة القانون، وملائمته مع الدستور ومع القوانين الإجرائية والموضوعية الأخرى التي تتقاطع معه، وإجمالا يمكن حصر الخطوط العريضة لأهم المستجدات في المرتكزات التالية:
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري تبني معايير المحاكمة العادلة التي تنبني أساسا على مبدأي الإنصاف المسطري و ضمان حقوق الدفاع بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
- ملاءمة مقتضيات قانون المسطرة المدنية مع الدستور والقوانين الأخرى كمدونة الشغل ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية وقانون التنظيم القضائي وقانون قضاء القرب والقانون المحدث للمحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية وقانون المحاكم التجارية وقانون المفوضين القضائيين... وكذا مع الاتفاقيات الدولية.
- تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها ، و تنظيمها بشكل يحقق الغاية من اعتمادها دون السقوط في التعقيد و البطء.
- اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا لكثرة الاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
- جعل دور القاضي أكثر إيجابية في سير المسطرة والتقليص من حالات صدور أحكام بعدم القبول ، مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة.
- إعادة النظر في قواعد الاختصاص النوعي وتوحيد مقتضياتها أمام جميع المحاكم .
- إقرار التبليغ بالوسائل الحديثة للاتصال مع اعتماد الوسائل الحديثة لعمل كتابة الضبط، وذلك بفتح المجال أمام إمكانية اعتماد السجلات الإلكترونية.
- ضبط وتبسيط إجراءات التبليغ و تسريع وتيرتها، وملاءمته مع قانون المفوضين القضائيين و مع ما استقرت عليه الممارسات الجديدة بشأن إجراءات التبليغ.
- إقرار آجال محددة ومضبوطة لتقليص أمد البت في القضايا سواء في المسطرة الشفوية أو المسطرة الكتابية أو عند البت في الأوامر المبنية على طلب أو في المادة الاستعجالية.
- تفعيل مسطرة التنفيذ بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ مع تخويلها صلاحيات و سلطات قضائية و إدارية واسعة في مجال التنفيذ.
ولكن رغم هذه الإيجابيات على أهميتها فإن المشروع اعترته عيوب دستورية جوهرية سيكشف عنها قرار المحكمة الدستورية ،لكن لا بأس من الوقوف عليها وبيان مواطن الخطأ فيها.
أولا-مساس قانون المسطرة المدنية بحق التقاضي كحق دستوري مضمون ؟
إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع.
وتأكيدا لذلك نصت المادة 118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون."
ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون أي مصون ومحترم وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام لا يقبل أي افتئات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات.
وتبعا لذلك يتأكد عدم دستورية أي مقتضى ورد في قانون المسطرة المدنية يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين فيما بينهم واحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء لحماية حقوقهم والدفاع عنها وكذا عدم جواز احداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء وتحدث تمييزا بينهم بحسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي ناهيتكم عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة باستحداث قواعد تمييزية للإدارة اتجاه المواطنين دون ضابط موضوعي ؟مما سيشكل مخالفة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي،وهو ما ستتصدى له المحكمة الدستورية من خلال:
-احداث حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف -المادة 30 والنقض -المادة 375،ومنع الطعن فيها بحسب مبالغ معينة وهو تمييز للمتقاضين فيما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي وهو أمر مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية .
-احداث حصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية القرارات الإدانة -المادة 375 - بالمنع من نقضها ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور الذي يمنع تحصين أي قرار اداري من الطعن.
-احداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الاخلال بواجب احترام المحكمة -المادة 93-بحيث يعتبر القرار نهائي وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته ، وفي ذلك مس بكفالة حق الدفاع ومكنه مراجعة وتصحيح الأحكام إن شابتها تجاوزات لأنه قد تكون إساءة في التفسير ويتعين دائما وضع رقابة على الأحكام لفحص قانونيتها وشرعيتها،لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة .
ثانيا-مساس قانون المسطرة باستقلال السلطة القضائية
ان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يحتم كأمر بديهي الغاء أي دور لوزير العدل في المساطر القضائية،لذلك فإن المواد من 404 إلى 407 التي تنظم مساطر خاصة كالشطط في استعمال السلطة وطلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أو من أجل الأمن العمومي تتعلق بممارسة طعون أو مساطر قضائية ذات طابع قضائي بامتياز تعتبر مشوبة بعيب عدم الدستورية وفقا للفصلين 107 و 109 من الدستور،لأن وزير العدل كسلطة إدارية لا يمكنه أن يتدخل في أي مسطرة قضائية أو يقيم أي طعن ،لاسيما أن هذه المساطر مخولة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض حصرا على غرار ما استقر عليه الان اجتهاد الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من حلول رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في جميع الاختصاصات التي كانت تعود لوزير العدل في اطار المساطر القضائية.
ثالثا-مساس قانون المسطرة المدنية باستقلال القاضي
نص الفصل 109 من الدستور على حماية استقلال القاضي بحيث يمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليه ولو كانت من رئيس المحكمة ذاته ،لكن المادة 97 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 352 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية تنتهكان بشكل جسيم هذا المبدأ وتشكل مخالفة دستورية ،لما سمحت بتغيير القاضي المقرر في الملف سواء ابتدائيا او استئنافيا كلما كان هناك موجب دون أن تحصره بحالات لا يجوز فيها هذا التغيير حتى لا يتم انتقاص من استقلالية القاضي والتأثير عليه في احكامه وفي تدبيره لملفاته ،وهكذا فإن تعيين القاضي المقرر او المكلف يحتم اتخاذ إجراءات لضمان استقلالية القاضي في اطار هذا التعيين عند تعدد القضاة او الأقسام او الغرف ،كما ان تغييره يجب ان يتم في اطار مراعاة عدم المس باستقلال القاضي.
رابعا-مساس قانون المسطرة المدنية بمجانية القضاء
إذا كان الفصل 121 من الدستور ينص على أنه "يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي."فإنه تم انتهاك هذا الفصل في العديد من المقتضيات الواردة في قانون المسطرة المدنية من قبيل ليس فقط فرض رسوم مكلفة للمتقاضين بل اثقال كاهلهم بوضع ضمانات مالية على عدة طعون لا تقبل شكلا إلا ايداعها مع المقال أو الطعن ،وهكذا تم فرض غرامات فرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر -المادة 430-والتعرض الخارج عن الخصومة -المادة 347-وتجريح القضاة -المادة 340 -ومخاصمتهم-المادة 425-والتشكك المشروع -المادة 409- ودعوى الزور لمادة 413-مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين الى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليس حق واجب الحماية وفقا للفصل 118 من الدستور.
خامسا-مساس قانون المسطرة المدنية بحقوق الدفاع
ينص الفصل 120 من الدستور على أنه " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم."
الملاحظ أن العديد من مقتضيات مواد قانون المسطرة المدنية تتضمن عيوب دستورية لخرقها مبادئ المحاكمة العادلة وحق التقاضي وكفالة حقوق الدفاع
وفي اطار تفعيل الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة كان يتعين في اطار المادة 11 تخصيص المحكمة وحدها دون غيرها في اثارة تصحيح المسطرة ،لان اثارة أي طرف لدفع لا يحمل على صحته ومشروعية اثارته ،فالمحكمة وحدها من تملك حق انذار الأطراف او تنبيهم للاخلالات الشكلية والمسطرية وليس الأطراف ،لان بعض الدفوع قد لا تكون جدية او صحيحة .
وهكذا تم حرمان الأطراف في المادة 62 من حقهم في اثارة جميع الدفوع بعدم القبول أمام محكمة الدرجة الثانية باستثناء الأحكام الغيابية رغم أن الاستئناف له أثر ناشر ،ورغم أن بعض الدفوع بعدم القبول مرتبطة بحالة الطعن أمام محكمة الاستئناف ولا يمكن حرمان أي طرف من اثارتها لكونها حالة مستجدة تتعلق الأهلية أو انعدام الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي مما يؤكد خرق حقوق الدفاع.
كما أن المادة 77 تنص على وجوب تضمين مقالات الدعوى والطعون بالاستئناف -المادة 216 -والطعن بالنقض -المادة 377- بيان الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ،وبطاقة تعريف المدعي تحت طائلة عدم القبول وهي بيانات لا علاقة لها بموضوع وستمس بجوهر الحق في التقاضي كحق مضمون وكفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة بسبب إجراءات شكلية غير مفيدة ولا أثر لها على الحق المحمي قانونا .
ومن نافلة القول أن المادة 78 بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى والمادة 353 بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية ستمسان بحق المحاكمة في أجل معقول وما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تبليغ جميع الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية لمحامي الأطراف وليس لهم شخصيا ،سعيا لاختصار أمد البت في القضايا وصيانة حقوق الدفاع .
وفي نفس الاتجاه فإن المادة 84 ستعرقل حقوق الدفاع لأن الملاحظ من الناحية العملية ان جميع التبليغات للإدارات والأشخاص الاعتبارية تسلم للمكلف بتسيير مكتب ضبطها ولا تسلم للممثل القانوني لذا عوض اعتبار وضع طابع مكتب ضبط الإدارة بمثابة تبليغ قانوني سليم وفق ما يجري به العمل حاليا تم وضع حواجز على التبليغ بهدف عرقلة الحق في التقاضي والمساس بحقوق الدفاع وطلب بطلان التبليغ لأسباب واهية.
كما تم التنصيص في المادة 99 على ان عدم حضور المدعي او محاميه او وكيله في المسطرة الشفوية يرتب عدم قبول الدعوى لكون المحكمة لا تتوفر على العناصر الضرورية للفصل ،وهذا يمس بحقوق الدفاع لكون اختيار التعامل الكتابي مع المحكمة يعني صراحة على أنه لا عبرة بحضوره او عدم حضوره على نتيجة الحكم ،فالمحكمة يمكنها اتخاذ إجراءات التحقيق في ولا يمكن ان نحكم بعدم قبول الدعوى نتيجة لعدم الحضور ونهمل الحق موضوع الدعوى ووجوب الحرص على حمايته.
كما أن المادة 101 وضعت جزاء قاس على عدم الادلاء بنسخ كافية من المستنتجات وهو استبعادها من الملف سواء بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية عوض تكليف من له المصلحة في تصويرها على نفقته على غرار تكليف الطرف الاخر بأداء الخبرة عند عدم أدائها ممن حكم عليه بذلك .
وفي نفس الاتجاه اعتبرت المادة 210 على أن عدم الادلاء بالنسخ الكافية لمقالات الطعن بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى أو الثانية -المادة 216 -أو محكمة النقض -المادة 377- يترتب عنه التشطيب على القضية عوض تولي كتابة الضبط تصوير النسخ غير الكافية مع اعتبارها بمثابة مصاريف قضائية لان الجزاءات المقررة قاسية وقد تعصف بالحقوق وذلك قياسا على طلب نسخة من الحكم عند عدم الادلاء بها من المحكمة المصدرة له .
ولا يفوتني التأكيد على أهمية فتح الحق للأطراف للتعقيب على مذكرة المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون لأنه لا معنى لخرق أي حقوق الدفاع في هذا المجال الوارد في المادة 364 لكون تسليم نسخة من المذكرة يعني منح الأطراف حق مناقشتهاو ابداء النظر فيها وليس اسكات صوتهم ضدا على حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة .
وفضلا عن ذلك فالمادة 604 الناصة على أن اجل الطعن يسري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم بناء على طلبه يمس بحقوق الدفاع لأنه لا يمكن للمحامي ان يتعقب اجال التبليغات امام كثرة القضايا بمكتبه ،لان العدالة تقتضي أن يبتدئ سريان اجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه من يوم التبليغ،ولا يسري ذلك على محاميه ان كان هو من اشرف على عملية التبليغ نيابة عنه".كما ان الاجل لا يسري الا بالنسبة لأخر تبليغ عند تعدد الأطراف المبلغ اليها وليس عند أول تبليغ لأنه قد ينتهي الاجل ولازال البعض ممن لم يتوصل من الأصل .ومن المهم الإشارة بأنه بالنظر لخطورة هذا المقتضى وعدم دستورية رفضت محكمة النقض تمديده للطعن بالنقض وإعادة النظر لأنه كان في قانون المسطرة المدنية الحالي خاص باجل الاستئناف ،لكن للأسف تم تمديده لجميع الطعون بدون استثناء ضد على قرارات محكمة النقض المستقر عليها في هذا المجال .
سادسا:مساس قانون المسطرة المدنية بحجية الأحكام واهدارها
نص الفصل 126 من الدستور على أنه " الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام."
لكن المادة 17 تنتهك جملة وتفصيلا حجية الأحكام وتجعلها منعدمة وبمثابة اعلان وفاة ، فخطورتها لا توصف وتجنيها على المبادئ العامة للقانون وللمسطرة لا يخفى على أحد،فهي تشكل نشار ضمن هذا القانون ،وتشكل وسيلة لهدم الاحكام وضياع الحقوق بمبررات غير مقبولة، لأنه لا يمكن تجاهل اجال الطعن وتمديدها لخمس سنوات او تجاوزها من جميع الأطراف بصرف النظر عن أي مبرر كما لا يقبل ممن ليس طرف في الدعوى ان يطلب بطلان الحكم الصادر فيها ولو كان النيابة العامة ولو وجدت اعتبارات النظام العام ،لان الحكم عنوان الحقيقة وهو النظام العام بعينه ،ولا يمكن القفز على الحقيقة القضائية بدعوى غريبة عن نظامنا القضائي .
ومن المهم البيان ان المادة 407 تستوعب اشكال صدور حكم مخالف للقانون او لقواعد المسطرة بحيث يمكن للوكيل العام للملك التقدم بطلب نقضه لفائدة القانون لذا فإن هذه المادة البالغة الخطورة تعتبر مخالفة للدستور.
والملاحظ أن هذه المادة تمنح للنيابة العامة سلطة طلب الغاء الاحكام خارج القواعد الدستورية ودون تقيد بقاعدتي الأجل العادي او الحضور في الخصومة في خرق سافر لدولة الحق والقانون والمشروعية وفي انتهاك للفصل 126 من الدستور القاضي بإلزامية تنفيذ الأحكام، رغم أن النيابة العامة تملك ممارسة طعون مماثلة لا شائبة حولها وهي الطعن لفائدة القانون.
كما أن محاولة ربط اعمال المادة ضمنيا وليس صراحة بالخطأ القضائي مخالفة دستورية لان الدستور وضع جزاء التعويض تؤديه الدولة -الفصل 122 من الدستور وليس الغاء الأحكام واهدار قوتها وقيمتها المستمدة من كون الاحكام تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ،والقاعدة البديهية أنه لا يمكن الجمع بين التعويض العيني "إلغاء الحكم "والتعويض المادي .
سابعا-مساس قانون المسطرة المدنية بمبدأ المساواة بين المواطن والإدارة
نص الفصل 6 من الدستور على أن" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.."
لكن قانون المسطرة المدنية في المادة أحدث استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ في المادة 383 ، بحيث أن الدولة واداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عليها لفائدة المواطنين الا بعد صدور قرار محكمة النقض في حين أن القرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيه، وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين وفقا للفصل السادس من الدستور واحداث تمييز غير مقبول ،وانتهاك أيضا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع لا فرق بين المواطن والإدارة،كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز ،وأيضا انقلابا على قرارات محكمة النقض الحكيمة التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية حتى لا يتم افراغ الاحكام والمقررات القضائية من قيمتها و من الحق الذي تحميه.
ثامنا-مساس قانون المسطرة المدنية بتخصص القضاء
نص الفصل 127 من الدستور على أنه "تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون".
والملاحظ أن قانون المسطرة المدنية أحدث بالمخالفة للدستور أقسام هجينة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف العاديتين، وهي القسم الإداري و القسم التجاري وما هي بالعادية ولا بالمتخصصة،فهي خليط ومزيج لهيئات متخصصة شكليا في اطار المحاكم العادية،وهي مسألة غير مقبولة.
ومما لا شك فيه فان احداث اقسام متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية العادية يعتبر تراجع خطير عن المحاكم المتخصصة وخرق دستوري لاسيما بعد النتائج المثمرة التي تحققت بعد طول التجربة ،وان ما يعتبر كحجة من قبيل تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين يمكن تعويضه بالزيادة في عدد المحاكم وليس بالالتفاف على التخصص بأقسام لن تعرف من التخصص الا الاسم لاسيما ان القضاة المشكلين لها قد يمارسون أنواع أخرى من القضاء قد تفرغ التخصص من مضمونه وتعصف بجودة الحماية القضائية وبمبدأ المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم ، أي المواطنين الفقراء أصحاب القضايا ذات القيمة 80 الف درهم لهم الأقسام المتخصصة والمواطنين الأغنياء أصحاب القضايا ذات القيمة الأكبر يتمتعون بالمحاكم المتخصصة،ولعمري إنه عبث ليس بعده عبث .
وقد سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت اجتهادا مبدئيا قضت فيه بعدم دستورية نص ورد في قانون التنظيم القضائي يقضي بتعين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية نائب عنه في المحاكم التجارية في اطار ضمان تخصص القضاة والمحاكم بالنقيض لوحدة القضاة والنيابة العامة . وهكذا اعتبرت المحكمة الدستورية "أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية)؛
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛"قرار تحت عدد 19-89وتاريخ 8-2-2019 في الملف عدد 19-41 منشور بموقع المحكمة الدستورية على الانترنت.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 د. الهيني يرافع بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.
د. الهيني يرافع بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.