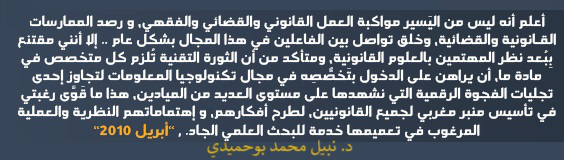رفقته نسخة مجهزة للتحميل
مقدمة:
يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية المنتجة، وأداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، بالنظر إلى الدور الفعال الذي يقوم به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.[1]
والناظر للبنية العقارية ببلادنا سيجد تنوعا في طبيعة الأملاك الموجودة، حيث نجد أنظمة عقارية حديثة كالملكيات المشتركة....، إلى جانب أنظمة عقارية تقليدية منها: الملك الخاص للدولة، الملك الغابوي، أراضي الجماعات السلالية... وأملاك الجماعات الترابية؛ و التي وتعد من أهم هذه الأنظمة العقارية، بحيث تمكن الجماعات الترابية من تكوين رصيدها العقاري وتنميته وتدبيره، كما تشكل أيضا دعامة أساسية لتعزيز قدراتها واستقلالها المالي، لإنجاز مختلف المشاريع ذات النفع العام في إطار برامجها التنموية من أجل تحقيق التنمية الترابية الشمولية والمستدامة[2] .
ويقصد بأملاك الجماعات الترابية - العقارية- كافة ما تملكه هذه الأخيرة من ممتلكات عقارية، وتتملكها ملكية تامة أو تتصرف فيها تصرفا كاملا أو يعود إليها تدبيرها في حدود ما يسمح به القانون، والتي اكتسبتها أو أصبحت تحت تصرفها إما عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو عن طريق الحصول عليها بالتراضي أو المنقولة ملكيتها عن طريق الهبات والوصايا... طبقا للمادة الثانية من القانون 57.19 لميثاق المرافق العمومية.[3]
هذه الأملاك تنقسم إلى صنفين اثنين، أملاك عامة وأخرى خاصة؛ ويراد بالأملاك العامة للجماعات الترابية: تلك التي تمتلكها الجماعات الترابية والمخصصة لتحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة المحلية، وهي بهذه الصفة لا يمكن أن تكون ملكية خاصة. [4]
أما الأملاك الخاصة فهي تشمل كل الأملاك التي تمتلكها الجماعات الترابية ملكية خاصة، تتصرف فيها بمثل تصرفات الأفراد في ملكياتهم، وبالتالي فهي تخضع للعمليات المعروفة في التعامل المدني من بيع وشراء وكراء ومبادلة، لكن هذه الحرية لا تؤخذ على إطلاقها لأنها مضبوطة بشروط مسطرية تجب مراعاتها.[5]
وتدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية مر بمحطات تاريخية ساهمت في بناءه وتطوره، حيث يرجع التأصيل التاريخي للأملاك العقارية للجماعات الترابية إلى ما قبل الحماية، حيث كانت تندرج ضمن ملك الدولة وكانت تستمد مختلف القواعد المنظمة له من الأعراف والتقاليد والأحكام المضمنة في مذهب الإمام مالك، غير أنه في سنة 1865 أصدر السلطان مولاي الحسن الأول، أمره بالقيام بجرد وإحصاء جميع أملاك الدولة في المملكة، ووضع ملفات وقوائم بها حسب كل منطقة، وكانت هذه العملية ذات أهمية كبيرة لمعرفة وضعية أملاك الدولة لأول مرة في تاريخ المغرب.[6]
أما بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 قامت سلطات الحماية بوضع مجموعة من القوانين، كظهير 1918 المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا[7]، ثم ظهير 1921 المتعلق بالأملاك العامة البلدية [8]، وكذا ظهير 1949 بشأن منح الرخص في أشغال الملك العمومي البلدي [9]، دون أن ننسى ظهير 1954 بشأن أملاك الجماعات القروية [10]، من أجل توفير بنية عقارية مناسبة لتحقيق أهدافها الاستعمارية، وأيضا ظهير [11]1963 المتعلق بالإذن في التخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرض مخزنية لازمة لبناء "دور جماعية"، والذي صدر بعد حصول المغرب على الاستقلال.
غير أن هذه الترسانة التشريعية أصبحت غير قادرة على حماية أملاك الجماعات الترابية خصوصا أنها لم تساهم في تكوين رصيد عقاري خاص بها، كما لم تعد تتلاءم والمستجدات التي طالت التنظيم الترابي للمملكة الذي أصبح بموجب دستور (2011) [12] تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.[13]
ومع توالي الإصلاحات في نظام اللامركزية الترابية، وقصد المساهمة في تطوير وتحسين تدبير هذه الأملاك وكذا المساهمة بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد دفع المشرع لإصدار القانون رقم (57.19)[14] المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والذي يعتبر نظاما عقاريا خاصا قائما بذاته ولبنة أخرى في الترسانة القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، حيث جاء هذا القانون بمجموعة من الإجراءات قصد تدبير هذه الأملاك العقارية من أجل تحقيق التنمية المنشودة، كما منح لعدة أجهزة مهمة تدبير هذه الأملاك العقارية والمحافظة عليها.
وفي هذا الصدد تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول:
هل نجح المشرع من خلال القانون 57.19 في إرساء نموذج قانوني متوازن يضمن تدبيرا فعالا ومستداما لأملاك الجماعات الترابية، أم أنه أعاد إنتاج نفس الإكراهات القديمة بصياغة جديدة؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين:
- المطلب الأول: أطر تدبير أملاك الجماعات الترابية بين تعدد الأجهزة وتحديات الفعالية
- المطلب الثاني: استغلال أملاك الجماعات الترابية بين منطق التنمية ومخاطر الهدر
المطلب الأول: أطر تدبير أملاك الجماعات الترابية بين تعدد الأجهزة وتحديات الفعالية
تعتبر الأملاك العقارية للجماعات الترابية مصدرا مهما لتنمية الموارد الذاتية للجماعة الترابية، ودعامة أساسية لتعزيز قدراتها واستقلالها المالي، ويتوقف تدبير هذه الأملاك على وجود مجموعة من الأجهزة وعلى حيويتها من أجل النهوض بتلك الأملاك.
لذلك منح المشرع المغربي لعدة أجهزة صلاحية تدبير هذه الأملاك، منها أجهزة منتخبة ومنها أجهزة ذات طابع إداري، وسيتم الوقوف في هذا المحور على دور الأجهزة المنتخبة في تدبير الأملاك الجماعية (الفقرة الأولى)، ثم دور الأجهزة الإدارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: دور الأجهزة المنتخبة في تدبير أملاك الجماعات الترابية
تتولى تدبير أملاك الجماعات الترابية ومؤسساتها العديد من الأجهزة المنتخبة تبعا لكل صنف من أصناف هذه الوحدات الترابية اللامركزية، وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14، نجده منح صلاحيات مهمة للمجلس الجماعي في تدبير الأملاك الجماعية (أولا)، وأناط برئيس هذا المجلس أدوار مهمة بغية القيام بذلك التدبير (ثانيا).
أولا: دور مجلس الجماعة في تدبير الأملاك الجماعية
يمارس مجلس الجماعة دورا كبيرا في تسيير الأملاك الجماعية، فبالرجوع للمادة (92) من القانون التنظيمي للجماعات نجدها تنص على ما يلي: "... يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
- المالية والجبايات والأملاك الجماعية؛
-الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
- تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكلة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل...".
كما نصت المادة (25)[15] منه على ضرورة تأسيس لجنة لدراسة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وتحتل هذه اللجنة أهمية في مجال تدبير الملك الجماعي، حيث تختص بدراسة كل قضية تهم الجانب المالي للأملاك العقارية وتقدم اقتراحات للمجلس أثناء تداوله، فهي التي تمكن المجلس من اتخاذ قرارات بشأن كيفية تدبير هذه الأملاك[16].
وبالرجوع لمقتضيات المادة (30) من القانون رقم 57.19، نجده ينص هو الأخر على أن مجلس الجماعة يتداول في عمليات الاقتناء والتفويت والمبادلة الجارية على العقارات التابعة للملك الخاص للجماعة الترابية، وكذا في قبول الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات الممنوحة للجماعة الترابية.
أما المادة (31) من هذا القانون، نصت على أن هذا المجلس يتداول في عملية الاقتناء بالمراضاة التي يعتزم إنجازها في دورته العادية أو الاستثنائية ويتخذ في شأنها مقررا يصادق عليها يبين فيه كافة العناصر العقارية المتمثلة في اسم مالك العقار أو المتعامل معه ومرجعه العقاري...
دون أن ننسى بأن هذا المجلس يتداول أيضا وفق المادة (32) من نفس القانون في دفتر التحملات المتعلقة بعملية التفويت عن طريق المزايدة العمومية في إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية ثم يصادق عليه بما فيه الثمن الافتتاحي المقترح من قبل اللجنة الإدارية للخبرة ويحق في هذه الحالة للمجلس الرفع من قيمة هذا الثمن إذا تبين له منخفضا لا يتماشى والأثمان الجارية في الأسواق العقارية.[17] غير أن الملاحظ أن تسيير الأملاك العقارية الجماعية يتميز بضعفه وهشاشته، ويتمثل ذلك ــــ على سبيل المثال ــــ في سوء استغلال الأملاك والتفريط فيها بتفويتها للغير بأثمنة بخسة.[18]
كما نصت المادة (7) من قانون 57.19، على أن مجلس الجماعة الترابية يقوم بالتداول أيضا في حدود الملك العام للجماعة الترابية، وبدراسة الملاحظات والتعرضات المعبر عنها خلال البحث العلني، قبل التداول بشأن التحديد.
فرغم غزارة النصوص القانونية وتوزيعها الدقيق للاختصاصات، إلا أن مجالس الجماعات غالبا ما تتخذ قرارات دون دراسات جدوى حقيقية أو بدون اللجوء إلى الخبرة العقارية، فضلا على أن النصوص لم تنص على آليات مراقبة قبلية لعمليات التفويت، مما يجعل الصلاحيات الممنوحة للمجلس غير كافية لضمان الحماية الفعلية للملك الجماعي.
ثانيا- دور رئيس مجلس الجماعة:
أفرد الباب الثاني من القانون التنظيمي 113.14 جملة من الصلاحيات لرئيس مجلس الجماعة، فالمادة (94) من هذا القانون أسندت إليه القيام بمجموعة من الأعمال؛ بما فيها مراجعة عقود الكراء والبيع والاقتناء والمبادلات، وكل معاملة تهم الملك الخاص للجماعة [19]، ومن أجل حسن تدبير الملك العام فإن القانون سمح له بمنح رخص الشغل واحتلال الملك العام الجماعي بإقامة بناء وذلك و فقا للبند العاشر من هذه المادة، كما يتولى مسؤولية القيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، ومسك وتحيين سجل المحتويات و تسوية وضعيتها القانونية،[20] و هي نفس الاختصاصات التي نص عليه المشرع في المادة (3)[21] من القانون رقم 57.19.
ومن الصلاحيات الأخرى الممنوحة لرئيس مجلس الجماعة نجد:
- تعين حدود الملك العام للجماعات الترابية وإجراء البحث العلني.[22]
كما يختص رئيس مجلس الجماعة طبقا للقفرة الثانية من المادة (9)[23] من القانون (57.19) لوحده بدراسة الملاحظات والتعرضات الواردة على قرار تحديد الملك العام، وهو ما لا يحقق التوازن بين حقوق الجماعة وحقوق الأشخاص المتعرضين على مضمون قرار التحديد الإداري للملك العام، فتفرد الرئيس بدراسة التعرضات لا يضمن العدالة الإجرائية، ويضعف حقوق المتعرضين، لذلك كان من الأجدر أن تدرس الملاحظات والتعرضات من طرف مجلس الجماعة، ويتداول فيها قبل أن يصدر رئيس المجلس قرارا بشأنها ضمانا وحماية من جهة الحقوق المتعرضين ومن جهة أخرى حفاظا على الملك العام للجماعة الترابية.
- منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء أو بدون بناء[24]، وما يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو غياب الشفافية المحيطة بهذه العملية، إذ لم يفرض المشرع أي إلزام قانوني على رئيس الجماعة بنشر هذه الرخص أو القرارات المتعلقة باستغلال الأملاك العقارية الجماعية، مما يحد من إمكانية مراقبتها من طرف المواطنين أو المجتمع المدني، ويفتح المجال أمام شبهات المحاباة أو الاستغلال غير المشروع.
- اتخاد قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها، وذلك بعد مداولات المجلس شريطة عدم مخالفة المقتضيات التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتعمير[25]، فاستنادا إلى أحكام المادة (32) من قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير[26]، فإن رئيس المجلس الجماعي يتخذ قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها هذه العقارات عندما يتعلق الأمر بإحداث طرق جماعية وساحات عامة ومواقف عامة للسيارات بالجماعات أو إلى تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا.
- تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة المستعملة التابعة للجماعات الترابي لتأكيد طابع الملكية العامة التي تكتسبها وبيان حدودها القانونية بناء على مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر في الموضوع، بمقتضى المادة (81) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.[27]
- قرار الإخراج، حيث يتخذ رئيس المجلس الجماعة الترابية قرار يقضي بإخراج عقارات من الملك العام للجماعة الترابية ويضمها إلى الملك الخاص بعد مداولات المجلس على اعتبار أنه لا يجوز إخراج العقارات من الأملاك العامة[28].
غير أنه إذا كان هدف المشرع من استخراج العقارات من الملك العام للجماعة الترابية ضمها إلى الملك الخاص هو إنشاء و تنمية رصيد ملكها العقاري الخاص للجماعات الترابية، و إدماجه في قاطرة التنمية، إلا أنه من أخطر الصلاحيات التي منحها هذا القانون لرئيس المجلس الجماعي، باعتبارها أداة تمكن ذوي النيات السيئة من استغلال هذه الصلاحية لمصالحهم الخاصة و التفريط في هذه الممتلكات ما يشكل تهديدا على رصيد الأملاك العقارية العامة للجماعة، وما يزيد من خطورة الأمر هو أنه وبالرغم اشتراط مداولة المجلس، إلا أن غياب رقابة خارجية (قضائية أو إدارية) يجعل من هذه السلطة مدخلا للتفريط في الممتلكات الجماعية.
فإذا كان العنصر البشري عصب تحقيق النجاح في كل عملية تنموية كيفما كان نوعها ومهما اختلفت مهامها وأهدافها، فإن المنتخب في معظم الجماعات وفي إطار الصلاحيات القانونية الواسعة الممنوحة له، لا يتوفر على الكفاءة والمؤهلات العلمية التي تمكنه من استيعاب هذه المهام على المستوى الإداري، ما لا يسمح له بالاضطلاع بمسؤولياته على الوجه المطلوب، وإذ كان ضعف المستوى العلمي والثقافي السمة الغالبية لمعظم المنتخبين الجماعيين، فإن ذلك ينعكس سلبا على دورهم ومكانتهم داخل الجماعة[29].
الفقرة الثانية: دور الأجهزة الإدارية في تدبير أملاك الجماعات الترابية
بالإضافة إلى دور المجلس الجماعي ورئيسه في مجال تدبير الأملاك الجماعية، تتدخل أجهزة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها في تدبير أملاك الجماعات الترابية، أبرزها الإدارة الجماعية التي تقوم بتتبع الأملاك العقارية وترتيبها وتصنيفها حسب طبيعة الملك (أولا)، كما تعد الرقابة الإدارية البعدية التي تباشر على الجماعات ذات أهمية بالغة في مجال تدبير الممتلكات (ثانيا).
أولا- الإدارة الجماعية المكلفة بالتدبير الأملاك الجماعية
نظر لأهمية أملاك الجماعات الترابية ومن أجل توفير عناية كافية لها وتسييرها بكيفية تضمن الرفع من مردوديتها والمحافظة عليها وتنميتها، فقد أسند المشرع هذه المهمة إلى مجموعة من المصالح، من بينها نجد مصلحة العمليات العقارية؛ حيث تقوم هذه المصلحة بإبرام العقود حسب نوع العملية والتنسيق بين المصالح الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالموضوع.[30]
إضافة إلى ذلك نجد مصلحة تدبير الملك الجماعي؛ والتي تعمل بتنسيق مع مصلحة تحفيظ الممتلكات على جرد الأملاك الجماعية، بنوعيها الخاص والعام، وتصنيفها من الناحية القانونية[31]، وترتيبها في سجل المحتويات وترقيمها وتبويبها بطريقة تظهر نوع الملك، أصله وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي. ويروم المشرع من وراء مسك هذا السجل تشجيع كل الجماعات الترابية على تكوين رصيد عقاري تابع لها، وهكذا سيصبح بإمكان الجماعة الترابية الرجوع إلى سجل محتوياتها ودراسة القسم الذي يحتوي على أملاكها العامة وتحديد إمكانياتها المادية بناء عليها.
كما أن مسك هذا السجل وتحيينه من رئيس مجلس الجماعة الترابية وإخبار المجلس بذلك وتبليغ نسخة إلى المحاسب المكلف سيكون من شأنه أن يعزز الرقابة الإدارية والمالية على إدارة وتدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية، أما نشره عبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال رقابة المجتمع المدني على هذه العقارات.
كما تعمل مصلحة تدبير الملك الجماعي على ضبط ودراسة ملفات المرافق الجماعية ذات الصبغة الاقتصادية، واستقبال الطلبات المتعلقة بتحيين وتحويل عقود استغلال المرافق الجماعية على اختلاف أنواعها. [32]
وبتنسيق مع مصلحة الشكايات يقوم مكتب تدبير المرافق الجماعية بوضع لجان مختصة أو مختلطة من أجل معاينة الأملاك التي تكون موضوع شكايات ويقوم بصفة عامة بمراقبة المرافق الجماعية بهدف الحفاظ عليها من أي تطاول[33].
أما بالنسبة لمصلحة الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي فيتجلى دورها في الإشراف على منح التراخيص المتعلقة بشغل الملك العام مؤقتا، وكذلك التراخيص المتعلقة بإقامة معارض تجارية، والترخيص...، وإعداد مشروع القرار التنظيمي الذي يتضمن القواعد العامة للاستغلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء.[34]
وما يمكن ملاحظته من خلال ما سبق، أنه رغم الدور المحوري للإدارة الجماعية في ضبط الأملاك العقارية وتدبيرها، فإن غياب إلزام قانوني بنشر سجل المحتويات وتفاصيل التراخيص المؤقتة للرأي العام، يضعف من آليات الشفافية ويحد من الرقابة المجتمعية، وهو ما يقتضي من المشرع التنصيص صراحة على نشر هذه المعطيات ضمن بوابة إلكترونية مركزية مفتوحة للعموم.
ثانيا- الجهاز الإداري المكلف بالرقابة
تعد الرقابة على الشؤون الإدارية للجماعات من الأركان الأساسية التي تميز اللامركزية الإدارية عن الأساليب التنظيمية الأخرى، ذلك أن استقلالية الجماعات ليس الهدف منه هو الوصول إلى تحقيق حكم ذاتي محلي لها، بل ترمي إلى تنمية محلية مستدامة تحت إشراف سلطات المراقبة [35]، فهذه الأخيرة لا تتعارض مع الاستقلالية الإدارية للجماعات، ولا تستهدف عرقلة الوحدات المنتخبة في أدائها لمهامها، بل هدفها الأساسي هو ترشيد التدبير الترابي وتعزيز مبدأ المشروعية، أو على الأقل هذا ما ينبغي أن تسعى إليه.
والرقابة على الجماعات تتمثل في تلك الرقابة الممارسة على الشؤون الإدارية والمالية بهدف حماية الصالح العام والحفاظ على وحدة الدولة، والتأكد من أن الجماعات تحترم مجال اختصاصاتها، ومن هنا برزت الحاجة إلى ضرورة وجود جهاز إداري تناط به مهمة الرقابة.
وبالرجوع للقانون التنظيمي للجماعات 113.14 نجده ينص في مادته 118 على أنه: "لا تكون مقررات المجالس الجماعية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين يوما من التوصل بها من رئيس المجلس الجماعي:
- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، ولاسيما الإقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها".
فالمشرع بمقتضى هذه المادة أعطى الصلاحية لعامل العمالة أو من ينوب عنه في التأشير على جميع المقررات التي يتخذها المجلس الجماعي والتي يكون لها تأثير مالي على الجماعة، وإذا أخدنا عمليات تدبير الملك الجماعي بجميع أنوعها فهي تدخل في هذا الإطار، غير أن ما يثير انتباهنا في هذه المادة هو الصياغة التي جاءت بها، فالبند أعلاه أن ابتدأ بتعميم وانتهى بتخصيص ودون تحديد القيمة التي تخضع للتأشير، مما يفهم منه أن جميع المقررات كيفما كانت قيمتها المالية تستوجب عرضها للتأشير.[36]
و هذا التوجه و إن كان اعتقادنا تبرره رغبة المشرع في الحرص على المواكبة و مراقبة جل الأعمال التي تقوم بها الجماعة، إلا أن ذلك لا يجب أن يشمل كل المقرارات، فبعض منها لا يحمل قيمة مالية كبرى، وبالتالي لا يجب أن تتعرض لطول المسطرة، فسلطة الرقابة تتخذ قراراتها داخل أجل عشرين يوما، ومعنى ذلك أن مقررات المجالس لا تعرف مصيرها هل قبلت أم لا، إلا بعد مرور هذا الأجل، مما يعرقل عمل المجلس الجماعي في تدبير شؤونه و استغلال أملاكه، كما تفقد الجماعات في الكثير من الحالات صلاحيتها التقريرية، وتتحول إلى مجرد إطار لصياغة الاقتراحات والمشاريع، كما أن هذا التأشير يحد من اختصاصات المجالس الجماعية في ميدان الاختيار فمقرراتها تخضع في الغالب للتعديل والتغيير .
ومن جهة أخرى وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (145) من الدستور، يمارس والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية تباعا على شرعية مقررات مجلس الجهة وقرارات رئيس مجلسها وعلى شرعية مقررات مجلس العمالة أو الإقليم وقرارات رئيس مجلسها ثم على شرعية مقررات مجلس الجماعة وقرارات رئيسها.
كما أنه بموجب المادة (47)[37]من قانون 57.19 فان جميع مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة (المقرر القاضي بتخطيط حدود الطرق العامة المعين فيه نزع ملكيتها، ومقرر تخطيط الطرق العامة من قبل سلطة المراقبة الإدارية، وعملية الاستغلال المؤقت وكذا على عملية الاقتناء ...) للتأشير عليها، حسب الحالة من قبل والي الجهة بالنسبة للجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للعمالة والإقليم أو الجماعة.
من الواضح إذن، أن المقررات المتخذة من قبل مجلس الجماعة الترابية أو رئيسه تخضع وجوبا حسب الحالة لتأشير الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم لبسط مراقبتها عليها والتأكد بمدى صحتها أو بطلانها وإذا وقع نزاع بشأن بطلانها بين سلطة المراقبة والجماعة المعنية يقوم الوالي أو العامل بإحالة طلب بطلان القرار أو المقرر على المحكمة الإدارية للبت فيه.
إلا أن طول آجال التأشير، وغياب مساطر الطعن السريع في رفض التأشير، يفرغ المجالس من صلاحياتها التقريرية، ويجعلها رهينة بموافقة سلطة الرقابة، في مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 136 من الدستور التي تنص على التدبير الحر.
المطلب الثاني: استغلال أملاك الجماعات الترابية بين منطق التنمية ومخاطر الهدر
تختلف طرق تدبير واحتلال أملاك الجماعات الترابية باختلاف طبيعة الملك المنصب عليه التصرف - ملك جماعي العام، ملك جماعي خاص- غير أنه سيتم الاقتصار في هذا المحور على البعض منها فقط، وتبعا لذلك سنحاول من خلال هذا المحور التطرق لكل من الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي (الفقرة الأولى)، ثم لكراء الملك الخاص الجماعي والوضع رهن الإشارة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي
إن الأملاك العامة للجماعات الترابية لا يمكن احتلالها إلا بموجب سند قانوني وشرعي وإلا تعرض المستغل للملك العام الجماعي إلى المطالبة بالتعويض، وعليه سنتطرق إلى حالات الترخيص لشغل المؤقت (أولا) ثم إلى حالات سحب رخصة الاستغلال المؤقت (ثانيا).
أولا – حالات الترخيص للاحتلال المؤقت.
إن عملية استغلال الملك العام من العمليات التدبيرية التي تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، ومن ثم فإن هذه الجماعات تقوم بالترخيص لاستغلال ملكها العقاري العام بموجب قرار إداري فردي أو بموجب عقد إداري.
كما يمكن أن نعتبر قرار الاحتلال المؤقت للملك العام بمثابة رخصة مؤقتة يمنحها رئيس الجماعة الترابية للمستغل فردا أو شركة بناء على مقرر المجلس ليشغل جزء من الملك العقاري العام الأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية مقابل إتاوة يؤديها لفائدة صندوق تجميع مداخيل الجماعة الترابية ابتداء من تاريخ تبليغه بالرخصة المذكورة[38]، ونظرا لكون الإتاوة ليست مرتبطة بمعايير موضوعية واضحة (كالموقع أو نوع النشاط)، فإن ذلك يؤدي إلى تفاوت غير مبرر بين مستفيد وآخر.
علاوة على ذلك، باستقراء المادة (15)[39] والمادة(16)[40] من القانون رقم (57.19) المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يتضح جليا أن عملية الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية يختلف حسب طبيعة البناء، فبصفة عامة رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام إذا تعلق الأمر بعدم إقامة بناء أما إذا تعلق الأمر بإقامة بناء فبقرار للرئيس بعد مداولات المجلس على اعتبار أنه إذا كان الغرض من الاحتلال المؤقت تجاريا أو صناعيا أو مهنيا، فإن الرئيس يتخذ القرار بعد مزايدة عمومية فلا يكون للمجلس آنذاك سوى المصادقة على دفتر التحملات وتحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة إدارية .
ثم هناك حالة الترخيص بالاحتلال المؤقت بالتراضي بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية[41] في إحدى الحالات التالية[42]:
ـ بعد مزايدتين لم تسفرا عن أي نتيجة.[43]
- لفائدة الملاك المجاورين من أجل ممارسة نشاط لا يعتبر امتدادا للنشاط الرئيسي الذي يزاولونه.
- لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام من أجل إنجاز مشروع يدخل في إطار المهام المسندة اليه.
- لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص معهود له بتدبير مرفق عمومي واستثناء بدون مقابل على وجه السرعة ودون اعتبار مدة معينة إذا تعلق الأمر بتلبية منشآت وبنيات تحتية عسكرية والتي يتم إنجازها لاعتبارات استعجالية وفق متطلبات عملياتية.
ويجوز كذلك منح الترخيص لاحتلال قطع أرضية لازمة لإنجاز الغرض من التدبير المفوض لمرفق عمومي أو منشأة عمومية شريطة ألا تكون هذه القطع الأرضية تابعة للملك العام، هنا يطرح إشكال الترخيص الذي تمنحه الجماعة الترابية كونه عقد يخضع للقانون العام أم للقانون الخاص على اعتبار أن الطرف الثاني للعلاقة التعاقدية قد يكون شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص.[44]
ولذلك اعتبرت المحكمة الإدارية بأكادير في حكم لها[45] بأن عقد الاحتلال المؤقت للملك العام يعتبر حسب ما يتضمنه من نظام قانوني غير مألوف عقدا إداريا حيث جاء في هذا الحكم مايلي:" فالعقد الإداري إذن يمكن أن يبرمه شخص كن أشخاص القانون العام وآخر من أشخاص القانون الخاص قصد تسيير مرفق عمومي أو للقيام بأشغال عامها لتدبير الملك العام أو استغلاله".
بعد تمام إجراءات إصدار قرار بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الصادر بصفة قانونية والمتضمن للبيانات المحددة قانونا[46] يتم تبليغه إلى المعني بالأمر بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية ليبدأ في إنتاج آثار قانونية، حيث يلتزم المرخص له باحتلال الملك العام للجماعات الترابية بأداء مبلغ مالي مقابل ذلك ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الترخيص المتضمن للآجال والمبين كيفيات أدائه وطريقة مراجعته.[47]
أما بخصوص مدة الاحتلال المؤقت بالرجوع إلى القانون (57.19) نجد مقتضياته تنص على أن مدة رخصة الاحتلال المؤقت لا تتعدى عشرة سنوات واستثناء لمدة أقصاها أربعين سنة شريطة إنجاز نشاط يرتبط بمرفق عام لحساب الجماعة الترابية أو تعلق الأمر بمشروع ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصاتها، على اعتبار أنه تمنح رخصة الاحتلال المؤقت دون تحديد المدة في الحالات التالية[48] :
- تهيئة الطرق الرابطة بين ملك مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح به.
- تهيئة ممرات للربط بين قطعتين أو أكثر مملوكة لنفس الشخص.
- ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لري الأملاك الخاصة أو لتصريف المياه عنها.
وتجدر الإشارة أن قرار الترخيص باستغلال الملك العام الجماعي مؤقتا في الحقيقة لا يمنح مراكز قانونية معينة للمرخص لهم، ولا يخول لهم حقوق مكتسبة، والدليل على ذلك هو جواز سحب الرخصة في أي وقت، وحتى قبل نهاية أمدها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبالتالي فوضعية المرخص له في هذه الحالة غير ثابتة على الإطلاق، مما يجعلنا نجزم أن حقوقه باستغلال الملك العام الجماعي هي حقوق مؤقتة ورهينة بتقديرات الإدارة ومقتضيات المصلحة العامة.
ثانيا- حالت سحب رخصة الاحتلال المؤقت
تعطي المادة (23) من قانون رقم (57.19) الحق للجماعة في سحب الرخصة في كل حين مهما كانت مدتها لدواعي المصلحة العامة، إلا أنه من جهة أخرى يجب على الجماعة الترابية أن تعلل سحب قرارها بأسباب موضوعية، وأن تبلغ قرار السحب إلى المرخص له ثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد للسحب.
ويبقى للمرخص له الذي تم سحب رخصة الاحتلال منه حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام للجماعة الترابية دون الأضرار الناتجة عن فقدان الأصل التجاري أو جزء منه أو أي عنصر من عناصره المادية أو المعنوية أو المهنية المرتبطة به؛ على اعتبار أن تحديد التعويض عن الضرر يحدد بواسطة خبرة إدارية، وفي حالة عدم الاتفاق على التعويض يمكن للمعني بالأمر اللجوء عن طريق القضاء الإداري المختص فيتم سحب رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام بحكم القانون وبدون أي تعويض بعد تبليغ إعذار إلى المستفيد من الرخصة، شريطة ألا يتعدى شهرا واحدا لإخلاء العقار[49]، وهذه هي الحالات[50]:
-إذا لم يحترم المستفيد الآجال المحددة في قرار الاحتلال المؤقت للشروع في الأشغال المرخص بها والانتهاء منها، دون عذر مقبول من قبل رئيس المجلس[51].
-إذا تخلى المستفيد للغير عن كل أو بعض الحقوق التي يخولها له قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت.[52]
- إذا خصص المستفيد القطع موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت لاستعمال آخر غير الذي تم الترخيص له به أو أحدث تغييرا في المنشآت المنجزة دون موافقة مسبقة للمجلس.[53]
-إذا لم يقم المستفيد بدفع إتاوة الاحتلال المؤقت عند حلول أجلها.[54]
- إذا صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد من الرخصة.
-إذا لم يحترم المستفيد بنود دفتر التحملات.[55]
وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي أوكل للجماعة الترابية حق مطالبة الأشخاص الذين يحتلون الملك العام التابع لها التوقف عن الاحتلال في الحال عن طريق إعذار، ويكون مدينا للجماعة بتعويض يساوي (5) مرات مبلغ الإتاوة المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني[56]، وإلا تمت متابعته قضائيا على اعتبار إلزامية التعويض تتم عبر أمر يصدره رئيس المجلس بناء على محاضر يحررها موظفون وأعوان محلفون ينتدبهم رئيس المجلس ويكون لهم الحق في الولوج إلى العقار موضوع الاحتلال.[57]
الفقرة الثانية: كراء الملك الخاص الجماعي والوضع رهن الإشارة
من بين آليات تدبير الأملاك الخاصة للجماعات الترابية نجد كراء الملك الخاص الجماعي (أولا)، والوضع رهن الإشارة (ثانيا).
أولاـ كراء الملك الخاص الجماعي
إن عمليات الكراء هي من أهم العمليات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية بهدف استغلال أملاكها العقارية الخاصة بشكل معقلن ومنتج لتحسين مردوديتها وتعزيز مداخيلها الذاتية للمساهمة بكيفية فعالة في ضمان استقلالها المالي ولئن كانت عقود الكراء التي تبرمها الجماعة الترابية في هذا المجال تعتبر من عقود القانون الخاص، إلا أن المشرع أخضعها لقواعد مسطرية خاصة تختلف من نظيرتها التي تخضع لقواعد القانون الخاص حماية للمصلحة العامة.[58]
وهكذا يمكن للجماعات الترابية أن تقوم بكراء أملاكها الخاصة لفائدة الدولة أو مؤسسة عمومية والأشخاص ذاتيين أو معنويين مقابل أداء الوجبة الكرائية وطبقا للمادتين (36) و (37) من القانون رقم (57.19) المتعلق بالمنظومة الجديدة الأملاك الجماعات الترابية، لا يمكن مراجعة الوجيبة الكرائية إلا باتفاق طرفي العقد، و عند عدم حصول الاتفاق تعرض القضية على أنظار القضاء للفصل في النزاع، و هذا ما يستفاد من حكم للمحكمة الإدارية بوجدة[59] و الذي جاء فيه مايلي: " ... وحيث يؤخذ من أوراق الملف و مستنداته و خاصة محضر اجتماع المجلس البلدي العيون سيدي ملوك أن تمت الزيادة في الوجيبة الشهرية للدكان موضوع الدعوى، دونما تبيان المقاييس و المعايير الموضوعية لتلك الزيادة كما هي محددة أعلاه ومن تم يبقى القرار المطعون فيه غير مشروع و الطعن بإلغائه مبرر" ، فالواضح أن غياب نص تنظيمي يحدد مقاييس موحدة لتقييم الوجيبة الكرائية يضعف حماية المال العام، ويجعل الجماعات عرضة لنزاعات متكررة مع المكتريين.
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة عقد الكراء تتم عبر طريقين إما عن طريق المزايدة العمومية أو بالمراضاة كما أنه من حيث مدته الزمنية يمكن أن يكون كراء عاديا أو كراء طويل الأمد.
كما يجدر التنبيه، أن الكراء عن طريق المزايدة العمومية هو المبدأ العام ولا يمكن اللجوء إلى الكراء بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من القانون عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك. وهكذا تقوم الجماعة أو بالأخرى المصلحة المكلفة بالممتلكات بإعداد دفتر التحملات وفق نموذج يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية الذي يحدد على الخصوص الشروط العامة والالتزامات المفروضة على المكري والمكتري وكذا مسطرة إجراء المزايدة العمومية كما يتضمن الثمن الافتتاحي الذي حددته اللجنة الإدارية للخيرة ومقتضيات أخرى وتبعا لذلك يتم عرضه على أنظار أعضاء المجلس للمصادقة عليه.[60]
و هذه الطريقة تنبني أساسا على مبدأ المنافسة، الذي يعد شرطا لحماية المصلحة العمومية للجماعة من كل محاباة أو تفريط في حقوقها، وتأمين أفضل المداخيل، بحكم أن المنافسة في كراء الأملاك الخاصة الجماعية ستدر على مالية الجماعات المعنية أكبر قدر ممكن من المداخيل، غير أن واقع مساهمتها في تمويل الميزانيات المحلية يبقى ضعيفا ودون المستوى المطلوب للرفع من قيمة التمويل الذاتي لميزانيات الجماعات المحلية، ويرجع الأمر في إحدى جوانبه الرئيسية إلى سيادة نوع من الممارسات التي تنقص من القيمة الاقتصادية لهذه الأملاك، وعدم حماية المصلحة العمومية للجماعة[61].
أما بخصوص الكراء بالمراضاة فطبقا لمقتضيات المادة (37) من القانون 57.19، فإن الجماعة الترابية يمكن لها تعود إلى كراء أملاكها الخاصة بالتراضي بناء على دفتر تحملات يحدد نموذجه بقرار مشترك وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية في الحالتين التاليتين:
1 - بعد مزايدتين لم تسفرا عن آية نتيجة دون أن يقل مبلغ الكراء عن الثمن الافتتاحي للمزايدتين طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (36) المتعلقة بالكراء عن طريق المزايدة العمومية.[62]
2 - الكراء لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام لأجل تخصيصها لغرض إداري أو لإنجاز مشروع ذي نفع عام يدخل في إطار المهام المسندة إليه.[63]
من الواضح إذن، أن الجماعات الترابية لا تلجأ إلى التعاقد بالتراضي إلا في هاتين الحالتين الاستثنائيتين الواردتين على سبيل الحصر عندما تقتضي المنفعة العامة ذلك[64]، لكن هذه العائدات تظل دون مستوى التوقعات، بسبب ضعف تقييم الأملاك وتفشي ممارسات تفتقر للحكامة، لذلك يتعين إدراج إلزامية إجراء تقييم دوري للأملاك المكتراة من طرف لجنة مختصة، مع نشر نتائج التقييم.
أما بخصوص المدة الزمنية لعقد الكراء فالمشرع ميز من خلال المادتن (38) و (39) من القانون57.19، بين نوعين من عقود الكراء من حيث مدته الزمنية عقد الكراء الطويل الأمد وعقد الكراء العادي؛ وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة (121) من القانون رقم (39.08)[65] فإن الكراء الطويل الأمد هو الكراء الذي تفوق مدته عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها، ويراد بالكراء العادي الكراء الذي لا تتجاوز مدته عشر سنوات، وتعتبر كذلك عقود كرائية عادية العقود التي أدى تجديدها لمدة تساوي أو تفوق عشر سنوات تطبيقا لأحكام المادة (39) من القانون رقم 57.19.
ثانيا- الوضع رهن الإشارة
إن مسطرة الوضع رهن الإشارة هي مسطرة إدارية تهدف إلى وضع عقارات تابعة للجماعات الترابية رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى أو مؤسسة عمومية من أجل تخصيصها المصلحة عامة تدخل في اختصاص الطرف المستفيد.
وإذا كان وضع أملاك الجماعات الترابية رهن الإشارة يشمل الأشخاص المعنوية العامة قصد استعمالها لفائدة المصالح العمومية التابعة لها بالمجان لمدة محددة بناء على اتفاقية تبرمها الجماعة الترابية المعنية مع الشخص المعنوي العام المستفيد طبق شروط محددة، إلا أنه يلاحظ أن المشرع لم ينص بصريح العبارة على الجمعيات المعترف لها بالمنفعة العامة ضمن المادة (41) من القانون لكي تستفيد من مسطرة وضع رهن الإشارة رغم أنها أسست من أجل خدمة المصلحة العامة[66].
فكان من الأجدر تمكين هذه الجمعيات من الاستفادة من الوضع رهن الإشارة، بما يضمن الرقابة ويحول دون أي استغلال غير مشروع للعقار الجماعي، خاصة مع اشتراط مداولات المجلس والتأشير، فعملية الوضع رهن الإشارة تخضع لمداولات مجلس الجماعة الترابية في إحدى دوراته العادية أو الاستثنائية، ويتخذ مقررا بشأنها مشفوعا باتفاقية الوضع رهن الإشارة تتضمن على الخصوص الشروط التالية [67] :
1 ـ الغرض من الوضع رهن الإشارة.
2 ـ مدة الوضع رهن الإشارة.
3- كل تغيير في غرض الوضع رهن الإشارة يجب أن يكون موضوع اتفاق آخر بين الطرفين المعنيين.[68]
4- استرجاع الجماعة الترابية للعقارات مع البنايات والتحسينات المنجزة مجانا فور انقضاء الغرض الذي خصصت له أو تغييره من طرف المستفيد بدون عرضه على موافقة المجلس.
إضافة إلى مجموعة من الوثائق والبيانات المرفقة بالمقرر ستحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، ثم يعرض ملف العملية العقارية على سلطة المراقبة الإدارية المختصة قصد التأشير عليها من قبل والي الجهة بخصوص مقررات مجلس الجهة ومن قبل عامل العمالة أو الإقليم بخصوص مقررات مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجماعة، وبعد التأشير على مقرر مجلس الجماعة القاضي بوضع رهن الإشارة، يتعين على رئيس المجلس بتنفيذ مقتضياته وذلك بإجراء التدابير الآتية [69]:
1- إبرام اتفاقية وضع رهن الإشارة مع الطرف المستفيد باسم الجماعة الترابية.
2- وضع العقار موضوع رهن الإشارة بيد المستفيد.
3- تدوين عملية رهن الإشارة ضمن سجل محتويات أملاك الجماعة الترابية المعنية بالأمر في الجزء المتعلق بأملاكها الخاصة.
فالواضح أن المشرع المغربي أولى أهمية لهذه الآلية باعتبارها وسيلة لتعبئة الملك الجماعي لفائدة الصالح العام، غير أن المشرع لم ينص على أي مقتضى يلزم الطرف المستفيد من الوضع رهن الإشارة بتحمل المسؤولية عن الأضرار أو الإهمال الذي قد يلحق بالعقار الجماعي أثناء مدة الاستغلال، مما يضعف من ضمانات حماية الملك الجماعي ويجعل الجماعة عاجزة عن المطالبة بالتعويض في حالات سوء الاستعمال.
كما يلاحظ أن عملية التأشير الإداري التي تخضع لها الاتفاقيات لا ترتبط بأجل محدد قانونا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام، خاصة في ظل عدم تقنين الآجال التي يتعين خلالها على سلطة المراقبة الإدارية التأشير أو الرد، مما يستدعي تدخلا تنظيميا لضبط هذه المسطرة وتلافي الإضرار بالنجاعة والفعالية في تدبير أملاك الجماعة.
خاتمة
على مدار هذه الدراسة، حاولنا الوقوف عند مدى فعالية القانون 57.19 في تدبير جيد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، وبقراءة القانون رقم 57.19 يتضح أن مقتضياته أكثر تنظيما وتدقيقا لاختصاصات المجلس الجماعي ورئيسه في الجانب المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية، غير أن النهوض بالتنمية المحلية لا يأتي بالتعديلات القانونية وإسناد اختصاصات واسعة للجماعات الترابية، وإنما يتطلب من أجل ذلك وضع حد لضعف المستوى العلمي والثقافي لمعظم المنتخبين الجماعيين، كون ذلك ينعكس سلبا على دورهم ومكانتهم داخل الجماعات الترابية، كون إنعدام الوعي لدى كثير من الجماعات الترابية بالأهمية والقيمة الاقتصادية لهذه الأملاك، وما تتيحه من فرص وإمكانيات تمويلية ذاتية ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويجعل تدبيرها مخل بالمصالح الاقتصادية للجماعات.
ومن أجل ذلك نقترح بعض المقترحات التالية:
- التأطير الإداري:
- ضرورة التأطير الإداري والقانوني للأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات الترابية.
- إخضاع المنتخبين المحليين لدورات تدريبية إجبارية حول تسيير الأملاك الجماعية، باعتبار أن ضعف كفاءتهم يشكل الخطر الأكبر على الملك العام.
- تحسين نظم المعلومات والشفافية:
- اعتماد المعلوميات في تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، لتوفير إحصاءات دقيقة للرصد العقاري وتحديد الحاجيات المستقبلية.
- التنصيص صراحة على إلزامية نشر سجل المحتويات العقارية والتراخيص المؤقتة على البوابة الإلكترونية للجماعات.
- إلزام الجماعات بنشر لائحة العقارات المكتراة أو الموضوعة رهن الإشارة في بوابة وطنية موحدة.
- اعتماد رقمنة كاملة لعمليات الكراء والمزايدة وربطها بمنصة وطنية للشفافية.
- التنصيص على إلزامية نشر جميع قرارات التفويت والرخص العقارية على بوابة إلكترونية وطنية لضمان الشفافية وتمكين المجتمع المدني من التتبع.
- مراجعة نظام الرسوم والواجبات الكرائية:
- إعادة النظر في الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك المحلي العمومي، مع مراعاة الموقع والأهمية التجارية والاقتصادية للمشروع.
- ملائمة الأثمنة والتسعيرات لقيمة العقارات المكتراة.
- ربط قيمة الإتاوة بمعايير موضوعية كالموقع، نوع النشاط، مدة الاستغلال، وذلك بموجب نص تنظيمي موحد.
- ضرورة إصدار مرسوم تطبيقي يحدد معايير مراجعة الوجيبة الكرائية وربطها بمؤشرات السوق العقارية الجهوية.
- تنظيم وتوزيع الصلاحيات والرقابة:
- إعادة النظر في بعض الصلاحيات المنفردة لرئيس الجماعة، خاصة المتعلقة بدراسة التعرضات وإخراج الملك العام، بجعلها موضوع تداول إلزامي.
- إحداث هيئة مستقلة للمراقبة العقارية تابعة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات تتولى مراقبة صفقات التفويت والاقتناء.
- إحداث لجنة محلية مستقلة لتقييم طلبات الترخيص والسحب، تتضمن ممثلين عن وزارة الداخلية والمالية لضمان الحياد.
- إحداث تصنيف للقرارات حسب الأثر المالي، مع إعفاء القرارات ذات الأثر المالي البسيط من التأشير المسبق.
- تحديد أجل تأشير أقصر للقرارات المستعجلة مثل رخص الاستغلال المؤقت.
- إقرار إمكانية الطعن في تقاعس سلطة الرقابة أمام المحكمة الإدارية من قبل الجماعة حماية لاستقلاليتها.
- تطوير وضعية عقود الوضع رهن الإشارة:
- إدراج الجمعيات ذات المنفعة العامة ضمن المستفيدين من الوضع رهن الإشارة، مع اشتراط المراقبة القبلية والبعدية.
- إقرار غرامات أو تعويضات مالية عند إخلال المستفيد من الوضع رهن الإشارة بشروط العقد.
- تفعيل لجان المراقبة الدورية لتقييم حسن استغلال الأملاك الجماعية الموضوعة رهن الإشارة أو المكتراة.
- إخضاع الغرامات الناتجة عن الاحتلال غير القانوني لمسطرة مراقبة داخلية لضمان عدم تعسف الرئيس في تقديرها.
قائمة المراجع
المراجع العامة:
- إدريس الفاخوري، الوسيط في نظام التحفيظ العقاري بالمغرب- دراسة لنظام التحفيظ العقاري والفقه الاداري والعمل القضائي، الطبعة الرابعة 2020، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء.
- محمد خيري: قضايا التحفيظ لعقاري في التشريع المغربي: المساطر الإدارية والقضائية، دار النشر المعرفة بالرباط، الطبعة الخامسة 2009.
- محمود شوراق: النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط 2022.
- محمد حيمود، مالية الجماعات الترابية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2017.
- رجاء كاون، تدبير وحماية الممتلكات العقارية للجماعات بين الواقع والإكراه، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص، مسلك قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي: 2016/2017.
- ثورية الهورش،" حماية الممتلكات العقارية للجماعات الحضرية بين النص القانوني والتدبير العملي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الدولة والجماعات المحلية والديمقراطية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية: 2009/2010.
- أحمد بوسيدي، حماية الأملاك العامة للجماعات الترابية، أعمال الندوة العلمية الثانية: " العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب"، منشورات المنبر القانوني.
- محمد الزويري، تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية على ضوء القانون الجديد 57.19، مقال منشور بموقع مجلة القانون والاعمال الدولية.
- مريم زان، الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات قانون رقم 57.19، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية، العدد25/2023.
- يوسف حسني، الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 13، 2022.
- عماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابية و متطلبات الملائمة، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، ط.الأولى .
[2]محمود شوراق: النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، 2022، ص:24.
[3]ـ ظهير شريف رقم 1.21.158 صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 57.17 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7006، بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص: 5661.
[4]- أحمد بوسيدي، حماية الأملاك العامة للجماعات الترابية، أعمال الندوة العلمية الثانية: " العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب"، منشورات المنبر القانوني، ص: 159.
[5]- ميلود بوخال، الممتلكات الجماعية: نظامها القانوني وتدبيرها، بحث لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة، الرباط،1985، ص: 9. أورده أحمد بوسيدي، م.س، ص: 159.
[6]- محمد خيري: قضايا التحفيظ التحفيظ العقاري في التشريع المغربي: المساطر الإدارية والقضائية، دار النشر المعرفة بالرباط، الطبعة الخامسة، 2009، ص: 71.
[7]ـ ظهير شريف بتاريخ 24 صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) يتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 299 بتاريخ 17 ربيع الثاني (20 يناير 1919) ص:34.
[8]ـ الظهير الشريف الصادر في 17من صفر 1340 (19 أكتوبر 1921) المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 446 بتاريçخ 14 ربيع الأول 1340 (10 نونبر 1921) ص:1024.
[9]ـ الضهير الشريف الصادر في 22 محرم 1369 (14 نونبر 1949)، في شان منح بعض الرخص في أشغال الملك العمومي البلدي، الجريدة الرسمية عدد 1937 بتاريخ 17صفر 1369 (9 دجنبر 1949) ص: 2195.
[10]ـ الظهير الشريف الصادر في 26 من شوال 1373 (28 من يونيو 1954) بشأن أملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره، الجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ 14 ذو القعدة 1373(16يوليوز 1954) ص: 2027.
[11]ـ الظهير الشريف رقم 1.62.308 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1383 (7 سبتمبر 1963) يتعلق بالإذن في التخلي للجماعات القروية بدون عوض عن قطع أرض مخزنية لازمة لبناء "دور جماعية "، الجريدة الرسمية عدد 2656 بتاريخ 1 جمادى الأولى 1383 (20 شتنبر 1963) ص: 2190.
[12]- ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432(30 يوليو 2011) ص: 3600.
[13]- مريم زان، الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات قانون رقم 57.19، مقال منشور بمجلة دفاتر قانونية، العدد25/2023، ص: 51.
[14] - ظهير شريف رقم 1.21.74 صادر في 3 ذي الحجة (14يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 7006 - 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021) ص:5654.
[15]- تنص المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14: "يحدث مجلس الجماعة ...، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية: - الميزانية والشؤون المالية والخدمات..."
[16]- رجاء كاون، تدبير وحماية الممتلكات العقارية للجماعات بين الواقع والإكراه، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون الخاص شعبة قانون العقار والعقود، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية وجدة،2016.2017، ص10.
[17]- محمود شوراق، النظام الجديد لأملاك الجماعات الترابية، دار القلم، الرباط، طبعة 2022، ص: 205.
[18]- محمد حيمود، مالية الجماعات الترابية، م، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الأولى 2017، ص:55
[19]- نصت المادة 94 من القانون التنظيمي في بندها التاسع بقولها: " يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص".
[20]- رجاء كاون م.س، ص 14.
[21]- تنص المادة 3 من قانون 57.19 على أنه: "يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف..."
[22]- المادة 7 من القانون رقم 57.19.
[23]- جاء في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون 57.19 ما يلي: " يمكن لكل ذي مصلحة أن يتقدم بملاحظاته وتعرضاته على قرار التحديد ...تتم دراسة الملاحظات والتعرضات السالفة الذكر من طرف رئيس مجلس الجماعة الترابية..."
[24]- المادتين 15 و16من القانون رقم 57.19.
[25]- المادة 11 من القانون رقم 57.19.
[26]- القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.92.31 في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1459 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليوز1992)، ص:887. كما تم تعديله بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات في مجال التعمير والبناء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريق رقم 1.16.124، الصادر في 12 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1737 (19 سبتمبر 2019)، ص: 6630.
[27]- محمود شوراق، م.س، ص 77.
[28]- الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 57.19.
[29]ـــ يوسف حسني، الجماعات الترابية وسؤال التنمية بالمغرب، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 13، 2022، ص: 447.
[30]- ثورية الهورش،" حماية الممتلكات العقارية للجماعات الحضرية بين النص القانوني والتدبير العملي" رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الدولة والجماعات المحلية والديمقراطية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص 44.
[31] - وفي هذا الصدد تنص الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 57.19 على ما يلي: " يتولى رئيس مجلس الجماعة الترابية مسك سجل المحتويات وتحيينه، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ عليه خلال الدورة العادية الأولى التي يعقدها المجلس كل سنة. ويقوم رئيس المجلس بنشر السجل المحين بوسائل الإشهار الملائمة، ولا سيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية كما يبلغ نسخة منه إلى المحاسب المكلف".
[32]-رجاء كاون، م.س، ص: 16.
[33]- ثورية الهروش، م.س، ص: 46.
[34]- محمد شوراق، م.س، ص: 100.
[35]- عماد أبركان، نظام الرقابة على الجماعات الترابية و متطلبات الملائمة، منشورات مجلة العلوم القانونية، سلسلة البحث الأكاديمي، ط.الأولى، ص: 52.
[36]- رجاء كاون، م.س، ص 18.
[37]- جاء في المادة 47 من قانون 57.19 مايلي:" تخضع مقررات مجالس الجماعات الترابية المتخذة طبقا لأحكام هذا القانون للتأشير عليها، حسب الحالة، من قبل والى الجهة أو الإقليم أو الجماعة ..."
[38]- محمود شوراق، م.س، ص: 103.
[39]- ينص الفصل 15 من القانون 57.19 على أنه: "يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء بموجب قرار تنظيمي لرئيس مجلس الجماعة الترابية يتخد بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية ..."
[40]- ينص الفصل 16 من القانون 57.19 على أنه: " يرخص بالاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بموجب قرار لرئيس مجلس الجماعة الترابية يتخذ بعد مداولات المجلس".
[41]- صدر في هذا الشأن قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2658.22 صادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022)، بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال املاكها الخاصة، بالجريدة الرسمية عدد 7168، بتاريخ 18 رجب 1444(9 فبراير 2023) ص:1261.
[42]- المادة 17 من القانون رقم 57.19
[43]- صدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر2022) بتحديد كيفيات وإجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة. نشر بالجريدة الرسمية عدد 7168، بتاريخ 18 رجب 1444(9 فبراير 2023) ص: 1239.
[44]ـ محمد الزويري، تدبير الأملاك العامة للجماعات الترابية على ضوء القانون الجديد 57.19، مقال منشور بموقع مجلة القانون والاعمال الدولية، تاريخ الإطلاع: 25/12/2024.
[45]- حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 124 الصادر بتاريخ 13-05-1999، في الملف عدد 276/19997، أورده حمد الزويري، م.س، تاريخ الاطلاع: 07/09/2024.
[46]- انظر المادة 22 من القانون 57.19.
[47] - المادة 21من القانون 57.19.
[48]- أنظر المادة 20 من القانون 57.19.
[49]- محمد الزويري، م س، تاريخ الولوج: 25/12/2024.
[50]- المادة 24 من القانون رقم 57.19.
[51]ـ البند الأول من المادة 24 من القانون رقم 57.19.
[52]ـ البند الثاني من المادة 24 من القانون رقم 57.19.
[53]ـ البند الثالث من المادة 24 من القانون رقم 57.19.
[54]ـ البند الرابع من المادة 24 من القانون رقم 57.1.
[55]ـ البند الخامس من المادة 24 من القانون رقم 57.19.
[56]- المادة 27 من القانون رقم 57.19.
[57]- محمد الزويري، م.س. تاريخ الولوج: 25/12/2023.
[58]- محمود شوراق، م.س، ص: 222.
[59] ـ المحكمة الإدارية بوجدة، حكم عدد 289، صادر بتاريخ 2000/11/15، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 40 شتنبر - أكتوبر 2001 ص: 198.
[60]ـ محمود شوراق، م.س ص: من 222 إلى 225.
[61]ـ رجاء كاون، م.س، ص: 76.
[62]- الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون 57.19
[63]- الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون 57.19.
[64]ـ مجمود شوراق، م.س: ص 223.
[65]- ظهير شريف رقم 1.11.178، صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22) نوفمبر (2011) بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص: 5587.
[66]- محمود شوراق، م.س، ص: 227.
[67]- المادة 41 من القانون 57.19.
[68]- محمود شوراق، م.س،ص: 227.
[69]- محمود شوراق، م.س، ص: 228.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 واقع وتحديات تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية في ضوء القانون رقم: 57.19
واقع وتحديات تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية في ضوء القانون رقم: 57.19