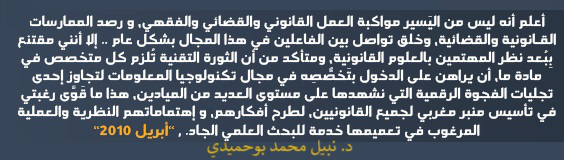تمر المنطقة العربية بمرحلة شديدة الحساسية، وذلك راجع إلى التحولات التي عرفتها منذ اندلاع ما نعت بالربيع العربي الذي ابتدأ بالثورة التونسية. وكان لسقوط النظام المصري دور كبير في إعطاء زخم لهذه الثورات -نظرا لموقع مصر في المنطقة العربية –حيث وصل امتدادها إلى أغلب دول المنطقة طبعا مع اختلاف في مستويات وأشكال التحركات والاتجاه الذي سارت فيه الأحداث.
فإذا كانت في كل من تونس ومصر مرت نوعا ما بأقل الخسائر، فإنها في البحرين واليمن وسوريا وبالخصوص في ليبيا أخذت منحى مغايرا وأكثر دموية، مما عجل بالحديث مرة أخرى عن فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، خصوصا وأن المنطقة العربية معينة بشكل أخص نظرا لموقعها الجيوسياسي.
بالرغم من كون التدخل يشكل انتهاكا لمبادئ أساسية في العلاقات الدولية، ومسارا لتحقيق أغراض مشبوهة، فإن الضمير الإنساني لا يمكنه أن يتحمل مشاهد مؤلمة لانتهاكات الحقوق والأعراف الدولية دون أن يتحرك، فكلما وقعت هذه الانتهاكات إلا وأصبحت المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، فيما يعرف بمسؤولية الحماية.
هذه الفكرة ظهرت على إثر دعوة رئيس وزراء الكندي في سنة 2000 جون كريتيان في مؤتمر الألفية عن إنشاء لجنة دولية معينة بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي يقوم على أساس التوفيق بين واجب تدخل المجتمع الدولي الذي يتحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول، وفي سنة 2001 انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول "مسؤولية الحماية"
ولمحاولة إبراز هذه الفكرة – مسؤولية الحماية - لابد من تحديد مفهوم التدخل الإنساني وبروز فكرة مسؤولية الحماية (أولا) ثم تحديد المبادئ المحددة لهذه المسؤولية(ثانيا).
أولا: من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية.
يثير التدخل الإنسانية جدلا قانونيا لكونه ينطوي على انتهاكا صريحا للحقوق والأعراف، لكن مع ازدياد مكانة الفرد ضمن المجال الدولي ظهرت فكرة مسؤولية الحماية.
أ- التدخل من أجل الإنسانية.
التدخل الإنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية، فالمعاهدات الدولية الأولى التي عرفت في تاريخ البشرية ترجع إلى عام 1978 ق.م، بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين، والتي تؤكد على البعد التاريخي لهذه الظاهرة كما تؤكد على حقيقة أخلاقية وإنسانية تحكم العلاقات الدولية وتهدف إلى تقديس حياة الإنسان وحمايتها في أوقات السلم والحرب.
وعلى الرغم من قدم الظاهرة، فإن مصدر وتصور فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، متعلق إلى حد كبير بتاريخ ما يسمى بقضية الشرق
La question d’orient
، فترقبا لكل إفراط من طرف الحكومة العثمانية ضد المسيحيين المقيمين بالإمبراطورية، قامت الدبلوماسية الغربية بوضع أسس شبه قانونية للتدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية.
أما على مستوى الفقه فإن كتاب مثل غروسيوس وڤاتيل اعتبروا هذا التدخل عملا مشروعا وفق القانون الدولي، بالإضافة إلى الأستاذ روجيه الذي دافع عن حق التدخل الذي بموجبه يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول التدخل دفاعا عن الإنسانية في شؤون دول أخرى إذا وقع منها اضطهاد صارخ لأقلية أو أشخاص يقيمون في إقليمها، ومن بين التعريفات التي أعطها الفقه لهذه الظاهرة نجدالتعريف التالي: "نظرية التدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية هي تلك النظرية التي تضع بمثابة قانون، حق المراقبة الدولية للسيادة الداخلية لدولة ما والتي تعتبرها هذه الدول مخالفة لقواعد الإنسانية، وتزعم تنظيمها من الناحية القانونية. وتبعا لهذه النظرية، كلما مست حكومة ما بالحقوق الإنسانية لشعبها، يمكن لدولة أو لجماعة من الدول أن تتدخل لإلغاء الأعمال الحكومية المنتقد، أو لمنح حدوث مثل هذه الأعمال في المستقبل، وعلى كل حال، إحلال سيادتها محل سيادة الدولة المراقبة بهذه الصفة" ويمكن القول بأن هذه النظرية المرتكزة على قوانين إنسانية مزعومة، أخذت كأسس لها طريقة معينة ومتميزة في فهم وتصور العلاقات الدولية طريقة أتى بها
Lorimer
، فهذا الكاتب يميز بين الدول "الهمجية" والدول شبه المتحضرة، ثم الدول المتحضرة، وبالطبع تعتبر دول أوروبا مهدا للحضارة بالامتياز،وفي سياق هذا الطرح يحق قانونيا لكل دولة من الدول المتحضرة أن تقوم بالمهمة المثلى، وفي حمل الرسالة الحضارية إلى البلدان الهمجية.
لكن هذه النظرية تفتقر إلى الأسس القانونية، وهذا ما يجعلها أداة فقط، لسياسة الدول العظمى، وفي كل الأحوال، فهي تتناقض مع القانون الدولي، فعامل الإنسانية أو القوانين الإنسانية لم تستطع الدول إبرازها على شكل قاعدة قانونية عامة ومجردة، بل وعلى العكس، فقد رفضت المدرسة الإيطالية للقانون هذه النظرية، باعتبارمبدأ استقلال الدول وعدم التدخل و الأصل.
والواقع أن هذه النظرية برزت منذ القرن التاسع عشر كتكريس لعدم المساواة بين الدول أو على الأصح بين الدول الأوروبية التي كانت تتوفر على وسائل التدخل، وباقي الدول. فما دام المجال مفتوح أمام الدول القوية لتقرير التدخل، في غياب أية قاعدة قانونية معترف بها، فلن تتدخل إلا طبقا لمصالحها الخاص. وعلى الرغم من المعارضات التي رافقت مسيرة هذه النظرية منذ ولادتها، فبعض الدول مازالت وإلى حد الساعة، تبحث عن إمكانية إقحامها في إطار القانون الدولي، بنعتها بتسميات مختلفة.
القانون الدولي المعاصر لا يستسيغ فكرة التدخل الإنساني، لأنها تشكل محاولة لبعث الاتجاه الاستعماري القديم الذي يبيح التدخل لعوامل إنسانية في الظاهر، ولكن القصد الحقيقي منها هو فرض الهيمنة الاستعمارية على دول الجنوب التي لم يكن يسمح لها بالاستفادة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثم إن حق التدخل لا يأخذ التحولات الجذرية التي عرفها القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص تصفية الاستعمار وانتهاء العمل بتقسيم الدول الغربية.
إن تتبع التسلسل التاريخي لحالات التدخل الإنساني يكشف بوضوح أن التدخل يعد دليلا على قوة الدولة التي تهدف إلى توفير مسوغ أخلاقي عند عدم وجود مسوغ قانوني يمكن بموجبه استخدام القوة في العلاقات الدولية. لذلك كان التدخل الإنساني الذي يتم بحجة حماية الأقليات الدينية والعرقية أو حماية حقوق الإنسان من اضطهاد السلطة الوطنية، ظاهريا يخفي الدوافع السياسية والتوسعية للدولة المتدخلة، ولذلك جاءت ممارسة التدخل الإنساني متوافقة وإرادة الدولة الحامية.
التطورات السريعة والعميقة التي عرفها المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة عمقت من نوع التعقد الذي يحدد تعامل القانوني الدولي مع الإنسان كفرد، والذي أصبح بموجبه من مجرد هدف لقاعدة قانونية إلى رعية ضمن المجتمع الدولي.
ب - موقع الفرد في القانون الدولي.
يحتل موقع الفرد في القانون الدولي الكثير من الغموض، كما تختلف آراء الفقهاء القانونيين حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ما بين مؤيد ومعارض ولذلك برزت ثلات نظريات لتحديد ذلك المكان الذي يشغله الفرد في القانون الدولي.
النظرية الوضعية ترى أن القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول، حين تتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولية، نظرا إلى قدرتها على إيجاد قواعد قانونية دولية، أما الفرد فلا تعده شخصا دوليا لأنه لا يتمتع بالسيادة، ومن ثم فهو لا يتمتع بالقدرة على إيجاد القواعد القانونية الدولية، ولذلك لا تنطبق عليه قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها، وضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الإيطالي دينيسو أنزيلوتي، ومازال الفقه التقليدي الدولي بأخذ بهذا الرأي.
أما النظرية الموضوعية "الواقعية" فتعد الفرد الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا، لأن القانون يتوجه في نهاية الأمر إلى الأفراد حكاما أو محكومين، ما دام هؤلاء هم الوحيدين الذين يتمتعون بالذكاء والإرادة. فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ومصالح الجماعة التي تتكون من أفراد، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي فقط، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سيل.
وتتوسط النظرية الحديثة النظريتين السابقتين، حيث هذا الفرد المستفيد النهائي من أحكام القانون الدولي. فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي رفاهية الفرد وسعادته، وقد يخاطب القانون الدولي الأفراد خطابا مباشرا بأن يكونوا موضوعا لبعض قواعده، ولذا تنشأ لهم حقوق بالمعنى الصحيح، ويلزمون بسلوك معين يترتب على مخالفته تعرضهم للجزاء، لذلك ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي، على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة، ولا يمارسها بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية النادرة، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام، هو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر.
ويرجع الجدل الفقهي حول مركز الفرد في القانون الدولي إلى أن المعاهدات الدولية تقرر حقوقا للأفراد، لكنهم لا يستطيعون وحدهم اتخاذ خطوات إيجابية للحصول عليها، لأن حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي تتم عن طريق الدول التي ينتمون إليها. وهكذا يجب الرجوع إلى كل معاهدة دولية لتحديد إذا ما كانت تعد الفرد شخصا دوليا من دون أن تطالبه باتخاذ أي خطوات إجرائية لإثبات هذا الوصف أو لاتعده كذلك طبقا لنصها. وفي العادة لا تقرر الاتفاقيات الدولية لحماية الأفراد حقوقا مباشرة لهم، وإنما ترتب حقوقا والتزامات تقع على عاتق الأطراف فيها، أي إن الدول هي التي تحمى هذه الحقوق لمواطنيها، كما أن الحقوق الدولية لا تصبح نافذة في إطار القانون الداخلي إلا وفقا لقواعد نفاذ المعاهدات داخل الدولة، وهو ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في القضية المتعلقة باختصاص محاكم دانزج .
ولقد شكلت محاكم نورمبرج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، حيث تمت معاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد الإنسانية أو جرائم حرب أمام محكمة عسكرية دولية. وقد استنتجت لجنة القانون الدولي من الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة مبادئ منها الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي، حيث رفضت المحكمة الاعتراض القاضي بأن القانون الدولي يحكم أعمال الدول ذات السيادة فقط ولا شأن له بمعاقبة الأفراد، خصوصا أن جرائمهم المرتكبة تعد من أعمال الدولة، فالدولة لذلك تحميهم من المسؤولية الشخصية. وقد ردت المحكمة على هذين الادعاءين بأن القانون الدولي يفرض واجبات ومسؤوليات على الدول والأفراد، وهذا متفق عليه منذ زمن بعيد .
ارتبطت أهم التطورات التي عرفها المجتمع الدولي بتعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وبتراجع مفهوم السيادة من صبغته المطلقة إلى النسبية، وتوسع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي، فحقوق الكائن الإنساني أصبحت تعبر الحدود الوطنية لتناقش ضمن المجال الدولي، وهو تطورا انطلاق مع إنشاء الأمم المتحدة وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة والطفل ومناهظة التعذيب ... إلخ.
إن التناقض الصارخ بين المجال السيادي للدولة والمجال الدولي بات من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين مختلف المعنيين بحقوق المشترك للإنسانية، ونتيجة لهذا الجدل ظهرت فكرة مسؤولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني.
ج- مسؤولية الحماية.
مفهوم مسؤولية الحماية ليس ببعيد عن مفهوم التدخل الإنساني، فهو يقوم على أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه الأخطار وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الدولية، وقد أثار هذا المفهوم جدلا واسعا سواء في حدوثه كما هو الحال في البوسنة والصومال وكوسوفا أو في عدم حدوثه كما هو الحال في رواندة.
ففي الفترة ما بين 1992 و 1993 فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والسلام إلى نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والاستخدام المفرض للقوة العسكرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انسحاب الأمم المتحدة، أما في إقليم كوسوفو فقد أثار تدخل حلف شمال الأطلسي سنة 1999 جدلا عنيف حول شرعيته، فقد اعتبر هذا التدخل بمثابة تجسيد للعولمة على صعيد العلاقات غير الودية والمتمثلة في اللجوء إلى استخدام القوة عبر تدخل عسكري جماعي بدعوى حماية الإنسانية، بعدما كانت العولمة محصورة في نطاق العلاقات السلمية فيما بين الدول ولاسيما وانه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن .
إن القراءة المتأنية للقرارات الصادرة عن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن تظهر أن الأمم المتحدة ظلت تعاني عبر تلك القرارات من مشكلة المواءمة بين الحق السيادي للدولة وحق المجتمع الدولي المرتبط بصياغة ضوابط القانون الدولي الإنساني .
ففكرة تدخل المجتمع الدولي بدأت تلقى قبولا واسعا في حالة عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في حماية مواطنيها بحيث تنتقل المهمة إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
بمعنى أنه ينبغي على الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة عن طريق مجلس الأمن ووفقا للميثاق، ففي هذه الحالة يتنحى مبدأ عدم التدخل لصالح المسؤولية الدولية للحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي وفق مجموعة من المبادئ من بينها
+ مبدأ السيادة.
السيادة تعنى الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهي تفيد واقعا سياسيا معينا وهو القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها، أي القدرة على الاحتكار الشرعي لأدوات العنف في الداخل، وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج، وهو مفهوم يوفر الاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قواتها أو حجمها أو ثرواتها واعترافا بهذا أنشئ هذا المبدأ بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة .
فالدولة كشخص متمتع بالسيادة تلتزم بالعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل، وعادة ما تكون الدولة مضطرة بمقتضى التزامها إلى التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانت تندرج ضمن المجال المحفوظ، لفائدة مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية. وهي في هذه الممارسة لا تنقص في الواقع من سيادتها بقدر ما تعبر عن تلك السيادة، إن السيادة الدولة لم تعد ذات صبغة مطلقة بل أصبحت تتعرض تدريجيا للتقليص مما دفع البعض إلى وضعها في موقع المواجهة المباشرة مع حقوق المجتمع الإنساني وذلك عن طريق التبشير بشعار "إن الإنسانية ينبغي أن تتفوق على السيادة" بمعنى إعادة تصنيف مفهومها من السيادة كسيطرة إلى السيادة كمسؤولية، سواء في الوظائف الداخلية للدولة أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسؤولية يلقى اعترافا متزايدا في ممارسة الدولة. بحيث يترتب عنها مسؤولية للدولة على سلامة مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة.
+ مسؤولية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين.
الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة " حيث يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة "، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، و الواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعبق بمجال حقوق الإنسان.
وثمة إستثناء مهم على مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من الميثاق تعهد إلى المجلس الأمن دورا رئيسا في حفظ الأمن و السلم الدوليين، وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السليمة في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسؤولية ورد في الفصل السابع الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا النص المادة 39 من الميثاق" ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان " هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر و الجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية فله أن يلجأ إلى استخدام القوى العسكرية و ما يلزم من الأعمال لحفظ السلم و الأمن، و الجدير بالذكر أن الفصل الثامن يعترف بوجود دور للمناطق الإقليمية في حفظ الأمن و السلم الدولتين. و لكنه ينص صراحة في المادة 53 على أن التنظيمات و الوكالات نفسها لا يجوز بمقتضاه أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، للإشارة فإن المادة العاشرة من الميثاق تعطي للجمعية العامة مسؤولية عامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة كما أن المادة الحادي عشر تخول الجمعية العامة مسؤولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين و لكنها مسؤولية تقتصر على تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة شريطة أن لا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعينة في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق.
ترتكز سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسلم و الأمن على دورها في تطبيق الشرعة لا على استخدام القوة الجبرية و يعتبر مفهوم الشرعية
« l’égalité »
بمثابة همزة وصل بين ممارسة الأمم المتحدة لسلطاتها في حفظ الأمن و بين اللجوء إلى استخدام القوة، حيث يعتبر التدخل الجماعي عملا شرعيا لأنه مؤذون به من قبل هيئة دولية تمثيلية، في حين ينظر إلى التدخل الفردي على أنه غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة الذاتية.
فمن بين أهم المنجزات التي تحققت بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية هو اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقوق الإنسان و تعزيزها، تتمثل في الإعلان العالمي حقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، الذي يضم التوافق السياسي و التركيب القانوني لهذه الحقوق، بالإضافة للعهدين المعتمدين في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية و الاجتماعية، فقد أصبحت هذه الحقوق مبدأ أساسيا من مبادئ العلاقات الدولية، ومن ثم وقع تحول من ثقافة الحضانة السياسية إلى ثقافة المسائلة الوطنية ثم الدولية، فالمنظمات الدولية و المجتمع الدولي و المنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية و النصوص الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها مرجعا مهما تحكم بموجبه على سلوك الدول.
وقد أدى هذا التقدم في مجال حقوق الإنسان إلى زيادة تطوير القانون الدولي الإنساني و اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن لهذه المسؤولية عناصر محددة وناظمة لها.
ثانيا : المبادئ المحددة لمسؤولية الحماية.
المبادئ الناظمة لمسؤولية الحماية تبدأ بمستوى معالجة الأسباب الجدرية للصراع الداخلي مرورا بالمستوى الثاني المتمثل في الرد، لتصل إلى المستوى الأخيرة المتمثل في مسؤولية إعادة البناء و المتابع.
أ – معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي.
تعترف المادة 55 من الميثاق صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و تعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة و التعليم و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تهيئة دواعي الاستقرار و الرفاهية لقيام علاقات سلمية بين الأمم، إلا أنه لا يوجد اتفاق على تحديد الأسباب المباشرة للصراع، إلا أن هناك اعترافا متزايدا على أنه لا يمكن فهم الصراعات المسجلة دون الإشارة إلى السباب الجذرية كالفقر والقمع السياسي وغيرها من الأسباب الإجتماعية والسياسية زيادة على أنه هناك تدابير يمكن أن تعالج الأٍسباب المباشرة للنزاع ومن بينها
1-
التدابير السياسية و التي تتحدد في التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، و تداول السلطة وتأييد الحريات وسيادة القانون كما تشمل التدابير الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة و المساعي الحميدة و بعثات تقصى الحقائق.
2-
التدابير الاقتصادية التي تتمثل في تقديم مساعدة إنمائية لمواجهة النقص في توزيع الموارد ودعم النمو الاقتصادية كما تشمل تمويل الاستثمارات و الدخول في معاملة تجارية أكثر يسر، وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات تجارية و مالية، و سحب كافة أنواع الدعم.
3-
التدابير القانونية وتشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون واستغلال القضاء و تنفيذ القوانين، واللجوء للتحكيم وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافر لدى كل الأطراف.
4-
التدابير العسكرية و تشمل إصلاح المؤسسات العسكرية و الأمنية و ضمان عملها في إطار القانون، وعلى المستوى الدولي يمكن اتخاد تدابير عسكرية كالانتشار الوقائي لقوات الأمم المتحدة
ب – مسؤولية الرد .
هذه المسؤولية تشمل على عدة تدابير منها
اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كخطوة مهمة وغير مسبوقة على ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم و جديد للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكاتهم لقواعد القانون الدولي الانساني و القانون الدولي الحقوق الإنسان.
و تعني هذه الأخيرة ان هناك ولاية قضائية على سلسلة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و جرائم الحرب بالرغم مما آثارته من جدل حول المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه لتحديد جرائم الحرب، بالإضافة إلى جريمة الأبادة الجماعية و جريمة العدوان.
التدابير الجبرية دون القوة العسكرية و التي تعوق قدرة الدولة في التعامل مع العالم الخارجي، و لكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وهذه التدابير و الإجراءات الجبرية أفضل من استخدام القوة إلا أنها مشوبة احيانا بعيب في تطبيقها. فهي غالبا لا تميز بين المذنب و البرئ، ويمكن أن تحدث أضرارا أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لاسيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة نتيجة لتعرض المدنيين لأضرار تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيقها .
في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات و المنظمات الأمنية المسؤولة عن كل من إنتهاكات جسمية لحقوق الإنسان كبديل عن الجزاءات العامة، وقد يستثنى كل من المواد الغدائية و اللوازم الطبية من هذه الجزاءات وقد تركز الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحاب القرار و ذلك في المجالات التالية
+ المجال العسكري من خلال وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن و المجتمع الدولي.
+ المجال الاقتصادي من خلال فرض جزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما او لمنظمة الاهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية و المنتجات النفطية.
+ المجال الدبلوماسي من خلال فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي ، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية.
+ أما اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات لاستثنائية أو حالة عدم فاعلية الجزاءات ، يصطدم بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة على نظام الدول ذات السيادة و قاعدة عدم التدخل تشجع الدول على حل مشاكلها الداخلية بنفسها على النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلى الحد الذي يهدد الأمن و السلم الدوليين.
+ لكن في ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ على النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الداخلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق.وقد استقر الرأي على أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تشكل خطرا واضحا على الأمن و السلم الدولتين و تهز الضمير الإنساني، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا.
لكن وفق مجموعة من المعايير التي ينبغي التحقيق منها قبل اتخاذ قرار التدخل ومنها:
الإذن : أي أن يأذن مجلس الأمن للقيام بتدخل عسكري، أو أن يطلبوا من الأمين العام الأمم المتحدة أن يشير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
عدالة القضية : التدخل العسكري ، كتدبير استثنائي يجب تبريره بالخطر المحدق بالمدنيين و الذي يؤدي إلى خطر لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشى وقوعها.
النية الصحيحة : أي بعدا استنفاد كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة، ووجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح.
التناسب : يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له وموته و شدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هدف الحماية الإنسانية.
وتأسيسا على ما سبق وجب التقيد بهذه المعايير السالفة حتى يمكن إضفاء نوع من المشروعية لهذا التدخل الإنساني إلا أن هذا غير كافي فهناك مسؤولية أخرى تتجلى في تدابير المتابعة وإعادة البناء.
ج . مسؤولية المتابعة وإعادة البناء
فهذه المسؤولية تعني تقديم مساعدة متكاملة –بعد التدخل العسكري- وذلك فيما يتعلق بالتعمير والعمل على حسن الإدارة وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء النظام العام من قبل موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء إلى السلطات المحلية. وبناء على ذلك فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل بهدف منع وقوع صراعات وحالات طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها، لذا يجب أن يكون هدف هذه الاستراتيجية المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري. والمهم أيضا أن تتضمن المسؤولية النهائية لأي تدخل عسكري من أجل بناء السلام، تشجيع النمو الاقتصادي لأنه ضروري لإنعاش البلاد المعنى بشكل عام.
وأخيرا إذا كان التدخل الانفرادي للدول عملا غير مشروع وفق أحكام القانون الدولي، فإن التدخل الدولي أصبح يكتسي صبغته الشرعية من خلال ربط حالات التدخل الإنساني بضرورات حفظ السلام والأمن الدوليين. بمعنى أن المجال المحفوظ لسيادة الدول بدأ يتقلص لصالح أحكام القانون الدولي، فالعالم يعيش اليوم فيما يعرف بظاهرة الاعتماد المتبادل والتي أدت إلى تعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى درجة تدويلها14. وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لكل القيم والحقوق الإنسانية ألا تصبح المسؤولية الدولية للحماية خيارا لابد منه؟
فإذا كانت في كل من تونس ومصر مرت نوعا ما بأقل الخسائر، فإنها في البحرين واليمن وسوريا وبالخصوص في ليبيا أخذت منحى مغايرا وأكثر دموية، مما عجل بالحديث مرة أخرى عن فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، خصوصا وأن المنطقة العربية معينة بشكل أخص نظرا لموقعها الجيوسياسي.
بالرغم من كون التدخل يشكل انتهاكا لمبادئ أساسية في العلاقات الدولية، ومسارا لتحقيق أغراض مشبوهة، فإن الضمير الإنساني لا يمكنه أن يتحمل مشاهد مؤلمة لانتهاكات الحقوق والأعراف الدولية دون أن يتحرك، فكلما وقعت هذه الانتهاكات إلا وأصبحت المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، فيما يعرف بمسؤولية الحماية.
هذه الفكرة ظهرت على إثر دعوة رئيس وزراء الكندي في سنة 2000 جون كريتيان في مؤتمر الألفية عن إنشاء لجنة دولية معينة بالتدخل والسيادة، تكون مهمتها دعم نقاش عالمي يقوم على أساس التوفيق بين واجب تدخل المجتمع الدولي الذي يتحتم عليه أن يتدخل أمام الانتهاكات الواسعة للقواعد الإنسانية وضرورة احترام سيادة الدول، وفي سنة 2001 انتهت اللجنة بعمل تقرير يدور حول "مسؤولية الحماية"
ولمحاولة إبراز هذه الفكرة – مسؤولية الحماية - لابد من تحديد مفهوم التدخل الإنساني وبروز فكرة مسؤولية الحماية (أولا) ثم تحديد المبادئ المحددة لهذه المسؤولية(ثانيا).
أولا: من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية.
يثير التدخل الإنسانية جدلا قانونيا لكونه ينطوي على انتهاكا صريحا للحقوق والأعراف، لكن مع ازدياد مكانة الفرد ضمن المجال الدولي ظهرت فكرة مسؤولية الحماية.
أ- التدخل من أجل الإنسانية.
التدخل الإنساني ظاهرة قديمة في تاريخ العلاقات الدولية، فالمعاهدات الدولية الأولى التي عرفت في تاريخ البشرية ترجع إلى عام 1978 ق.م، بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين، والتي تؤكد على البعد التاريخي لهذه الظاهرة كما تؤكد على حقيقة أخلاقية وإنسانية تحكم العلاقات الدولية وتهدف إلى تقديس حياة الإنسان وحمايتها في أوقات السلم والحرب.
وعلى الرغم من قدم الظاهرة، فإن مصدر وتصور فكرة التدخل للدفاع عن الإنسانية، متعلق إلى حد كبير بتاريخ ما يسمى بقضية الشرق
La question d’orient
، فترقبا لكل إفراط من طرف الحكومة العثمانية ضد المسيحيين المقيمين بالإمبراطورية، قامت الدبلوماسية الغربية بوضع أسس شبه قانونية للتدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية.
أما على مستوى الفقه فإن كتاب مثل غروسيوس وڤاتيل اعتبروا هذا التدخل عملا مشروعا وفق القانون الدولي، بالإضافة إلى الأستاذ روجيه الذي دافع عن حق التدخل الذي بموجبه يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول التدخل دفاعا عن الإنسانية في شؤون دول أخرى إذا وقع منها اضطهاد صارخ لأقلية أو أشخاص يقيمون في إقليمها، ومن بين التعريفات التي أعطها الفقه لهذه الظاهرة نجدالتعريف التالي: "نظرية التدخل من أجل الدفاع عن الإنسانية هي تلك النظرية التي تضع بمثابة قانون، حق المراقبة الدولية للسيادة الداخلية لدولة ما والتي تعتبرها هذه الدول مخالفة لقواعد الإنسانية، وتزعم تنظيمها من الناحية القانونية. وتبعا لهذه النظرية، كلما مست حكومة ما بالحقوق الإنسانية لشعبها، يمكن لدولة أو لجماعة من الدول أن تتدخل لإلغاء الأعمال الحكومية المنتقد، أو لمنح حدوث مثل هذه الأعمال في المستقبل، وعلى كل حال، إحلال سيادتها محل سيادة الدولة المراقبة بهذه الصفة" ويمكن القول بأن هذه النظرية المرتكزة على قوانين إنسانية مزعومة، أخذت كأسس لها طريقة معينة ومتميزة في فهم وتصور العلاقات الدولية طريقة أتى بها
Lorimer
، فهذا الكاتب يميز بين الدول "الهمجية" والدول شبه المتحضرة، ثم الدول المتحضرة، وبالطبع تعتبر دول أوروبا مهدا للحضارة بالامتياز،وفي سياق هذا الطرح يحق قانونيا لكل دولة من الدول المتحضرة أن تقوم بالمهمة المثلى، وفي حمل الرسالة الحضارية إلى البلدان الهمجية.
لكن هذه النظرية تفتقر إلى الأسس القانونية، وهذا ما يجعلها أداة فقط، لسياسة الدول العظمى، وفي كل الأحوال، فهي تتناقض مع القانون الدولي، فعامل الإنسانية أو القوانين الإنسانية لم تستطع الدول إبرازها على شكل قاعدة قانونية عامة ومجردة، بل وعلى العكس، فقد رفضت المدرسة الإيطالية للقانون هذه النظرية، باعتبارمبدأ استقلال الدول وعدم التدخل و الأصل.
والواقع أن هذه النظرية برزت منذ القرن التاسع عشر كتكريس لعدم المساواة بين الدول أو على الأصح بين الدول الأوروبية التي كانت تتوفر على وسائل التدخل، وباقي الدول. فما دام المجال مفتوح أمام الدول القوية لتقرير التدخل، في غياب أية قاعدة قانونية معترف بها، فلن تتدخل إلا طبقا لمصالحها الخاص. وعلى الرغم من المعارضات التي رافقت مسيرة هذه النظرية منذ ولادتها، فبعض الدول مازالت وإلى حد الساعة، تبحث عن إمكانية إقحامها في إطار القانون الدولي، بنعتها بتسميات مختلفة.
القانون الدولي المعاصر لا يستسيغ فكرة التدخل الإنساني، لأنها تشكل محاولة لبعث الاتجاه الاستعماري القديم الذي يبيح التدخل لعوامل إنسانية في الظاهر، ولكن القصد الحقيقي منها هو فرض الهيمنة الاستعمارية على دول الجنوب التي لم يكن يسمح لها بالاستفادة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ثم إن حق التدخل لا يأخذ التحولات الجذرية التي عرفها القانون الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وعلى وجه الخصوص تصفية الاستعمار وانتهاء العمل بتقسيم الدول الغربية.
إن تتبع التسلسل التاريخي لحالات التدخل الإنساني يكشف بوضوح أن التدخل يعد دليلا على قوة الدولة التي تهدف إلى توفير مسوغ أخلاقي عند عدم وجود مسوغ قانوني يمكن بموجبه استخدام القوة في العلاقات الدولية. لذلك كان التدخل الإنساني الذي يتم بحجة حماية الأقليات الدينية والعرقية أو حماية حقوق الإنسان من اضطهاد السلطة الوطنية، ظاهريا يخفي الدوافع السياسية والتوسعية للدولة المتدخلة، ولذلك جاءت ممارسة التدخل الإنساني متوافقة وإرادة الدولة الحامية.
التطورات السريعة والعميقة التي عرفها المجتمع الدولي بعد نهاية الحرب الباردة عمقت من نوع التعقد الذي يحدد تعامل القانوني الدولي مع الإنسان كفرد، والذي أصبح بموجبه من مجرد هدف لقاعدة قانونية إلى رعية ضمن المجتمع الدولي.
ب - موقع الفرد في القانون الدولي.
يحتل موقع الفرد في القانون الدولي الكثير من الغموض، كما تختلف آراء الفقهاء القانونيين حول تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية ما بين مؤيد ومعارض ولذلك برزت ثلات نظريات لتحديد ذلك المكان الذي يشغله الفرد في القانون الدولي.
النظرية الوضعية ترى أن القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقات بين الدول، حين تتمتع الدول ذات السيادة فقط بالشخصية القانونية الدولية، نظرا إلى قدرتها على إيجاد قواعد قانونية دولية، أما الفرد فلا تعده شخصا دوليا لأنه لا يتمتع بالسيادة، ومن ثم فهو لا يتمتع بالقدرة على إيجاد القواعد القانونية الدولية، ولذلك لا تنطبق عليه قواعد القانون الدولي بصورة مباشرة إلا من خلال الدولة التي ينتمي إليها، وضمن الحدود التي يقررها القانون الدولي، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الإيطالي دينيسو أنزيلوتي، ومازال الفقه التقليدي الدولي بأخذ بهذا الرأي.
أما النظرية الموضوعية "الواقعية" فتعد الفرد الشخص الوحيد الخاضع للقانون الدولي، والمخاطب الحقيقي بكل قواعد القانون سواء أكان دوليا أم داخليا، لأن القانون يتوجه في نهاية الأمر إلى الأفراد حكاما أو محكومين، ما دام هؤلاء هم الوحيدين الذين يتمتعون بالذكاء والإرادة. فأنصار هذه النظرية ينكرون شخصية الدول ومصالح الجماعة التي تتكون من أفراد، أما الشخصية المعنوية فهي نوع من الخيال القانوني، ولذا فإن الفرد هو الشخص القانوني الدولي فقط، ويتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي جورج سيل.
وتتوسط النظرية الحديثة النظريتين السابقتين، حيث هذا الفرد المستفيد النهائي من أحكام القانون الدولي. فالهدف النهائي من قواعد القانون الدولي رفاهية الفرد وسعادته، وقد يخاطب القانون الدولي الأفراد خطابا مباشرا بأن يكونوا موضوعا لبعض قواعده، ولذا تنشأ لهم حقوق بالمعنى الصحيح، ويلزمون بسلوك معين يترتب على مخالفته تعرضهم للجزاء، لذلك ينتهي أنصار هذه النظرية إلى أن للفرد وضع الشخص الدولي، على أن أهليته لاكتساب الحقوق محدودة، ولا يمارسها بنفسه إلا في بعض الأحوال الاستثنائية النادرة، عندما تخاطبه قواعد القانون الدولي مباشرة، فيصبح شخصا قانونيا دوليا، لكن هذه الحالات الاستثنائية لا تؤثر في الأصل العام، هو أن الفرد ليس من أشخاص القانون الدولي المعتادين ويتزعم هذه النظرية شارل روسو وبول ريتر.
ويرجع الجدل الفقهي حول مركز الفرد في القانون الدولي إلى أن المعاهدات الدولية تقرر حقوقا للأفراد، لكنهم لا يستطيعون وحدهم اتخاذ خطوات إيجابية للحصول عليها، لأن حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي تتم عن طريق الدول التي ينتمون إليها. وهكذا يجب الرجوع إلى كل معاهدة دولية لتحديد إذا ما كانت تعد الفرد شخصا دوليا من دون أن تطالبه باتخاذ أي خطوات إجرائية لإثبات هذا الوصف أو لاتعده كذلك طبقا لنصها. وفي العادة لا تقرر الاتفاقيات الدولية لحماية الأفراد حقوقا مباشرة لهم، وإنما ترتب حقوقا والتزامات تقع على عاتق الأطراف فيها، أي إن الدول هي التي تحمى هذه الحقوق لمواطنيها، كما أن الحقوق الدولية لا تصبح نافذة في إطار القانون الداخلي إلا وفقا لقواعد نفاذ المعاهدات داخل الدولة، وهو ما أكدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في القضية المتعلقة باختصاص محاكم دانزج .
ولقد شكلت محاكم نورمبرج وطوكيو نقطة البداية لتطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، حيث تمت معاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم دولية ضد الإنسانية أو جرائم حرب أمام محكمة عسكرية دولية. وقد استنتجت لجنة القانون الدولي من الأحكام التي أصدرتها هذه المحكمة مبادئ منها الاعتراف بمسؤولية الفرد جنائيا على الصعيد الدولي، حيث رفضت المحكمة الاعتراض القاضي بأن القانون الدولي يحكم أعمال الدول ذات السيادة فقط ولا شأن له بمعاقبة الأفراد، خصوصا أن جرائمهم المرتكبة تعد من أعمال الدولة، فالدولة لذلك تحميهم من المسؤولية الشخصية. وقد ردت المحكمة على هذين الادعاءين بأن القانون الدولي يفرض واجبات ومسؤوليات على الدول والأفراد، وهذا متفق عليه منذ زمن بعيد .
ارتبطت أهم التطورات التي عرفها المجتمع الدولي بتعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وبتراجع مفهوم السيادة من صبغته المطلقة إلى النسبية، وتوسع الاختصاص الدولي على حساب الاختصاص الداخلي، فحقوق الكائن الإنساني أصبحت تعبر الحدود الوطنية لتناقش ضمن المجال الدولي، وهو تطورا انطلاق مع إنشاء الأمم المتحدة وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثيقتي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة والطفل ومناهظة التعذيب ... إلخ.
إن التناقض الصارخ بين المجال السيادي للدولة والمجال الدولي بات من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين مختلف المعنيين بحقوق المشترك للإنسانية، ونتيجة لهذا الجدل ظهرت فكرة مسؤولية الحماية التي تعد تطورا لمبدأ التدخل الإنساني.
ج- مسؤولية الحماية.
مفهوم مسؤولية الحماية ليس ببعيد عن مفهوم التدخل الإنساني، فهو يقوم على أساس إنقاذ الشعوب التي تواجه الأخطار وذلك بتقديم المعونة لهم، سواء عن طريق الدول أو المنظمات غير الدولية، وقد أثار هذا المفهوم جدلا واسعا سواء في حدوثه كما هو الحال في البوسنة والصومال وكوسوفا أو في عدم حدوثه كما هو الحال في رواندة.
ففي الفترة ما بين 1992 و 1993 فشلت عمليات حفظ السلم في الصومال في إعادة الأمن والسلام إلى نصابهما نتيجة لسوء التخطيط والاستخدام المفرض للقوة العسكرية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انسحاب الأمم المتحدة، أما في إقليم كوسوفو فقد أثار تدخل حلف شمال الأطلسي سنة 1999 جدلا عنيف حول شرعيته، فقد اعتبر هذا التدخل بمثابة تجسيد للعولمة على صعيد العلاقات غير الودية والمتمثلة في اللجوء إلى استخدام القوة عبر تدخل عسكري جماعي بدعوى حماية الإنسانية، بعدما كانت العولمة محصورة في نطاق العلاقات السلمية فيما بين الدول ولاسيما وانه حدث في دولة ذات سيادة ودون موافقة مجلس الأمن .
إن القراءة المتأنية للقرارات الصادرة عن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن تظهر أن الأمم المتحدة ظلت تعاني عبر تلك القرارات من مشكلة المواءمة بين الحق السيادي للدولة وحق المجتمع الدولي المرتبط بصياغة ضوابط القانون الدولي الإنساني .
ففكرة تدخل المجتمع الدولي بدأت تلقى قبولا واسعا في حالة عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في حماية مواطنيها بحيث تنتقل المهمة إلى المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، وفقا للفصلين السادس والثامن من ميثاق الأمم المتحدة، للمساعدة في حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
بمعنى أنه ينبغي على الأمم المتحدة اتخاذ إجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة عن طريق مجلس الأمن ووفقا للميثاق، ففي هذه الحالة يتنحى مبدأ عدم التدخل لصالح المسؤولية الدولية للحماية كنهج جديد للمجتمع الدولي وفق مجموعة من المبادئ من بينها
+ مبدأ السيادة.
السيادة تعنى الهوية القانونية للدولة في القانون الدولي، وهي تفيد واقعا سياسيا معينا وهو القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسي في داخل الدولة وخارجها، أي القدرة على الاحتكار الشرعي لأدوات العنف في الداخل، وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج، وهو مفهوم يوفر الاستقرار في العلاقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تعتبر متساوية بغض النظر عن قواتها أو حجمها أو ثرواتها واعترافا بهذا أنشئ هذا المبدأ بين جميع الدول باعتباره حجر الزاوية لميثاق الأمم المتحدة .
فالدولة كشخص متمتع بالسيادة تلتزم بالعديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف سواء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو حفظ السلام أو تحقيق مبادئ الاعتماد المتبادل، وعادة ما تكون الدولة مضطرة بمقتضى التزامها إلى التنازل عن بعض الاختصاصات التي كانت تندرج ضمن المجال المحفوظ، لفائدة مؤسسات دولية أو تنظيمات إقليمية. وهي في هذه الممارسة لا تنقص في الواقع من سيادتها بقدر ما تعبر عن تلك السيادة، إن السيادة الدولة لم تعد ذات صبغة مطلقة بل أصبحت تتعرض تدريجيا للتقليص مما دفع البعض إلى وضعها في موقع المواجهة المباشرة مع حقوق المجتمع الإنساني وذلك عن طريق التبشير بشعار "إن الإنسانية ينبغي أن تتفوق على السيادة" بمعنى إعادة تصنيف مفهومها من السيادة كسيطرة إلى السيادة كمسؤولية، سواء في الوظائف الداخلية للدولة أو فيما يتعلق بواجباتها الخارجية، ومن ثم صار التفكير في السيادة كمسؤولية يلقى اعترافا متزايدا في ممارسة الدولة. بحيث يترتب عنها مسؤولية للدولة على سلامة مواطنيها داخليا وأمام المجتمع الدولي خارجيا من خلال الأمم المتحدة.
+ مسؤولية الأمم المتحدة فيما يتعلق بحفظ السلام والأمن الدوليين.
الأصل في مبدأ عدم التدخل الصلابة، كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة " حيث يمتنع أعضاء الهيئة جميعا عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة "، كما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تحظر على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ، و الواقع أن هذا المبدأ الأخير مثار جدل، لاسيما فيما يتعبق بمجال حقوق الإنسان.
وثمة إستثناء مهم على مبدأ عدم التدخل، فالمادة 24 من الميثاق تعهد إلى المجلس الأمن دورا رئيسا في حفظ الأمن و السلم الدوليين، وبالرغم من ورود أحكام متعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السليمة في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة .إلا أن البعد التنفيذي لهذه المسؤولية ورد في الفصل السابع الذي يصف التدابير التي يمكن لمجلس الأمن أن يتخذها وفقا النص المادة 39 من الميثاق" ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان " هذه التدابير قد تكون من أعمال الحظر و الجزاءات وقطع العلاقات الدبلوماسية وفقا لنص المادة 41 من الميثاق. غير أنه إذا رأي المجلس أن هذه التدابير غير كافية فله أن يلجأ إلى استخدام القوى العسكرية و ما يلزم من الأعمال لحفظ السلم و الأمن، و الجدير بالذكر أن الفصل الثامن يعترف بوجود دور للمناطق الإقليمية في حفظ الأمن و السلم الدولتين. و لكنه ينص صراحة في المادة 53 على أن التنظيمات و الوكالات نفسها لا يجوز بمقتضاه أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، للإشارة فإن المادة العاشرة من الميثاق تعطي للجمعية العامة مسؤولية عامة فيما يتعلق بأي مسألة تقع في نطاق سلطة الأمم المتحدة كما أن المادة الحادي عشر تخول الجمعية العامة مسؤولية يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين و لكنها مسؤولية تقتصر على تقديم التوصيات ولا تتخذ قرارات ملزمة شريطة أن لا يكون مجلس الأمن يناقش القضية المعينة في الوقت نفسه وذلك وفقا للمادة 12 من الميثاق.
ترتكز سلطة الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالسلم و الأمن على دورها في تطبيق الشرعة لا على استخدام القوة الجبرية و يعتبر مفهوم الشرعية
« l’égalité »
بمثابة همزة وصل بين ممارسة الأمم المتحدة لسلطاتها في حفظ الأمن و بين اللجوء إلى استخدام القوة، حيث يعتبر التدخل الجماعي عملا شرعيا لأنه مؤذون به من قبل هيئة دولية تمثيلية، في حين ينظر إلى التدخل الفردي على أنه غير مشروع باعتباره لا يمثل إلا المصلحة الذاتية.
فمن بين أهم المنجزات التي تحققت بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية هو اعتماد معايير جديدة لسلوك الدول في حماية حقوق الإنسان و تعزيزها، تتمثل في الإعلان العالمي حقوق الإنسان الصادر في سنة 1948، الذي يضم التوافق السياسي و التركيب القانوني لهذه الحقوق، بالإضافة للعهدين المعتمدين في عام 1966 بشأن الحقوق المدنية و الاجتماعية، فقد أصبحت هذه الحقوق مبدأ أساسيا من مبادئ العلاقات الدولية، ومن ثم وقع تحول من ثقافة الحضانة السياسية إلى ثقافة المسائلة الوطنية ثم الدولية، فالمنظمات الدولية و المجتمع الدولي و المنظمات غير الحكومية تستخدم القواعد الدولية و النصوص الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها مرجعا مهما تحكم بموجبه على سلوك الدول.
وقد أدى هذا التقدم في مجال حقوق الإنسان إلى زيادة تطوير القانون الدولي الإنساني و اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن لهذه المسؤولية عناصر محددة وناظمة لها.
ثانيا : المبادئ المحددة لمسؤولية الحماية.
المبادئ الناظمة لمسؤولية الحماية تبدأ بمستوى معالجة الأسباب الجدرية للصراع الداخلي مرورا بالمستوى الثاني المتمثل في الرد، لتصل إلى المستوى الأخيرة المتمثل في مسؤولية إعادة البناء و المتابع.
أ – معالجة الأسباب المباشرة للصراع الداخلي.
تعترف المادة 55 من الميثاق صراحة بأن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية و تعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة و التعليم و الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، من أجل تهيئة دواعي الاستقرار و الرفاهية لقيام علاقات سلمية بين الأمم، إلا أنه لا يوجد اتفاق على تحديد الأسباب المباشرة للصراع، إلا أن هناك اعترافا متزايدا على أنه لا يمكن فهم الصراعات المسجلة دون الإشارة إلى السباب الجذرية كالفقر والقمع السياسي وغيرها من الأسباب الإجتماعية والسياسية زيادة على أنه هناك تدابير يمكن أن تعالج الأٍسباب المباشرة للنزاع ومن بينها
1-
التدابير السياسية و التي تتحدد في التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، و تداول السلطة وتأييد الحريات وسيادة القانون كما تشمل التدابير الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العام للأمم المتحدة كالوساطة و المساعي الحميدة و بعثات تقصى الحقائق.
2-
التدابير الاقتصادية التي تتمثل في تقديم مساعدة إنمائية لمواجهة النقص في توزيع الموارد ودعم النمو الاقتصادية كما تشمل تمويل الاستثمارات و الدخول في معاملة تجارية أكثر يسر، وقد تشمل هذه التدابير اتخاذ إجراءات ذات طبيعة قسرية كالتهديد بجزاءات تجارية و مالية، و سحب كافة أنواع الدعم.
3-
التدابير القانونية وتشمل الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون واستغلال القضاء و تنفيذ القوانين، واللجوء للتحكيم وإن كانت هذه التدابير قد تكون غير مقبولة أو متوافر لدى كل الأطراف.
4-
التدابير العسكرية و تشمل إصلاح المؤسسات العسكرية و الأمنية و ضمان عملها في إطار القانون، وعلى المستوى الدولي يمكن اتخاد تدابير عسكرية كالانتشار الوقائي لقوات الأمم المتحدة
ب – مسؤولية الرد .
هذه المسؤولية تشمل على عدة تدابير منها
اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كخطوة مهمة وغير مسبوقة على ترسيخ دعائم نظام قانوني دائم و جديد للمسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكاتهم لقواعد القانون الدولي الانساني و القانون الدولي الحقوق الإنسان.
و تعني هذه الأخيرة ان هناك ولاية قضائية على سلسلة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و جرائم الحرب بالرغم مما آثارته من جدل حول المعيار الذي سيتم الاعتماد عليه لتحديد جرائم الحرب، بالإضافة إلى جريمة الأبادة الجماعية و جريمة العدوان.
التدابير الجبرية دون القوة العسكرية و التي تعوق قدرة الدولة في التعامل مع العالم الخارجي، و لكنها لا تمنع الدولة من القيام بأعمال داخل حدودها، وهذه التدابير و الإجراءات الجبرية أفضل من استخدام القوة إلا أنها مشوبة احيانا بعيب في تطبيقها. فهي غالبا لا تميز بين المذنب و البرئ، ويمكن أن تحدث أضرارا أكبر من الفائدة المنتظرة منها، لاسيما بالنسبة للمدنيين. فالجزاءات الاقتصادية فقدت مقبوليتها بصورة متزايدة نتيجة لتعرض المدنيين لأضرار تكون بعيدة جدا عن التناسب مع الآثار المرجوة من تطبيقها .
في السنوات الأخيرة، برزت الجزاءات التي تستهدف القيادات و المنظمات الأمنية المسؤولة عن كل من إنتهاكات جسمية لحقوق الإنسان كبديل عن الجزاءات العامة، وقد يستثنى كل من المواد الغدائية و اللوازم الطبية من هذه الجزاءات وقد تركز الجهود الرامية إلى تحديد أهداف الجزاءات تحديدا أكثر فاعلية لتقليل آثارها على المدنيين الأبرياء وزيادته على أصحاب القرار و ذلك في المجالات التالية
+ المجال العسكري من خلال وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب، كذلك حظر بيع الأسلحة الذي يعد أداة مهمة في يد مجلس الأمن و المجتمع الدولي.
+ المجال الاقتصادي من خلال فرض جزاءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما او لمنظمة الاهابية أو حركة تمرد. وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية و المنتجات النفطية.
+ المجال الدبلوماسي من خلال فرض قيود على التمثيل الدبلوماسي ، بما في ذلك طرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية.
+ أما اللجوء للقوة العسكرية كخيار أخير في الحالات لاستثنائية أو حالة عدم فاعلية الجزاءات ، يصطدم بمبدأ عدم التدخل الذي يشكل القاعدة التي يجب تبرير أي خروج عنها. فجميع أعضاء الأمم المتحدة لهم مصلحة في المحافظة على نظام الدول ذات السيادة و قاعدة عدم التدخل تشجع الدول على حل مشاكلها الداخلية بنفسها على النحو الذي يمنع من اتساع هذه المشاكل إلى الحد الذي يهدد الأمن و السلم الدوليين.
+ لكن في ظروف استثنائية تصبح فيها مصلحة جميع الدول في الحفاظ على النظام الدولي تتطلب نفسها القيام برد فعل وذلك عندما ينهار النظام كله في دولة ما أو يبلغ الصراع الداخلي حدا من العنف يهدد المدنيين بإبادة جماعية أو تطهير عرقي واسع النطاق.وقد استقر الرأي على أن هذه الظروف الاستثنائية يجب أن تكون حالات عنف تشكل خطرا واضحا على الأمن و السلم الدولتين و تهز الضمير الإنساني، بحيث تستدعي تدخلا عسكريا.
لكن وفق مجموعة من المعايير التي ينبغي التحقيق منها قبل اتخاذ قرار التدخل ومنها:
الإذن : أي أن يأذن مجلس الأمن للقيام بتدخل عسكري، أو أن يطلبوا من الأمين العام الأمم المتحدة أن يشير ذلك بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة
عدالة القضية : التدخل العسكري ، كتدبير استثنائي يجب تبريره بالخطر المحدق بالمدنيين و الذي يؤدي إلى خطر لا يمكن إصلاحه، مثل خسارة كبيرة في الأرواح واقعة فعلا أو يخشى وقوعها.
النية الصحيحة : أي بعدا استنفاد كل الخيارات غير العسكرية لمنع وقوع الأزمة، ووجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن التدابير الأقل من التدخل العسكري لن تنجح.
التناسب : يجب أن يكون نطاق التدخل العسكري المخطط له وموته و شدته عند الحد الأدنى اللازم لضمان هدف الحماية الإنسانية.
وتأسيسا على ما سبق وجب التقيد بهذه المعايير السالفة حتى يمكن إضفاء نوع من المشروعية لهذا التدخل الإنساني إلا أن هذا غير كافي فهناك مسؤولية أخرى تتجلى في تدابير المتابعة وإعادة البناء.
ج . مسؤولية المتابعة وإعادة البناء
فهذه المسؤولية تعني تقديم مساعدة متكاملة –بعد التدخل العسكري- وذلك فيما يتعلق بالتعمير والعمل على حسن الإدارة وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة بناء النظام العام من قبل موظفين دوليين يعملون في شراكة مع السلطات المحلية بهدف تحويل سلطة إعادة البناء إلى السلطات المحلية. وبناء على ذلك فإن التفكير في التدخل العسكري يبرز أهمية وضع استراتيجية لما بعد التدخل بهدف منع وقوع صراعات وحالات طوارئ إنسانية أو زيادة حدتها أو انتشارها أو بقائها، لذا يجب أن يكون هدف هذه الاستراتيجية المساعدة على عدم ضمان تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري. والمهم أيضا أن تتضمن المسؤولية النهائية لأي تدخل عسكري من أجل بناء السلام، تشجيع النمو الاقتصادي لأنه ضروري لإنعاش البلاد المعنى بشكل عام.
وأخيرا إذا كان التدخل الانفرادي للدول عملا غير مشروع وفق أحكام القانون الدولي، فإن التدخل الدولي أصبح يكتسي صبغته الشرعية من خلال ربط حالات التدخل الإنساني بضرورات حفظ السلام والأمن الدوليين. بمعنى أن المجال المحفوظ لسيادة الدول بدأ يتقلص لصالح أحكام القانون الدولي، فالعالم يعيش اليوم فيما يعرف بظاهرة الاعتماد المتبادل والتي أدت إلى تعاظم الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان إلى درجة تدويلها14. وفي ظل الانتهاكات الجسيمة لكل القيم والحقوق الإنسانية ألا تصبح المسؤولية الدولية للحماية خيارا لابد منه؟



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية
التدخل الإنساني ومسؤولية الحماية