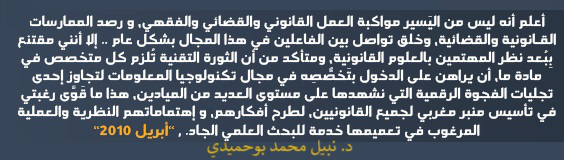ذ عبد السلام العيماني، عضو المجلس الأعلى للقضاء، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط
.المغرب باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنظومة الدولية، كان وما يزال عضوا فاعلا بالمنظمات الدولية، وملتزما بمقررات الإعلانات والمواثيق الصادرة عن تلك المنظمات والهيآت، ومن أجل ذلك فقد كان الهم المتواصل للدولة المغربية يتمثل في كيفية جعل المنظومة القانونية متناغمة ومتساوقة مع ما التزم به المغرب بإرادته السيادية أمام المنتظم الدولي، وعلى رأس كل ذلك تأهيل القضاء وتحديث المنظومة التشريعية بما ينسج والدور الذي يتعين أن تعلبه تلك المنظومة ويقوم به القضاء.
وإذا كانت موجة الحقوق والحريات التي تجتاح العالم الثالث في الآونة الأخيرة قد تأثرت بمجموعة من العوامل والمتغيرات الاجتماعية التي شهدتها بعض الدول، فإن المغرب جسد استثناء ممتدا في الزمان، ومتصلا بعمق الالتزامات الواقعة على عاتقه؛ ذلك أن نظرة المغرب للسلطة القضائية كانت محط نقاش مجتمعي مستفيض أدلت فيه كل المكونات الاجتماعية بدلوها، حتى لئن المذكرات و الأوراق و التوصيات التي صدرت عن تلك الجمعيات و الهيآت لا تعد ولا تحصى، الشيء الذي كان حاسما في تأسيس نظرة متقدمة وحداثية لفكرة استقلال السلطة القضائية استقلالا حقيقيا .
ولقد كانت التجربة الرائدة التي شهدها المغرب في مطلع الألفية الثالثة، مثالا يحتدى به في مجال العدالة الانتقالية ؛ إذ شكلت هيئة الإنصاف والمصالحة قوة الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المغربية من حيث إعادة النظر في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
ولقد كان المغرب صريحا إلى أقصى الحدود، مع نفسه، عندما اعترف بالتجاوزات الخطيرة التي شهدها المغرب خلال فترة ما قبل إنشاء الهيئة المذكورة، إذ شكلت الشهادات التي تم الإدلاء بها والتي نشرت بمختلف وسائل الإعلام صدمة حقيقية للضمير المجتمعي، وقد كان من المؤلم جدا أن يكون للقضاء دور أساسي في كل المآسي و الانتهاكات التي شهدتها تلك الحقبة من التاريخ الحديث للمغرب . ولعل التوصيات التي خرجت بها هيأة الإنصاف والمصالحة لدليل على قوة الدور الذي لعبه القضاء إبان تلك المرحلة وهو ما دفع بالهيأة المذكورة إلى ضرورة التوصية بحتمية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية استقلال تاما، وذلك من أجل النأي بالقضاء عن لعب أدوار سياسية يستعمل من خلالها في تصفية الحسابات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين.
ولأهمية تلك الخلاصات والتوصيات، فقد اعتبرت المدخل الحقيقي لتأسيس دولة الحق و القانون الذي يلعب فيها القضاء الدور الأساسي والحاسم في إرساء التوازنات الاجتماعية القضائية على أساس التطبيق السليم للقانون؛ ومن تم فقد ظهرت مجموعة من المؤشرات التي دلت على استجابة الدولة المغربية لتلك التوصيات وتفاعلها معها . و قد كان خطاب 09 مارس 2011 التاريخي الذي نصبت فيه لجنة مراجعة الدستور معبرا عن أوج ذلك التجاوب، إذ أنه من المعلوم أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان واضحا وصريحا في الدعوة إلى التقيد بتلك التوصيات والعمل على دسترتها، وهو الأمر الذي شكل بلا منازع قوة الرغبة في بناء صرح الدولة الحداثية والأصيلة، دولة يسود فيها القانون وتحترم الحقوق والحريات سواء أكانت فردية أو جماعية، و قد كان ذلك كله مبني على سبعة مرتكزات كما جاء بالخطاب المولوي السامي، منها « ... ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب ؛ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه … «
فالنطق الملكي جسد بحق قوة النظرة و رصانتها عندما أكد على أن الهدف من دسترة توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الالتزامات الدولية للمغرب، مع العمل على الارتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة قضائية مستقلة، كل ذلك من أجل توطيد سمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه .
فتلك الأهداف السامية لا يمكن الوصول إليها إلا بوجود سلطة قضائية قوية قائمة على الاستقلال المطلق عن جميع ما يمكن أن يؤثر فيها وفي قراراتها . ومن هنا فإن التساؤل موضوع هذه المداخلة يجد سنده في هذه النظرة المتقدمة لشكل بناء الدولة المغربية الحديثة، إذ أن أول ما نصطدم به في خضم الحديث عن مفهوم السلطة القضائية هو هل تعتبر النيابة العامة جزء لا يتجزأ من تلك السلطة أم أنها لا تعتبر كذلك ؟ وتبعا لذلك هل يعتبر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تحقيقا للاستقلال الكامل والتام والمنشود للسلطة القضائية أم لا ؟
إن الحديث عن هذا الإشكال يعتبر صلب وجوهر الإشكالات التي يتعين أن تكون موضوع تداول ديمقراطي تغلب فيه المصلحة العليا للوطن بدل التجاذبات المصلحية الضيقة، ذلك أن تحديد الطبيعة القانونية لمركز النيابة العامة في الجهاز القضائي سيحدد لا محالة الوجهة التي سيتجه لها الجواب عن التساؤل المطروح؛ أخذا بعين الاعتبار أن النقاش يجب أن يتسم بنوع من الاجتهاد والابتكارية التي يتعين أن تطبع الفكر الحقوقي والقانوني المغربي استجابة للنداء الملكي الذي تم التعبير عنه بمناسبة تنصيب اللجنة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ؛ و الذي جاء فيه : « وإننا ننتظر منكم، لما هو معهود فيكم من روح المسؤولية الوطنية العالية انتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة».
وفي هذا السياق فإننا نرى أن توضيح الرأي بشأن مدى توقف تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية على استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية استقلالا تاما يجب أن يمر عبر مجموعة من الخطوات المنهجية، ابتداء من بسط الآراء التي تعرضت لتحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة و ما واجهته تلك الآراء من انتقادات، مرورا بالتزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي وما يرتبه ذلك من إعادة النظر في الرؤية التقليدية للنيابة العامة في المغرب، وصولا إلى النظرة الدستورية المتقدمة للطبيعة القانونية للنيابة العامة.
إن الحديث عن النيابة العامة في المنظومة القضائية المغربية، لهو حديث عن تجذر تاريخي موسوم بنوع من النظرة الأمنية التي كانت تتحكم في عمل هذا الجهاز، خاصة أن المغرب، الذي مر من مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قد وجد في بعض التوجهات الفقهية والقانونية ما يشفي غليله من أجل تحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة، إلا أن تحديده لتلك الطبيعة كان موسوما بنوع من المرونة انسجاما منه مع التزاماته الدولية التي ما فتئ يعبر عنها منذ أول دستور للمملكة لسنة 1962، وأخذا بعين الاعتبار لما جاء به المرجع التاريخي الحديث للمنظومة القانونية المغربية والمتمثل في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. إلا أن زوال تلك الظروف الاستثنائية ودخول المغرب عهدا من الاستقرار السياسي والمجتمعي، دفعه إلى ضرورة إعادة التفكير في طريقة نظرته للنيابة العامة طبيعة ودورا وسلطات بما ينسجم أكثر مع التوصيات والتقارير الدولية في هذا المضمار.
واستنادا على ذلك، فمن المفيد التطرق إلى موضوع النيابة العامة في هذا الشق الأول من هذه المداخلة من خلال نقطتين أساسيتين، أولاهما تتعلق بمركز النيابة العامة في الأنظمة القضائية على ضوء التوجهات الفقهية والانتقادات التي لاقتها تلك التوجهات، في حين سنفرد النقطة الثانية للتفصيل في ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة من أجل استجابة حقيقية لالتزامات المغرب الدولية.
الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التوجهات الفقهية
لقد تعددت الآراء الفقهية التي تطرقت للطبيعة القانونية للنيابة العامة، وتأثرت تلك التوجهات بمجموعة من المؤثرات التي طبعت الحقب التاريخية للدول، فكانت تنطلق غالبا من القراءة البعدية لما كانت عليه النيابات العامة في مختلف الأنظمة القضائية. ولذلك فإن الفقهاء القانونيين كانوا دائما ولا يزالون يؤسسون نظرتهم على أسس واقعية و ليست قانونية، إذ أن تطرقهم للطبيعة القانونية للنيابة العامة لم يكن من منطلق تحديد الشكل والطبيعة التي يجب أن تكون عليه تلك المؤسسة وإنما من أجل وصف واقع معيش، وهو الأمر الذي جعل تلك التصنيفات تكون محل انتقاد يأتي من الفقه القانوني ذاته.
التحديد الفقهي للطبيعة القانونية للنيابة العامة
تتوزع النظرة الفقهية للطبيعة القانونية للنيابة العامة على ثلاثة توجهات أساسية، أولها أن النيابة العامة جهة إدارية، وثانيها أنها جهة قضائية، في حين ترى النظرة الثالثة أن النيابة العامة هي جهة مختلطة الطبيعة تجمع بين الإداري و القضائي، وقد كان لكل توجه على حدة مبرراته، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن تلك التوجهات الفقهية لم تكن توجهات مؤسسة كما هو الحال بالنسبة إلى معظم المؤسسات القانونية الفكرية والمؤسساتية، وإنما كانت توجهات قائمة على الملاحظة والاستنتاج لما هو موجود في الأنظمة القضائية المختلفة.
وفي هذا السياق يمكن التطرق لكل توجه على حدة بصورة مقتضبة، على أن يكون ذلك ممهدا للفقرة الموالية التي سنتناول فيها الانتقادات الموجهة لتلك الرؤى .
النيابة العامة ذات طبيعة إدارية
يرى أنصار هذا الاتجاه أن تبعية النيابة العامة للسلطة المباشرة للسلطة التنفيذية يجعلها تمتثل للتوجهات العامة التي تسطرها الحكومات في مجالات الحياة اليومية، ولذلك فإن وجودها في المحاكم يعتبر امتدادا للسلطة التنفيذية في الجهاز القضائي، وأنها تعبر عن وجهة النظر الحكومية في القضايا المعروضة على أنظار القضاء، ويرى أنصار هذا الرأي أن النيابة العامة لا يمكن أن تتحرك إلا بإذن من السلطة الحكومية التي تتبع لها، و بالتالي فإن كل المواقف والاختصاصات التي تمارسها النيابة العامة في هذا الصدد تستند إلى وجود سلطة تسلسلية وتراتبية، قوامها أن وزير العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية هو الرئيس المباشر للنيابة العامة وهو البوابة الرئيسية لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء .
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية
ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن النيابة العامة، ما هي في آخر المطاف إلا مجموع الأفراد المنتمين إلى السلطة القضائية، وأن حملهم لصفة القضاء تجعلهم جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية بمفهومها العام، زيادة على أن جل الأنظمة القضائية ترى بعدم التخصص وأن القاضي الواحد يمكن له أن يتدرج خلال مساره المهني بين ممارسة قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، وأن السبب في ذلك راجع إلى وحدة المسار المهني للقضاة عموما انطلاقا من بداية تكوينهم إلى غاية بلوغهم سن التقاعد، وبالتالي فإنه من الإجحاف القول إن جهاز النيابة العامة يعتبر جهازا إداريا، بل هو على النقيض من ذلك فهو جهاز قضائي وهو جزء من السلطة القضائية بمفهومه المتعارف عليه في الأدبيات الدستورية والسياسية الكبرى.
النيابة العامة جهاز مختلط
على عكس الاتجاهين الأولين، اللذين يركزان على الطبيعة الأحادية والمتفردة للنيابة العامة، يذهب الاتجاه الثالث إلى أن للنيابة العامة طبيعة مزدوجة تجمع بين ما هو إداري وما هو قضائي، ويستند هذا الاتجاه في دراسته للطبيعة القانونية للنيابة العامة على معيارين، المعيار العضوي والمعيار الوظيفي.
فمن حيث المعيار العضوي، يستند هذا الاتجاه إلى أنه لا يمكن تفسير التراتبية الإدارية التي تطبع عمل النيابة العامة إلا بكونها جزءا لا يتجزأ من مفهوم المرفق الإداري الذي يطبع عمل دواليب ومرافق وزارة العدل، وبالتالي، فإنه على غرار ما تخضع له تلك المرافق والدواليب من سلطة رئاسية لوزير العدل، فإن النيابة العامة تخضع للسلطة الرئاسية نفسها.
أما من حيث المعيار الوظيفي، فإن هذا الاتجاه الفقهي يرى أن النيابة العامة وإن كانت تخضع للسلطة الرئاسية لوزير العدل في بعض الأنظمة القضائية، فإنها تخضع من حيث عملها لمجموعة من القواعد القانونية التي تؤطر قواعد اختصاصاتها، وبالتالي فهي عند تطبيقها لتلك القواعد القانونية تتقمص دور الجهاز القضائي، كما أن الأعضاء المكونين لجهاز النيابة العامة قضاة في الأصل، وبالتالي، فإنهم يختلفون من حيث الإطار القانوني المنظم لوضعيتهم عن القانون المنظم للوضعية المهنية لباقي أعضاء إدارة وزارة العدل.
إن هذه الاتجاهات الثلاثة التي تم التطرق لها والتطرق لأسسها، تستند كلها على دراسة العينات القضائية لمجموع الأنظمة السائدة في العالم، وبالتالي فإن الخلاصات التي خلصت لها لا تنفك تتعرض لمجموعة من الانتقادات التي يوجهها الفقهاء أنفسهم لتلك الطبيعة القانونية للنيابة العامة وهو ما سنتطرق له في الفقرة الموالية.
إن الانتقادات الموجهة إلى الطبيعة القانونية للنيابة العامة ترتكز على مجموعة من المرتكزات، منها ما يرتكز على المقوم التاريخي ومنها ما يستند على الفكر الحقوقي، و منها ما يراعي مقومات أخرى، لكن ما سنركز عليه في مداخلتنا هذه، هو المقومان التاريخي والحقوقي .
إن الذين ارتكزوا على البعد التاريخي في نقد الطبيعة القانونية للنيابة العامة، ذهبوا إلى أن اصطباغ النيابة العامة بالطبيعة الإدارية، يجد سنده عند نشأة هذا الجهاز خاصة عندما ثارت الشعوب الأوربية في وجه الإقطاعية، و لما توجست هذه الأخيرة من الأمر خيفة، ابتدعت هذا الجهاز من أجل إظهاره وكأنه يدافع عن المصلحة العليا للمجتمع، إلا أنه في حقيقته لم يوجد إلا من أجل ضمان طريقة قانونية للتدخل في الجهاز القضائي وعمله من أجل حماية المصالح التي تتمتع بها نفس الطبقة الإقطاعية. ويرى موجهو هذه الانتقادات إلى أن مجموعة من الأنظمة السياسية لم تستوعب حجم التحولات التي عرفها الفكر الإنساني، وما أنتجته تلك التحولات من إعادة النظر في مجموعة من المسلمات وعلى رأسها اعتبار الدولة كصاحبة امتياز إلى دولة في خدمة المواطن، و بالتالي فإن أساس اعتبار النيابة العامة جهازا إداريا لم يعد له مبرر، لأنه لم يعد مقبولا اعتبار الدولة فوق القانون، وبالتالي لم يعد لوزير العدل أي دور في حماية مصالح الدولة التي يتعين أن تخضع في آخر المطاف للقانون وسيادته، بما يمثل ذلك من أسس للدولة الديمقراطية الحديثة.
وبالموازاة مع الانتقادات الموجهة على أساس تاريخي، ظهرت مجموعة من الانتقادات التي ركزت على البعد الحقوقي في انتقاد الطبيعة القانونية للنيابة العامة. و يرى أصحاب هذا التوجه النقدي أنه في ظل ما عرفه العالم من تحول في الفكر الحقوقي خلال القرن العشرين خصوصا بعيد الحرب العالمية الثانية، فإن مجموعة من الأنظمة السياسية الرائدة في الديمقراطية ارتأت التخلي عن المقاربة الإدارية والأمنية لعمل النيابة العامة، وتعويضها بالنظرة الحقوقية، منطلقة من كون النيابة العامة في الأصل، تعتبر جزءا من السلطة القضائية التي يعود إليها وحدها أمر حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
ومن ثمة يذهب أصحاب هذا الانتقاد المؤسس على البعد الحقوقي، إلى أنه في ظل مناخ متسم بالفكر الحقوقي لا يمكن التسليم بكون النيابة العامة ذات طبيعة إدارية و حتى ذات طبيعة مزدوجة، إذ يرى هذا الفريق أن اعتبار النيابة العامة جهازا إداريا من شأنه أن يطلق يد الدولة في التصرف في الحقوق والحريات التي تم إقرارها عبر نضالات إنسانية متواصلة، وبالتالي فإن هذه الحقوق ستبقى مهددة مادامت النيابة العامة تحت السلطة والإشراف المباشرين للسلطة التنفيذية مجسدة في وزارة العدل. كما يرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا يمكن تصور الطبيعة المختلطة للنيابة العامة، لأنه من شأنه أن ينتقص من مركزها ومن الاختصاصات التي خولت لها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكنتيجة منطقية لكل ذلك، فإنه لا يمكن القول باستقلال السلطة القضائية استقلالا فعليا ومطلقا وفق ما تعارف عليه الفكر السياسي المتقدم. وعلى ذلك، فإن اعتبار النيابة العامة جهازا مختلطا يدل على كون تطبيق القانون في مجموعة من الأحوال سوف يكون مطبوعا بمزاحية السلطة التنفيذية خاصة في ظل وجود مجموعة من القواعد القانونية التي تؤطر عمل النيابة العامة، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لسلطة الملاءمة، التي يمكن أن تكون سيفا ذو حدين إما من أجل الإفلات من العقاب أو من أجل التعسف في استعمال تلك السلطات في ظل ضوابط قانونية، وهو ما يشكل جوهر الاستعمال السياسي للنيابة العامة بين الفرقاء من أجل تصفية الحسابات على حساب ضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون وبناء المؤسسات الخاضعة لحكمه .
وتأسيسا على كل ذلك، فإن المنتقدين للطبيعة الإدارية أو المختلطة للنيابة العامة، يخلصون إلى أن اعتبار هذه الأخيرة ذات طبيعة قضائية، هو ما يجب تبنيه على اعتبار أن هذه الطبيعة تنسجم والمهام الموكولة إليها، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، مادامت أنها تسهر على حماية و ضمان تمتع الأفراد والجماعات بالحقوق والحريات سواء عند مثولهم أمام القضاء أو قبل ذلك أو بعده. ولعل هذا الاتجاه الذي يناصره هذا الفريق هو ما ينسجم والتوجه العالمي نحو إقرار وتكريس مناخ حقوقي يطبع تعامل وعلاقة الدولة بالخاضعين لسلطانها وفق ما أقرته ولا تزال تقره المواثيق والعهود الدولية، لذلك يدعو أنصار هذه الانتقادات إلى ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة على ضوء ما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية، ومن تلك الجهات المدعوة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة نجد المغرب خاصة بعد إقرار دستور 2011 ، وبناء على ما التزم به من عهود والتزامات أمام المنتظم الدولي .
ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة
إن الطبيعة القانونية للنيابة العامة بالمغرب تجد سندها في ما يمكن أن نسميه بالبعد التاريخي أو الخلفية التاريخية، سواء من حيث التاريخ الحقيقي الذي هو أحداث ووقائع، أو من خلال الخلفية التاريخية للمنظومة القانونية المجسدة في القانون الفرنسي . لذلك فإن هذه الطبيعة يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس، ومن ثم فإن المقاربة التاريخية هي التي يتعين الارتكاز عليها من أجل فهم أعمق وأشمل للطبيعة القانونية للنيابة العامة في المنظومة القانونية المغربية.
فبالرجوع إلى التاريخ الحديث للمغرب كدولة مستقلة ، نجد أن هذا الأخير شهد مجموعة من الأحداث التي طبعت المناخ السياسي خاصة خلال فترة السبعينات، الشيء الذي دفع مركز القرار إلى التعامل مع المؤسسات الإستراتيجية على نحو من المقاربة الأمنية التي طبعت مجمل القوانين التي لا تزال سارية إلى حينه، ومن تلك القوانين ما يرتبط بالنظام القضائي المغربي .
إن المغرب ، تعامل مع القضاء عموما باعتباره مرفقا من مرافق الدولة التابعة لوزارة العدل، ومن ثم، فإن الأحداث التي تم الكشف عنها من خلال الخلاصات التي انتهت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الدور السلبي الذي لعبه القضاء في تلك الفترة، الشيء الذي جعله مجرد أداة بيد الدولة، ولم تكن لهذه الأخيرة أية تأثيرات لولا تحكمها في جهاز النيابة العامة تحكما يكاد يختفي معه وجهها القضائي، فمن التحكم في المسار المهني لرجال القضاء المشتغلين بالنيابة العامة إلى التدخل في القرارات التي قد تتخذها النيابات العامة، إلى ما يشكل ذلك من تأثير على المسار الطبيعي للقضايا المنظورة من القضاء. ولذلك فإن معظم التجاوزات الحقوقية التي عرفها المغرب خلال الفترة التي كشفت عنها هيأة الإنصاف والمصالحة، أكدت أن القضاء كان له دور فيها، ومن ثم نادت توصيات الهيأة المذكورة بضرورة ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية و ضرورة إخراج السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل من السلطة القضائية إخراجا حقيقيا ومطلقا .
إذا ما نظرنا إلى طبيعة الخلاصات التي وقفت عليها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، نجد أنها تجسد أزمة عدم انضباط المنظومة القانونية المغربية لما تفرضه وتقره الاتفاقيات الدولية في ميدان الحقوق والحريات. إذ أن هذه الأخيرة وانطلاقا من الفكر الإنساني الراسخ بضرورة قيام الدول الحديثة على سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، ترى أن هذه الأخيرة يتعين أن تضمن لها الدول الاستقلال التام والحقيقي عن السلطتين السابقتين، كما يجب أن تلعب دورا أساسيا في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بما يضمن جعل المؤسسات والأفراد سواسية أمام القانون، ولن يتأتى ذلك، إلا باعتماد مقاربة حقوقية منسجمة مع ما تفرضه الإرادة الدولية من أجل التأكيد على الاندماج الفعلي والصريح للمغرب في المنظومة العالمية، سواء من خلال النص القانوني أو من خلال البعد المؤسساتي .
لذلك، فإن النظرة التي كانت تحكم المغرب، في تعامله على القضاء عموما والنيابة العامة على وجه الخصوص، يجب أن تتغير بما يثبت أن المغرب قد قام بالخطوات اللازمة لإظهار حسن نواياه أمام المنتظم الدولي، خاصة عندما يقر بالطبيعة القضائية لجهاز النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، في مناخ أصبح يتسم أكثر فأكثر بضرورة احترام الحقوق والحريات من خلال الممارسة اليومية مع الانضباط المطلق لحكم القانون. ونجد أنفسنا في هذه المداخلة غير مضطرين للتذكير بما توصي به الاتفاقيات الدولية من ضرورة ضمان أن يمثل الأفراد أمام جهات قضائية مختصة ، متسمة بالحياد والاستقلال وأن تصدر قراراتها باستقلال تام عن أي تأثير يمكن أن تخضع له وبخاصة من جهة السلطة التنفيذية. لذلك فإن المغرب وهو يعي هذه المتغيرات التي أصبحت أكثر إلحاحا، سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في المركز القانوني للنيابة العامة، وفي هذا الصدد، نجد أن مختلف الفاعلين الحقوقيين نادوا ولا يزالون بضرورة فصل السلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية فصلا ينسجم والمعايير الدولية المؤسسة لسلطة قضائية مستقلة، ما تظهر معه الإرادة المجتمعية التي توافقت على ضرورة الاحتكام إلى سلطة قضائية غير خاضعة إلا لحكم القانون، واعتبرت ذلك المدخل الحقيقي للدولة الحداثية والديمقراطية التي تضمن فيها الحقوق والحريات سواء للأفراد أو الجماعات.
وخلاصة القول، إن المغرب آمن بما لا يدع مجالا للشك بأن الظرف مواتيا لتبني المقاربة الحقوقية والقانونية للطبيعة القانونية للنيابة العامة، بعيدا عن كل تأثير لخلفيات تاريخية أو لمعايير مصلحية ضيقة غير المصلحة العليا للوطن، ويعضد كل ذلك الإجماع على ما تضمنه الدستور من إقرار باستقلال السلطة القضائية كسلطة واحدة غير قابلة للتجزئة بين شقيها المتمثلين في قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.
لذلك وجب علينا التساؤل حول الكيفية التي تعامل معها المغرب من خلال دستور 2011 في ما يتعلق بتبني المقاربة القانونية الصرفة للنيابة العامة، التي من خلالها يتضح الانتصار للطبيعة القضائية للنيابة العامة.
المركز القانوني للنيابة العامة في الدستور الجديد
إن الحديث عن المركز القانوني للنيابة العامة على ضوء أحكام الدستور الجديد لسنة 2011، يعني تحديد طبيعتها القانونية على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، ومن أهداف ذلك الوقوف على مدى اعتبار النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية أم أنها منفصلة عنها. ولن يتأتى الوقوف على ذلك، إلا من خلال تبيان المحددات الدستورية العامة التي تؤسس للطبيعة القانونية للنيابة العامة وكذا لعلاقتها بوزارة العدل والحريات، حتى نتمكن من الوقوف على مدى اعتبار استقلال النيابة العامة شرطا أساسيا لاستقلال السلطة القضائية.
المحددات الدستورية للطبيعة القانونية للنيابة العامة
يعتبر الدستور المغربي لسنة 2011 فرصة تاريخية مكنت مختلف الفاعلين في حقل العدالة من تناول مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة، وما يستقطب الاهتمام كل ما يتعلق بالقضاء باعتباره جوهر وقلب تلك المنظومة. وإذا كان الكل مجمع على ضرورة استقلال السلطة القضائية، وحاسم في كون الدستور الجديد قد عمل على ضمان ذلك الاستقلال ونص عليه، فإن الجدل بقي محتدما حول مدى اعتبار النيابة العامة جزء من السلطة القضائية بالمفهوم الدستوري أم العكس. ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع موضوع النيابة العامة على أساس مقاربة دستورية تستند إلى مفهوم التأويل الديمقراطي القائم على اعتبار الغايات والأهداف الحقيقية التي قصدها المشرع الدستوري مع استغلال القاموس المفاهيمي الذي لجأ إليه المشرع الدستوري عند تفصيله لمقتضيات الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية.
ولعل أهم ما يثير الانتباه في هذا السياق هو أن المشرع الدستوري عمل على تبني وحدة المفهوم المتعلق بـ»القاضي» في جميع المقتضيات، وإن ظهر فيها نوع من التمييز بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة مع ترك باب الاجتهاد واسعا في بعض جوانب التنظيم القانوني للسلطة القضائية خاصة ما يتعلق بالنيابة العامة.
وحدة مفهوم القاضي في الدستور الجديد
إن القارئ للمقتضيات الدستورية لن يجد عناء في تلقف الإشارة الواضحة التي مفادها أن المشرع الدستوري استعمل لفظة « القاضي « للدلالة على كل فرد من أفراد السلطة القضائية كيفما كان موقعه، سواء أكان يشتغل في قضاء الحكم بكل أنواعه أو قضاء النيابة العامة.
وبلغة الأرقام، نجد أن المشرع الدستوري استعمل لفظة « القاضي « في ستة مواقع، منها أربعة منها في الفصل 109 وواحدة بالفصل 117، بينما استعمل لفظة « قضاة « أربع مرات في الفصول 57 و110 و111 و115، أما لفظ « القضاء» فقد وردت في الفصول 67 و109 و110 و111 و113 و115 و126. وما يلاحظ من استعمال هذه الألفاظ الدالة على القضاء والقضاة والقاضي، أن لها دلالة عامة تجمع بين كل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ما يعني أن نية المشرع الدستوري انصرفت إلى توحيد مفهوم القاضي في الدلالة الدستورية وهو ما يجب الانتباه إليه عند التداول القانوني والتشريعي في كل ما سيصدر من قوانين سواء أكانت تنظيمية أم قوانين عادية .
إن ما ذهبت إليه بعض المقتضيات الدستورية يدل على القوة الدستورية لحمولة مفهوم القاضي، و لنأخذ على ذلك مثالا مما جاء في الفصل 67 من الدستور، التي تنص على عمل لجان تقصي الحقائق، حيث جاء في الفصل المذكور ما يلي : « للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
لا يجوز تقصي الحقائق في ملفات أمام القضاء
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق . يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان. «
فمن خلال هذا الفصل يتبين لنا أن المشرع قصر عمل لجان تقضي الحقائق بمجرد وضع القضاء يده على الوقائع موضوع تقصي الحقائق، وهو ما يعني أن المشرع استعمل لفظ القضاء للدلالة على القضاء الواقف وكذا على القضاء الجالس، ولم يفرق بينهما ، لأن العبرة بالسلطة التي وضعت يدها على الوقائع موضوع التحقيق أهي السلطة التشريعية أو السلطة القضائية . و من ثمة يتضح أن المشرع الدستوري استعمل لفظ القاضي بدلالة واحدة لا تفريق و لاتمييز فيها بين قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة.
و لعل إرادة المشرع الدستوري الرامية إلى عدم التمييز بين الأفراد العاملين بكل من قضاء الحكم و قضاء النيابة العامة ، يكمن في طريقة تعيينهم إذ أنه بموجب الفصل 57 من الدستور و الذي ينص على أنه : يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية « إذ أن المستفاد من هذا المقتضى هو أن المسار المهني للقضاة يبتدئ واحدا، و لا فرق بين قضاة طرفي السلطة القضائية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لتدبير الوضعية الفردية و المسار المهني للقضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فكل لفظة في الدستور جاءت في هذا الخصوص إنما تدل على دلالة واحدة ألا و هي اتحاد صفة القاضي في كل من القضاة العاملين بالنيابة العامة أو الذين يعتلون منصة الحكم .
انطلاقا مما ذكر يتبين بما لا يدع مجالا للشك بأن إرادة المشرع الدستوري اتجهت إلى جعل الأفراد العاملين بالسلطة القضائية بشقيها قضاة بالمفهوم المتعارف عليه دوليا و كما تعبر عن ذلك العهود والاتفاقيات الدولية ، ولعل تفسير ذلك يرجع إلى استحضار اللجنة المكلفة بوضع مسودة الدستور للخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى دسترة الالتزامات الدولية للمغرب والتي من بينها ما يتعلق بالقضاء والسلطة القضائية .
فالموقف المتقدم جدا للإرادة الدستورية العليا ، يجب أن يتم الاحتفاظ به عند صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية مهما كانت طبيعتها و قوتها الإلزامية . وهو الأمر الذي يظهر بوضوح وجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة المغربية من أجل الرقي بالسلطة القضائية بشقيها قضاء النيابة العامة و قضاء الحكم إلى مصاف السلطة القضائية المستقلة . لكن رغم هذه الإشارات التي أشرنا إليها على سبيل المثال في هذا المقام للدلالة على وحدة صفة القاضي ، فإن المشرع الدستوري ترك عبارة عامة تحتاج للتداول فيها ألا و هي عبارة « السلطة التي يتبعون لها « فما المقصود بهذه السلطة و ما هي أثار دلالاتها المحتملة؟ هذا ما سنتطرق له في الفقرة الموالية .
المفهوم العام ل « السلطة التي يتبعون لها « كمؤشر على التأويل الديمقراطي
إن المقاربة المعتمدة في تبيان معنى و مفهوم عبارة : « السلطة التي يتبعون لها « التي أوردها المشرع الدستوري في فصلين هما 110 و 116 من الدستور ، يجب أن تكون مقاربة ديمقراطية أي متصفة بالمواصفات التي تخضع للنطق المولوي الذي جاء بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 و الذي جاء فيه بالحرف : « أما الإصلاح القضائي ، فاعتبارا لبعده الإستراتيجي ، فإنه يتعين ، فيما يرجع إلى مهمة البرلمان ، اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة . وهنا نود ، مجددا أن ندعوكم إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية ، كما نحث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ، على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها. « فالمقاربة الظاهرة و الباطنة أو الالتزام الدقيق بروح و مضمون مقتضيات الدستور تقتضي إعطاء التفسير الذي ينسجم و الاستقلال المطلق للسلطة القضائية ، سواء قضاء الحكم أو قضاء النيابة العامة . و من ثم نجد أن أهم ما يجب إثارة الانتباه إليه هو كيف يمكن قراءة عبارة :» السلطة التي يتبعون لها « ؟ هل يجب قراءتها على أنها توجه نحو إبقاء النيابة العامة تابعة لسلطة وزير العدل و الحريات أم أن إيراد تلك العبارة بذلك الشكل جاء من أجل ترك المجال للتداول في الشكل الذي يتعين أن تكون عليه السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة و التي ليست هي وزارة العدل و الحريات ؟
إن ما يمكن الترجيح به هو ما اتجهت إليه الإرادة الملكية الواردة في الخطاب الذي قدم به جلالته مسودة الدستور بتاريخ 17 يونيو 2011 و الذي جاء فيه : « ... كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كمؤسسة دستورية يرأسها الملك ، لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء ، وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي، وتخويل رئيس محكمة النقض ، مهام الرئيس المنتدب ، بدل وزير العدل حاليا، تجسيدا لفصل السلط « ؛ فمن خلال هذا الخطاب يتضح بأن المقاربة القائمة على فصل السلطات كانت واضحة جلية عند التنصيص على استبعاد وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لفصل السلط .
لعل هذه المقاربة هي ما يجب اعتمادها للقول بأن المراد بإيراد عبارة «السلطة التي يتبعون لها «، إنما جاءت من أجل ترك المجال للتداول حول شكل السلطة التي ستصبح مسيرة لأعمال النيابة العامة، بدل وزير العدل كما هو عليه الأمر حاليا. ومن المفيد جدا في هذا السياق، القول إن هذه المقاربة تنسجم إلى أقصى الحدود مع التوجهات الدولية الرامية إلى إقرار استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
ومن ثم، فإن التفسير الذي نراه ديمقراطيا، هو ذلك الذي ينسجم والتزامات المغرب الدولية من جهة، وما أوصت به هيأة الإنصاف والمصالحة التي دعا جلالته إلى دسترتها، وما ناضلت من أجله الجمعيات وكل الفاعلين الحقوقيين، من أجل تحقيق فصل تام وحقيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية، وفك كل أشكال الارتباط بينهما، لأن ذلك كله هو السبيل لضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات من غير تدخل للسلطة التنفيذية، كما جاء به الدستور كالتزام ملقى على عاتق القضاة جميعا وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور والذي نص على أنه «يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون».
وبناء على ما ذكر، فإن ما يستخلص من العبارة موضوع النقاش، هو أنها جاءت من أجل بلورة تصور جماعي متوافق عليه بغرض الاتفاق على الشكل، الذي يتعين أن تكون عليه الجهة التي ستشرف على عمل النيابة العامة، هل ستكون جهة منتخبة أم معينة؟ وهل ستكون الجهة التي ستشرف على النيابة العامة فرادا واحدا أم هيأة جماعية ؟ وهل هذا التعيين، يجب أن يكون مضبوطا بضوابط أم بغير ضوابط ؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي يجب أن تنصب النقاشات حولها.
وإسهاما منا في إثراء النقاش، حري بنا أن نثير الانتباه إلى أن المرحلة التاريخية التي نعيشها تعتبر بحق فرصة، نعبر من خلالها على انخراطنا العملي والحقيقي في المنظومة الدولية. وبهذه المناسبة، يمكن إثارة الانتباه إلى أن ما خلصت له لجنة فينيسيا باعتبارها لجنة أوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، أرضية مشتركة تجسد المشترك الإنساني في التنظيم والتأطير لعمل النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.
لقد شكل موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في هذه الظرفية التاريخية نقاشا مستفيضا، داخل أجهزة الاتحاد الأوربي وانتهى الأمر إلى تكوين لجنة أوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، أطلق عليها اسم «لجنة فينيسيا» التي أعدت أخيرا بتاريخ 3 يناير 2011 تقريرا حول الآليات الأوربية المتعلقة باستقلال النظام القضائي في جزئين يهم الثاني منهما النيابة العامة تحت عدد 494/2008 وتم تبنيها خلال الدورة 85 بفيينا انطلاقا من مجموعة من الوثائق الدولية المتعلقة بالنيابة العامة والتي يمكن حصرها في ما يلي :
- التوصية عدد 2000/REC . 19 الصادرة عن لجنة وزراء المجلس الأوربي حول درو النيابة العامة داخل المنظومة القضائية الجنائية.
- المبادئ التوجيهية الخاصة بأعضاء النيابة العامة لسنة 1990 الصادرة عن الأمم المتحدة .
- مبادئ المسؤولية المهنية وإعلان الحقوق والواجبات الأساسية لوكلاء النيابة العامة ونوابهم لسنة 1999 الصادرة عن «الجمعية الدولية لوكلاء النيابة العامة».
- إعلان بوردو الصادر عن المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين والمجلس الاستشاري لوكلاء النيابة العامة الأوربيين حول موضوع «قضاة ووكلاء نيابة عامة في مجتمع ديمقراطي».
- الخطوط التوجيهية الأوربية حول دور النيابة العامة المجلس الأوربي بودابيست 2005 .
كل هذه الوثائق الدولية أجابت بوضوح عن تساؤلات وضعية النيابة العامة في المنظومة القانونية الدولية، وأكدت بالملموس أن النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية تمارس عملها في التصاق وطيد بالحقوق والحريات، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية.
وقد كان من نتائج التوصية الأوربية المذكورة أعلاه أن عمدت مجموعة من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوربي إلى تعديل دساتيرها وقوانينها الداخلية من أجل تحيينها وإرساء طابع الاستقلالية على قضاء النيابة العامة، منها على الخصوص المملكة البلجيكية التي تعتبر بحق التلميذ النجيب في مجال، الاستجابة للتوصيات الأوربية والدولية على حد سواء. في هذا المجال عدلت بلجيكا المادة 151 من دستورها لتنص صراحة على استقلالية النيابة العامة وفصلت تلك الاستقلالية في العديد من القوانين التنظيمية، وذلك على الشكل التالي :
إحداث ما يسمى بـمجمع الوكلاء العامين
College des Procureurs Généraux
، ويتألف من مجموع الوكلاء العامين بالمملكة وتتحدد مهامه في تحديد السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها وكذا حسن تدبير عمل النيابة العامة ولتحقيق هذه الأهداف، يحق لهذا المجمع اتخاذ قرارات آمرة للوكلاء العامين بالمملكة ووكلاء الملك وكافة أعضاء النيابة العامة، ولا يحق لهم أن يتخذوا قرارات تخص أفرادا بعينهم، ولا أن تنصب قراراتهم على نيابة عامة أو عضو فيها دون غيرهم، إنما يشترط أن تكون التعليمات عامة ومجردة أي أن تطبق على جميع النيابات العامة وعلى كافة أعضائها وأن تكون مجردة لا تمس شخصا أو مجالا بعينه وإنما على عموم المواطنين.
ولتحقيق هذه المهمة، يجتمع مجمع الوكلاء العامين للملك مرة في الشهر على الأقل، ويجب أن تكون لهم أيضا اجتماعات مع مسؤولي الأمن والشرطة القضائية ومع مجلس وكلاء الملك تحت رئاسة أحد الوكلاء العامين بالتناوب، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختصاصات التي يتمتع بها الوكيل العام للملك ببروكسيل في مجال الإرهاب والجرائم المالية والاقتصادية وغيرها.
مجلس وكلاء الملك
يجتمع جميع وكلاء الملك داخل إطار يسمى مجلس وكلاء الملك، من أجل اطلاع مجمع الوكلاء العامين للملك على سير الأشغال والإشكاليات المعترضة في إطار تطبيق القواعد الموحدة للسياسة الجنائية وكل ما له علاقة بعمل النيابة العامة.
لما كان الأمر كذلك، يحق لنا الآن التساؤل عن وضعية وزير العدل والحريات في ظل استقلالية النيابة العامة في إطار المعادلة الصعبة المتمثلة في الموازنة، بين الحفاظ على مبدأ استقلالية قضاء النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وبين دور وزير العدل والحريات في تطبيق سياسة حكومته في مجال العدل، التي هو مسؤول عنها أمام حكومته التي بدورها مسؤولة عنها أمام البرلمان؟.
الجواب نجده أيضا في التوصيات الأوروبية لحقوق الإنسان، والوثائق الدولية ذات الصلة المذكورة أعلاه، والتي تحدد علاقة الجهة الحكومية المكلفة بالعدل بقضاء النيابة العمة في كون وزير العدل- باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية- والساهر على تطبيق برنامجها في مجال العدل والحريات، يمكنه أن يحدد لمجمع الوكلاء العامين للملك التوجهات العامة للسياسة الجنائية في مجال الأبحاث والتحريات، شريطة أن تكون هذه التوجهات عامة ومجردة، لا تمس شخصا أو هيأة معينة، ولا نيابة عامة أو عضو فيها دون الآخر، و يتولى مجمع الوكلاء العامين بعد ذلك تبليغها إلى باقي أعضاء النيابة العامة من خلال مجلس وكلاء الملك .
يمكن في هذا الإطار أن يحضر وزير العدل والحريات اجتماعات مجمع الوكلاء العامين للملك، من أجل أن يبسط توجهات الحكومة في مجال العدل والسياسة الجنائية، والإجراءات والآليات الكفيلة بتطبيقها، والموارد المالية واللوجستيكية المعتمدة لذلك، والمخصصة من قبل الحكومة لتنفيذها. ماعدا ذلك، يبقى وزير العدل والحريات بعيدا كل البعد عن كنه وعمل النيابة العامة، ضمانا لمبدأ استقلالية النيابة العامة وفق المفهوم الذي حددته المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وأكدته مجموعة من قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي وجهت ضربات موجعة لفرنسا، بسبب توغل وزير العدل في نيابتها العامة وهو ما سوف نبسطه في المطلب الموالي .
وخلاصة القول في هذا المضمار، هو أن اعتماد التأويل الديمقراطي لعبارة «السلطة التي يتبعون لها « يجب أن يسير نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية المبني على الفصل الصريح لها عن السلطة التنفيذية، لأنه من غير استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فلن يمكننا التحدث عن استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
استقلال القضاء رهين باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
بالرجوع إلى تاريخ العلاقة القائمة من وزارة العدل والنيابة العامة، سنجد أن أهم ملامح تلك العلاقة قائمة على محورين، أولهما محور التنقيط والتقييم وثانيهما محور التوجيه والإشراف، وبالتالي فإنه من المفيد جدا التساؤل حول ما إذا كان الدستور الجديد لسنة 2011 قد حافظ على نفس مقومات تلك العلاقة أم لا ؟ وهل لذلك أثر على تصور اكتمال الاستقلال المنشود للسلطة القضائية؟.
من حيث التنقيط، نجد أن السلطة التي كان يتمتع بها وزير العدل، تتجسد في كونه الجهة المكلفة بتنقيط عمل الوكلاء العامين للملك وفق مقتضيات الفصل 3 من المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم، وبالتالي فإن سلطته على جهاز النيابة العامة كانت قائمة على أمرين، أولهما أنه الرئيس الإداري المباشر الذي يتولى أمر التنقيط، بالإضافة إلى أنه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يجعله متمكنا من كل أسباب القوة والسلطة ويكون له مركزا متميزا في إطار المنظومة القضائية. وما يزيده تميزا هو كون جميع القرارات التي قد تتخذ في حق أعضاء النيابة العامة غير قابلة للطعن فيها، وبالتالي فإن سلطة التنقيط كانت تلعب دورين أحدهما ظاهري وهو التقييم بمفهومه الإيجابي، وثانيهما ذو طابع سلبي يتمثل في كونه وسيلة ضغط على أعضاء جهاز النيابة العامة.
لكن بمقتضى الدستور الجديد، فإننا نجد أن الوضع قد تغير، خاصة أن أهم مقتضى جاء به الدستور الجديد في هذا الباب هو مسألة الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة. وإمكانية الطعن هذه مكن منها المشرع الدستوري كلا من قاضي النيابة العامة وقاضي الحكم على اعتبار أن المقتضى المتعلق بها جاء عاما ولا يخص فئة دون أخرى.
فامتلاك القاضي بصفة عامة لإمكانية الطعن، يعد مؤشرا حقيقيا حول إرادة المشرع الدستوري لتمكين أعضاء السلطة القضائية، سواء أكانوا عاملين بقضاء الحكم أو بقضاء النيابة العامة من استقلال حقيقي ينأى بهم عن كل تأثير، خاصة أن إحساسهم بوجود ضمانات حقيقية أثناء أدائهم لمهامهم، يشكل عامل دفع لتمتعهم بالاستقلال المطلوب وبالتالي يلقي على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذا الاستقلال.
وأمام هذا الوضع الجديد، يمكن إعادة النظر في علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، فمن جهة يجب التأكيد بأن مسألة التنقيط في حد ذاتها يمكن أن تكون وسيلة للضغط على قرارات القاضي، لذلك جعل المشرع الدستوري هذه المسألة نسبية لا تخضع إلى مزاج الجهة المسؤولة على تقييم عمل القاضي وإنما يمكن لهذا الأخير المنازعة فيها وإثبات أن القصد من ذلك هو التأثير على قراراته. ومع إمكانية تصور صحة الطعون، فإنه يكون من الممكن جدا تصور قيام الضرر، فهل يمكن في مثل هذه الحالات أن نتصور أن وزير العدل شخصيا هو الذي أحدث الضرر أم أن مؤسسة وزير العدل هي المحدِثة للضرر؟.
إن الجواب على هذا السؤال له أهمية خاصة، ذلك أن الوقوف على حقيقة الجواب من شأنه أن يوضح أكثر مسألة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، فإذا كان معروفا أن المتسبب في الضرر هو الشخص الطبعي ذاته - وليس الشخص المعنوي ممثلا في الإدارة - في حالة تقييم عمل الآخرين، فإنه في هذه الحالة يمكن القول بأن المسؤولية الشخصية لوزير العدل كفكرة ستكون حاضرة بقوة، فكيف يمكن التعامل مع هذه الوضعية في ظل افتراض وجود تسلسلية هرمية مؤثرة
بموجب آلية التنقيط ؟
إن هذا الوضع الذي نخلص إليه بناء على قراءة متكاملة لمقتضيات الدستور، سيضعنا أمام نتيجة واحدة وهي أنه لا يمكن اعتبار وزير العدل متمتعا بالصفة القضائية كما كان الأمر من قبل، ولا يمكن له الإشراف على مؤسسة النيابة العامة، لأن الجهة التي ستشرف على هذه الأخيرة يجب أن تكون قادرة على تقييم العمل القضائي باعتباره أهم ما يقوم به أعضاء النيابة العامة. وبالتالي فإن الجهة التي يتعين أن يتبع لها قضاة النيابة العامة يجب أن تتوفر فيهم الصفة القضائية حتى يمكنهم تملك سلطة التنقيط التي تبقى في حد ذاتها نسبية ويمكن الطعن فيها باعتبارات أخرى غير تلك التي تتعلق بوزير العدل .
إن هذا الوضع الذي أصبح يطبع علاقة النيابة العامة بوزير العدل على مستوى التنقيط، لا يقل أهمية عن الوضع الذي أصبح يطبع ذات العلاقة على مستوى التوجيه والإشراف.
إن الوجه الثاني للعلاقة التي كانت تطبع علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، تتمثل في ما كان يمتلكه هذا الأخير من أدوات توجيهية لعمل النيابة العامة وخاصة في ما يتعلق بالدوريات والمناشير التي كانت ترسم الطريق لعمل النيابة العامة في مجموعة من القضايا، وأغلبها يتعلق بالطابع القضائي، لذلك فإن هذه الآلية بدورها أصبح من الجائز التساؤل حولها في ظل أحكام الدستور الجديد.
فإذا كان من المعلوم أن عمل النيابة العامة يعتبر جزء من عمل القضاء بموجب منطوق الفصل 117 من الدستور، على اعتبار أن عملها يقوم على حماية حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم، فإن هذا الطابع القضائي يأبى التوجيه لما فيه من مس باستقلالية القرار القضائي . ومن ثم فإن العمل على إعادة النظر في علاقة وزير العدل بالنيابة العامة على مستوى التوجيه والإشراف يجب أن يعاد فيها النظر لتنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.
وفي هذا الإطار، يمكن التركيز على أمرين، أولهما نقد المرجع التاريخي لعلاقة النيابة العامة بوزارة العدل، وثانيهما الارتكاز على مقتضيات الدستور نفسه.
وإذا كانت موجة الحقوق والحريات التي تجتاح العالم الثالث في الآونة الأخيرة قد تأثرت بمجموعة من العوامل والمتغيرات الاجتماعية التي شهدتها بعض الدول، فإن المغرب جسد استثناء ممتدا في الزمان، ومتصلا بعمق الالتزامات الواقعة على عاتقه؛ ذلك أن نظرة المغرب للسلطة القضائية كانت محط نقاش مجتمعي مستفيض أدلت فيه كل المكونات الاجتماعية بدلوها، حتى لئن المذكرات و الأوراق و التوصيات التي صدرت عن تلك الجمعيات و الهيآت لا تعد ولا تحصى، الشيء الذي كان حاسما في تأسيس نظرة متقدمة وحداثية لفكرة استقلال السلطة القضائية استقلالا حقيقيا .
ولقد كانت التجربة الرائدة التي شهدها المغرب في مطلع الألفية الثالثة، مثالا يحتدى به في مجال العدالة الانتقالية ؛ إذ شكلت هيئة الإنصاف والمصالحة قوة الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المغربية من حيث إعادة النظر في مجال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
ولقد كان المغرب صريحا إلى أقصى الحدود، مع نفسه، عندما اعترف بالتجاوزات الخطيرة التي شهدها المغرب خلال فترة ما قبل إنشاء الهيئة المذكورة، إذ شكلت الشهادات التي تم الإدلاء بها والتي نشرت بمختلف وسائل الإعلام صدمة حقيقية للضمير المجتمعي، وقد كان من المؤلم جدا أن يكون للقضاء دور أساسي في كل المآسي و الانتهاكات التي شهدتها تلك الحقبة من التاريخ الحديث للمغرب . ولعل التوصيات التي خرجت بها هيأة الإنصاف والمصالحة لدليل على قوة الدور الذي لعبه القضاء إبان تلك المرحلة وهو ما دفع بالهيأة المذكورة إلى ضرورة التوصية بحتمية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية استقلال تاما، وذلك من أجل النأي بالقضاء عن لعب أدوار سياسية يستعمل من خلالها في تصفية الحسابات السياسية بين مختلف الفرقاء السياسيين.
ولأهمية تلك الخلاصات والتوصيات، فقد اعتبرت المدخل الحقيقي لتأسيس دولة الحق و القانون الذي يلعب فيها القضاء الدور الأساسي والحاسم في إرساء التوازنات الاجتماعية القضائية على أساس التطبيق السليم للقانون؛ ومن تم فقد ظهرت مجموعة من المؤشرات التي دلت على استجابة الدولة المغربية لتلك التوصيات وتفاعلها معها . و قد كان خطاب 09 مارس 2011 التاريخي الذي نصبت فيه لجنة مراجعة الدستور معبرا عن أوج ذلك التجاوب، إذ أنه من المعلوم أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان واضحا وصريحا في الدعوة إلى التقيد بتلك التوصيات والعمل على دسترتها، وهو الأمر الذي شكل بلا منازع قوة الرغبة في بناء صرح الدولة الحداثية والأصيلة، دولة يسود فيها القانون وتحترم الحقوق والحريات سواء أكانت فردية أو جماعية، و قد كان ذلك كله مبني على سبعة مرتكزات كما جاء بالخطاب المولوي السامي، منها « ... ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، سيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب ؛ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه … «
فالنطق الملكي جسد بحق قوة النظرة و رصانتها عندما أكد على أن الهدف من دسترة توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الالتزامات الدولية للمغرب، مع العمل على الارتقاء بالقضاء إلى مرتبة سلطة قضائية مستقلة، كل ذلك من أجل توطيد سمو الدستور وسيادة القانون والمساواة أمامه .
فتلك الأهداف السامية لا يمكن الوصول إليها إلا بوجود سلطة قضائية قوية قائمة على الاستقلال المطلق عن جميع ما يمكن أن يؤثر فيها وفي قراراتها . ومن هنا فإن التساؤل موضوع هذه المداخلة يجد سنده في هذه النظرة المتقدمة لشكل بناء الدولة المغربية الحديثة، إذ أن أول ما نصطدم به في خضم الحديث عن مفهوم السلطة القضائية هو هل تعتبر النيابة العامة جزء لا يتجزأ من تلك السلطة أم أنها لا تعتبر كذلك ؟ وتبعا لذلك هل يعتبر استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل تحقيقا للاستقلال الكامل والتام والمنشود للسلطة القضائية أم لا ؟
إن الحديث عن هذا الإشكال يعتبر صلب وجوهر الإشكالات التي يتعين أن تكون موضوع تداول ديمقراطي تغلب فيه المصلحة العليا للوطن بدل التجاذبات المصلحية الضيقة، ذلك أن تحديد الطبيعة القانونية لمركز النيابة العامة في الجهاز القضائي سيحدد لا محالة الوجهة التي سيتجه لها الجواب عن التساؤل المطروح؛ أخذا بعين الاعتبار أن النقاش يجب أن يتسم بنوع من الاجتهاد والابتكارية التي يتعين أن تطبع الفكر الحقوقي والقانوني المغربي استجابة للنداء الملكي الذي تم التعبير عنه بمناسبة تنصيب اللجنة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة ؛ و الذي جاء فيه : « وإننا ننتظر منكم، لما هو معهود فيكم من روح المسؤولية الوطنية العالية انتهاج الاجتهاد الخلاق والإصغاء والانفتاح للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة».
وفي هذا السياق فإننا نرى أن توضيح الرأي بشأن مدى توقف تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية على استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية استقلالا تاما يجب أن يمر عبر مجموعة من الخطوات المنهجية، ابتداء من بسط الآراء التي تعرضت لتحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة و ما واجهته تلك الآراء من انتقادات، مرورا بالتزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي وما يرتبه ذلك من إعادة النظر في الرؤية التقليدية للنيابة العامة في المغرب، وصولا إلى النظرة الدستورية المتقدمة للطبيعة القانونية للنيابة العامة.
إن الحديث عن النيابة العامة في المنظومة القضائية المغربية، لهو حديث عن تجذر تاريخي موسوم بنوع من النظرة الأمنية التي كانت تتحكم في عمل هذا الجهاز، خاصة أن المغرب، الذي مر من مجموعة من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قد وجد في بعض التوجهات الفقهية والقانونية ما يشفي غليله من أجل تحديد الطبيعة القانونية للنيابة العامة، إلا أن تحديده لتلك الطبيعة كان موسوما بنوع من المرونة انسجاما منه مع التزاماته الدولية التي ما فتئ يعبر عنها منذ أول دستور للمملكة لسنة 1962، وأخذا بعين الاعتبار لما جاء به المرجع التاريخي الحديث للمنظومة القانونية المغربية والمتمثل في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. إلا أن زوال تلك الظروف الاستثنائية ودخول المغرب عهدا من الاستقرار السياسي والمجتمعي، دفعه إلى ضرورة إعادة التفكير في طريقة نظرته للنيابة العامة طبيعة ودورا وسلطات بما ينسجم أكثر مع التوصيات والتقارير الدولية في هذا المضمار.
واستنادا على ذلك، فمن المفيد التطرق إلى موضوع النيابة العامة في هذا الشق الأول من هذه المداخلة من خلال نقطتين أساسيتين، أولاهما تتعلق بمركز النيابة العامة في الأنظمة القضائية على ضوء التوجهات الفقهية والانتقادات التي لاقتها تلك التوجهات، في حين سنفرد النقطة الثانية للتفصيل في ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة من أجل استجابة حقيقية لالتزامات المغرب الدولية.
الطبيعة القانونية للنيابة العامة في التوجهات الفقهية
لقد تعددت الآراء الفقهية التي تطرقت للطبيعة القانونية للنيابة العامة، وتأثرت تلك التوجهات بمجموعة من المؤثرات التي طبعت الحقب التاريخية للدول، فكانت تنطلق غالبا من القراءة البعدية لما كانت عليه النيابات العامة في مختلف الأنظمة القضائية. ولذلك فإن الفقهاء القانونيين كانوا دائما ولا يزالون يؤسسون نظرتهم على أسس واقعية و ليست قانونية، إذ أن تطرقهم للطبيعة القانونية للنيابة العامة لم يكن من منطلق تحديد الشكل والطبيعة التي يجب أن تكون عليه تلك المؤسسة وإنما من أجل وصف واقع معيش، وهو الأمر الذي جعل تلك التصنيفات تكون محل انتقاد يأتي من الفقه القانوني ذاته.
التحديد الفقهي للطبيعة القانونية للنيابة العامة
تتوزع النظرة الفقهية للطبيعة القانونية للنيابة العامة على ثلاثة توجهات أساسية، أولها أن النيابة العامة جهة إدارية، وثانيها أنها جهة قضائية، في حين ترى النظرة الثالثة أن النيابة العامة هي جهة مختلطة الطبيعة تجمع بين الإداري و القضائي، وقد كان لكل توجه على حدة مبرراته، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن تلك التوجهات الفقهية لم تكن توجهات مؤسسة كما هو الحال بالنسبة إلى معظم المؤسسات القانونية الفكرية والمؤسساتية، وإنما كانت توجهات قائمة على الملاحظة والاستنتاج لما هو موجود في الأنظمة القضائية المختلفة.
وفي هذا السياق يمكن التطرق لكل توجه على حدة بصورة مقتضبة، على أن يكون ذلك ممهدا للفقرة الموالية التي سنتناول فيها الانتقادات الموجهة لتلك الرؤى .
النيابة العامة ذات طبيعة إدارية
يرى أنصار هذا الاتجاه أن تبعية النيابة العامة للسلطة المباشرة للسلطة التنفيذية يجعلها تمتثل للتوجهات العامة التي تسطرها الحكومات في مجالات الحياة اليومية، ولذلك فإن وجودها في المحاكم يعتبر امتدادا للسلطة التنفيذية في الجهاز القضائي، وأنها تعبر عن وجهة النظر الحكومية في القضايا المعروضة على أنظار القضاء، ويرى أنصار هذا الرأي أن النيابة العامة لا يمكن أن تتحرك إلا بإذن من السلطة الحكومية التي تتبع لها، و بالتالي فإن كل المواقف والاختصاصات التي تمارسها النيابة العامة في هذا الصدد تستند إلى وجود سلطة تسلسلية وتراتبية، قوامها أن وزير العدل باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية هو الرئيس المباشر للنيابة العامة وهو البوابة الرئيسية لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء .
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية
ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن النيابة العامة، ما هي في آخر المطاف إلا مجموع الأفراد المنتمين إلى السلطة القضائية، وأن حملهم لصفة القضاء تجعلهم جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية بمفهومها العام، زيادة على أن جل الأنظمة القضائية ترى بعدم التخصص وأن القاضي الواحد يمكن له أن يتدرج خلال مساره المهني بين ممارسة قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، وأن السبب في ذلك راجع إلى وحدة المسار المهني للقضاة عموما انطلاقا من بداية تكوينهم إلى غاية بلوغهم سن التقاعد، وبالتالي فإنه من الإجحاف القول إن جهاز النيابة العامة يعتبر جهازا إداريا، بل هو على النقيض من ذلك فهو جهاز قضائي وهو جزء من السلطة القضائية بمفهومه المتعارف عليه في الأدبيات الدستورية والسياسية الكبرى.
النيابة العامة جهاز مختلط
على عكس الاتجاهين الأولين، اللذين يركزان على الطبيعة الأحادية والمتفردة للنيابة العامة، يذهب الاتجاه الثالث إلى أن للنيابة العامة طبيعة مزدوجة تجمع بين ما هو إداري وما هو قضائي، ويستند هذا الاتجاه في دراسته للطبيعة القانونية للنيابة العامة على معيارين، المعيار العضوي والمعيار الوظيفي.
فمن حيث المعيار العضوي، يستند هذا الاتجاه إلى أنه لا يمكن تفسير التراتبية الإدارية التي تطبع عمل النيابة العامة إلا بكونها جزءا لا يتجزأ من مفهوم المرفق الإداري الذي يطبع عمل دواليب ومرافق وزارة العدل، وبالتالي، فإنه على غرار ما تخضع له تلك المرافق والدواليب من سلطة رئاسية لوزير العدل، فإن النيابة العامة تخضع للسلطة الرئاسية نفسها.
أما من حيث المعيار الوظيفي، فإن هذا الاتجاه الفقهي يرى أن النيابة العامة وإن كانت تخضع للسلطة الرئاسية لوزير العدل في بعض الأنظمة القضائية، فإنها تخضع من حيث عملها لمجموعة من القواعد القانونية التي تؤطر قواعد اختصاصاتها، وبالتالي فهي عند تطبيقها لتلك القواعد القانونية تتقمص دور الجهاز القضائي، كما أن الأعضاء المكونين لجهاز النيابة العامة قضاة في الأصل، وبالتالي، فإنهم يختلفون من حيث الإطار القانوني المنظم لوضعيتهم عن القانون المنظم للوضعية المهنية لباقي أعضاء إدارة وزارة العدل.
إن هذه الاتجاهات الثلاثة التي تم التطرق لها والتطرق لأسسها، تستند كلها على دراسة العينات القضائية لمجموع الأنظمة السائدة في العالم، وبالتالي فإن الخلاصات التي خلصت لها لا تنفك تتعرض لمجموعة من الانتقادات التي يوجهها الفقهاء أنفسهم لتلك الطبيعة القانونية للنيابة العامة وهو ما سنتطرق له في الفقرة الموالية.
إن الانتقادات الموجهة إلى الطبيعة القانونية للنيابة العامة ترتكز على مجموعة من المرتكزات، منها ما يرتكز على المقوم التاريخي ومنها ما يستند على الفكر الحقوقي، و منها ما يراعي مقومات أخرى، لكن ما سنركز عليه في مداخلتنا هذه، هو المقومان التاريخي والحقوقي .
إن الذين ارتكزوا على البعد التاريخي في نقد الطبيعة القانونية للنيابة العامة، ذهبوا إلى أن اصطباغ النيابة العامة بالطبيعة الإدارية، يجد سنده عند نشأة هذا الجهاز خاصة عندما ثارت الشعوب الأوربية في وجه الإقطاعية، و لما توجست هذه الأخيرة من الأمر خيفة، ابتدعت هذا الجهاز من أجل إظهاره وكأنه يدافع عن المصلحة العليا للمجتمع، إلا أنه في حقيقته لم يوجد إلا من أجل ضمان طريقة قانونية للتدخل في الجهاز القضائي وعمله من أجل حماية المصالح التي تتمتع بها نفس الطبقة الإقطاعية. ويرى موجهو هذه الانتقادات إلى أن مجموعة من الأنظمة السياسية لم تستوعب حجم التحولات التي عرفها الفكر الإنساني، وما أنتجته تلك التحولات من إعادة النظر في مجموعة من المسلمات وعلى رأسها اعتبار الدولة كصاحبة امتياز إلى دولة في خدمة المواطن، و بالتالي فإن أساس اعتبار النيابة العامة جهازا إداريا لم يعد له مبرر، لأنه لم يعد مقبولا اعتبار الدولة فوق القانون، وبالتالي لم يعد لوزير العدل أي دور في حماية مصالح الدولة التي يتعين أن تخضع في آخر المطاف للقانون وسيادته، بما يمثل ذلك من أسس للدولة الديمقراطية الحديثة.
وبالموازاة مع الانتقادات الموجهة على أساس تاريخي، ظهرت مجموعة من الانتقادات التي ركزت على البعد الحقوقي في انتقاد الطبيعة القانونية للنيابة العامة. و يرى أصحاب هذا التوجه النقدي أنه في ظل ما عرفه العالم من تحول في الفكر الحقوقي خلال القرن العشرين خصوصا بعيد الحرب العالمية الثانية، فإن مجموعة من الأنظمة السياسية الرائدة في الديمقراطية ارتأت التخلي عن المقاربة الإدارية والأمنية لعمل النيابة العامة، وتعويضها بالنظرة الحقوقية، منطلقة من كون النيابة العامة في الأصل، تعتبر جزءا من السلطة القضائية التي يعود إليها وحدها أمر حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
ومن ثمة يذهب أصحاب هذا الانتقاد المؤسس على البعد الحقوقي، إلى أنه في ظل مناخ متسم بالفكر الحقوقي لا يمكن التسليم بكون النيابة العامة ذات طبيعة إدارية و حتى ذات طبيعة مزدوجة، إذ يرى هذا الفريق أن اعتبار النيابة العامة جهازا إداريا من شأنه أن يطلق يد الدولة في التصرف في الحقوق والحريات التي تم إقرارها عبر نضالات إنسانية متواصلة، وبالتالي فإن هذه الحقوق ستبقى مهددة مادامت النيابة العامة تحت السلطة والإشراف المباشرين للسلطة التنفيذية مجسدة في وزارة العدل. كما يرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا يمكن تصور الطبيعة المختلطة للنيابة العامة، لأنه من شأنه أن ينتقص من مركزها ومن الاختصاصات التي خولت لها باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكنتيجة منطقية لكل ذلك، فإنه لا يمكن القول باستقلال السلطة القضائية استقلالا فعليا ومطلقا وفق ما تعارف عليه الفكر السياسي المتقدم. وعلى ذلك، فإن اعتبار النيابة العامة جهازا مختلطا يدل على كون تطبيق القانون في مجموعة من الأحوال سوف يكون مطبوعا بمزاحية السلطة التنفيذية خاصة في ظل وجود مجموعة من القواعد القانونية التي تؤطر عمل النيابة العامة، كما هو الأمر مثلا بالنسبة لسلطة الملاءمة، التي يمكن أن تكون سيفا ذو حدين إما من أجل الإفلات من العقاب أو من أجل التعسف في استعمال تلك السلطات في ظل ضوابط قانونية، وهو ما يشكل جوهر الاستعمال السياسي للنيابة العامة بين الفرقاء من أجل تصفية الحسابات على حساب ضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون وبناء المؤسسات الخاضعة لحكمه .
وتأسيسا على كل ذلك، فإن المنتقدين للطبيعة الإدارية أو المختلطة للنيابة العامة، يخلصون إلى أن اعتبار هذه الأخيرة ذات طبيعة قضائية، هو ما يجب تبنيه على اعتبار أن هذه الطبيعة تنسجم والمهام الموكولة إليها، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، مادامت أنها تسهر على حماية و ضمان تمتع الأفراد والجماعات بالحقوق والحريات سواء عند مثولهم أمام القضاء أو قبل ذلك أو بعده. ولعل هذا الاتجاه الذي يناصره هذا الفريق هو ما ينسجم والتوجه العالمي نحو إقرار وتكريس مناخ حقوقي يطبع تعامل وعلاقة الدولة بالخاضعين لسلطانها وفق ما أقرته ولا تزال تقره المواثيق والعهود الدولية، لذلك يدعو أنصار هذه الانتقادات إلى ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة على ضوء ما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية، ومن تلك الجهات المدعوة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة نجد المغرب خاصة بعد إقرار دستور 2011 ، وبناء على ما التزم به من عهود والتزامات أمام المنتظم الدولي .
ضرورة إعادة النظر في الطبيعة القانونية للنيابة العامة
إن الطبيعة القانونية للنيابة العامة بالمغرب تجد سندها في ما يمكن أن نسميه بالبعد التاريخي أو الخلفية التاريخية، سواء من حيث التاريخ الحقيقي الذي هو أحداث ووقائع، أو من خلال الخلفية التاريخية للمنظومة القانونية المجسدة في القانون الفرنسي . لذلك فإن هذه الطبيعة يجب أن يتم التعامل معها على هذا الأساس، ومن ثم فإن المقاربة التاريخية هي التي يتعين الارتكاز عليها من أجل فهم أعمق وأشمل للطبيعة القانونية للنيابة العامة في المنظومة القانونية المغربية.
فبالرجوع إلى التاريخ الحديث للمغرب كدولة مستقلة ، نجد أن هذا الأخير شهد مجموعة من الأحداث التي طبعت المناخ السياسي خاصة خلال فترة السبعينات، الشيء الذي دفع مركز القرار إلى التعامل مع المؤسسات الإستراتيجية على نحو من المقاربة الأمنية التي طبعت مجمل القوانين التي لا تزال سارية إلى حينه، ومن تلك القوانين ما يرتبط بالنظام القضائي المغربي .
إن المغرب ، تعامل مع القضاء عموما باعتباره مرفقا من مرافق الدولة التابعة لوزارة العدل، ومن ثم، فإن الأحداث التي تم الكشف عنها من خلال الخلاصات التي انتهت إليها هيأة الإنصاف والمصالحة، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك الدور السلبي الذي لعبه القضاء في تلك الفترة، الشيء الذي جعله مجرد أداة بيد الدولة، ولم تكن لهذه الأخيرة أية تأثيرات لولا تحكمها في جهاز النيابة العامة تحكما يكاد يختفي معه وجهها القضائي، فمن التحكم في المسار المهني لرجال القضاء المشتغلين بالنيابة العامة إلى التدخل في القرارات التي قد تتخذها النيابات العامة، إلى ما يشكل ذلك من تأثير على المسار الطبيعي للقضايا المنظورة من القضاء. ولذلك فإن معظم التجاوزات الحقوقية التي عرفها المغرب خلال الفترة التي كشفت عنها هيأة الإنصاف والمصالحة، أكدت أن القضاء كان له دور فيها، ومن ثم نادت توصيات الهيأة المذكورة بضرورة ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية و ضرورة إخراج السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل من السلطة القضائية إخراجا حقيقيا ومطلقا .
إذا ما نظرنا إلى طبيعة الخلاصات التي وقفت عليها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، نجد أنها تجسد أزمة عدم انضباط المنظومة القانونية المغربية لما تفرضه وتقره الاتفاقيات الدولية في ميدان الحقوق والحريات. إذ أن هذه الأخيرة وانطلاقا من الفكر الإنساني الراسخ بضرورة قيام الدول الحديثة على سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، ترى أن هذه الأخيرة يتعين أن تضمن لها الدول الاستقلال التام والحقيقي عن السلطتين السابقتين، كما يجب أن تلعب دورا أساسيا في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بما يضمن جعل المؤسسات والأفراد سواسية أمام القانون، ولن يتأتى ذلك، إلا باعتماد مقاربة حقوقية منسجمة مع ما تفرضه الإرادة الدولية من أجل التأكيد على الاندماج الفعلي والصريح للمغرب في المنظومة العالمية، سواء من خلال النص القانوني أو من خلال البعد المؤسساتي .
لذلك، فإن النظرة التي كانت تحكم المغرب، في تعامله على القضاء عموما والنيابة العامة على وجه الخصوص، يجب أن تتغير بما يثبت أن المغرب قد قام بالخطوات اللازمة لإظهار حسن نواياه أمام المنتظم الدولي، خاصة عندما يقر بالطبيعة القضائية لجهاز النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، في مناخ أصبح يتسم أكثر فأكثر بضرورة احترام الحقوق والحريات من خلال الممارسة اليومية مع الانضباط المطلق لحكم القانون. ونجد أنفسنا في هذه المداخلة غير مضطرين للتذكير بما توصي به الاتفاقيات الدولية من ضرورة ضمان أن يمثل الأفراد أمام جهات قضائية مختصة ، متسمة بالحياد والاستقلال وأن تصدر قراراتها باستقلال تام عن أي تأثير يمكن أن تخضع له وبخاصة من جهة السلطة التنفيذية. لذلك فإن المغرب وهو يعي هذه المتغيرات التي أصبحت أكثر إلحاحا، سيجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في المركز القانوني للنيابة العامة، وفي هذا الصدد، نجد أن مختلف الفاعلين الحقوقيين نادوا ولا يزالون بضرورة فصل السلطة القضائية عن نظيرتها التنفيذية فصلا ينسجم والمعايير الدولية المؤسسة لسلطة قضائية مستقلة، ما تظهر معه الإرادة المجتمعية التي توافقت على ضرورة الاحتكام إلى سلطة قضائية غير خاضعة إلا لحكم القانون، واعتبرت ذلك المدخل الحقيقي للدولة الحداثية والديمقراطية التي تضمن فيها الحقوق والحريات سواء للأفراد أو الجماعات.
وخلاصة القول، إن المغرب آمن بما لا يدع مجالا للشك بأن الظرف مواتيا لتبني المقاربة الحقوقية والقانونية للطبيعة القانونية للنيابة العامة، بعيدا عن كل تأثير لخلفيات تاريخية أو لمعايير مصلحية ضيقة غير المصلحة العليا للوطن، ويعضد كل ذلك الإجماع على ما تضمنه الدستور من إقرار باستقلال السلطة القضائية كسلطة واحدة غير قابلة للتجزئة بين شقيها المتمثلين في قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة.
لذلك وجب علينا التساؤل حول الكيفية التي تعامل معها المغرب من خلال دستور 2011 في ما يتعلق بتبني المقاربة القانونية الصرفة للنيابة العامة، التي من خلالها يتضح الانتصار للطبيعة القضائية للنيابة العامة.
المركز القانوني للنيابة العامة في الدستور الجديد
إن الحديث عن المركز القانوني للنيابة العامة على ضوء أحكام الدستور الجديد لسنة 2011، يعني تحديد طبيعتها القانونية على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، ومن أهداف ذلك الوقوف على مدى اعتبار النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية أم أنها منفصلة عنها. ولن يتأتى الوقوف على ذلك، إلا من خلال تبيان المحددات الدستورية العامة التي تؤسس للطبيعة القانونية للنيابة العامة وكذا لعلاقتها بوزارة العدل والحريات، حتى نتمكن من الوقوف على مدى اعتبار استقلال النيابة العامة شرطا أساسيا لاستقلال السلطة القضائية.
المحددات الدستورية للطبيعة القانونية للنيابة العامة
يعتبر الدستور المغربي لسنة 2011 فرصة تاريخية مكنت مختلف الفاعلين في حقل العدالة من تناول مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة، وما يستقطب الاهتمام كل ما يتعلق بالقضاء باعتباره جوهر وقلب تلك المنظومة. وإذا كان الكل مجمع على ضرورة استقلال السلطة القضائية، وحاسم في كون الدستور الجديد قد عمل على ضمان ذلك الاستقلال ونص عليه، فإن الجدل بقي محتدما حول مدى اعتبار النيابة العامة جزء من السلطة القضائية بالمفهوم الدستوري أم العكس. ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع موضوع النيابة العامة على أساس مقاربة دستورية تستند إلى مفهوم التأويل الديمقراطي القائم على اعتبار الغايات والأهداف الحقيقية التي قصدها المشرع الدستوري مع استغلال القاموس المفاهيمي الذي لجأ إليه المشرع الدستوري عند تفصيله لمقتضيات الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية.
ولعل أهم ما يثير الانتباه في هذا السياق هو أن المشرع الدستوري عمل على تبني وحدة المفهوم المتعلق بـ»القاضي» في جميع المقتضيات، وإن ظهر فيها نوع من التمييز بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة مع ترك باب الاجتهاد واسعا في بعض جوانب التنظيم القانوني للسلطة القضائية خاصة ما يتعلق بالنيابة العامة.
وحدة مفهوم القاضي في الدستور الجديد
إن القارئ للمقتضيات الدستورية لن يجد عناء في تلقف الإشارة الواضحة التي مفادها أن المشرع الدستوري استعمل لفظة « القاضي « للدلالة على كل فرد من أفراد السلطة القضائية كيفما كان موقعه، سواء أكان يشتغل في قضاء الحكم بكل أنواعه أو قضاء النيابة العامة.
وبلغة الأرقام، نجد أن المشرع الدستوري استعمل لفظة « القاضي « في ستة مواقع، منها أربعة منها في الفصل 109 وواحدة بالفصل 117، بينما استعمل لفظة « قضاة « أربع مرات في الفصول 57 و110 و111 و115، أما لفظ « القضاء» فقد وردت في الفصول 67 و109 و110 و111 و113 و115 و126. وما يلاحظ من استعمال هذه الألفاظ الدالة على القضاء والقضاة والقاضي، أن لها دلالة عامة تجمع بين كل من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، ما يعني أن نية المشرع الدستوري انصرفت إلى توحيد مفهوم القاضي في الدلالة الدستورية وهو ما يجب الانتباه إليه عند التداول القانوني والتشريعي في كل ما سيصدر من قوانين سواء أكانت تنظيمية أم قوانين عادية .
إن ما ذهبت إليه بعض المقتضيات الدستورية يدل على القوة الدستورية لحمولة مفهوم القاضي، و لنأخذ على ذلك مثالا مما جاء في الفصل 67 من الدستور، التي تنص على عمل لجان تقصي الحقائق، حيث جاء في الفصل المذكور ما يلي : « للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
لا يجوز تقصي الحقائق في ملفات أمام القضاء
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، وتخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق . يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان. «
فمن خلال هذا الفصل يتبين لنا أن المشرع قصر عمل لجان تقضي الحقائق بمجرد وضع القضاء يده على الوقائع موضوع تقصي الحقائق، وهو ما يعني أن المشرع استعمل لفظ القضاء للدلالة على القضاء الواقف وكذا على القضاء الجالس، ولم يفرق بينهما ، لأن العبرة بالسلطة التي وضعت يدها على الوقائع موضوع التحقيق أهي السلطة التشريعية أو السلطة القضائية . و من ثمة يتضح أن المشرع الدستوري استعمل لفظ القاضي بدلالة واحدة لا تفريق و لاتمييز فيها بين قضاة الحكم و قضاة النيابة العامة.
و لعل إرادة المشرع الدستوري الرامية إلى عدم التمييز بين الأفراد العاملين بكل من قضاء الحكم و قضاء النيابة العامة ، يكمن في طريقة تعيينهم إذ أنه بموجب الفصل 57 من الدستور و الذي ينص على أنه : يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية « إذ أن المستفاد من هذا المقتضى هو أن المسار المهني للقضاة يبتدئ واحدا، و لا فرق بين قضاة طرفي السلطة القضائية ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لتدبير الوضعية الفردية و المسار المهني للقضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فكل لفظة في الدستور جاءت في هذا الخصوص إنما تدل على دلالة واحدة ألا و هي اتحاد صفة القاضي في كل من القضاة العاملين بالنيابة العامة أو الذين يعتلون منصة الحكم .
انطلاقا مما ذكر يتبين بما لا يدع مجالا للشك بأن إرادة المشرع الدستوري اتجهت إلى جعل الأفراد العاملين بالسلطة القضائية بشقيها قضاة بالمفهوم المتعارف عليه دوليا و كما تعبر عن ذلك العهود والاتفاقيات الدولية ، ولعل تفسير ذلك يرجع إلى استحضار اللجنة المكلفة بوضع مسودة الدستور للخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى دسترة الالتزامات الدولية للمغرب والتي من بينها ما يتعلق بالقضاء والسلطة القضائية .
فالموقف المتقدم جدا للإرادة الدستورية العليا ، يجب أن يتم الاحتفاظ به عند صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية مهما كانت طبيعتها و قوتها الإلزامية . وهو الأمر الذي يظهر بوضوح وجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة المغربية من أجل الرقي بالسلطة القضائية بشقيها قضاء النيابة العامة و قضاء الحكم إلى مصاف السلطة القضائية المستقلة . لكن رغم هذه الإشارات التي أشرنا إليها على سبيل المثال في هذا المقام للدلالة على وحدة صفة القاضي ، فإن المشرع الدستوري ترك عبارة عامة تحتاج للتداول فيها ألا و هي عبارة « السلطة التي يتبعون لها « فما المقصود بهذه السلطة و ما هي أثار دلالاتها المحتملة؟ هذا ما سنتطرق له في الفقرة الموالية .
المفهوم العام ل « السلطة التي يتبعون لها « كمؤشر على التأويل الديمقراطي
إن المقاربة المعتمدة في تبيان معنى و مفهوم عبارة : « السلطة التي يتبعون لها « التي أوردها المشرع الدستوري في فصلين هما 110 و 116 من الدستور ، يجب أن تكون مقاربة ديمقراطية أي متصفة بالمواصفات التي تخضع للنطق المولوي الذي جاء بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته لمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 و الذي جاء فيه بالحرف : « أما الإصلاح القضائي ، فاعتبارا لبعده الإستراتيجي ، فإنه يتعين ، فيما يرجع إلى مهمة البرلمان ، اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة . وهنا نود ، مجددا أن ندعوكم إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية ، كما نحث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية ، على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها. « فالمقاربة الظاهرة و الباطنة أو الالتزام الدقيق بروح و مضمون مقتضيات الدستور تقتضي إعطاء التفسير الذي ينسجم و الاستقلال المطلق للسلطة القضائية ، سواء قضاء الحكم أو قضاء النيابة العامة . و من ثم نجد أن أهم ما يجب إثارة الانتباه إليه هو كيف يمكن قراءة عبارة :» السلطة التي يتبعون لها « ؟ هل يجب قراءتها على أنها توجه نحو إبقاء النيابة العامة تابعة لسلطة وزير العدل و الحريات أم أن إيراد تلك العبارة بذلك الشكل جاء من أجل ترك المجال للتداول في الشكل الذي يتعين أن تكون عليه السلطة التي ستتبع لها النيابة العامة و التي ليست هي وزارة العدل و الحريات ؟
إن ما يمكن الترجيح به هو ما اتجهت إليه الإرادة الملكية الواردة في الخطاب الذي قدم به جلالته مسودة الدستور بتاريخ 17 يونيو 2011 و الذي جاء فيه : « ... كما تم إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، كمؤسسة دستورية يرأسها الملك ، لتحل محل المجلس الأعلى للقضاء ، وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي، وتخويل رئيس محكمة النقض ، مهام الرئيس المنتدب ، بدل وزير العدل حاليا، تجسيدا لفصل السلط « ؛ فمن خلال هذا الخطاب يتضح بأن المقاربة القائمة على فصل السلطات كانت واضحة جلية عند التنصيص على استبعاد وزير العدل من تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لفصل السلط .
لعل هذه المقاربة هي ما يجب اعتمادها للقول بأن المراد بإيراد عبارة «السلطة التي يتبعون لها «، إنما جاءت من أجل ترك المجال للتداول حول شكل السلطة التي ستصبح مسيرة لأعمال النيابة العامة، بدل وزير العدل كما هو عليه الأمر حاليا. ومن المفيد جدا في هذا السياق، القول إن هذه المقاربة تنسجم إلى أقصى الحدود مع التوجهات الدولية الرامية إلى إقرار استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
ومن ثم، فإن التفسير الذي نراه ديمقراطيا، هو ذلك الذي ينسجم والتزامات المغرب الدولية من جهة، وما أوصت به هيأة الإنصاف والمصالحة التي دعا جلالته إلى دسترتها، وما ناضلت من أجله الجمعيات وكل الفاعلين الحقوقيين، من أجل تحقيق فصل تام وحقيقي بين السلطة التنفيذية والقضائية، وفك كل أشكال الارتباط بينهما، لأن ذلك كله هو السبيل لضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات من غير تدخل للسلطة التنفيذية، كما جاء به الدستور كالتزام ملقى على عاتق القضاة جميعا وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور والذي نص على أنه «يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون».
وبناء على ما ذكر، فإن ما يستخلص من العبارة موضوع النقاش، هو أنها جاءت من أجل بلورة تصور جماعي متوافق عليه بغرض الاتفاق على الشكل، الذي يتعين أن تكون عليه الجهة التي ستشرف على عمل النيابة العامة، هل ستكون جهة منتخبة أم معينة؟ وهل ستكون الجهة التي ستشرف على النيابة العامة فرادا واحدا أم هيأة جماعية ؟ وهل هذا التعيين، يجب أن يكون مضبوطا بضوابط أم بغير ضوابط ؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي يجب أن تنصب النقاشات حولها.
وإسهاما منا في إثراء النقاش، حري بنا أن نثير الانتباه إلى أن المرحلة التاريخية التي نعيشها تعتبر بحق فرصة، نعبر من خلالها على انخراطنا العملي والحقيقي في المنظومة الدولية. وبهذه المناسبة، يمكن إثارة الانتباه إلى أن ما خلصت له لجنة فينيسيا باعتبارها لجنة أوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، أرضية مشتركة تجسد المشترك الإنساني في التنظيم والتأطير لعمل النيابة العامة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.
لقد شكل موضوع استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في هذه الظرفية التاريخية نقاشا مستفيضا، داخل أجهزة الاتحاد الأوربي وانتهى الأمر إلى تكوين لجنة أوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، أطلق عليها اسم «لجنة فينيسيا» التي أعدت أخيرا بتاريخ 3 يناير 2011 تقريرا حول الآليات الأوربية المتعلقة باستقلال النظام القضائي في جزئين يهم الثاني منهما النيابة العامة تحت عدد 494/2008 وتم تبنيها خلال الدورة 85 بفيينا انطلاقا من مجموعة من الوثائق الدولية المتعلقة بالنيابة العامة والتي يمكن حصرها في ما يلي :
- التوصية عدد 2000/REC . 19 الصادرة عن لجنة وزراء المجلس الأوربي حول درو النيابة العامة داخل المنظومة القضائية الجنائية.
- المبادئ التوجيهية الخاصة بأعضاء النيابة العامة لسنة 1990 الصادرة عن الأمم المتحدة .
- مبادئ المسؤولية المهنية وإعلان الحقوق والواجبات الأساسية لوكلاء النيابة العامة ونوابهم لسنة 1999 الصادرة عن «الجمعية الدولية لوكلاء النيابة العامة».
- إعلان بوردو الصادر عن المجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين والمجلس الاستشاري لوكلاء النيابة العامة الأوربيين حول موضوع «قضاة ووكلاء نيابة عامة في مجتمع ديمقراطي».
- الخطوط التوجيهية الأوربية حول دور النيابة العامة المجلس الأوربي بودابيست 2005 .
كل هذه الوثائق الدولية أجابت بوضوح عن تساؤلات وضعية النيابة العامة في المنظومة القانونية الدولية، وأكدت بالملموس أن النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية تمارس عملها في التصاق وطيد بالحقوق والحريات، ويجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية.
وقد كان من نتائج التوصية الأوربية المذكورة أعلاه أن عمدت مجموعة من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوربي إلى تعديل دساتيرها وقوانينها الداخلية من أجل تحيينها وإرساء طابع الاستقلالية على قضاء النيابة العامة، منها على الخصوص المملكة البلجيكية التي تعتبر بحق التلميذ النجيب في مجال، الاستجابة للتوصيات الأوربية والدولية على حد سواء. في هذا المجال عدلت بلجيكا المادة 151 من دستورها لتنص صراحة على استقلالية النيابة العامة وفصلت تلك الاستقلالية في العديد من القوانين التنظيمية، وذلك على الشكل التالي :
إحداث ما يسمى بـمجمع الوكلاء العامين
College des Procureurs Généraux
، ويتألف من مجموع الوكلاء العامين بالمملكة وتتحدد مهامه في تحديد السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها وكذا حسن تدبير عمل النيابة العامة ولتحقيق هذه الأهداف، يحق لهذا المجمع اتخاذ قرارات آمرة للوكلاء العامين بالمملكة ووكلاء الملك وكافة أعضاء النيابة العامة، ولا يحق لهم أن يتخذوا قرارات تخص أفرادا بعينهم، ولا أن تنصب قراراتهم على نيابة عامة أو عضو فيها دون غيرهم، إنما يشترط أن تكون التعليمات عامة ومجردة أي أن تطبق على جميع النيابات العامة وعلى كافة أعضائها وأن تكون مجردة لا تمس شخصا أو مجالا بعينه وإنما على عموم المواطنين.
ولتحقيق هذه المهمة، يجتمع مجمع الوكلاء العامين للملك مرة في الشهر على الأقل، ويجب أن تكون لهم أيضا اجتماعات مع مسؤولي الأمن والشرطة القضائية ومع مجلس وكلاء الملك تحت رئاسة أحد الوكلاء العامين بالتناوب، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاختصاصات التي يتمتع بها الوكيل العام للملك ببروكسيل في مجال الإرهاب والجرائم المالية والاقتصادية وغيرها.
مجلس وكلاء الملك
يجتمع جميع وكلاء الملك داخل إطار يسمى مجلس وكلاء الملك، من أجل اطلاع مجمع الوكلاء العامين للملك على سير الأشغال والإشكاليات المعترضة في إطار تطبيق القواعد الموحدة للسياسة الجنائية وكل ما له علاقة بعمل النيابة العامة.
لما كان الأمر كذلك، يحق لنا الآن التساؤل عن وضعية وزير العدل والحريات في ظل استقلالية النيابة العامة في إطار المعادلة الصعبة المتمثلة في الموازنة، بين الحفاظ على مبدأ استقلالية قضاء النيابة العامة كجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية وبين دور وزير العدل والحريات في تطبيق سياسة حكومته في مجال العدل، التي هو مسؤول عنها أمام حكومته التي بدورها مسؤولة عنها أمام البرلمان؟.
الجواب نجده أيضا في التوصيات الأوروبية لحقوق الإنسان، والوثائق الدولية ذات الصلة المذكورة أعلاه، والتي تحدد علاقة الجهة الحكومية المكلفة بالعدل بقضاء النيابة العمة في كون وزير العدل- باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية- والساهر على تطبيق برنامجها في مجال العدل والحريات، يمكنه أن يحدد لمجمع الوكلاء العامين للملك التوجهات العامة للسياسة الجنائية في مجال الأبحاث والتحريات، شريطة أن تكون هذه التوجهات عامة ومجردة، لا تمس شخصا أو هيأة معينة، ولا نيابة عامة أو عضو فيها دون الآخر، و يتولى مجمع الوكلاء العامين بعد ذلك تبليغها إلى باقي أعضاء النيابة العامة من خلال مجلس وكلاء الملك .
يمكن في هذا الإطار أن يحضر وزير العدل والحريات اجتماعات مجمع الوكلاء العامين للملك، من أجل أن يبسط توجهات الحكومة في مجال العدل والسياسة الجنائية، والإجراءات والآليات الكفيلة بتطبيقها، والموارد المالية واللوجستيكية المعتمدة لذلك، والمخصصة من قبل الحكومة لتنفيذها. ماعدا ذلك، يبقى وزير العدل والحريات بعيدا كل البعد عن كنه وعمل النيابة العامة، ضمانا لمبدأ استقلالية النيابة العامة وفق المفهوم الذي حددته المادة 5 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وأكدته مجموعة من قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي وجهت ضربات موجعة لفرنسا، بسبب توغل وزير العدل في نيابتها العامة وهو ما سوف نبسطه في المطلب الموالي .
وخلاصة القول في هذا المضمار، هو أن اعتماد التأويل الديمقراطي لعبارة «السلطة التي يتبعون لها « يجب أن يسير نحو تعزيز استقلال السلطة القضائية المبني على الفصل الصريح لها عن السلطة التنفيذية، لأنه من غير استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فلن يمكننا التحدث عن استقلال حقيقي للسلطة القضائية.
استقلال القضاء رهين باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
بالرجوع إلى تاريخ العلاقة القائمة من وزارة العدل والنيابة العامة، سنجد أن أهم ملامح تلك العلاقة قائمة على محورين، أولهما محور التنقيط والتقييم وثانيهما محور التوجيه والإشراف، وبالتالي فإنه من المفيد جدا التساؤل حول ما إذا كان الدستور الجديد لسنة 2011 قد حافظ على نفس مقومات تلك العلاقة أم لا ؟ وهل لذلك أثر على تصور اكتمال الاستقلال المنشود للسلطة القضائية؟.
من حيث التنقيط، نجد أن السلطة التي كان يتمتع بها وزير العدل، تتجسد في كونه الجهة المكلفة بتنقيط عمل الوكلاء العامين للملك وفق مقتضيات الفصل 3 من المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم، وبالتالي فإن سلطته على جهاز النيابة العامة كانت قائمة على أمرين، أولهما أنه الرئيس الإداري المباشر الذي يتولى أمر التنقيط، بالإضافة إلى أنه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يجعله متمكنا من كل أسباب القوة والسلطة ويكون له مركزا متميزا في إطار المنظومة القضائية. وما يزيده تميزا هو كون جميع القرارات التي قد تتخذ في حق أعضاء النيابة العامة غير قابلة للطعن فيها، وبالتالي فإن سلطة التنقيط كانت تلعب دورين أحدهما ظاهري وهو التقييم بمفهومه الإيجابي، وثانيهما ذو طابع سلبي يتمثل في كونه وسيلة ضغط على أعضاء جهاز النيابة العامة.
لكن بمقتضى الدستور الجديد، فإننا نجد أن الوضع قد تغير، خاصة أن أهم مقتضى جاء به الدستور الجديد في هذا الباب هو مسألة الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة. وإمكانية الطعن هذه مكن منها المشرع الدستوري كلا من قاضي النيابة العامة وقاضي الحكم على اعتبار أن المقتضى المتعلق بها جاء عاما ولا يخص فئة دون أخرى.
فامتلاك القاضي بصفة عامة لإمكانية الطعن، يعد مؤشرا حقيقيا حول إرادة المشرع الدستوري لتمكين أعضاء السلطة القضائية، سواء أكانوا عاملين بقضاء الحكم أو بقضاء النيابة العامة من استقلال حقيقي ينأى بهم عن كل تأثير، خاصة أن إحساسهم بوجود ضمانات حقيقية أثناء أدائهم لمهامهم، يشكل عامل دفع لتمتعهم بالاستقلال المطلوب وبالتالي يلقي على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على هذا الاستقلال.
وأمام هذا الوضع الجديد، يمكن إعادة النظر في علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، فمن جهة يجب التأكيد بأن مسألة التنقيط في حد ذاتها يمكن أن تكون وسيلة للضغط على قرارات القاضي، لذلك جعل المشرع الدستوري هذه المسألة نسبية لا تخضع إلى مزاج الجهة المسؤولة على تقييم عمل القاضي وإنما يمكن لهذا الأخير المنازعة فيها وإثبات أن القصد من ذلك هو التأثير على قراراته. ومع إمكانية تصور صحة الطعون، فإنه يكون من الممكن جدا تصور قيام الضرر، فهل يمكن في مثل هذه الحالات أن نتصور أن وزير العدل شخصيا هو الذي أحدث الضرر أم أن مؤسسة وزير العدل هي المحدِثة للضرر؟.
إن الجواب على هذا السؤال له أهمية خاصة، ذلك أن الوقوف على حقيقة الجواب من شأنه أن يوضح أكثر مسألة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، فإذا كان معروفا أن المتسبب في الضرر هو الشخص الطبعي ذاته - وليس الشخص المعنوي ممثلا في الإدارة - في حالة تقييم عمل الآخرين، فإنه في هذه الحالة يمكن القول بأن المسؤولية الشخصية لوزير العدل كفكرة ستكون حاضرة بقوة، فكيف يمكن التعامل مع هذه الوضعية في ظل افتراض وجود تسلسلية هرمية مؤثرة
بموجب آلية التنقيط ؟
إن هذا الوضع الذي نخلص إليه بناء على قراءة متكاملة لمقتضيات الدستور، سيضعنا أمام نتيجة واحدة وهي أنه لا يمكن اعتبار وزير العدل متمتعا بالصفة القضائية كما كان الأمر من قبل، ولا يمكن له الإشراف على مؤسسة النيابة العامة، لأن الجهة التي ستشرف على هذه الأخيرة يجب أن تكون قادرة على تقييم العمل القضائي باعتباره أهم ما يقوم به أعضاء النيابة العامة. وبالتالي فإن الجهة التي يتعين أن يتبع لها قضاة النيابة العامة يجب أن تتوفر فيهم الصفة القضائية حتى يمكنهم تملك سلطة التنقيط التي تبقى في حد ذاتها نسبية ويمكن الطعن فيها باعتبارات أخرى غير تلك التي تتعلق بوزير العدل .
إن هذا الوضع الذي أصبح يطبع علاقة النيابة العامة بوزير العدل على مستوى التنقيط، لا يقل أهمية عن الوضع الذي أصبح يطبع ذات العلاقة على مستوى التوجيه والإشراف.
إن الوجه الثاني للعلاقة التي كانت تطبع علاقة وزير العدل بالنيابة العامة، تتمثل في ما كان يمتلكه هذا الأخير من أدوات توجيهية لعمل النيابة العامة وخاصة في ما يتعلق بالدوريات والمناشير التي كانت ترسم الطريق لعمل النيابة العامة في مجموعة من القضايا، وأغلبها يتعلق بالطابع القضائي، لذلك فإن هذه الآلية بدورها أصبح من الجائز التساؤل حولها في ظل أحكام الدستور الجديد.
فإذا كان من المعلوم أن عمل النيابة العامة يعتبر جزء من عمل القضاء بموجب منطوق الفصل 117 من الدستور، على اعتبار أن عملها يقوم على حماية حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم، فإن هذا الطابع القضائي يأبى التوجيه لما فيه من مس باستقلالية القرار القضائي . ومن ثم فإن العمل على إعادة النظر في علاقة وزير العدل بالنيابة العامة على مستوى التوجيه والإشراف يجب أن يعاد فيها النظر لتنسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة.
وفي هذا الإطار، يمكن التركيز على أمرين، أولهما نقد المرجع التاريخي لعلاقة النيابة العامة بوزارة العدل، وثانيهما الارتكاز على مقتضيات الدستور نفسه.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور ؟
أي استقلال للنيابة العامة يكرس لاستقلال السلطة القضائية في الدستور ؟