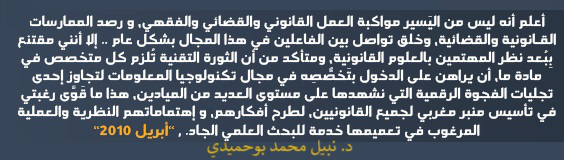رفقته نسخة من المقال للتحميل

- مقدمة:
هيمن العرف الدستوري (دستور غير مكتوب) في الحضارات القديمة حيث يعود أقدم دستور عرفي إلى كونفيشيوس بالصين القديمة مرورا بالديمقراطية اليوناية وحقب مختلفة من العصرين الروماني والبيزنطي، كما عرفه العرب في جاهليتهم فكانوا يتفقون على اختيار رؤساء القبائل وإعلان الحروب وتوقيفها وقبول المصالحة بالعرف، و يقصد بالدستور العرفي " مجموع القواعد القانونية الناتجة عن التقاليد والممارسات المتواترة والسوابق التي اكتسبت بفعل العمل بها وفي سياقات زمنية قوة إلزامية "[2] أو " مجموع الاستعمالات والتقاليد والممارسات التي تنظم طريقة اشتغال المؤسسات الدستورية وغير مقننة في وثيقة رسمية والمكتسبة لقوة قانونية ملزمة[3].
وبمجيء الإسلام وظهور مفهوم الأمة مكان مفهوم القبيلة تم سن بعض قواعد وضوابط التعامل بين الجماعات والأفراد كما تم تنظيم بعض المعاملات الاجتماعية والمالية بين ساكنة يثرب وزائريها من المسلمين واليهود والنصارى والوثنيين .... في إطار ما عُرِفَ ب (وثيقة المدينة) التي مثلت أول دستور مكتوب في تاريخ العرب والمسلمين، وتضمنت 71 مادة أوردها ابن إسحاق ونقلها عنه ابن هشام في سيرته.
فالدلالات والمعاني التي يحملها الدستور تختلف باختلاف مقاربة التعريف هل هي شكلية أم مادية موضوعية، فالمعنى الشكلي يجعل من الدستور مجموع القواعد المتمتعة بالشكل الدستوري والمضمنة في وثيقة أو وثائق خاصة تحظى بقيمة سامية على باقي المبادئ التشريعية أو التنظيمية، والتي لا يمكن تعديلها إلا وفق مسطرة خاصة يطلق عليها سلطة المراجعة والتعديل، في حين أن الدستور في دلالاته المادية يعني مجموع القواعد المرتبطة بممارسة السلطة السياسية.[4]
وقد ظهر هذا النوع من الدساتير عند العرب والمسلمين في عهد الملك العثماني عبد الحميد الأول سنة 1835 ثم في عهد عبد الحميد الثالث سنة 1908.
ويرجع الفضل في إقرار معظم دساتير العالم إلى الثورة الفرنسية والدستور الفرنسي الأول والذي سبقته حركة فكرية واجتماعية وسياسية عميقة أطرها كتاب كبار" كمونتسكيو" صاحب كتاب (روح القوانين) وجان جاك روسو صاحب كتاب (العقد الاجتماعي) وكانا من أوائل المفكرين الذين طرحوا نقطا لا زالت متداولة في معظم الدساتير كفصل السلط والتوازن بين حرية الفرد ومقتضيات الحياة الاجتماعية والسياسية ...
وفي المغرب بدأت الحركة الدستورية والإصلاحية سنة 1900، بعد الانكسارات التي عرفها المغرب في علاقته الدولية إثر هزيمتي اسلي وتطوان أواخر القرن التاسع عشر، فبدأت النخبة المغربية السياسية والفكرية تُبدي اهتماما ملحوظا بموضوع الإصلاحات، وفي سنة 1900 تقدم عبد الله بن سعيد من شمال المغرب بمشروع دستوري رفعه إلى السلطان مولاي عبد العزيز، الذي دعا عددا من الشخصيات لتزويده بآراء كتابية بشأن الإصلاحات المنتظرة ، وبعدها كشف الأستاذ علال الفاسي " في حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية " عن مذكرة الحاج علي الزنيبر السلاوي التي يمكن اعتبارها أول نص تتوفر فيه بعض مواصفات الوثيقة الدستورية، إضافة إلى مذكرة أخرى لمؤلف مجهول أعلن عنها الأستاذ علال الفاسي سنة 1968، واعتبرها عبد الكريم غلاب أكثر من نص دستوري، ويبقى مشروع دستور 1908 أهمها على الإطلاق، رغم أن الاستاذ عبد الله العروي يذهب إلى أنه ليس هناك شك بأن الوثيقة هي تَبَنٍ للدستور العثماني في 23 ديسمبر 1876 الذي دخل حيز التطبيق في 24 يوليوز 1908.
المبحث الأول: البوادر الأولى للحركة الدستورية بالمغرب:
على الرغم من أن الحركة الدستورية قد نشطت في المغرب منذ مطلع القرن العشرين، إبان المرحلة العزيزية، وبالضبط من خلال ظهور أفكار و مذكرات دستورية ستمهد لميلاد مشروع دستور 1908 الذي نشر في جريدة " لسان المغرب " الصادرة من مدينة طنجة، في أربعة أعداد متتالية ، ثم بعد ذلك صدور دستور الجمهورية الريفية سنة 1921، فإن الحركة الوطنية المغربية بعد الاستقلال لم تتوجه بمطالبها العاجلة لتتطرق عمليا إلى معالجة المسألة الدستورية، بل اكتفت بمجرد الانتظار الذي تواصل لسنوات عديدة بخلاف بقية دول المغرب الكبير، التي توجهت منذ حصولها على الاستقلال مباشرة إلى انتخاب جمعيات تأسيسية لوضع اللبنات الأولى لدساتيرها .
فبعد انسداد آفاق المجلس الوطني الاستشاري المعين من طرف المغفور له محمد الخامس تحت رئاسة المهدي بن بركة سيعرف المغرب خطوات - وإن كانت متعثرة - نحو إقامة أول دستور للمملكة سنة 1962، وهذه الخطوات يمكن إجمالها في: مجلس الدستور، والعهد الملكي والقانون الأساسي للمملكة.
أولا: الإرهاصات الأولية للتفكير الدستوري لمغرب ما قبل الاستقلال.
عرفت الثورة الحفيظية " إلى جانب البيعة المشروطة عدة مذكرات دستورية بعضها رفع إلى السلطان و البعض الآخر ظل تداوله محدودا ، إلى أن تم نشره فيما بعد ، و أهم هذه المشاريع مشروع جريدة "لسان المغرب" الذي تم نشره على صفحاتها شهر أكتوبر و نونبر 1908 ، و مشروع الحاج علي زنيبر الذي عنونه ب "حفظ الاستقلال و لفظ سيطرة الاحتلال" ، و مشروع عبد الكريم مراد الطرابلسي ، و بعد إحكام الاستعمار قبضته على المملكة الشريفة ، سيعرف مقاومة شديدة من طرف المجاهدين المغاربة في جبال الأطلس وفي شمال المغرب وجنوبه ، دون أن يضعف الجهاد إيمانهم بأولوية الإصلاحات السياسية والدستورية ، و حسبنا في هذا المقام الإشارة إلى تجربة الثورة الريفية التي سعت لتحصين مشروعها الجهادي بإحداث مؤسسات دستورية تغيت توسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار ، حيث تم وضع دستور للجمهورية الفتية و شكلت بموجبه حكومة يرأسها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي.
- مشروع دستور 1908 والمذكرات الممهدة له:
فأثناء محاضرة عامة ألقيت بتاريخ 15 نوفمبر 1968 حول موضوع "حفريات عن الحركة الدستورية في المغرب قبل الحماية" قدم علال الفاسي سلسلة من النصوص الأصلية توصل إلى اكتشافها، ومن بين هذه المجموعة نَصَّيْن يُثيران الانتباه بالنسبة لغِنَاهُما بالمقارنة مع العصر الذي وضعا فيه، وبسبب المجهود المبذول من طرف واضعيه، وهي مذكرة دستورية تنسب إلى شيخ سوري اسمه عبد الكريم مراد الطرابلسي كان قد استقر بفاس سنة 1906 وبعث بها إلى السلطان عبد العزيز، ثم مشروع الحاج علي زنيبر السلاوي وفي الأخير مشروع دستور 1908.[5]
1 -مشروع عبد الكريم مراد الطرابلسي: يمكن تقسيم مذكرة عبد الكريم مراد إلى ثلاثة مجالات أساسية: المجال الأول خاص بالتمثيل الوطني، والثاني يهم إصلاح الجيش، والثالث مخصص للتنظيم المالي للدولة. وتعارض المذكرة نتائج مؤتمر الجزيرة، والتدخل الأجنبي الذي نشا عنه في الشرطة والبنوك وغيرها، حيث يقول صاحب المذكرة " ثم اطلعت على ما تم عليه مؤتمر الجزيرة من عمل البوليس والبنك وغيره، وأن عموم الرعية نافرة من هذا التدخل خوفا من رسوخ قدمي المباشرين من الضباط الفرنسيين والإسبانيين إذا صفا لهم الوقت لأنهم بدعوى الاطلاع يلزمون الحكومة على الاستدانة، وسيؤول أمرهم على مراقبة واردات المخزن ومتصرفاته "[6]
ويمكن اعتبار الجزء المخصص للتمثيل الوطني من أقوى ما جاءت به المذكرة، حيث يؤكد المؤلف على أن الوسيلة الأكثر فعالية من اجل مواجهة القوى الأجنبية هي التوفر على جمعية وطنية، ويحدد تكوينها ودورها في اثني عشر فصلا:
- التكوين: الجمعية الوطنية أو مجلس الأمة مجلس شورى يتكون من ممثلي القبائل مندوب عن كل قبيلة منتخب لمدة خمس سنوات، ويتحدد عمرهم بين 30 و60 سنة ويجب أن يعرفوا القراءة والكتابة والحساب، كما يجب ان يكونوا فقهاء مقبولين.
- الوظيفة: يختص مجلس الأمة في النظر في سلامة المعاهدات المعقودة مع القوى الأجنبية، وفي ميدان تحديد الأجور ورواتب الوزراء والعمال.
ويبث في هذه القضايا بأغلبية الأعضاء، حيث أن قراراته ترفع إلى مجلس ثان يسمى المجلس الأعلى مكون من عشرين عضوا تحت رئاسة السلطان، غير أن العلاقات بين المجلسين تبدو غير موضحة من طرف واضع المذكرة الدستورية.[7]
وفي الأخير وبالرغم من أن عبد الكريم غلاب اعتبرها أكثر من نص دستوري ومشروع الإصلاح الأوضاع السياسية والقانونية والدفاعية والمالية[8] إلا أنها اعتبرت اقل نضجا من المشروع الذي قدم إلى مولاي عبد الحفيظ سنة 1908 لكونها لم تتحدث عن المبادئ الدستورية الأساسية، كحقوق المواطنين - إلا الحق في العمل والضمان الاجتماعي - ولم تتحدث أيضا عن الملك والدولة والحكومة واختصاصات كل سلطة إلا من خلال أعمال مجلس الأمة وتنفيذ القوانين.
2 -مذكرة الحاج علي زنيبر السلاوي: جاءت مذكرة الحاج علي زنيبر تحت عنوان " حفظ الاستقلال ولفض السيطرة والاحتلال " لا تذكر بصريح العبارة كلمة "دستور" ولكنها تقترح لائحة من الإصلاحات من اجل حماية استقلال البلاد المهدد ليس فقط من جانب القوى الأجنبية ولكن كذلك من طرف " الاستبداد الذي هو أحد أشكال الاحتلال".
وتنص الوثيقة أساسا:
- على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية.
- إصلاح الشرطة وتوحيدها.
- مساواة الجميع أمام الضريبة.
- إنشاء بنك للدولة.
- التوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة.
- رفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب.
- إدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.
ويرى عبد الكريم غلاب أن الجماعة الوطنية هي التي كانت وراء مشروع الدستور، وكانت تتخفى خلف فرج الله نمور مدير جريدة لسان المغرب وهو لبناني يقطن المغرب. يحتوي المشروع على 93 فصلا و11 بابا، وله ملحقات تشمل القانون الداخلي لمنتدى الشورى إضافة إلى قانون الانتخاب والقانون الجنائي.
كما أن مشروع الدستور ركز على ثلاث موضوعات رئيسية:
1. المميزات العامة للدولة وخصائصها.
2 حقوق المواطنين وواجباتهم.
3 تنظيم الدولة ومؤسساتها.
وهكذا نجد الدستور في باب الدولة والدين يقر بان دين الدولة الشريفة هو الإسلام وأن مذهبها الشرعي هو المذهب المالكي، وأن العاصمة هي مدينة فاس، كما يحترم الديانات الأخرى ويقر لمعتنقيها حق أداء شعائرهم بكل حرية في دائرة مراعاة الآداب العمومية.
أما فيما يخص بمؤسسات الدولة الرئيسية فان الدستور يشير إلى:
1. المؤسسة الملكية: لقد أولى الدستور مكانة متميزة لهذه المؤسسة حيث يُعتبر السلطان أمير المسلمين وحامي حوزة الدين، كما أنه المسؤول الأول عن ضمان حماية أبناء هذه الدولة باعتباره وارث البركة الكريمة.
وباستقراء للمادة 11 من نفس المشروع يتضح أن للسلطان مهاما متعددة، فباسمه تُسك النقود وتُخطب الخطب، كما أن له دورا حاسما في الدفاع عن حوزة الدولة الشريفة لذلك أُسندت له مهمة قيادة الجيوش الكبرى وإشهار الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات مع الدول، كما أن له الحق في تعيين موظفي الدولة سواء كانوا كبارا أو صغارا مثلما له الحق في عزلهم بمنحهم "النياشين"، وفي مقابل ذلك نجد السلطان غير مسؤول سواء على صعيد السياسة الداخلية أو على صعيد تدبيره للسياسة الخارجية.
2 مؤسسة الحكومة: لقد أخضع أصحاب مشروع دستور 1908 الحكومة إلى مراقبة مزدوجة، فمن جهة تخضع الحكومة إلى السلطان، ومن جهة أخرى يراقبها منتدى الشورى باعتباره هيئة تشريعية، والملاحظ على الهيكلة التنظيمية للحكومة كونها تتسم بعدم التعقيد فالسلطان هو الذي يعين الوزير الأكبر ليفسح المجال لهذا الأخير قصد اختيار خمسة وزراء يتم عرض أسمائهم على منتدى الشورى ليدلوا برأيهم اتجاه تشكيلة الحكومة، فإذا ما أقروا انتخاب الوزراء الخمسة عرضوا رأيهم على السلطان ليصادق على تعيينهم.
.3 مؤسسة البرلمان : و تتكون من مجلسين مجلس الأمة و مجلس الشرفاء :
- مجلس الأمة: ويتشكل من مندوب عن كل 20000 من السكان ويجب أن تتوفر فيهم بعض الشروط كما يحددها الفصل 44 من الدستور كالتمكن من القراءة والكتابة، وأن يتجاوز عمره 28 سنة وان لا يكون قد حكم عليه سابقا بالإفلاس أو بالحبس بسبب السرقة أو القتل أو أي جنحة جنائية، وأن يتحلى بحسن السلوك والاحترام.[9]
- مجلس الشرفاء: ويتكون من 25 عضو يختار منهم السلطان الرئيس وستة أعضاء وينتخب مجلس الأمة مع هيئة الوزراء وجماعة العلماء بقية الأعضاء أي ثمانية عشر عضوا، ولابد أن يكون عضو مجلس الشرفاء بالغا الخامسة والأربعين من عمره، وعضويته مدى حياته إلا إذا خرج برضاه أو لعذر الطعن في السن.[10]
ورغم الغموض الذي شاب الكثير من نصوص هذا المشروع إلا انه يعد ثورة جديدة في الرؤيا في علاقة الحاكمين بالشعب التي كانت تحكمها نظرة تقليدية تقوم على تفويض السلطة السياسية بدون إحداث تقنيات للمراقبة أو المشاركة، فالمشروع جاء في تحريره كامل البنيات، متوازنا في اختياراته واضحا في نزوعه إلى إقامة دولة عصرية مفتوحة على الخارج، ومحتفظة في نفس الوقت بأصالتها ومؤسساتها التقليدية.[11] وأخيرا فان موقف السلطان عبد الحفيظ من مشروع الدستور يندرج في إطار موقفه الرافض للبيعة المشروطة، حيث وضع حدا لهذا المد الدستوري واقبره في المهد.
غير أن المسالة الدستورية ستعرف أبعادا أخرى باستقرار الحماية في المغرب على إثر اتفاقية 30 مارس 1912، ومنذ تلك الفترة فان العالم القروي سيأخذ المبادرة إلى حدود الثلاثينات من خلال التجربة الدستورية الريفية.
- التجربة الدستورية الريفية:
وأول قرار اتخذته الجمعية الوطنية في أول اجتماع لها في خريف سنة 1921 هو إعلان استقلال الوطن وتأسيس جمهورية يرأسها محمد بن عبد الكريم الخطابي باعتباره قائد حرب التحرير، ثم عقدت بعد ذلك عدة اجتماعات صادقت من خلالها على دستور البلاد الذي يستند على مبدأ سيادة الشعب، غير انه لم يراعي التقاليد الدستورية حيث لم يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل وضع السلطتين معا في يد الجمعية الوطنية وجعل رئيسها هو رئيس الجمهورية في نفس الوقت، وجعل كل عضو من أعضاء الجمعية ملزما بتنفيذ المقررات التي تقرها الجمعية.
كما نص دستور الجمهورية على تشكيل حكومة تضم أربعة مناصب، أما باقي المناصب الأخرى فهي من اختصاص رئيس الجمهورية، ويعتبر أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وهو وحده المسؤول أمام الجمعية الوطنية.[12]
أما السلطة القضائية فلم تمارس من طرف الجمعية الوطنية، حيث تم إلغاء العمل بالنظام القبلي لتسوية المنازعات وإنشاء نظام قضائي بتطبيق الشرع.
وكانت الحكومة الريفية الوحيدة تتكون كالتالي:
الرئيس: محمد بن عبد الكريم الخطابي
نائب الرئيس: امحمد الخطابي
وزير الخارجية والبحرية: محمد ازرقان
وزير الحرب: عبد السلام بن الحاج محمد البو عياشي
وزير الاقتصاد: عبد السلام الخطابي
وزير الداخلية: اليزيد بن الحاج حمو
وزير العدل: بن علي بولحية
وزير الأحباس: احمد اكرود
السكرتارية: عبد الهادي بن محمد ومحمد البوفرامي
ديوان الصحافة: حنان بن عبد العزيز وعبد القادر الفاسي
السفير في لندن: عبد الكريم بن الحاج
السفير في باريس: حدو بن حمو.
كما وضعت الجمعية الوطنية ميثاقا قوميا للجمهوريين من مواده:
- عدم الاعتراف بأية معاهدة لها مساس بحقوق البلاد وخاصة معاهدة الحماية.
- جلاء الاسبان من المنطقة الريفية التي لم تكن في حوزتهم قبل معاهدة الحماية.
- الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية.
- مطالبة اسبانيا بان تدفع تعويضات عن خسائر الحرب.
- إنشاء علاقات ودية مع كافة الدول دون تمييز، وعقد اتفاقيات تجارية معها.
وتبقى أهمية هذه المشاريع برزت في كونها سلمت فكرة الدستور إلى رواد الحركة الوطنية من أجل تبنيها والدفاع عنها، بل وجعلها مدخلا للاستقلال عن فرنسا، وهو ما تبلور فعليا في ورقتي " مطالب الشعب المغربي " المؤرخة بتاريخ 1 ديسمبر 1934، و" المطالب المستعجلة للشعب المغربي " في 25 أكتوبر 1936، اللتين تقدم بهما قادة الحركة الوطنية برئاسة علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وأحمد بلافريج لسلطات الحماية الفرنسية.[13]
لكن بعد فشل المحاولتين السابقتين في إقناع سلطات الحماية بدسترة البلاد، غيرت الحركة الوطنية أولويات نضالها من أجل الاستقلال، من المطالبة بالدستور كمدخل للاستقلال إلى المطالبة بالاستقلال كمدخل للدستور، وهذا التغيير في الأولويات كان سببا في ظهور أول انشقاق حزبي، حيث خرج محمد بلحسن الوزاني المعارض لخطوة تأجيل المسألة الدستورية من "كتلة العمل الوطني " التي أسسها رفقة علال الفاسي وأحمد بلافريج، وأسس " الحركة القومية" التي تحولت فيما بعد إلى "حزب الشورى والاستقلال".
ثانيا: تطور الحركة الدستورية بعد الاستقلال (1956-1962)
بعد نيل المغرب لاستقلاله سار بخطوات تدريجية باتجاه بناء دستوري متكامل يجسد رغبة الملك محمد الخامس بعدم التسرع في هذا المجال بشكل يؤدي لاستيراد أشكال جاهزة من النظم الدستورية التي قد لا تكون متفقة مع حاجات المغرب وتقاليده العريقة في الحكم.[14]
- المجلس الوطني الاستشاري:
ففي ظل هذا التوافق من أجل بناء وتشييد دعائم المغرب المنشود، تم تأسيس المجلس الوطني الاستشاري، كأول مؤسسة تمثيلية وكإطار للتشاور وتبادل الآراء في شهر غشت من عام 1956م، برئاسة المهدي بن بركة والذي يُعد الخطوة الأولى نحو حياة نيابية تمكن الشعب المغربي من المشاركة في تدبير شؤونه العامة من خلال ممثليه في المجلس النيابي في ظل ملكية دستورية وديمقراطية حقيقية.
وقد نشأ هذا المجلس نتيجة للتوافق بين ملك البلاد ومختلف القوى السياسية على أن مرحلة ما بعد الاستقلال هي مرحلة انتقالية تقتضي تحولاً تدريجياً نحو الديمقراطية. وكان هذا المجلس يتكون من (76) عضواً يعينهم الملك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وكان الأعضاء يمثلون جميع التيارات السياسية الحزبية والمستقلة، والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية، ومختلف الهيئات كالمحامين والأطباء والصيادلة والمهندسين والعلماء والمؤسسات الثقافية وحبر عن رجال الدين اليهودي.
لقد اعتبر المجلس استشاريا لدى الملك من دون صلاحيات تقريرية أو تشريعية، بموجب الاتفاق على حساسية المرحلة التي يجب أن تنطلق بهذا النهج التمهيدي في أفق التحول نحو صورة أكثر ديمقراطية، وهو ما عبر عنه محمد الخامس خلال افتتاح هذا المجلس، في خطاب جاء فيه: "....إننا نرجو مراعاة المرحلة التي تجتازها بلادنا ومعرفة ما يمكن تنفيذه وما يتعذر تحقيقه من الرغبات، فإن ذلك ضروري لعدم إضاعة الوقت في دراسة مسائل لم يحن إبانها، أو لا يمكن في الوقت الحاضر إنجازها... "، وأضاف "...وليس معنى ذلك أننا مطمئنون لهذه الطريقة، بل إننا متيقنون أن الانتخابات الحرة، هي أقوم وأنجع سبيل لضمان إقامة ديمقراطية سليمة، ونحن عازمون بحول الله على تغيير أوضاع هذا المجلس بمجرد ما تتيسر السبل لذلك، من تمهيد للطريق، ووضع إطار للحياة النيابية، وهكذا ستتبدل طريقة اختيار الأعضاء من التعيين المباشر أو من قوائم الهيئات إلى أسلوب الانتخاب الحر، ويزاد إلى جانب الاستشارة حق الاقتراح للمشروعات ومراقبة أعمال الحكومة وإبداء الملاحظات في السياسة العامة للدولة...."
لم يكن أعضاء المجلس الوطني الاستشاري منتخبين، ولهذا لا يمكن القول بان ذلك المجلس كان يعكس صورة مطابقة كل المطابقة للواقع السياسي المغربي، ومع ذلك فان البنية السياسية التي كان يقوم عليها المجلس الوطني الاستشاري قد تأثرت إلى أبعد حد من جراء التحولات السياسية التي عرفتها الحركة الوطنية في يناير 1959.
كان لحزب الاستقلال حضور مكثف في المجلس الوطني الاستشاري لا فقط من خلال الأعضاء الذين يمثلون الحزب بصورة مباشرة، بل على الخصوص من خلال المنتمين إلى الحزب واكتسبوا عضوية المجلس بوصفهم يمثلون النقابات والهيئات المهنية والثقافية وغيرها، أما الباقي فلم يكونوا ينتمون إلى أحزاب أخرى وهذا ما فسح مجالا واسعا لتحالفات سياسية ستؤدي بعد خمسة أشهر إلى قيام الاتحاد الوطني للقوات الشعبية[15].
وفيما يتعلق بتركيب المجلس، فقد ساهم المهدي بنبركة في هندسة تركيبته بالتنسيق مع مختلف المكونات ومحمد الخامس حيث تم تشكيله عن طريق الاختيار، فكان يتكون من 76 عضو، 16 شخصية تمثل النزعات السياسية، 10 منها تنتمي لحزب الاستقلال (المهدي بنبركة، محمد غازي، أبوبكر القادري، عبد العزيز بن إدريس، محمد طنانة، أحمد مكوار، الحاج محمد البعمراني، الدكتور بناني، علي بوعيدة، مولاي عبد الله بن محمد العلوي) .6 لحزب الشورى والاستقلال (محمد فاضل موقيت، علي الكتاني، حمزة العراقي، الحاج أحمد معنينو، الداودي محمد، إبراهيم الهلالي). و 6 شخصيات سياسية لا تنتمي إلى أي حزب من الحزبين السابقين (عبد اللطيف الصبيحي، المكي الناصري، الحاج عابد السوسي، لوسيان إبن سيمون، أحمد الجندي، عبدالله الصبيحي).
وتمثل 37 شخصية المنظمات الاقتصادية والاجتماعية، 10 منها ينوبون عن الاتحاد المغربي للشغل (المحجوب بن الصديق، الطيب بن بوعزة، عبد الرزاق محمد، التباري محمد، الحسين حجبي، محمد الشوفاني، المهدي الورزازي، الهاشمي بناني، إدريس المذكوري، المختار ابارودي)، و18 منها عن الفلاحين (الحسين ولد يحيى بن يماني، الحاج احمد المذكوري، الحاج بوشعيب الجبلي، الحاج إبراهيم بن المامون، مولاي مصطفى بن شريف العلوي، عبد القادر بوعنان، إبراهيم السنوسي، حاج محمد برشيد، التهامي بن قدور بن زوينة، موسى بن بوشعيب الدكالي، الحاد إدريس بن شقرون، الحاج حمو اسكور، صلاح موحى اوطالب، موحا أوحدو، الشاهد الوزاني، محمد ولد العيساوي، الحاج عمر بن القايد العيادي)، و9 منها عن التجار ورجال الصناعة (محمد العراقي، احمد أولحاج، عمر الدويري، محمد الدباغ، مبارك الجديدي الفرجي، جو أوحنا، داوود بن أزراف، عبد الحي العراقي، عبد الكريم الهلالي). و15 ممثلا عن هيآت مختلفة، المهندسون في الصناعة والفلاحة ( عبد الهادي صبيحي، احمد تازي)، الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان (محمد الحلو، بنسالم جسوس، عبد السلام حراقي)، معاهد ثقافية (التهامي عمار، أحمد ميدينة)، المحامون (جاك الكايم)، العلماء (االشيخ ماء العينين محمد، محمد بن الطاهر اليفراني، شلومو بن السباط "حبر عن رجال الدين اليهودي"، الحاج محمد تطواني، محمد داوود) محام لدى المحاكم الشريفية (عبد السلام الورديغي). كما تم تعيين مجموعة من الاعضاء في اماكن فارغة بحكم تعيين اصحابها في مهام أخرى، حيث تم في 5 نونبر 1957 تعويض مقعدين باسم حزب الاستقلال (احمد بن منصور النجاعي في مكان محمد غزاي الذي عين سفيرا للمغرب بالسعودية، ومحمد بن محمد بن شقرون مكان الحاج محمد العمراني الذي عين عاملا بأكادير)، وبالهيئات الثقافية (تعيين عبد الرحمان القادري عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مكان احمد مدينة الذي عين كاتبا عاما بعمالة تطوان)، وفي صنف الفلاحين (الحسين جاع مكان الحاج محمد بن ابراهيم الذي لم يحضر قط لأي اجتماع، والجيلاني خربيش مكان موحا وحدو الذي عين قائدا)، ومن بين العلماء (محمد بن محمد عرماس مكان الحاج محمد بن الطاهر اليفراني الذي توفي).[16]
وقد حدد الظهير مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري في سنتين مع إمكانية تجديد تعيينهم. وبالنسبة لتسيير المجلس فيعقد دورتين عاديتين في كل سنة (دورة في الربيع ودورة في الخريف) أو دورات غير اعتيادية إن اقتضى الحال ذلك. ولا يمكن أن يعقد جلسة إلا بحضور ثلثي أعضائه.[17]
إلا أن هذا المجلس لم يستمر طويلاً في ممارسة المهام التي كانت موكلة إليه، حيث تم حله في شهر مايو من عام 1959م، وكان المجلس آنذاك برئاسة المهدي بن بركة.[18]
ليبقى أهم ما يمكن تسجيله في هذه المرحلة هو رؤية الملك محمد الخامس للدستور المنشود لمرحلة ما بعد الاستقلال، فقد ورد في خطاب العرش في 16 نونبر 1956 في سياق الحديث عن بناء المؤسسات التطرق إلى المجلس التأسيسي لوضع دستور للمملكة في حين أصدر المجلس الوطني للمقاومة في غشت 1956 بيانا يحدد فيها المطالب الدستورية المتمحورة حول نقطتين أساسيتين: المطالبة بنظام ملكي دستوري يتلاءم مع مبادئ الإسلام الصحيح، واحترام حقوق الانسان كما حددها الميثاق الدولي الخاص بها.
وبذلك تحول المطلب الدستوري لدى الملك، على الأقل على مستوى الخطاب، في الفترة التي أعقبت استقالة حكومة البكاي الثانية، كانت فترة توتر بين الملك وقيادة حزب الاستقلال، فلم يكن الملك راضيا على بيان الحزب بضرورة قيام حكومة منسجمة.[19]
- العهد الملكي:
الذي نشر في "الجريدة الرسمية" للبلاد عام 1958، "إننا لجادون في السعي لإقرار نظام ملكي دستوري تراعى فيه المصلحة العليا للبلاد وطابعها الخاص وتتحقق بفضله ديمقراطية صحيحة تستمد محتوياتها من روح التعاليم الإسلامية وواقع التطور المغربي وإشراك الشعب تدريجيا في تدبير شؤون البلاد ومراقبة تسييرها".[20]
ومن ضمن المبادئ التي أقرها "العهد الملكي" بأن تكون "سيادة البلاد تتجسم في الملك الذي هو الأمين والحفيظ عليها"، بالإضافة إلى التمييز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تختص بهذه الأخيرة الحكومة التي تُحدَد سلطاتها واختصاصات رئيسها وأعضائها بظهير شريف بينما يباشر الملك السلطة التشريعية مع المؤسسات التي سيقيمها.
ورسم "العهد الملكي" الإطار الذي يجب أن تمارس داخله حقوق الإنسان في البلاد، إذ تضمن إقرار مبدأ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بموجب قانون يضمن للناس حرية التعبير والنشر والاجتماع وتكوين الجمعيات.[21]
ثانيا: عبر إصداره لقانون الحريات العامة في 15 نوفمبر 1958 الذي وضع الإطار القانوني لتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية.
وبذلك فإن "العهد الملكي كان بمثابة الأرضية السياسية والتشريعية التي قعدت دولة المؤسسات بالمغرب ووضعت اللبنات الأولى لملامح النظام الدستوري للبلاد كملكية دستورية".
- القانون الأساسي للمملكة: 2 يونيو 1961
ويقرر هذا القانون المهم العديد من الحقوق ، المعترف بها للمواطنين، فعلى المستوى القانوني والسياسي فقد أشار إلى مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات ، وإلزام الدولة بصيانة كرامة الأشخاص ، وكفالة الحريات العامة والخاصة ، كما أشار إلى حقوق ذات طابع اقتصادي واجتماعي كتأكيد إقرار نظام اقتصادي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنمية الإنتاج وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتأميم الثروات الوطنية ، والتزام الدولة بوجوب كفالة التعليم في إطار توجيه عربي وإسلامي وبناء على حاجيات المجتمع وما يتطلبه من تكوين تقني ومهني وعلمي ، ولم يكتف القانون الأساسي بالإشارة إلى أنواع الحقوق ، بل حاول إرساء دعائم مجال سياسي قانوني يساعد على ممارسة هذه الحقوق، فأكد على دعامتين أساسيتين : مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء ضمانا للعدل[23] .
كما أنه خصص في نهاية القانون الأساسي فصلان لرسم مستجدات السياسة الخارجية، حيث أعلن فيهما عن" التزام المغرب بانتهاج سياسة عدم التبعية، وعن تعلقه بمبادئ مؤتمر باندونج ووفائه لجامعة الدول العربية، ولميثاق الأمم المتحدة، وللميثاق الأساسي لمؤتمر القمة الإفريقي بالدار البيضاء، ومقرراته في الوحدة الأفريقية، ومحاربة الاستعمار والعنصرية في جميع أشكالها "[24].
وبالإضافة إلى الحقوق والحريات، تضمن القانون الأساسي للمملكة كذلك على عدة مبادئ تتعلق بطبيعة الدولة المغربية [25]، ومنها أن المغرب مملكة عربية إسلامية، والإسلام دين الدولة الرسمي، والعربية لغة البلاد الرسمية، ومتابعة الكفاح لاستكمال وحدة البلاد الترابية.
واستمر العمل بهذه المبادئ منذ الإعلان عن القانون الأساسي يوم 8 يونيو 1961 إلى حين المصادقة على الدستور الأول يوم 7 دجنبر 1962.
- دستور دجنبر 1962
وفي 7 دجنبر سنة 1962 وَّفّى الملك الحسن الثاني بوعد أبيه الذي كان قد وعد بوضع دستور للبلاد قبل انتهاء 1962، ولم يمنعه من ذلك سوى موته المفاجئ إثر عملية جراحية بسيطة على الحنجرة في 27 فبراير 1961، وطرح مشروع دستور ممنوح على الاستفتاء الشعبي، دون أخذ رأي المعارضة فيه أو العودة إلى إحياء فكرة مجلس الدستور، لتُحسم بذلك معركة الدستور والسلطة التأسيسية لفائدة الملك. وتم الاستفتاء على الدستور، رغم دعوة أحزاب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والدستور الديمقراطي والحزب الشيوعي المغربي إلى مقاطعته واستبداله بانتخاب مجلس تأسيسي للدستور، وقد تم اتهام
" الاتحاد الوطني للقوات الشعبية " بأنه، بدعوته إلى انتخاب مجلس تأسيسي، " يريد الإطاحة بالملكية كما حدث حين الثورة الفرنسية عندما اجتمع مجلس تأسيسي سنة 1789 وقرر إلغاء الملكية". ولم يكن ذلك ليثني المعارضة اليسارية عن مطلبها بانتخاب مجلس تأسيسي، بحجة أن " ممثلي الشعب هم الذين يجب أن يضعوا الدستور"، وأنها " لا تريد دستورا ممنوحا، لأن الدستور تنظيم ديمقراطي للحكم وهو حق مقدس للشعب"، وأن "هذا الدستور هو الذي سيضعه ممثلو الشعب والذي سيضع حدا للالتباس والغموض والفوضى السائدة في تسيير شؤون البلاد"[26]
غير أن أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار المستقلين صوتوا لصالح الدستور، والنتيجة الرسمية للاستفتاء كانت بالإيجاب بنسبة 84 في المائة.
هذا " الإصلاح السياسي " الذي تمثل في وضع دستور ممنوح للبلاد، حسم الصراع وإلى اليوم حول مجموعة من القضايا الخلافية لصالح الملك: كاختصاصات الملك الواسعة، وطبيعة النظام السياسي، ودور البرلمان، ودور الأحزاب، وكيفية تشكيل الحكومة وصلاحياتها، وهو ما جعل آمال المعارضة وبخاصة الإتحاد الوطني للقوات الشعبية في إقامة ملكية برلمانية عصرية يسود فيها الملك ولا يحكم تتبخر، كما أن حزب الاستقلال الذي حاول من خلال تصويته الإيجابي على الدستور مغازلة القصر للحصول على وزارات هامة في الحكومة التي أعقبت انتخابات 17 ماي 1963، خرج هو الآخر خاوي الوفاض حينما استأثر صنيع القصر الجديد، حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، المعروف اختصارا باسم " الفديك" بأغلب الوزارات، ضمن تكتيك السلطة الجديد، ما جعل الحزب ينتقل للمعارضة ولأول مرة منذ الاستقلال.
ومن حيث المضمون، حدد هذا الدستور في فصله الأول طبيعة النظام السياسي المغربي بكونه نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، وفي فصله الثالث منع نظام الحزب الوحيد، وجعل دور الأحزاب مختزلا فقط في تنظيم المواطنين وتمثيلهم دون أي أمل في الوصول إلى السلطة، كما هو متعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية، لأنه وببساطة، من يمتلك السلطة بحسب الدستور هو الملك، كما هو منطوق الفصل 19 " الملك أمير المؤمنين، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين، والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة." و في فصله 14 أقر حق الإضراب، لكنه أفرغه من أي معنى حينما أضاف إليه عبارة" وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق"، وأما الفصل 24 فقد أعطى للملك وحده الحق في تعيين أو إعفاء الوزير الأول وباقي الوزراء، دون تمتيع الوزير الأول بأي سلطة تقريرية كيفما كان نوعها، واكتفى الفصل 62 بتمتيع الوزير الأول فقط بسلطة تنظيمية مرتبطة بعمل مختلف الوزارات. وجعل الفصل 36 البرلمان مكونا من مجلسين: مجلس للنواب ينتخب جميع أعضائه بالاقتراع المباشر وآخر للمستشارين وينتخب أعضاؤه بصفة غير مباشرة عن طريق مستشاري الجماعات المحلية والهيئات المهنية وممثلي المأجورين، وحدد الفصل 44 مدة مجلس النواب في أربع سنوات.
أما حدود السلط: أي العلاقة بين السلط الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضاء. فقد جعل القضاء مستقل عن السلطتين السابقتين (ف 82)، في حين أن سلطة التنفيذ وسلطة التشريع بينهما علاقة خاصة: تعاون من جهة (مساهمة الحكومة في التشريع عن طريق مقترحات القوانين، ومساهمة الملك عن طريق الاستفتاء، مساهمة البرلمان في عمل الحكومة عن طريق الأسئلة)، وتبادل للضغط من جهة أخرى (حل البرلمان من قبل الملك، سحب الثقة وملتمس الرقابة من قبل البرلمان). وتبادل الضغط هذا هو ما يسمى “التوازن” في الأنظمة الدستورية البرلمانية، ف” لا الحكومة (الملك في دستور 1962) عاجزة عن حل برلمان يمكنه أن يسحب منها ثقته، ولا البرلمان عاجز عن سحب ثقته من حكومة (الملك في الدستور المغربي لسنة 1962) يمكنها حله"[27]
- دستور يوليوز 1970:
وفي العام 1969 تم اكتشاف تنظيم سري مسلح بقيادة الفقيه البصري، وهو أحد مؤسسي جيش التحرير المغربي، وقائد" التيار البلانكي" داخل الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومحكوم عليه سابقا بالإعدام فيما عرف بـ " مؤامرة يوليوز 1963" التي استهدفت حياة الملك، وقد قيل حينها أن هذا التنظيم كان يسعى للإطاحة بالنظام احتجاجا على فرضه دستور ديسمبر 1962، وسده لكل منافذ النشاط السياسي.
في ظل هذه الأجواء، ومن أجل العمل على تنفيس الجو السياسي الداخلي لتلميع صورة المغرب في الخارج، وتجنيب البلاد آثار انقلاب يونيو 1965 العسكري الذي أوصل الهواري بومدين للسلطة في الجارة الجزائر، أصدر الملك الحسن الثاني عفوا ملكيا على مجموعة من المعتقلين السياسيين، وأرفقه بخطاب إذاعي يوم 8 يوليوز 1970 أعلن فيه عن نهاية حالة الاستثناء، وعن نيته تعديل دستور 1962.
فجاء دستور 24 يوليوز 1970، ليحافظ بدوره على الطابع العتيق للملكية المغربية، حيث لم يُحدث إلا تغييرات شكلية وطفيفة، دون المساس بجوهر أول دستور اعتمده المغرب المستقل[28].
ويذهب عبد الله العروي إلى أن الدستور الملكي المغربي يحتمل قراءتين: شرعية، وديمقراطية. إذ يرى أن كل كلمة أساسية فيه قد تُؤَول تأويلين (سيادة، حكومة، قانون، انتخاب... إلخ). وعلى هذا الأساس، يمكن لأي امرئ أن يُعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خلافة، أو بصيغة ديمقراطية حتى تَحسب أنه دستور دولة اسكندنافية، وهو ما يُعد نتاجا لإرث مزدوج: تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية. [29]
لقد جاء هذا الدستور ليقنن ويُدسْتِر حالة الاستثناء، ويركز أكثر السلطات في يد الملك، ما شكل تراجعا كبيرا عن دستور 62 على علته، وهذه بعض الإشارات الدالة على هذا التراجع:
* تم الاحتفاظ بمتن الفصل 19 الذي يشكل وحده دستورا آخرا، يرى محمد معتصم في أطروحته بأن الملك الدستوري لا يعدو كونه امتدادا استراتيجيا للملك كأمير للمؤمنين، فثمة ما فوق الدستور، وهو أمير المؤمنين الذي يستمد سلطته من الكتاب والسنة، وأصله الشريف والعلوي المقدس، إذ نجد بأن أغلب صلاحيات الملك الدستوري تجد أساسها في بعض صلاحيات أمير المؤمنين، لا في دستور الجمهورية الخامسة الذي أضفى عليها فقط لبوسا عصريا، ذلك أن وظيفة الدستور ليست إلا تجديد العهد المقدس بين الملك وشعبه. [30]
كما ينطوي الفصل 19 على طابع تقليداني ملحوظ، لا يقتصر على لقب أمير المؤمنين، بقدر ما ينصرف إلى ألقاب أخرى، من قبيل "رمز"، و"حامي"، و"ضامن"، لما تتضمنه من إيحاءات سياسية ودينية ورمزية قوية. فإذا وقفنا على لفظ "الضمان" لوحده، فإنه ينطوي في السياق المغربي، على بعد رمزي - ديني مُعَبر، إذ يشير عبد اللطيف المنوني إلى أن "الضامن هو الذي يتوسط لدى الله أو قديس لإنقاذ شخص أو جماعة..".[31]
وبالرغم من عدم التنصيص الدستوري الصريح على سمو السيادة الملكية على التمثيل البرلماني، فإن اعتبار الملك رمزا لوحدة الأمة، يجعله يمثل أحياءها وأمواتها، ومن سيُخلقون من الرعايا، هذا في حين لا يمثل عضو البرلمان إلا دائرة انتخابية متغيرة.[32] وهكذا فإن مقتضى "الممثل الأسمى للأمة" يمكن اعتباره ابتكارا دستوريا للحد من الآثار المحتملة للمادة الثانية من الدستور، التي تؤكد على مبدأ السيادة الشعبية.[33] كما أن تنصيص الفصل 23 من الدستور على أن شخص الملك مقدس لا تُنتهك حرمته، ما هو إلا امتداد لشرفاوية وعصمة الإمام. أما الحكومة المنبثقة عنه دستوريا، فإن وزراءها، وحتى النواب البرلمانيين، ليسوا إلا مُعينين أو مساعدين، وفق تصور الماوردي لأمير المؤمنين.[34]
ومن الناحية العملية، برز توظيف الفصل 19، والحضور اللافت للمرجعية التقليدية في سياقات مختلفة، لعل أبرزها إعلان حالة الاستثناء (1965 – 1970) من طرف الملك الحسن الثاني، وهو ما نظر إليه بعض المراقبين كاستراتيجية دفاعية نهجتها المؤسسة الملكية ضد المعارضة العلمانية. هذا دون إغفال تجليات أخرى لتوظيف المرجعية الدينية في الحياة السياسية خلال تلك الفترة، من قبيل إحياء طقس التماس الشفاعة من أمير المؤمنين (طلب العفو والشفاعة من طرف أعيان مدينة مراكش عقب أحداث سنة 1984...). [35]
* وجاء الفصل 21 بصيغة جديدة أعيد من خلالها النظر في تركيبة مجلس الوصاية، واختصاصاته التي استثني منها مراجعة الدستور، وصفته الجديدة كهيئة استشارية تعمل إلى جانب الملك غير البالغ لسن الرشد، إلى حين بلوغه ذلك. بخلاف دستور 62 الذي أعطى سلطة
التسيير إلى مجلس الوصاية دون تقييدها بموانع أخرى كضرورة الاستشارة مع الملك اليافع، أو الامتناع عن مراجعة الدستور. والهدف من وراء ذلك، هو سد كل المنافذ التي قدد تتسرب من خلالها بعض صلاحيات الملك إلى جهات أخرى.
* وعلى عكس دستور 1962، قيد الفصل 37 من الدستور الجديد حصانة النواب البرلمانين في حال إبدائهم رأيا يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك، ولوح بإمكانية متابعتهم أو إلقاء القبض عليهم في حال وقوعهم في مخالفة من هذا النوع.
* كما جرى اعتماد نظام الغرفة الواحدة مع تقليص نسبة الأعضاء المنتخبين مباشرة من الشعب (المجلس مكون من 240 عضواً، ينتخب تسعون منهم بواسطة الاقتراع العام المباشر، فيما ينتخب الباقون، وعددهم مائة وخمسون، بالاقتراع غير المباشر) وحددت مدة العضوية في ست سنوات.
وكرد فعل مباشر على هذا الدستور المخيب للآمال، تشكلت بتاريخ 22 يوليوز " الكتلة الوطنية" من حزبي الاستقلال بقيادة علال الفاسي والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد، وصدر عنها ميثاق سلا التأسيسي الذي دعا إلى إقامة ديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، كما دعت الكتلة للتصويت بـ "لا" ضد مشروع دستور 70، كما أصدرت لجنتها المركزية بيانا في 4 غشت من نفس السنة تعلن فيه قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريخ 21 و28 غشت من نفس السنة، ما جعل برلمان 1970 "المنتخب" برلمانا غير ذي معنى، ما دام لا يستطيع ضم قوى المعارضة لتحييدها وإدماجها في اللعبة، وقد ترأسه السيد عبد الهادي بوطالب بأمر ملكي.
وقد وضعت المحاولة الانقلابية لسنة 1971 حدا لحياة دستور 1970.
- دستور مارس 1972:
في ظل هذا التجاذب سيتم عرض مشروع تعديل الدستور، وبالرغم من الإيجابيات التي جاء بها بالمقارنة مع الدساتير السابقة، إلا أن المعارضة قررت الامتناع عن التصويت معتبرة أن الأسلوب الذي تم من خلاله تعديل الدستور يعتبر معاديا للديمقراطية. وأنه دستور لم يأخذ باقتراحاتها التي تفاوضت مع الملكية بشأنها لإدخال إصلاحات سياسية ودستورية منذ 1971. في حين اعتبرته المؤسسة الملكية أنه "يشكل صرحا جديدا "وينم عن "روح الطموح وإرادة الوثبة إلى الأمام".[36]
وهكذا أمر الملك بحل مجلس النواب المنبثق عن دستور 1970، وكلف التكنوقراطي " كريم العمراني " بتشكيل حكومة جديدة في 3 أبريل 1972، ودعا الكتلة إلى المشاركة فيها، لكنها رفضت، وشنت حملة ضد المجلس والحكومة، واسهم في تصعيد الموقف تظاهرات الفلاحين احتجاجا على منح السلطة الملكية جزء من الأراضي إلى عناصر الإقطاع، في محاولة لاستمالتهم إلى جانبها، فضلا عن المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الحكم ومحاولة اغتيال الملك الحسن الثاني عام 1971، مما دفع الملك إلى إيقاف العمل بالدستور، ووضع المغرب تحت حالة الاستثناء دون الإعلان الرسمي عنها.[37]
وبتاريخ 30 أبريل 1972 أعلن الملك الحسن الثاني عن تأجيل الانتخابات المنبثقة عن الدستور الجديد إلى تاريخ غير محدد، وبقي الدستور الثالث مجمدا بحيث لم ينتخب مجلس النواب، ولم تنشأ عنه حكومة طيلة خمس سنوات. إلا أن قضية الصحراء المغربية عملت على تهيئة جو للانفتاح السياسي.[38]
وهو ما نجح فيه النظام بامتياز مع بداية 1974، حيث بدأ بتعبئة الجميع خلفه حول معركة استرجاع الصحراء من المستعمر الإسباني، وبناء الوحدة الترابية للمغرب، وهذه معركة وطنية كبرى أرغمت جميع الفاعلين السياسيين قصرا ومعارضة على التوحد خلفها. وقد ظهر ذلك جليا من خلال مساهمة الجميع في المسيرة الخضراء التي نظمت بتاريخ 6 نوفمبر 1975، وأدت إلى تحرير الصحراء، وهكذا عرفت البلاد تدشين "المسلسل الديمقراطي" سنتي 1976 و 1977 عبر إجراء ثالث انتخابات محلية وتشريعية في المغرب، وعودة بعض القوى السياسية التي كانت تعاني من الحظر كالتقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلى الشرعية، فيما تم تأجيل مسألة الإصلاح الدستوري والسياسي بدعوى تصليب الجبهة الداخلية.
لكن، ومع انتخاب برلمان 1977، ودخول بنود دستور 1972 حيز التطبيق، بهدف قيام المؤسسات التمثيلية بدورها في تعزيز البناء إذ أصبحت مقتنعة بالحوار السياسي للمشاركة في الحكم في إطار المشروعية الديمقراطية، مع اعترافها بالشرعية الدينية والتاريخية والسياسية للملكية. وبذلك اقتصر دورها في معارضة الاختيارات المطروحة بدلا من معارضة النظام السياسي. ولم تخرج النتائج الرسمية عن النسق شبه الإجماعي، إذ يبلغ عدد المؤيدين 98 % بنسبة مشاركة ناهزت 92 %، مما يدل على تجاوز المعارضة الحزبية، ومن خلاله بلورة حدود المشاركة السياسية كما ترتئيها الحكومة.[39]
- دستور سبتمبر 1992:
وعلى اعتبار المغرب فاعلا نشيطا داخل المنتظم الدولي فقد تأثر برياح التغيير؛ حيث أشار العاهل المغربي الحسن الثاني على أنه "سيكون من مجافاة الصواب القول إننا غير معنيين بالأحداث التي شهدها العالم أو ادعاء ألا تأثير لها علينا" [42]" فالعالم كله عرف تغييرات عميقة قلبت كل الأسس بما في ذلك أن جانبا مهما من هذا المجتمع هوى بكامله مبرزا عن نفسه للعالم مظهرا غير منتظر بدا فيه نظام القطبية وقد انقلب رأسا على عقب. وكان من الطبيعي والحالة هذه أن يسعى المغرب بدوره إلى التلاؤم مع النظام الجديد فمبررات الانحسار والانقطاع التي كانت واردة فيما مضى لم يعد لها وجود"[43].
وقد دفع عجز الدساتير الثلاث السابقة والإصلاحات السياسية الشكلية التي رافقتها قوى المعارضة اليسارية إلى المطالبة بتغييرها، أو تعديلها كحد أدنى، عبر رفع مذكرتين حول الإصلاح الدستوري إلى القصر " الأولى بتاريخ 9 أكتوبر 1991 من طرف كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم من منظمة العمل الديمقراطي الشعبي( قبل تأسيس الكتلة الديمقراطية)، والثانية بتاريخ 19 يونيو 1992 من طرف الكتلة الديمقراطية التي كانت قد تأسست بتاريخ 17 ماي 1992 من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي"[44].
وقد تمحورت مطالب أحزاب الكتلة الديمقراطية في مذكرة سنة 1991 ومذكرة سنة 1992 أساسا حول الملكية البرلمانية وتدعيم حقوق الانسان وتحديد مسؤولية مختلف السلط واختصاصاتها وتوضيح العلاقات فيما بينها في إطار التوازن والتوافق من خلال جملة من الاقتراحات تهم ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية الفردية والجماعية، وتوسيع صلاحيات مؤسسة البرلمان الذي كان يتكون من مجلس النواب فقط، من خلال توسيع مجال القانون وتحديد أجل الآمر بتنفيذه، وتعزيز صلاحيات مجلس النواب في مراقبة عمل الحكومة، أما السلطة التنفيذية فطالبت بتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها أكثر... إلى جانب اقتراحات تهم إصلاح السلطة القضائية بهدف ضمان استقلاليتها وإحداث
عدد من المؤسسات والارتقاء بأخرى إلى مصاف المؤسسات الدستورية بهدف تعزيز الشفافية والحكامة...[45]
بدوره النظام، وبهدف تلميع صورته على المستوى الدولي، واحتواء المد النضالي الذي عرفه المغرب مع بداية التسعينات فيما يخص المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية، بادر إلى الإعلان عن نيته إطلاق مشروع دستوري جديد، ووعد بالنظر في مطالب الكتلة الديمقراطية مع احترام قاعدة " الملك يسود ويحكم "، كما جاء في حديث الملك لصحيفة " لوموند" الفرنسية في شتنبر 1992 والذي قال فيه "الإسلام يمنع إقامة ملكية دستورية يفوض فيها الملك جميع سلطه ويصبح يملك دون أن يحكم" ، وتم إلغاء ظهير "المقيم العام الفرنسي هانري بانصو" لسنة 1935 سيء الصيت، والمعروف اختصارا بظهير "كل ما من شأنه".
لكن الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء 14 سبتمبر 1992 لم يحمل في طياته أي تغيير جدي يذكر، فلم يستجب لمطالب الكتلة الديمقراطية حول حكومة مسؤولة، منبثقة من الأغلبية البرلمانية، تحدد وتدبر سياسة الدولة بموجب نص الدستور، الذي ينبغي أن ينص كذلك على ترحيل بعض اختصاصات المجلس الوزاري إلى المجلس الحكومي، والإقرار بإمكانية ترؤس الوزير الأول للمجلس الوزاري عوض الملك عن طريق التفويض.
بل تم الاكتفاء فقط بتعديل بسيط للفصل 24 الذي أصبحت صيغته كالتالي " يعين الملك الوزير الأول. ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. وله أن يعفيهم من مهامهم. ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها" بدلا من صيغة " يعين الملك الوزير الأول والوزراء ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم إن استقالوا" الواردة في دستور 72، بالإضافة إلى التأسيس التدريجي لنظام الملكية البرلمانية وتوسيع صلاحيات البرلمان، بفرض بعض القيود على اختصاصات الملك، كتحديد أجل تنفيذ القانون في 30 يوما، ما من شأنه الحد من مشكل تأخر صدور القوانين[46]، واشتراط موافقة البرلمان على الاتفاقيات التي لها وقع مالي على ميزانية الدولة، وعدم حل البرلمان في حالة الاستثناء [47] ...، وتخويله آليات لمراقبة عمل الحكومة بعد أن كانت كفة الصلاحيات تميل بشكل كبير لصالح الحكومة في ظل الدساتير السابقة (دستور 1962 - دستور 1970 – دستور 1972 ) وتتجلى هذه الآليات في تنصيب الحكومة من طرف البرلمان من خلال التصويت بالثقة على برنامجها [48]، دسترة لجان تقصي الحقائق التي تتمثل مهمتها في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، أما على مستوى القضاء فلم تتم الاستجابة لمطالب الكتلة الديمقراطية، بضمان فعلي لاستقلال القضاء وصيانة حرمته.
وهكذا رفضت أحزاب الكتلة دستور 92 ودعت إلى مقاطعته باستثناء حزب التقدم والاشتراكية الذي صوت لصالحه ودعا الناخبين للتصويت الإيجابي عليه.
- دستور سبتمبر 1996:
وعموما جاء التعديل الدستوري لسنة 1996 مستجيباً فقط لبعض مطالب المعارضة الثانوية التي وردت في مذكرتها التي وجهتها للملك الراحل الحسن الثاني بتاريخ 23 أبريل 1996، ودارت إجمالاً حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، وحول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصلاح الإدارة والقضاء وضمان نزاهة الانتخابات.... في حين تجاهل مطالب أساسية أخرى متعلقة بصلاحيات الملك، والحكومة، والوزير الأول، ورغم ذلك صوتت أحزاب الكتلة الديمقراطية، باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بنعم على دستور عام 1996، ووصفت تصويتها الإيجابي هذا بالتصويت السياسي الذي هدفت من وراءه إرسال رسالة ثقة وتشجيع إلى النظام لتهيئة الأجواء قبل الدخول في تجربة التناوب التوافقي.
ومن ناحية أولى، أدت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ثمنا باهظا من تماسكها التنظيمي بسبب موقفها الرافض للتعديل الجديد، إذ رحل عنها تيار واسع من أطرها المؤيدين للدستور، وشكلوا حزبا سياسيا جديدا تحت اسم " الحزب الاشتراكي الديمقراطي " بقيادة عيسى الورديغي وذلك في الفاتح من سبتمبر 1996 أي قبل 13 يوما فقط من الاستفتاء على الدستور (في ديسمبر سنة 2005 اندمج هذا الحزب بصفة كلية في صفوف الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
ومن ناحية ثانية وقع تقارب بين النظام السياسي وأحزاب الكتلة الأخرى المساندة، تطور فيما بعد إلى إشراك هذه الأحزاب في أول حكومة تناوب توافقي يعرفها المغرب منذ الاستقلال، وألقي على عاتقها مسؤولية إنقاذ البلاد من " السكتة القلبية" التي حذر منها الملك الراحل في قبة البرلمان في دورة مايو التشريعية سنة 1995[51] على خلفية تقرير قاتم لمدير البنك الدولي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب[52].
واقتداء بأحزاب الكتلة الديمقراطية قدمت أحزاب الوفاق أيضا (الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية)[53] مذكرات مطلبية سنة 1996، وقد وافقت رؤيتها للإصلاح التصور الملكي من خلال مطالبتها بتكريس الملكية الدستورية الحاكمة والاكتفاء بتعديلات بخصوص الغرفة الثانية للبرلمان.
فالتاريخ الدستوري للمغرب تميز بجدل كبير بين مختلف القوى السياسية حول موقع الملك في النظام السياسي والدستوري، فالملك والأحزاب الموالية له يسعيان لإرساء الملكية الدستورية التي يسود فيها
الملك ويحكم، أما أحزاب المعارضة فترى أن السيادة للأمة وأن الملك يجب أن يسود دون أن يحكم في إطار نظام الملكية البرلمانية[54].
دستور يونيو 2011:
يمثل دستور سنة 2011 أول تعديل دستوري في عهد الملك محمد السادس، الذي لم يقدم أي إشارة إلى عزمه إجراء أي تعديل دستوري طيلة اثنا عشر سنة من توليه الحكم، رغم الأوراش الإصلاحية التي دعا إليها والتي يستلزم بعضها تعديلا دستوريا، كورش الجهوية المتقدمة ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه للأمم المتحدة كحل للنزاع حول الصحراء.
جاء خطاب 9 مارس 2011 الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن هذا التعديل، كرد فعل على تداعيات الانتفاضات التي عرفتها المنطقة والتي خرج على إثرها آلاف المغاربة إلى الشوارع للاحتجاج
والتعبير عن مطالبهم.
فلقد طفت من جديد مطالب بإجراء اصلاح دستوري وسياسي، عبرت عنها أحزاب الحركة الوطنية في مناسبات متفرقة (برامجها الانتخابية لسنة 2007، المؤتمرات الوطنية لسنة 2009...)[55] ، إلى جانب فاعل جديد في الساحة السياسية تمثل في المجتمع المدني بمكوناته الحقوقية والثقافية والسياسية التي قدمت بدورها مطالب تتوافق مع المجال الذي تنشط فيه، كما تم في 6 يونيو 2002 تأسيس تنظيم اختير له اسم "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي "، ضم عددا من الأحزاب السياسية و الهيئات المجتمعية، سعت على اختلاف اهتماماتها إلى بلورة تصور حول الإصلاح الدستوري [56].
لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب إلا سنة 2011 من خلال خطاب 9 مارس الذي جاء على خلفية أحداث ما عُرف "بالربيع العربي"، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منعطفا سياسيا خطيرا تجسد في حركات واحتجاجات شعبية كبيرة، بدأت في تونس تم انتشرت في باقي دول المنطقة.
وبوصول مدى هذه الاحتجاجات إلى المغرب، نزل إلى الشوارع عدد كبير من المغاربة في 53 مدينة في 20 فبراير 2011، مطالبين بالديمقراطية والتغيير تحت شعار " الشعب يريد دستورا جديدا " وباتت هذه الحركة تعرف بحركة " 20 فبراير"، وقد ضمت إلى جانب الشباب غير المنتمين لأي تيار، إحدى
أكبر الجماعات الاسلامية المعارضة غير الرسمية التي تعرف ب "جماعة العدل والاحسان"، بالإضافة إلى
بعض الأحزاب اليسارية الصغيرة وبعض الهيئات الحقوقية، فقد ضمنت حركة 20 فبرابر مزيجا من
ايديولوجيات مختلفة توحدها فقط معارضتها للحكم السلطوي بمختلف تجلياته.[57]د
وعلى إثر هذه الأحداث وما آلت إليه الأوضاع في باقي دول المنطقة، عمل الملك محمد السادس في خطاب له بتاريخ 9 مارس 2011 على الإعلان عن جملة من الاصلاحات السياسية التي حدد الإطار العام لها في تعديل دستوري ينبني على سبع مرتكزات من بينها: الطابع التعددي للهوية المغربية، توسيع مجال
الحريات الفردية والجماعية، إصلاح القضاء، توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها ...، وعهد إلى لجنة خاصة
لإعداد مسودة هذا الدستور، بتشاور مع مختلف الفعاليات السياسية في ظرف أربعة أشهر، من أجل تقديمه للاستفتاء في فاتح يونيو، وقد ترأس هذه اللجنة الجامعي عبد اللطيف المنوني، وقد نُظر إلى هذا الإصلاح الدستوري كاستباق لتداعيات موجة "الربيع العربي" على المغرب، في سياق مظاهرات حركة 20 فبراير التي رفعت جملة من المطالب الإصلاحية، لعل من أبرزها توسيع الحريات وإقامة ملكية برلمانية.[58]
ومن المضامين الجديدة لدستور سنة 2011 توسيع روافد هوية المملكة، من خلال تنصيصه على مقوماتها العربية والاسلامية و الأمازيغية والصحراوية الحسانية، الغنية بروافدها الافريقية و الأندلسية و العبرية والمتوسطية، مع التأكيد على المكانة المتميزة للدين الاسلامي فيها، فهذه الهوية المتعددة الروافد كانت غائبة في ظل دستور سنة 1996 الذي لم يكن يعترف إلا "بالعروبة و الاسلام"، فدستور 2011 سعى إلى الانفتاح على كل المكونات والثقافات المغربية، وانسجاما مع هذا المقتضى تمت دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، لكن رغم هذا الاعتراف إلا أن الدستور ربط تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بصدور قانون تنظيمي يبين كيفيات إدماجها في مجال التعليم و المجالات العامة (ذات الأولوية )الفصل 5 .[59]
كما أقر دستور 2011 حقوقا جديدة تتوافق مع التطورات التي عرفتها حقوق الانسان عالميا ونضال الهيئات الحقوقية في المغرب، من هذه الحقوق نجد الحق في الحياة (الفصل 20 )، الحق في الأمن الشخصي،)الفصل 21 )، الحق في حماية الحياة الخاصة (الفصل 24 )، الحق في الحصول على المعلومة (الفصل 27)، الحق في تقديم ملتمسات (الفصل 14 )، الحق في تقديم العرائض(الفصل 15)، أما بخصوص نظام الحكم و طبيعة العلاقة بين السلط، فقد جاء في الفصل الأول من الدستور أن نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية و اجتماعية، و أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوزيعها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.[60]
وقد شكلت الملكية البرلمانية أحد مطالب حركة 20 فبراير، لكن التنصيص الدستوري الصريح عليها لا يعني بالضرورة أن المغرب قد انتقل من الملكية الدستورية إلى الملكية البرلمانية، فمن خلال المضمون والتعابير التي جاءت في الفصل الأول يتبين أن هناك توجها نحو إرساء نظام الملكية البرلمانية، لكن بالنظر إلى روح الوثيقة الدستورية ومضمونها يلاحظ أنه لا يتوفر الحد الأدنى لإحداث القطيعة مع نظام السلطة الدستورية الذي يسود فيه الملك ولا يحكم[61] ، فهو لازال يتمتع بصلاحيات واسعة تجعله الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، رغم بعض القيود التي أصبحت ترد على بعض اختصاصاته مقارنة مع دستور 1996 ، حيث أصبح ملزما بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية، ويعين الوزراء ويقيلهم بعد استشارة رئيس الحكومة[62]..
أما بخصوص صلاحيات البرلمان، فإلى جانب تكريس دستور 2011 للعمل بنظام المجلسين، فانه قد سعى إلى توسيع صلاحيات البرلمان في مجالي التشريع ومراقبة الحكومة حيث تم توسيع مجال القانون
ليشمل مجالات مختلفة (الفصل 71)، كما تخصص جلسة شهرية لإجابة رئيس الحكومة على الأسئلة، المتعلقة بالسياسيات العمومية، وجلسة سنوية لمناقشة هذه السياسات وتقييمها (الفصل 101)، كما سعى لصيانة مكانة المعارضة البرلمانية وتمكينها من ممارسة دورها من خلال تمكينها من عدد من الحقوق منها الحق في التعبير عن الرأي والاجتماع، استفادتها من حيز زمني في وسائل الاعلام يتناسب مع
تمثيليتها، المشاركة في مسطرة التشريع (الفصل 10).
يبقى دستور 2011 ورغم تنصيصه على الاختيار الديمقراطي باعتباره ثابتًا من الثوابت، لم تتحقق فيه مجموعة من المعايير الديموقراطية، سواء على مستوى طريقة وضعه أو على مستوى مضمونه. فبعيدا عن الطريقة الديموقراطية الأساس في وضع الدستور، الديموقراطي التي هي مجلس تأسيسي منتخب، ظل الملك هو مالك السلطة التأسيسية، وبعيدا حتى عن الصيغة التوافقية، التي تقتضيها الديموقراطية التشاركية، كانت وظيفة كل من اللجنة الاستشارية وآلية التتبع السياسية إضفاء الشرعية العلمية والسياسية على المسار الإعدادي للدستور، ولم تكن الوظيفة تحقيق شراكة دستورية فعلية، واذا كان الاستفتاء آلية من آليات الديمقراطية، فقد شابته مجموعة من الشوائب التي أفرغته من طابعه الديمقراطي ، لتكون نتيجة كل ذلك دستور استمرارية وليس دستور قطيعة. فقد ظل الاختلال الجوهري على مستوى السيادة قائمً، وإن قُو يِض بذلك توسيع مجال الحقوق، ليبقى المغرب في وضعية مأسسة منقوصة، تفتقد الجوهر الديمقراطي. لقد تكيفت الملكية مع موجة الربيع العربي، لكن فقط من منطلق هواجس المرحلة، وليس من منطلق استشرافٍ إستراتيجي، كان يقتضي بالضرورة الاستجابة لمطلب دستور ديمقراطي: شكلًا، ومضمونا. ومما لا شكّ فيه أنّ هذا الاختيار ستكون له عواقب سلبية على مختلف المؤسسات السياسية والدستورية، ومنها المؤسسة الملكية.[63]
علي سبيل الختم:
لقد شكل الصراع على السلطة في مغرب ما بعد الاستقلال أساس التعثرات الكثيرة، وسبب في ضياع الفرص السانحة لولوج خانة الدول الديمقراطية، ودفعت إلى البحث عن نصوص دستورية بديلة، لتدبير مراحل الصراع على السلطة والتنافس عليها في مرحلة لاحقة، والمشاركة فيها كمرحلة متقدمة معلنة عن الاقتراب من المحطة الديمقراطية.
فاعتماد ستة دساتير [64]منذ الاستقلال إلى الآن، دليل على الصعوبات التي واجهت المشروع الديمقراطي المغربي، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن العنصر الذي يدفع إلى وقوع اختلالات في النظام السياسي، ويتجه به في الكثير من الأحيان نحو التراجع عن المكاسب المحققة بنضالات وتضحيات كبيرة، وتفويت للفرص التي تحرم الأجيال من الحياة الديمقراطية، هل أعطاب الانتقال الديمقراطي مرتبطة بالوثيقة الدستورية
التي تنص صراحة على الملكية الدستورية وفصل السلط، وسيادة الشعب والحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وعلى النظام البرلماني، بل وصل بنا المسار إلى أن يتم التنصيص في الدستور الحالي لعام 2011 على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة المغربية.
لقد حقق المغرب تراكما حقيقيا في مجال الممارسة الدستورية، وكذا الفكر الدستوري المغربي أصبح رائدا بدراساته واجتهاداته، قابل للتصدير نحو من يرغب في الاستفادة الفورية من دروس مستخلصة من تجربة دستورية غنية وقوية، ولكن في نفس الوقت، وبعد التنزيل المسترسل لمضامين دستور 2011 ، يتضح في الكثير من الأحيان، أن هذه الوثيقة تحتاج إلى مراجعة فورية لتجاوز بعض النقائص والبياضات التي تكتنفها، ولما لا أن نستغل فرصة المراجعة لطرح مسألة الحسم في الانتقال الديمقراطي للولوج، وبشكل نهائي، لحقبة جديدة حقبة الديمقراطية الكاملة والتامة، فالمجتمع المغربي قدم الشيء الكثير من أجل هذه اللحظة، لحظة الدستور الديمقراطي.[65]
[1] - نوال بوهالي، دروس عبر الخط في القانون الدستوري، أستاذة محاضرة "ب " كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة، الجزائر.
[2] - Ardani Philippe: ¨ Institutions Politiques et Droit Constitutionnel ¨16Ed Lite 1992 p92.
[3] - Menouni Abdelatif: ¨ Institutions Politiques et Droit Constitutionnel ¨ Les éditions Toubkal 1991 p 80.
[4] - اتركين محمد، الدستور والدستورانية -من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق -الطبعة الأولى 2007، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء، صفحة 37.
[5] - محمد المدني، " بروز الدستورانية وظهور الحركة الوطنية "، مجلة أبحاث، العدد السادس، خريف 1984، ص: 12.
[6] - عبد العزيز لوزي، " المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب "، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 5، 1996، ص. 18.
[7] - محمد المدني، مرجع سابق، ص. 11.
[8] - عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب 1908-1992، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثالثة، 1993، مشار إليه في محمد المدني، " بروز الدستورانية وظهور الحركة الوطنية "، ص.19.
[9] - محمد المدني، مرجع سابق، ص:12.
[10] - علال الفاسي، "جمعية الاتحاد والترقي المغربية ومشروع دستور 1908"، مجلة " أطياف مغربية " العدد الأول، ديسمبر 2008/يناير2009، ص:9.
[11] - عبد الهادي بوطالب، النظم السياسية المعاصرة، دار الكتاب، الدار البيضاء 1981، ج2، ص:154.
[12] -عبد العزيز لوزي، مرجع سابق، ص:27.
[13] - للمزيد راجع عز الدين شملال، "البوادر الاولى للحركة الدستورية بالمغرب"، موقع العلوم القانونية، 24 أكتوبر 2012، ومتاح على bit.ly/2C3YsOh
[14] - محمد عرب صاصيلا، الموجز في القانون الدستوري، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1981، ص:302.
[15] -عبد اللطيف جبرو -المهدي بنبركة في مواجهة العاصفة- الطبعة 3 مطبعة دار النشر المغربية، 1991. ص 50.
[16] - من معطيات كتاب ذاكرة المستقبل، مونوغرافيا القيادات والأطر والتنظيمات؛ الاتحاد الاشتراكي 1959-2009؛ محمد الشاوي، دار النشر المغربية 2011، ص 241-246.
[17] - المرجع نفسه.
[18] - مجلة أطياف مغربية، "محطات تاريخية"، العدد الأول، دجنبر 2008/يناير 2009.
[19] - موساوي العجلاوي، " الدستور في المغرب المستقل، قراءة تاريخية، المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2010، عدد 167، ص.105.
[20] - مقتطف من خطاب، وجهه محمد الخامس إلى الأمة يوم 8 مايو 1958.
[21] - محمد ضريف، حقوق الإنسان بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط، تاريخ النشر 1994، ص: 69.
[22] - بخصوص الظروف التاريخية لإصدار القانون الأساسي للمملكة يراجع: عبد الكريم غلاب: التطور الدستوري والنيابي بالمغرب (1908-1977)، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء،1978، ص: 187-189.
[23] - محمد ضريف، حقوق الإنسان بالمغرب، مرجع سابق، ص: 71.
[24] - عبد العزيز لوزى: المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد: 5، 1996، ص: 54-55.
[25] - عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب (1908-1977)، مرجع سابق، ص: 188.
[26] - محمد عابد الجابري، الديمقراطية في المغرب من التأجيل إلى التزوير، سلسلة "مواقف"، العدد 4، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، 2002، ص 40-41.
[27] - المختار مطيع، المبادئ العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1995، ص 157.
[28] - Boujrada، K، Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique، op. cit، p: 12.
[29] - العروي، عبد الله، "من ديوان السياسة"، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2010، ص: 117-118.
[30] - معتصم، محمد، "النظام السياسي الدستوري المغربي"، الطبعة الأولى، الدار البيضاء: مؤسسة إيزيس للنشر، 1992، ص: 32
[31] - المرجع نفسه، ص: 75-76.
[32] - المرجع نفسه، ص: 79.
[33] - Boujrada، K، Le Maroc à la lumière de l’enjeu démocratique، op. cit، p: 10.
[34] - معتصم، محمد، "النظام السياسي الدستوري المغربي"، مرجع سابق، ص: 77.
[35] - El ayadi، Bourquia et Darif، Etat monarchie et religion، les cahiers bleus، (3) , 2005, p: 16- 17- 18
[36] - عبد العزيز لوزي" المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب"، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية 1996، ص:109
[37] - نبيه الأصفهاني، أزمة نظام الحكم في المغرب، مجلة السياسة الدولية، العدد 30، القاهرة، 1972، ص 164.
[38] - عبد الاله بلقزيز، استراتيجية النضال الديمقراطي في المغرب، مجلة المستقبل العربي، العدد 194، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1995، ص 94.
[39] - احمد السهيلي، شكل الديمقراطية والاتجاهات في المغرب، الدار البيضاء، 1982، ص 43.
[40] " -Transitions Démocratiques Africaines"KARTHALA-PARIS-1997.p44 - v.J.P. Daloz. Et p. Quantin.
[41] -محمد زين الدين، "المسألة الدستورية في مغرب الأمس واليوم" دبلوم الدراسات العليا– كلية الحقوق-البيضاء1999 ص64.
[42] - راجع نص خطاب العرش ليوم 3 مارس 1991 – النص منشور ضمن سلسلة خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني- منشورات وزارة الإعلام- الرباط- مارس 1991- مارس 1992- ص10 .
[43] - راجع نص خطاب العرش لسنة 1995- نص الخطاب الملكي السامي منشور ضمن انبعاث أمة –ج40- مطبوعات القصر الملكي – الرباط 1995 - ص85.
[44] - أسماء قادري، تأثير سياق التعديل الدستوري على مضمون الوثيقة الدستورية في المغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، العدد التاسع، فبراير 2021 | المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا – برلين، صفحة 101.
[45] - نفس المرجع.
[46] - Abdelmoughit Ben Messaoud Tredano , Démocratie Culture politique et l alternance au Maroc, Les éditions Magrebines , 1996-p65.
[47] - الفصل 51 من دستور 1992 الذي كان ينص على أنه لا يترتب عن حالة الاستثناء حل مجلس النواب لأن البرلمان كان مكونا من مجلس النواب فقط، والفصل 51 من دستور 1996.
[48] - الفصل 59 من دستور سنة 1992، ويقابله في دستور سنة 1996 الفصل 60.
[49] -Michel Rousset, Le juge Administratif et La protection des droits de L’homme, Le harmattan- paris 1994 ,p331.
[50] - الفصل 36، ويعتبر هذا المقتضى من مستجدات دستور 1996.
[51] - خطاب الملك الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1995-1996، بتاريخ 93 أكتوبر 1995، منشور على الموقع الإلكتروني www.habous.gov.ma le 20 /01/2020.
[52] - تم إعداد هذا التقرير بطلب رسمي من الملك الحسن الثاني إلى مدير البنك الدولي، في يونيو من سنة 1995.
[53] - أحزاب الوفاق كانت دائما مؤيدة للرؤية الملكية للإصلاح الدستوري، وتقدمها بمذكرات مطلبية سنة 1995 جاء اقتداء بأحزاب الكتلة فقط، لذا جاءت مطالبها متوافقة مع التوجه العام للمؤسسة الملكية.
[54] - محمد الغالي، دستور المملكة المغربية لسنة 2011 في ضوء الربيع العربي: جدلية الثابت والمتحول، منشور في الموقع الالكتروني:
www.tabayyun.dohainstitute.org le 28 /01/2020
www.tabayyun.dohainstitute.org le 28 /01/2020
[55] - أمينة المسعودي، الإصلاحات الدستورية في العالم العربي، (منشور على الموقع الالكتروني: www.constutitionnet.org
Le 14 /12/2019 ،
Le 14 /12/2019 ،
[56] - للاطلاع على أشغال هذه الحركة أنظر: آراء ومواقف حول الاصلاح الدستوري: حركة المطالبة بدستور ديمقراطي، مؤسسة
فريدريش إيبرت، دار القلم، 2005.
فريدريش إيبرت، دار القلم، 2005.
[57] - محمد مدني، ادريس المغراوي وسلوى الزرهوني، دراسة نقدية للدستور المغربي لعام 2011، المؤسسة الديمقراطية والانتخابات،
. السويد، 2012، ص 10.
. السويد، 2012، ص 10.
[58] - Tourabi, A, Réforme constitutionnelle au Maroc: une évolution au temps des révolutions, Arab Reform Initiative, 2011, p: 1.
[59] - أسماء قادري، تأثير سياق التعديل الدستوري على مضمون الوثيقة الدستورية في المغرب، مرجع سابق، ص:106.
[60] - المرجع نفسه، ص:107.
[61] - عبد الإله سطي، الملكية البرلمانية وأسئلة الإصلاح الدستوري في المغرب، مقال منشور في الموقع الالكتروني:
[62] - الفصل 47 من دستور 2011.
[63] - محمد باسك منار، دستور سنة 2011 في المغرب: أيّ سياق لأيّ مضمون؟، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2014، ص:28.
[64] - بالإضافة إلى دستور 1962 تم إجراء استفتاءات دستورية شملت استفتاء 24 يوليوز 1970 ثم استفتاء فاتح مارس1972، و بعده استفتاء 4 سبتمبر 1992 ثم استفتاء 13 سبتمبر 1996 انتهاء باستفتاء 1 يوليوز 2011.
[65] - محمد العمراني بوخبزة، الفكر الدستوري المغربي: مسار ومنعرجات، التطور الدستوري للمغرب الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية أعمال الندوة الدولية، الرباط 10 – 11 يوليوز 2018.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 













 لمحة تاريخية عن التطور الدستوري بالمغرب
لمحة تاريخية عن التطور الدستوري بالمغرب