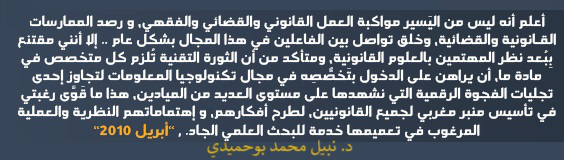يعرف الطعن بالنقض لفائدة القانون، طريق استثنائي للطعن بالنقض في الحكم المخالف للقانون، يستهدف فقط المصلحة العامة المتمثلة في ضمان توحيد أحكام القضاء بشأن تطبيقها وتفسيرها للقانون تأكيدا لوحدة القانون في الدولة، فليس للطعن عند قبوله مردود بالسلب أو الإيجاب على مراكز الخصوم، وإنما يقتصر أثر نقض الحكم على بيان أوجه مخالفته للقانون حتى لا تتأسى به المحاكم مستقبلا[1].
وهكذا فإن ممارسة هذا النوع من الطعون لا يمكن أن يتصور إلا من طرف جهاز واحد، وهو ممثل النيابة العامة[2] وخصوصا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصريح مقتضيات الفصل 381 من قانون المسطرة المدنية والفصول من 558 الى 562 من قانون المسطرة الجنائية، لكن النقاش المطروح، هو طبيعة تدخل الوكيل العام للملك في هذا الطعن، بمعنى هل يتدخل كطرف أصلي أم كطرف منضم؟ .
تباينت آراء الفقهاء واختلفت بهذا الخصوص إلى تلات اتجاهات مختلفة، يرى الاتجاه الأول أن تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون يكون من قبيل التدخل الأصلي[3]، بينما يرى الاتجاه الثاني أن تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لا يعدو أن يكون سوى تدخلا انضماميا لا غير[4]، في حين يرى الاتجاه الثالث أن تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون لا يندرج لا ضمن الطبيعة الأصلية ولا الانضامية، وإنما هو عبارة عن تدخل من نوع خاص[5]، لكن هذا الأمر يتصور بصورة واضحة في المجال المدني لأن تدخل الوكيل العام للملك في إطاره واضح المعالم، ولا يثير أي إشكال يذكر، وهو يختلف عليه في المجال الجنائي الذي سنقتصر عليه في هذا المحور.
ولمعرفة دور وكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون، وأمام الجدل الذي ثار حول استقلال القضاء[6]، خصوصا بعد صدور القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض[7]، الأمر الدي يدعونا إلى طرح التساؤل التالي:
ما هو دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون أو بالأحرى دور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الطعن بالنقض لفائدة القانون بعد صدور القانون رقم 33.17، بمعنى هل يمكن أن نتصور صدور أوامر من طرف وزير العدل بعد هذا التعديل؟ وخصوصا أن النصوص التشريعية الجنائية لا زالت بنفس الصيغة !
سنميز هنا بين محطتين الأولى تتمثل في وظيفة الوكيل العام للملك قبل صدور القانون رقم 33.17 ( المحور الأول) والثانية بعد صدور هذا القانون ( المحور الثاني).
المحور الأول: وظيفة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قبل صدور قانون رقم 33.17
إن التسليم بمقتضيات الفصول المنظمة للطعن بالنقض لفائدة القانون في المجال الزجري قبل صدور قانون رقم 33.17، يجعل التداخل بين السلط أمر وارد، وبترخيص من المشرع، لأن ممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون في هذا المجال يأخذ بعديين، إما يمارس من طرف الوكيل العام للملك وبصورة تلقائية[8]، أو بواسطة الوكيل العام للملك، لكن بأمر من وزير العادل.
والواضح أن المشرع استعمل في المادة 558 من ق م ج مصطلح يفيد خضوع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لوزير العدل بحيث نص "تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون.... وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.."، ومصطلح–أمر[9] - يدل على التحكم الذي يمارسه وزير العدل على عضو من جسم القضاء.
وقد حاول المشرع التخفيف من حدة هذا الوضع في المادة 560 ق م ج بنصه "يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل إلى الغرفة الجنائية استنادا إلى الأمر الكتابي الذي يوجهه إليه وزير العدل..."، حيث استعمل المشرع مصطلح "يمكن"، وهي تندرج ضمن الألفاظ الدالة على الصفة المكملة، مما يعني أن وزير العدل يرفع الأمر ويبقى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأخذ به أو رفضه.
إذن ما الجدوى في أن يستعمل المشرع -أمر- ثم يترك السلطة التقديرية للوكيل العام للملك لدى محمة النقض؟
إن هذا ناتج عن التردد الذي ساد المشرع بخصوص استقلال السلطة القضائية عن التبعية لوزير العدل، وهو مطلب حقوقي اختلف فيه كل الفرقاء السياسية[10].
وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة تدخل وزير العدل في هذا الطعن، بمعنى هل هو وظيفة أم سلطة؟
برجوعنا إلى النصوص القانونية المنظمة للطعن بالنقض لفائدة القانون وخصوصا المواد 558 و 560 من ق م ج، نستشف أن المشرع لم يحدد طبيعة تدخل وزير العدل، لكن بالعودة إلى مقتضيات الفصل 107 من الدستور المغربي الذي ينص: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية".
ومن المعلوم أن وزير العدل ينتمي إلى السلطة التنفيذية، بينما ينتمي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى السلطة القضائية[11]، مما يجعل تدخل وزير العدل في الطعن بالنقض لفائدة القانون يندرج ضمن اختصاصاته السلطوية لا الوظيفية لأنه يتبع للسلطة الحكومية.
ولكن هذا الوضع يقودنا إلى طرح سؤال آخر وهو كيف أن المشرع الدستوري يفصل بين السلط، في حين لا زال قانون المسطرة الجنائية يسمح بتدخل وزير العدل في النيابة العامة[12] ؟
نعتقد أن صدور قانون المسطرة الجنائية كان في فترة زمنية سابقة على صدور دستور 2011، الذي وضع لبنة أساسية في استقلال السلطة القضائية، إذ من بين المرتكزات الأساسية التي أشار إليها الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة[13] قائمة الذات، بينما يعود آخر تعديل ل ق المسطرة الجنائية سنة 2002[14]، وهو ما يفسر بطء عجلة التشريع وعدم مواكبة القواعد القانونية للتطور الذي يسود المجتمع بين الفينة والأخرى.
ورغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على صدور الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة، لا زالت السلطة القضائية بيد وزير العدل وذلك راجع إلى عدة اعتبارات لعل أهمها انتظار صدور قوانين تفصل بين اختصاصات وزارة العدل والسلطة القضائية.
ولهذا نتساءل، أي دور لوزير العدل بعد صدور قانون 33.17؟
المحور الثاني: وظيفة الوكيل العام للملك في الطعن بالنقض لفائدة القانون بعد صدور قانون 33.17
يشكل صدور قانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية لرئيس النيابة العامة[15] مرحلة فارقة في بلادنا، حيث تضمن هذا القانون 10 مواد، ونص في المادة الثانية منه على ما يلي: يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في مماسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك اصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل وكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة محل وزير العدل في:
- الإشراف على النيابة العالمة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- السهر على حسن سير الدعوى في مجال اختصاصه،
- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه،
- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها،
إن هذا التوجه الداعم لاستقلال النيابة العامة عن سلطة وزير العدل يعتبر بالنسبة لبعض الفاعلين في مجال القضاء خطوة إلى الأمام، وانتصارا للتوجه الحقوقي الشامل الذي يفصل بين السلط ويضع الحدود الضرورية التي تمنع تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وتتويجا للإجماع الوطني والحقوقي المنبثق عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة والمصادق عليه من طرف الهيئة الوطنية لميثاق إصلاح العدالة الذي حظي بالموافقة الملكية في حفل رسمي أعلن فيه عن مشروع مجتمعي لإصلاح القضاء وتطوير العدالة شاركت فيه كل الهيئات والمنظمات الوطنية[16] .
إن هذه النقلة النوعية التي عرفها استقلال القضاء ستصيب الطعن بالنقض لفائدة القانون لا محالة، بحيث لا يعقل بعد هذا التعديل أن يتلقى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أوامر حسب ما جاء على لسان المشرع في المادة 558 من ق م.
وهو ما يدفعنا إلى طرح تساؤل غاية في الأهمية، وهو ما مآل الطعن بالنقض لفائدة القانون بعد نقل اختصاصات وزير العدل، بمعنى هل سيعمل قانون رقم 33.17 بطريقة فورية على وقف العمل بالنصوص القانونية المنظمة في ق م ج؟
لا شك في أن النص الخاص يعدل النص العام، لكن نحن الآن أمام مسألة متفاوتة، إذ لا يقتصر الأمر على حلول الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محل وزير العدل، وإنما هو إجراء قانوني به مسطرة قانونية واضحة المعالم، تحتاج لتدخل تشريعي من أجل العمل على تغييره.
ويفترض في المشرع أن يكرس التناغم بين النصوص القانونية، فأما أن يتوجه إلى تعديل المقتضيات القانون الخاصة بتدخل وزير العدل وأن يجعلها أقل حدة ومرونة حتى يسهل للوكيل العام للملك الأخذ بها أو عدم الأخذ بها لحسن سير العدالة، وأما أن يتوجه إلى توطيد استقلال السلطة القضائية، وإلغاء أي تدخل لوزير العدل في كل من ق م م و ق م م، وهذا التوجه حري بالتأييد ولقي ترحيبا كبيرا لدى الاتحاد الأوروبي.
ويقودنا الجواب عن السؤال أعلاه إلى فرضيتين:
الفرضية الأولى: تتمثل في الإبقاء على اختصاص وزير العدل في الطعن بالنقض لفائدة القانون مع تغيير المشرع لمصطلح –أمر- ب – طلب- أو –ملتمس-، بحيث نقترح إعادة صياغة المادة 558 على الشكل التالي: "تنقسم طلبات الطعن بالنقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وإلى طلبات ترفع بطلب (أو بملتمس ) من وزير العدل".
هكذا سيساهم وزير العدل بدوره في إرساء المبادئ القانونية وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتصحيح الأخطاء التي تؤثر في شرعية الحكم، وتطوير دواليب العمل القضائي وتخليقه بطريقة غير مباشرة، دون المساس بالاستقلال العضوي أو الوظيفي للسلطة القضائية[17]، لأنه لا مجال للحديث حول الفرق بين الطلب والأمر لكون الفرق بينهما واسع، ولكون هذا الطعن لا يتعلق بحقوق الأفراد بقدر ما يكرس حسن سير العدالة.
الفرضية الثانية: وتتمثل في القطع مع أي تدخل لوزير العدل في الطعن بالنقض لفائدة القانون، وجعله اختصاصا محصورا على وجه الخصوص للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، كما هو الشأن بالنسبة إلى المادة المدنية، وبذلك إلغاء كل المقتضيات التي تسمح لوزير العدل بالتدخل سواء في إطار أوامر أو طلبات، رغم أن هذه الفرضية مستبعدة إلى أنها ممكنة، خصوصا مع الدعر الذي طال مكونات القضاء مع التضاربات الفقهية بين مؤيد لهذا التدخل ومعارض له.
وما يمكن ملاحظته في مشروع قانون المسطرة الجنائية هو إدخال وزير العدل في الطعن بالنقض لفائدة القانون[18]، وهو ما جعل البعض[19] ينتقد واضع هذا المشروع لكونه جعلنا نستأنس مع مبدأ فصل السلطات، إلا أنه من حيث لا ندري جعل وزير العدل وهو جزء من السلطة التنفيذية في داخل السلطة القضائية وهو ما لا يستقيم مع الصلاحيات الجديدة المخولة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من حيث تحمله اختصاصاته الكاملة كرئيس للنيابة العامة حسب القانون الجديد، ويتعين تدارك هذا الخلط في الاختصاصات بضرورة حماية مبدأ فصل السلطات من طرف ممثلي الأمة في البرلمان عند مناقشة هذا المشروع.
خاتمة
إن المتمحص في الطعن بالنقض لفائدة القانون سيلاحظ وللوهلة الأولى أن المشرع اقتصر على جهة وحيدة في ممارسة هذا الطعن والمتمثلة أساسا في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وذلك رغم كثرة المشاغل الملقاة على هذا الجهاز وجسامتها.
وما يزيد من حدة هذا التوجه هو عدم تحديد المشرع الوسائل الكفيلة بتمكين الوكيل العام للملك من معرفة الأحكام المخالفة للقانون أو قواعد المسطرة، مما يفرغ هذا الطعن من محتواه.
لذلك نعتقد أنه يجب فتح المجال لكل مكونات جهاز النيابة العامة لممارسة الطعن بالنقض لفائدة القانون، إذ لا يعقل أن يقتصر هذا الطعن على جهاز وحيد، غير قادر حتى على ممارسة مشاغله الخاصة، ونقترح أن يجعل المشرع جميع وكلاء العامين للملك مختصين في هذا الطعن بشكل تضامني، وكذا رئاسة محكمة النقض ورأساء المحاكم في القضايا المدنية التي يصعب على الوكلاء العامين الإحاطة بها خصوصا إذا كانت طراف منظما فقط.
كما نقترح الاستفادة من الوسائل التكنلوجيا من أجل تسهيل التنسيق بين الأجهزة القضائية سواء من حيث التنقيب على الأحكام المخالفة للقانون أو قواعد المسطرة أو من حيث التواصل مع الوكلاء العامين للملك فيما بينهم، وفي ذلك فائدة خاصة، تتمثل أساسا في تجاوز البطء الذي يخيم على القضاء والتدبير الجيد لمرفق العدالة.
الهوامش
[1] - أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية- القاهرة، 1990، ص 1141.
[2] - بالعودة تاريخيا إلى تطور النيابة، فإن نشأتها كجهاز كان مع بداية القرن الرابع عشر، وبالضبط في 1303 وذلك حينما كلف الملك فليب لوبون Philipe lepon بعض الأشخاص بالقيام بمهام وكلاء الملك، وسماهم نواب عامين للملك لدى المحكمة العليا ونواب للملك لدى المحاكم الدنيا، وقد تمثلت مهمتهم أساسا في تمثيل الملك أمام هذه المحاكم، وأثناء التورة الفرنسية، ثم إلغاء جهاز النيابة العامة بإعتبارها مؤسسة تخدم مصالح الملكية المستبدة، غير أن رجال الثورة الفرنسية سرعان ما اقتنعوا بأنه باستطاعة جهاز النيابة العامة أن يخدم العدالة بشكل أفضل، وهكذا صدر المشرع اختصاصات النيابة العامة في المادة الجنائية على وجه الخصوص حيث ثم إحداث وظيفة المدعي العام l’accusateur public أمام المحاكم التي أحدثتها تلك التورة، ومن الملاحظ أن الإصلاح القضائي الفرنسي الصادر في 22 دجنبر 1958، قد ظل وفيا لهذا التصور انطلاقا لتبعية النيابة العامة لوزير العدل. ومن هنا تسرب هذا النظام إلى التشريع المغربي باعتبار فرنسا كانت دولة حامية.
- عبد الحق دهبي، الأدوار الجديدة المسندة للنيابة العامة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور في:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=55222&r=0 ثم الاطلاع عليه بتاريخ 14-07-2019 على الساعة 14:15.
- عبد الحق دهبي، الأدوار الجديدة المسندة للنيابة العامة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد، مقال منشور في:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=55222&r=0 ثم الاطلاع عليه بتاريخ 14-07-2019 على الساعة 14:15.
[3] - أحمد بن يوسف، دور النيابة العامة في المجلس الاعلى، مقال منشور في عمل المجلس الاعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أشغال الندوة تخليدا للذكرى الاربعين لتأسيس المجلس الاعلى- الرباط 17-19 شعبان 1997، مطبعة ومكتبة الامنية 1999 ص 337-338.
[4] - محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الطبعة 1986، ص 12.
[5] - الشرقاوي الغزواني نور الدين، تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائي، 1995، ص 188-189.
- وفي الحقيقة هذا التوجه هو الجدير بالتأييد لان ممارسة هذا الطعن يعتبر من المساطر الخاصة المنظمة من خلال مقتضيات خاصة.
- وفي الحقيقة هذا التوجه هو الجدير بالتأييد لان ممارسة هذا الطعن يعتبر من المساطر الخاصة المنظمة من خلال مقتضيات خاصة.
[6] - يجدر التنبيه إلى أن أول المنظرين لاستقلال القضاء هو المفكر والفيلسوف منتيسكيو في كتابه روح التشريع ( بالفرنسية: De l’esprit des lois)، وقد نشر في المرة الأولى كمقال في النظرية السياسية، عام 1748 بمساعدة الكاتبة "كلودين دوئتسان" ونشر في الأصل بشكل جزئي دون الإشارة لمؤلفه، وذلك أن أعمال مونتيسكيو كانت تخضع للرقابة، وقد انتشر تأثيرها إلى خارج فرنسا بفضل الترجمة السريعة إلى اللغات الآخرين، عام 1750، وفي عام 1751، أضافة الكنيسة الكاتوليكية " روح التشريع" ضمن قائمة الكتب الممنوعة، لكن أطروحة منتيسكيو السياسية كان لها تأثير هائل على عدد من أعمال الباحثين.
- مونتسكيو –ويكيبيديا- الموسوعة الحرة:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88 ثم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2019 على الساعة 13:05.
- للمزيد من التوسع حول المبادئ الأساسية لاستقال القضاء، انظر منتيسكيو، ترجمة عادل زعيتر، روح الشرائع، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2016.
- مونتسكيو –ويكيبيديا- الموسوعة الحرة:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%88 ثم الاطلاع عليه بتاريخ 22-06-2019 على الساعة 13:05.
- للمزيد من التوسع حول المبادئ الأساسية لاستقال القضاء، انظر منتيسكيو، ترجمة عادل زعيتر، روح الشرائع، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2016.
[7] - ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 ( 30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، ( الجريدة الرسمية، ع، 6605- 27 ذو الحجة 1438 ( 18 سبتمبر 2017)).
[8] - وهذا الوضع لا يطرح أي اشكال وخصوصا وأنه يتطابق مع ما ورد في مقتضيات الفصل 381 من ق م م الذي ينص على ما يلي: "إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الاطراف بطلب نقضه في الاجل المقرر فإنه يحيله على المحكمة.
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض".
إذا صدر عن المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض".
[9] - ومصطلح أمر من الإمارة، والمفعول مأمور عليه، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة النحل الآية 90 "إن الله يأمر بالعدل"، وفي سورة النساء الآية 58 "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".
[10] - اختلفت الفرق البرلمانية بين مؤيد لتبعية النيابة العامة لوزارة العدل، وبين رافض لهذه التبعية، محمد الهيني، فرق الأغلبية البرلمانية وتبعية النيابة العامة لوزير العدل: ألا في الفتنة الدستورية سقطوا. مقال منشور في الموقع الإلكتروني:
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%A%D9%81%D9%8A_a6421.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 13//06/2019 على الساعة
14:41.
https://www.marocdroit.com/%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%A%D9%81%D9%8A_a6421.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 13//06/2019 على الساعة
14:41.
[11] - والدليل على ذلك هو أن المشرع الدستوري نص على هذه المؤسسة في الباب السابع المعنون بالسلطة القضائية من الفصل 110 و116، وبذلك تسري كلها كل أحكام الدستور وما تلاه من قوانين تنظيمية، ولذلك فإن تدبير وضعيتهم المهنية مند التعيين إلى غاية الإحالة على التقاعد يتم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما يميزهم عن قضاة الأحكام هو انتمائهم إلى التسلسل إداري على رأسه سلطة رئاسية عليا هي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وهذا ما يجعل كل مرؤوس خاضع لسلطة رئيسه الأعلى وملزم بتنفيذ تعليماته التي يجب أن تكون قانونية، وفضلا عن ذلك فإن تعليمات رئيس النيابة العامة يجب أن تكون كتابية ( الفصل 110 من الدستور والمواد 25 و 43 من النظام الأساسي للقضاة والمادة 2 من القانون رقم 33.17، والفصول 16 و18 و 20 من قانون التنظيم القضائي للملكة لسنة 1974).
- منبر النيابة العامة، مجلة خاصة بقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، العدد التاسع- 2017، ص 39-40.
- منبر النيابة العامة، مجلة خاصة بقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، العدد التاسع- 2017، ص 39-40.
[12] - والغريب في الأمر أن هذا الوضع يسري حتى على قضاة الأحكام وقضاة التحقيق، إذ حسب المادة 52 من ق م ج، يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف.
[13] - وبذلك تقرر إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك، وهذه إشارة إلى أن المغرب دخل مند سنة 2011 مرحلة فصل السلط، لينهي بذلك الخلاف الفقهي الذي كان سائدا في إطار دستور 1996 حول طبيعة القضاء بالمغرب.
- أسامة عبي، استقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضمانات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية- السنة الجامعية 2015-2016، ص 2.
- أسامة عبي، استقلال السلطة القضائية بالمغرب الدعامات والضمانات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية – المحمدية- السنة الجامعية 2015-2016، ص 2.
[14] - بغض النظر عن التعديلات المتلاحقة التي شهدها ق م ج والتي كان آخرها القانون رقم 89.18 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.45 بتاريخ 4 رجب 1440 (11 مارس 2019)، (الجريدة الرسمية، عدد 6763 بتاريخ 18 رجب 1440( 25 مارس 2019)، ص 1612، المتعلق بتتميم وتغير أحكام الفصلان 66 و46 من القانون رقم 22.01 المتعلق ب، ق م ج إلى أنها لم تشمل الطعن بالنقض لفائدة القانون ولا حتى النصوص المرتبطة بالتبع بالقانون رقم 33.17.
[15] - صدر هذا القانون تطبيق للفصل 25 من قانون 100.13 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء الذي ينص على ما يلي: "يوضع قضاة النيابة العامة تحث سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين"، أنظر كذلك المادة الأولى من قانون 33.17المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض .
[16] - نور الدين الفلاق، استقلال النيابة العامة من خلال قانون رقم 33.17 ومدى انعكاسها على مهنة المحاماة، مجلة المحاكم المغربية، عدد 159- ماي/ يونيو 2018، ص 85.
[[17]]url:#_ftnref17 - وهو ما سيكرس المبدأ الذي جاء به المشرع الدستوري في الفصل 1 و107، والقائل بتعاون السلط وتوازنها، مع احترام استقلالها.
[[18]]url:#_ftnref18 - وذلك من خلال منح وزير العدل صلاحيات رفع الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة للغرف الجنائية، بمحكمة النقض ( المادة 560 ).
[[19]]url:#_ftnref19 - أحمد أبو العلاء، دليل الباحث في قانون المسطرة الجنائية المغربي من خلال الاسئلة والاجوبة، مطبعة الهدايا، الطبعة الاولى 2016، ص 164.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون
دور النيابة العامة في الطعن بالنقض لفائدة القانون