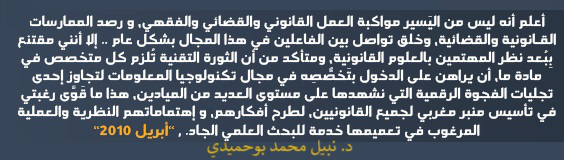تطرح مجموعة من المفاهيم نفسها بإلحاح عند الحاجة إليها ، ذلك أن استعمال تلك المفاهيم تعني بالضرورة استحضار دلالاتها المستمدة من أبعادها اللغوية و كذا من السياق الذي وضعت فيه و المجال الذي ستستعمل فيه .
و بما أن لكل مجال مصطلحاته و لكل مصطلح معانيه التي تختلف من حقل معرفي إلى آخر ، فإن التساؤل عن معنى " التأويل الديمقراطي للدستور " يجب أن يكون المنطلق في قراءة المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 .
و قد أفردنا دستور 2011 بالاختصاص لكون الخطاب الملكي السامي خصه بضرورة التأويل الديمقراطي ، فهذا الاختصاص يعتبر إشارة قوية إلى أن هناك إرادة قوية لدى أعلى سلطة بالدولة المغربية في أن يكون البناء العصري و الحديث للدولة المغربية بناء اجتماعيا قائما على مجموعة من المبادئ الناتجة عن إعمال آلية التوافق ليس بين الفرقاء السياسيين و حسب ، و لكن حتى بين صناع القرار و الجهات المعنية بتنفيذ القرار .
و من هذا المنطلق يجب البحث في معنى " التأويل الديمقراطي للدستور " ؛ إذ أن أول ما يجب أن يثار الانتباه إليه أنه لابد من التمييز بين مرحلتين ، مرحلة ما قبل وضع الدستور ، و مرحلة ما بعد وضعه . فإذا كانت المرحلة الأولى تأسيسية ، فإن الثانية تنزيلية ، لذلك وجب علينا تسليط الضوء على بعض مقتضيات كل مرحلة على حدة حتى يتضح لنا المعنى الحقيقي من مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " . و يشكل التفصيل في الجواب عن التساؤل المركزي حول السلطات التي يملكها المشرعون سواء الدستوريون أم العاديون ، جوابا حقيقيا عن تفسير معنى المبدأ المذكور.
سلطات السلطة المكلفة بوضع الدستور
من المعلوم في الفقه الدستوري أن الجهة التي يناط بها أمر وضع الدستور تعتبر بالفعل سلطة ذات صلاحيات مطلقة ، فلا حدود لصلاحياتها في كل مجال مهما دق أو عظُم . لذلك فإن السلطة التي تعنى بوضع الدستور في صيغته الأولية يجب أن تعامل بطريقة خاصة تجعل لها حقوقا و ترتب عليها التزامات .
و هكذا ؛ فإن أول ما يجب الإشارة إليه هو أنه يتعين أن تكون للسلطة المكلفة بوضع مشروع أو مسودة أي دستور كامل السلطات ، و لا مجال لمحاسبة أي عضو منها أو محاسبتها على أي فعل تشريعي دستوري قامت به و لو أعادت النظر في طبيعة الأجهزة المكونة للدولة . إذ أن أهم وظيفة تقوم بها السلطة المكلفة بوضع الدستور تتمثل في إحدى صورتين ؛ إما أن تعمل على إعادة تشكيل نظام الدولة و شكلها بعد أن تكون هذه الأخيرة قد انتقلت من مرحلة إلى أخرى ، و هذه الصورة لا تتحقق إلا في حالة حدوث ثورة أو انقلاب عسكري أو ما شابه ذلك من قطيعة مع مرحلة ما قبل تشكيل السلطة التي تتولى وضع الدستور ؛ و إما أن تعمل السلطة المكلفة بوضع الدستور على إعادة تنظيم اختصاصات السلط و المؤسسات الدستورية داخل الدولة في إطار الاستمرار الزماني للدولة من حيث الجوهر و من حيث شكلها و طبيعتها . و بالتالي فإن مدى الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة المكلفة بوضع الدستور، يستمد من السياق التاريخي الذي أنشأت فيه تلك السلطة ذاتها .
وهكذا ، فبالرجوع للحالة المغربية ، نجد أن الاختيار وقع على الصورة الثانية . ذلك أن التوافق بين الإرادة الملكية و الإرادة الشعبية حول الطريقة التي تناسب البيئة المغربية من أجل الدفع أكثر بالمسار الديمقراطي و الحداثي للدولة المغربية في إطار الاحترام المطلق للخصوصية و الهوية المغربية الراسخة ، مكَن من اتخاذ القرار التاريخي المعلن عنه بتاريخ 09 مارس 2011 بشأن تأسيس لجنة مكلفة بوضع الدستور الجديد ، وهو الدستور الذي يشكل بالفعل أول اللمسات الدستورية للدولة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس .
فإذا كانت هناك مجموعة من الحيثيات و الخصوصيات التي طبعت تأسيس تلك اللجنة ، فإن أهم ما يمكن أن نشير إليه ، هو أنها جاءت من أجل تلبية الحاجة الملحة التي عبرت عنها مجموعة من التفاعلات الاجتماعية و السياسية و الثقافية التي طبعت الساحة المغربية خلال عهد الملك محمد السادس.
فالتحولات الاجتماعية و السياسية في أبعادها المختلفة ، و التي شهدها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب ، مهدت بالفعل لظهور مناخ جديد متسم بالطابع الحقوقي و منخرط في البيئة الكونية و محافظ على الخصوصية المغربية . فهذه التركيبة الثلاثية للتطور المجتمعي الذي شهده المغرب استطاعت أن تفرض وجود واقع جديد يتمثل في التركيز على ضرورة إعادة النظر في الإطار الدستوري للدولة المغربية بالشكل الذي سيمكن من استيعاب ما استجد في الواقع المغربي .
و من تم فإن التوافق بين الإرادتين الملكية و الشعبية ، استطاع أن ينتج آلية دستورية تمكن من تلبية الحاجة التي ظهرت ، و تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين على الساحة المغربية و خاصة في البعد المتعلق بإعادة النظر في سلطات و مؤسسات الدولة المغربية و إعادة ترتيب اختصاصاتها .
و من هذه المنطلقات نجد أن اللجنة المكلفة بوضع الدستور جاءت لتلبي هدفا محددا و دقيقا يتمثل في إعادة النظر في مجموعة من المبادئ و التصورات حول سلطات الدولة و أجهزتها ، و كذا حول المؤسسات الدستورية و وظائفها ، في إطار مناخ متسم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة ، و بناء على قرارات تتخذ على أساس توافقي .
فعمل اللجنة الدستورية ، أسس على مبدأ التشارك و هو مبدأ يجب أن يكون حاضرا عند وضع أية قاعدة دستورية ، على اعتبار أن تلك القاعدة ما هي في الأخير إلا قيودا تؤطر عمل المؤسسات الدستورية التي سيخضع الجميع لحكمها ، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات ، و حتى الدولة عينها ستخضع لها . لذلك ، فإن القاعدة الدستورية يجب أن تكون قاعدة نابعة من الطبيعية و البيئة التي ستبسط عليها أحكامها . و زيادة على مبدأ التشارك الذي يعني إسهام الجميع في صياغة القاعدة الدستورية ، فإن مبدأ التوافق يجب أن يحظى بالاهتمام اللازم به ، ذلك أن تضارب الأفكار و تدافعها بل و تصارعها لحد التناقض أحيانا لن يمكن من وضع أية قاعدة دستورية من غير للجوء لمبدأ التوافق ؛ إذ لابد من إيجاد الحل المتوافق عليه القائم على فكرة التنازل المتبادل في إطار فكرة التعايش المشترك . فالقاعدة الدستورية في نهاية المطاف هي قاعدة سامية سيخضع لها الجميع ، لذلك وجب أن تنال الاحترام المطلق لكل الأطراف و الأفراد ، ومن تم فإن هذا الاحترام لن يكون له صدى في نفوس الأفراد و الهيئات ما لم يجد هؤلاء الأفراد و تلك الهيئات بعض ضالتها في القاعدة الدستورية .
و إذا كانت اللجنة المكلفة بوضع الدستور قد عمدت إلى تنظيم مشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين ، فإنها استطاعت أن تستوعب إلى حد بعيد مختلف التوجهات السائدة في البيئة المغربية ، كما استطاعت أن تضمن التركيبة الثلاثية التي أشرنا إليها أعلاه ، على امتداد الدستور ، و في مختلف أبوابه و فصوله.
و لما كانت ، القواعد الدستورية تتسم بنوع من العمومية و التجريد فوق التشريعي، نظرا لطبيعتها الخاصة ، فإن نفس القواعد لا تكون كافية لوحدها في تنظيم السلط و المؤسسات الدستورية التي تتشكل منها الدولة . لذلك فإن أغلب القواعد الدستورية تكون في حاجة ماسة لأجرأة قانونية و تشريعية عادية حتى تكون قادرة على تجسيد سيادة فكرة الدستور في جزئيات الحياة اليومية . و بخلاف القاعدة الدستورية التي تتولى السلطة المكلفة بوضع الدستور وضعها ، فإن أجرأة تلك القاعدة تعود للسلطة التشريعية باعتبارها الجهة الدستورية الموكول لها وضع القواعد القانونية و التشريعية العادية ؛ لذلك وجب التساؤل عن حدود و صلاحيات هذه السلطة في سن القاعدة القانونية ، و هل لها السلطة المطلقة كما للسلطة المكلفة بوضع الدستور أم أن لسلطاتها ضوابط و قيودا يجب التقيد بها ؟
إن الجواب عن هذا السؤال هو الذي يبرز البعد الحقيقي لمبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " .
أجرأة القاعدة الدستورية و مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور "
بخلاف السلطة المطلقة للسلطة المكلفة بوضع الدستور ، فإن السلطة التشريعية تكون لها سلطات مقيدة في مجال التشريع . فإذا كانت الأولى سيدة قرارها و لا سلطان لها في أداء وظيفتها إلا سلطان المصلحة العليا للمجتمع ، فإن الثانية تكون محكومة بما قررته السلطة الأولى بموجب القواعد الدستورية . لذلك يكون من المفيد أن نتساءل عن حدود السلطة التي تمتلكها المؤسسة التشريعية و هي بصدد أداء مهمتها الكامنة في وضع القاعدة القانونية التشريعية العادية و سنها .
صحيح أن السلطة التشريعية ما هي في نهاية المطاف إلا عبارة عن مجموعة أفراد انتخبهم الشعب في انتخابات يفترض أن تكون نزيهة و شفافة ، و معبرة عن إرادة الكتلة الناخبة ، ومن هذا الجانب فإن تلك السلطة تعتبر معبرة عن الإرادة الشعبية ، ويجب أن يكون لمهمتها التشريعية بعد شعبي ، من أجل ضمان أكبر قدر من التوافق بين البيئة الاجتماعية و القاعدة القانونية التي ستحكم ذات البيئة. و من ثمة يجب أن نثير الانتباه إلى مبدأ هام و خطير في ذات الوقت ؛ هذا المبدأ يتمثل في كون تعبير المؤسسة التشريعية عن إرادة الشعب لا يمكن أن يتجسد في سلطة مستبدة و مطلقة .
فالقاعدة التشريعية ، أنواع و أصناف ، منها ما يمس الأفراد كلهم بغض النظر عن مراكزهم القانونية أو الاجتماعية ، ومنها ما يمس فئة أو طائفة معينة دون الأخرى ، و منها ما يمس الاختيارات الكبرى للدولة ، بغض النظر عن المصلحة الفردية و الجماعية لطائفة من الأفراد .
و من هذا الاختلاف وجب أن تكون القاعدة القانونية متسمة بنوع من المصداقية و الشفافية . فلا يمكن لأفراد السلطة التشريعية سواء أكانوا أغلبية أو معارضة أن يتفقوا على سن قاعدة تشريعية تناقض التوجهات العامة للأفراد ممثلة في القيم و القواعد العامة التي تحكم سلوكهم اليومي. إذ لو تم ذلك لما احترمت تلك القاعدة القانونية . وبالتالي فإن السلطة التشريعية لن تكون في هذه الحالة ممثلة للإرادة الشعبية و لن تجسد التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب .
فأداء القاعدة القانونية لوظيفتها لن يتم إلا إذا كانت تلك القاعدة بالفعل ملبية لحاجيات و ضرورات مجتمعية أصيلة ، فرضتها الظروف و أملتها المناسبة التي دفعت بسنها . و من تم فإن العملية التشريعية تتسم بنوع من البطء الناتج عن التغير البطيء الذي يطبع تطور الفكر المجتمعي . و بالتالي فإن القاعدة القانونية التي تقوم السلطة التشريعية بسنها يجب أن تتسم بنوع من الديمقراطية التي تعبر عن التوجهات العامة و الغالبة في البيئة الاجتماعية ؛ فما لم تأخذ تلك السلطة تلك التوجهات بعين الاعتبار و تستبد برأيها في سن قاعدة قانونية معينة ، فإن هذه الأخيرة ما تلبث تهمل و يتم تغييرها بمجرد سيطرة اتجاه مخالف للاتجاه الذي سن تلك القاعدة على السلطة التشريعية بعد إجراء الانتخابات . فالقاعدة القانونية " الديمقراطية " هي القاعدة التي تستمد من البيئة الاجتماعية بغض النظر عن التوجه السياسي للتيار الغالب على السلطة التشريعية . إذ يتعين التمييز هنا بين الحاجة الاجتماعية للقانون باعتبارها تجسد أبهى صور المصلحة العليا ، وبين التوجهات السياسية التي تسعى لحشد الدعم و الزخم الشعبي من أجل الوصول إلى ممارسة الحكم .
فممارسة الحكم و سن التشريعات يجب أن يراعي الاختلاف الاجتماعي القائم ، وبالتالي فإن كل حزب أو جهة سياسية استطاعت أن تصل إلى ممارسة الحكم يجب أن تكون معبرة عن كل الأطياف الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع ، وليس فقط عن الفئة التي انتخبتها ؛ و بالتالي متى ما كانت هذه المقاربة غائبة عن التصور العام لممارسة السلطة التشريعية في مفهومها العام ، فإن عملها لن يكون مطبوعا بالبعد الديمقراطي .
هذا على مستوى القاعدة التشريعية التي ستتولى تنظيم علاقات الأفراد عموما داخل المجتمع . أما على مستوى القاعدة القانونية التي ستكون مهمتها وضع آليات تنظيمية للسلط و المؤسسات الدستورية ، فإن المؤسسة التشريعية و كذا التنفيذية يجب أن يخضعا لقيود تمليها سواء المقتضيات و القواعد الدستورية ، أو يفرضها المناخ العام السائد في المجتمع .
و هكذا؛ فإنه غالبا ما تتولى ، بالنسبة لنظامنا الدستوري و التشريعي ، السلطة التنفيذية أمر وضع مشاريع القوانين التي تتصدى لتنظيم مجموعة من المرافق الإدارية و قد تتعداها إلى وضع قواعد قانونية تعطي صلاحيات و سلطات لجهة ما أو تنزعها عنها . ثم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة و المرور بالمساطر المعمول بها يتم عرض المقتضيات المذكورة على السلطة التشريعية التي تتولى دراسة تلك المقتضيات و التصويت عليها بالإيجاب أو السلب .
فهذه المساطر و الإجراءات و إن كانت موسومة بنوع من التماهي بين اللون السياسي المهيمن على السلطة التنفيذية و ذاك المسيطر على السلطة التشريعية -على اعتبار أن الأغلبية الحكومية لا تنبثق إلا من الأغلبية البرلمانية – فإن ذلك التماهي ليس مطلقا و إنما يكون موسوما بدوره بتنوع الرؤى و اختلافها بتنوع و اختلاف تركيبة التحالف المشكل للحكومة أو السلطة التنفيذية . و من تم فإن المسؤولية السياسية تتحملها الحكومة كاملة و ليس أحد مكونتها بمفرده .
إلا أن ذلك التوافق الحاصل على مستوى السلطة التنفيذية ، يجب ألا يكون بدوره مستبدا عند صياغة مشاريع القوانين ، خاصة إذا ما كانت تلك المشاريع ستهم قطاعا بعينه . إذ يجب أن تكون تلك المشاريع عبارة عن ثمرة مشاورات و تبادل لوجهات النظر بين الجهة الموكول لها وضع تلك القواعد القانونية و الجهة التي ستتولى تطبيقها و تنفيذها فيما بعد المصادقة عليها . و بالتالي فإن مسألة سن القوانين ليست سلطة مطلقة تمتلكها السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية كل فيما يخصه ، و إنما هي عبارة عن " تفاوض سياسي " قبل كل شيء يفضي إلى توافق حول مبدأ معين يتولى خبراء القاعدة القانونية صياغته في شكل قانون .
و عليه فإن مسألة النقاش المجتمعي في حالة سن تشريعات تهم قطاعات بعينها يجب أن يكون مبنيا على أساس تبادل وجهات النظر بين المؤسسة التشريعية بمفهومها الواسع ، و بين القطاع أو السلطة المعنية . فلا يجوز بأي وجه كان أن تستبد سلطة بعينها بوضع قاعدة قانونية من شأنها أن تحكم أو تنظم قطاعا أو سلطة ما ، خاصة إذا كانت تلك السلطة دستورية أو تلك المؤسسة دستورية ، إذ في هذه الحالة يجب أن تكون القاعدة القانونية العادية امتدادا للتوافق الشعبي الذي طبع صياغة القاعدة الدستورية . فمن غير هذا الامتداد فإن أي تفسير للقاعدة الدستورية لن يكون إلا عبارة عن تحجيم لنطاقها و تضييق لمداها ، و تحوير لمعناها بالشكل الذي يخدم فقط الرؤية الضيقة للجهة السياسية التي تتولى ممارسة سلطة التشريع بالمعنى الواسع .
فلا يتصور أن تكون القاعدة القانونية ديمقراطية ، و لا يجب أن نتصور أن يكون لتلك القاعدة أي أثر على أرض الواقع متى ما تحقق الاستبداد بذلك الوضع و لم تؤخذ بعين الاعتبار آراء و تطلعات الجهات المعنية بتلك القواعد . و بالتالي فإن معنى " التأويل الديمقراطي للدستور" ينبني على ضرورة التوافق على المعنى المجتمعي للقاعدة القانونية و ليس على الرؤية السياسية التي تتبناها السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية و هما تمارسان سلطة التشريع . إذ لو حصل هذا الاستئثار بتحديد المعنى لكان مجسدا لفكرة الإقصاء للرأي الآخر ، و لن ينفع تبرير لذلك الموقف أن تقول السلطة التنفيذية أو التشريعية أن صناديق الاقتراع هي التي أتت بها من أجل ممارسة الحكم .
و في هذا السياق يمكن القول بأن الحديث عن الحالة المغربية ، يجب أن ينطلق من كون المخطط التشريعي الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال الولاية التشريعية الحالية ، مستمد من الدستور أساسا ، و خاصة الفصل 86 منه و الذي ينص على أنه : " تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. " و بالتالي فإن هذا الاختيار التشريعي الذي ستتولى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية تنفيذه هو اختيار قسري و مفروض دستوريا و لا علاقة له بالبرنامج الانتخابي للفرقاء السياسيين و لو تم إدراجه بتلك البرامج .
و على هذا الأساس ؛ فإن القوانين المعنية بهذا المخطط التشريعي يمكن تصنيفها إلى صنفين ، قوانين تنظيمية و هي المعنية مباشرة بالمقتضى الدستوري ، و قوانين عادية مرتبطة بتلك القوانين التنظيمية . و كلا الصنفين يعتبر امتدادا للقاعدة الدستورية ؛ و من ثمة فإن النفس التشاركي و التوافقي الذي طبع صياغة القاعدة الدستورية يجب أن يسود عند صياغة القاعدة التشريعية سواء أكانت في صورة قوانين تنظيمية أو عادية .
إن الحديث عن القوانين التنظيمية إنما يعني أمرين ؛
إما أن تكون تلك القوانين التنظيمية متعلقة بالحقوق و الحريات كما هو الأمر بالنسبة لقانون الإضراب مثلا أو الحق في الطعن في دستورية القوانين ؛ فهذه الطائفة من القوانين التنظيمية يجب أن تسن بتوافق مطلق بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين و ليس السياسيين فقط ، ذلك أن مسألة الحقوق و الحريات لا يعنى بها السياسيون فقط و إنما عموم أفراد المجتمع . و لذلك فإن أي قانون تنظيمي لا يأخذ بهذا البعد لا يكون مؤسسا على تأويل ديمقراطي للدستور .
و إما أن تكون تلك القوانين التنظيمية متعلقة بسلطة أو اختصاص أو تنظيم مجموعة من السلطات أو المؤسسات الدستورية ، كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات المرتبطة بالسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية . و هنا وجب التمييز بين حق السلطة التشريعية بمفهومها الواسع في سن قوانين تنظيمية دون مشاورات مع باقي الفرقاء الاجتماعيين كما هو الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان أو القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87 من الدستور ) ؛ و بين واجبها في إيجاد صيغة توافقية على مضمون القاعدة التشريعية سواء أكانت تلك القاعدة متعلقة بقانون تنظيمي أن قانون عادي متى تعلقت بسلطة أخرى كالسلطة القضائية عند وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مثلا ، فمثل هذا القانون يجب أن يسن بتنسيق مطلق مع رجال القضاء حتى تضمن الاستقلالية المطلقة و المقررة دستوريا للسلطة القضائية ، وحتى لا تنتقص تلك السلطة بموجب هوى و رغبة السلطة التنفيذية في الاستمرار في احتكار الوظائف القضائية . وما ينطبق على السلطة القضائية ينطبق على كل المؤسسات و السلط التي حدد لها الدستور إمكانية استصدار قوانين تنظيمية من أجل تنظيم اختصاصاتها، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للمحكمة الدستورية .
إن الحديث عن مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " يعني بكل اختصار أن تتأسس السياسة التشريعية على فكرة التشارك و التوافق و خاصة خلال الولاية التشريعية الحالية التي تتسم بوضع مجموع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛ و لا مجال للاحتماء بنتيجة الانتخابات لأن المرحلة التي يمر منه المغرب في هذه الفترة تعتبر مرحلة دقيقة و تاريخية بكل المقاييس .
و بما أن لكل مجال مصطلحاته و لكل مصطلح معانيه التي تختلف من حقل معرفي إلى آخر ، فإن التساؤل عن معنى " التأويل الديمقراطي للدستور " يجب أن يكون المنطلق في قراءة المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 .
و قد أفردنا دستور 2011 بالاختصاص لكون الخطاب الملكي السامي خصه بضرورة التأويل الديمقراطي ، فهذا الاختصاص يعتبر إشارة قوية إلى أن هناك إرادة قوية لدى أعلى سلطة بالدولة المغربية في أن يكون البناء العصري و الحديث للدولة المغربية بناء اجتماعيا قائما على مجموعة من المبادئ الناتجة عن إعمال آلية التوافق ليس بين الفرقاء السياسيين و حسب ، و لكن حتى بين صناع القرار و الجهات المعنية بتنفيذ القرار .
و من هذا المنطلق يجب البحث في معنى " التأويل الديمقراطي للدستور " ؛ إذ أن أول ما يجب أن يثار الانتباه إليه أنه لابد من التمييز بين مرحلتين ، مرحلة ما قبل وضع الدستور ، و مرحلة ما بعد وضعه . فإذا كانت المرحلة الأولى تأسيسية ، فإن الثانية تنزيلية ، لذلك وجب علينا تسليط الضوء على بعض مقتضيات كل مرحلة على حدة حتى يتضح لنا المعنى الحقيقي من مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " . و يشكل التفصيل في الجواب عن التساؤل المركزي حول السلطات التي يملكها المشرعون سواء الدستوريون أم العاديون ، جوابا حقيقيا عن تفسير معنى المبدأ المذكور.
سلطات السلطة المكلفة بوضع الدستور
من المعلوم في الفقه الدستوري أن الجهة التي يناط بها أمر وضع الدستور تعتبر بالفعل سلطة ذات صلاحيات مطلقة ، فلا حدود لصلاحياتها في كل مجال مهما دق أو عظُم . لذلك فإن السلطة التي تعنى بوضع الدستور في صيغته الأولية يجب أن تعامل بطريقة خاصة تجعل لها حقوقا و ترتب عليها التزامات .
و هكذا ؛ فإن أول ما يجب الإشارة إليه هو أنه يتعين أن تكون للسلطة المكلفة بوضع مشروع أو مسودة أي دستور كامل السلطات ، و لا مجال لمحاسبة أي عضو منها أو محاسبتها على أي فعل تشريعي دستوري قامت به و لو أعادت النظر في طبيعة الأجهزة المكونة للدولة . إذ أن أهم وظيفة تقوم بها السلطة المكلفة بوضع الدستور تتمثل في إحدى صورتين ؛ إما أن تعمل على إعادة تشكيل نظام الدولة و شكلها بعد أن تكون هذه الأخيرة قد انتقلت من مرحلة إلى أخرى ، و هذه الصورة لا تتحقق إلا في حالة حدوث ثورة أو انقلاب عسكري أو ما شابه ذلك من قطيعة مع مرحلة ما قبل تشكيل السلطة التي تتولى وضع الدستور ؛ و إما أن تعمل السلطة المكلفة بوضع الدستور على إعادة تنظيم اختصاصات السلط و المؤسسات الدستورية داخل الدولة في إطار الاستمرار الزماني للدولة من حيث الجوهر و من حيث شكلها و طبيعتها . و بالتالي فإن مدى الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة المكلفة بوضع الدستور، يستمد من السياق التاريخي الذي أنشأت فيه تلك السلطة ذاتها .
وهكذا ، فبالرجوع للحالة المغربية ، نجد أن الاختيار وقع على الصورة الثانية . ذلك أن التوافق بين الإرادة الملكية و الإرادة الشعبية حول الطريقة التي تناسب البيئة المغربية من أجل الدفع أكثر بالمسار الديمقراطي و الحداثي للدولة المغربية في إطار الاحترام المطلق للخصوصية و الهوية المغربية الراسخة ، مكَن من اتخاذ القرار التاريخي المعلن عنه بتاريخ 09 مارس 2011 بشأن تأسيس لجنة مكلفة بوضع الدستور الجديد ، وهو الدستور الذي يشكل بالفعل أول اللمسات الدستورية للدولة المغربية في عهد جلالة الملك محمد السادس .
فإذا كانت هناك مجموعة من الحيثيات و الخصوصيات التي طبعت تأسيس تلك اللجنة ، فإن أهم ما يمكن أن نشير إليه ، هو أنها جاءت من أجل تلبية الحاجة الملحة التي عبرت عنها مجموعة من التفاعلات الاجتماعية و السياسية و الثقافية التي طبعت الساحة المغربية خلال عهد الملك محمد السادس.
فالتحولات الاجتماعية و السياسية في أبعادها المختلفة ، و التي شهدها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب ، مهدت بالفعل لظهور مناخ جديد متسم بالطابع الحقوقي و منخرط في البيئة الكونية و محافظ على الخصوصية المغربية . فهذه التركيبة الثلاثية للتطور المجتمعي الذي شهده المغرب استطاعت أن تفرض وجود واقع جديد يتمثل في التركيز على ضرورة إعادة النظر في الإطار الدستوري للدولة المغربية بالشكل الذي سيمكن من استيعاب ما استجد في الواقع المغربي .
و من تم فإن التوافق بين الإرادتين الملكية و الشعبية ، استطاع أن ينتج آلية دستورية تمكن من تلبية الحاجة التي ظهرت ، و تستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين على الساحة المغربية و خاصة في البعد المتعلق بإعادة النظر في سلطات و مؤسسات الدولة المغربية و إعادة ترتيب اختصاصاتها .
و من هذه المنطلقات نجد أن اللجنة المكلفة بوضع الدستور جاءت لتلبي هدفا محددا و دقيقا يتمثل في إعادة النظر في مجموعة من المبادئ و التصورات حول سلطات الدولة و أجهزتها ، و كذا حول المؤسسات الدستورية و وظائفها ، في إطار مناخ متسم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة ، و بناء على قرارات تتخذ على أساس توافقي .
فعمل اللجنة الدستورية ، أسس على مبدأ التشارك و هو مبدأ يجب أن يكون حاضرا عند وضع أية قاعدة دستورية ، على اعتبار أن تلك القاعدة ما هي في الأخير إلا قيودا تؤطر عمل المؤسسات الدستورية التي سيخضع الجميع لحكمها ، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات ، و حتى الدولة عينها ستخضع لها . لذلك ، فإن القاعدة الدستورية يجب أن تكون قاعدة نابعة من الطبيعية و البيئة التي ستبسط عليها أحكامها . و زيادة على مبدأ التشارك الذي يعني إسهام الجميع في صياغة القاعدة الدستورية ، فإن مبدأ التوافق يجب أن يحظى بالاهتمام اللازم به ، ذلك أن تضارب الأفكار و تدافعها بل و تصارعها لحد التناقض أحيانا لن يمكن من وضع أية قاعدة دستورية من غير للجوء لمبدأ التوافق ؛ إذ لابد من إيجاد الحل المتوافق عليه القائم على فكرة التنازل المتبادل في إطار فكرة التعايش المشترك . فالقاعدة الدستورية في نهاية المطاف هي قاعدة سامية سيخضع لها الجميع ، لذلك وجب أن تنال الاحترام المطلق لكل الأطراف و الأفراد ، ومن تم فإن هذا الاحترام لن يكون له صدى في نفوس الأفراد و الهيئات ما لم يجد هؤلاء الأفراد و تلك الهيئات بعض ضالتها في القاعدة الدستورية .
و إذا كانت اللجنة المكلفة بوضع الدستور قد عمدت إلى تنظيم مشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين ، فإنها استطاعت أن تستوعب إلى حد بعيد مختلف التوجهات السائدة في البيئة المغربية ، كما استطاعت أن تضمن التركيبة الثلاثية التي أشرنا إليها أعلاه ، على امتداد الدستور ، و في مختلف أبوابه و فصوله.
و لما كانت ، القواعد الدستورية تتسم بنوع من العمومية و التجريد فوق التشريعي، نظرا لطبيعتها الخاصة ، فإن نفس القواعد لا تكون كافية لوحدها في تنظيم السلط و المؤسسات الدستورية التي تتشكل منها الدولة . لذلك فإن أغلب القواعد الدستورية تكون في حاجة ماسة لأجرأة قانونية و تشريعية عادية حتى تكون قادرة على تجسيد سيادة فكرة الدستور في جزئيات الحياة اليومية . و بخلاف القاعدة الدستورية التي تتولى السلطة المكلفة بوضع الدستور وضعها ، فإن أجرأة تلك القاعدة تعود للسلطة التشريعية باعتبارها الجهة الدستورية الموكول لها وضع القواعد القانونية و التشريعية العادية ؛ لذلك وجب التساؤل عن حدود و صلاحيات هذه السلطة في سن القاعدة القانونية ، و هل لها السلطة المطلقة كما للسلطة المكلفة بوضع الدستور أم أن لسلطاتها ضوابط و قيودا يجب التقيد بها ؟
إن الجواب عن هذا السؤال هو الذي يبرز البعد الحقيقي لمبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " .
أجرأة القاعدة الدستورية و مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور "
بخلاف السلطة المطلقة للسلطة المكلفة بوضع الدستور ، فإن السلطة التشريعية تكون لها سلطات مقيدة في مجال التشريع . فإذا كانت الأولى سيدة قرارها و لا سلطان لها في أداء وظيفتها إلا سلطان المصلحة العليا للمجتمع ، فإن الثانية تكون محكومة بما قررته السلطة الأولى بموجب القواعد الدستورية . لذلك يكون من المفيد أن نتساءل عن حدود السلطة التي تمتلكها المؤسسة التشريعية و هي بصدد أداء مهمتها الكامنة في وضع القاعدة القانونية التشريعية العادية و سنها .
صحيح أن السلطة التشريعية ما هي في نهاية المطاف إلا عبارة عن مجموعة أفراد انتخبهم الشعب في انتخابات يفترض أن تكون نزيهة و شفافة ، و معبرة عن إرادة الكتلة الناخبة ، ومن هذا الجانب فإن تلك السلطة تعتبر معبرة عن الإرادة الشعبية ، ويجب أن يكون لمهمتها التشريعية بعد شعبي ، من أجل ضمان أكبر قدر من التوافق بين البيئة الاجتماعية و القاعدة القانونية التي ستحكم ذات البيئة. و من ثمة يجب أن نثير الانتباه إلى مبدأ هام و خطير في ذات الوقت ؛ هذا المبدأ يتمثل في كون تعبير المؤسسة التشريعية عن إرادة الشعب لا يمكن أن يتجسد في سلطة مستبدة و مطلقة .
فالقاعدة التشريعية ، أنواع و أصناف ، منها ما يمس الأفراد كلهم بغض النظر عن مراكزهم القانونية أو الاجتماعية ، ومنها ما يمس فئة أو طائفة معينة دون الأخرى ، و منها ما يمس الاختيارات الكبرى للدولة ، بغض النظر عن المصلحة الفردية و الجماعية لطائفة من الأفراد .
و من هذا الاختلاف وجب أن تكون القاعدة القانونية متسمة بنوع من المصداقية و الشفافية . فلا يمكن لأفراد السلطة التشريعية سواء أكانوا أغلبية أو معارضة أن يتفقوا على سن قاعدة تشريعية تناقض التوجهات العامة للأفراد ممثلة في القيم و القواعد العامة التي تحكم سلوكهم اليومي. إذ لو تم ذلك لما احترمت تلك القاعدة القانونية . وبالتالي فإن السلطة التشريعية لن تكون في هذه الحالة ممثلة للإرادة الشعبية و لن تجسد التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب .
فأداء القاعدة القانونية لوظيفتها لن يتم إلا إذا كانت تلك القاعدة بالفعل ملبية لحاجيات و ضرورات مجتمعية أصيلة ، فرضتها الظروف و أملتها المناسبة التي دفعت بسنها . و من تم فإن العملية التشريعية تتسم بنوع من البطء الناتج عن التغير البطيء الذي يطبع تطور الفكر المجتمعي . و بالتالي فإن القاعدة القانونية التي تقوم السلطة التشريعية بسنها يجب أن تتسم بنوع من الديمقراطية التي تعبر عن التوجهات العامة و الغالبة في البيئة الاجتماعية ؛ فما لم تأخذ تلك السلطة تلك التوجهات بعين الاعتبار و تستبد برأيها في سن قاعدة قانونية معينة ، فإن هذه الأخيرة ما تلبث تهمل و يتم تغييرها بمجرد سيطرة اتجاه مخالف للاتجاه الذي سن تلك القاعدة على السلطة التشريعية بعد إجراء الانتخابات . فالقاعدة القانونية " الديمقراطية " هي القاعدة التي تستمد من البيئة الاجتماعية بغض النظر عن التوجه السياسي للتيار الغالب على السلطة التشريعية . إذ يتعين التمييز هنا بين الحاجة الاجتماعية للقانون باعتبارها تجسد أبهى صور المصلحة العليا ، وبين التوجهات السياسية التي تسعى لحشد الدعم و الزخم الشعبي من أجل الوصول إلى ممارسة الحكم .
فممارسة الحكم و سن التشريعات يجب أن يراعي الاختلاف الاجتماعي القائم ، وبالتالي فإن كل حزب أو جهة سياسية استطاعت أن تصل إلى ممارسة الحكم يجب أن تكون معبرة عن كل الأطياف الاجتماعية الموجودة داخل المجتمع ، وليس فقط عن الفئة التي انتخبتها ؛ و بالتالي متى ما كانت هذه المقاربة غائبة عن التصور العام لممارسة السلطة التشريعية في مفهومها العام ، فإن عملها لن يكون مطبوعا بالبعد الديمقراطي .
هذا على مستوى القاعدة التشريعية التي ستتولى تنظيم علاقات الأفراد عموما داخل المجتمع . أما على مستوى القاعدة القانونية التي ستكون مهمتها وضع آليات تنظيمية للسلط و المؤسسات الدستورية ، فإن المؤسسة التشريعية و كذا التنفيذية يجب أن يخضعا لقيود تمليها سواء المقتضيات و القواعد الدستورية ، أو يفرضها المناخ العام السائد في المجتمع .
و هكذا؛ فإنه غالبا ما تتولى ، بالنسبة لنظامنا الدستوري و التشريعي ، السلطة التنفيذية أمر وضع مشاريع القوانين التي تتصدى لتنظيم مجموعة من المرافق الإدارية و قد تتعداها إلى وضع قواعد قانونية تعطي صلاحيات و سلطات لجهة ما أو تنزعها عنها . ثم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة و المرور بالمساطر المعمول بها يتم عرض المقتضيات المذكورة على السلطة التشريعية التي تتولى دراسة تلك المقتضيات و التصويت عليها بالإيجاب أو السلب .
فهذه المساطر و الإجراءات و إن كانت موسومة بنوع من التماهي بين اللون السياسي المهيمن على السلطة التنفيذية و ذاك المسيطر على السلطة التشريعية -على اعتبار أن الأغلبية الحكومية لا تنبثق إلا من الأغلبية البرلمانية – فإن ذلك التماهي ليس مطلقا و إنما يكون موسوما بدوره بتنوع الرؤى و اختلافها بتنوع و اختلاف تركيبة التحالف المشكل للحكومة أو السلطة التنفيذية . و من تم فإن المسؤولية السياسية تتحملها الحكومة كاملة و ليس أحد مكونتها بمفرده .
إلا أن ذلك التوافق الحاصل على مستوى السلطة التنفيذية ، يجب ألا يكون بدوره مستبدا عند صياغة مشاريع القوانين ، خاصة إذا ما كانت تلك المشاريع ستهم قطاعا بعينه . إذ يجب أن تكون تلك المشاريع عبارة عن ثمرة مشاورات و تبادل لوجهات النظر بين الجهة الموكول لها وضع تلك القواعد القانونية و الجهة التي ستتولى تطبيقها و تنفيذها فيما بعد المصادقة عليها . و بالتالي فإن مسألة سن القوانين ليست سلطة مطلقة تمتلكها السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية كل فيما يخصه ، و إنما هي عبارة عن " تفاوض سياسي " قبل كل شيء يفضي إلى توافق حول مبدأ معين يتولى خبراء القاعدة القانونية صياغته في شكل قانون .
و عليه فإن مسألة النقاش المجتمعي في حالة سن تشريعات تهم قطاعات بعينها يجب أن يكون مبنيا على أساس تبادل وجهات النظر بين المؤسسة التشريعية بمفهومها الواسع ، و بين القطاع أو السلطة المعنية . فلا يجوز بأي وجه كان أن تستبد سلطة بعينها بوضع قاعدة قانونية من شأنها أن تحكم أو تنظم قطاعا أو سلطة ما ، خاصة إذا كانت تلك السلطة دستورية أو تلك المؤسسة دستورية ، إذ في هذه الحالة يجب أن تكون القاعدة القانونية العادية امتدادا للتوافق الشعبي الذي طبع صياغة القاعدة الدستورية . فمن غير هذا الامتداد فإن أي تفسير للقاعدة الدستورية لن يكون إلا عبارة عن تحجيم لنطاقها و تضييق لمداها ، و تحوير لمعناها بالشكل الذي يخدم فقط الرؤية الضيقة للجهة السياسية التي تتولى ممارسة سلطة التشريع بالمعنى الواسع .
فلا يتصور أن تكون القاعدة القانونية ديمقراطية ، و لا يجب أن نتصور أن يكون لتلك القاعدة أي أثر على أرض الواقع متى ما تحقق الاستبداد بذلك الوضع و لم تؤخذ بعين الاعتبار آراء و تطلعات الجهات المعنية بتلك القواعد . و بالتالي فإن معنى " التأويل الديمقراطي للدستور" ينبني على ضرورة التوافق على المعنى المجتمعي للقاعدة القانونية و ليس على الرؤية السياسية التي تتبناها السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية و هما تمارسان سلطة التشريع . إذ لو حصل هذا الاستئثار بتحديد المعنى لكان مجسدا لفكرة الإقصاء للرأي الآخر ، و لن ينفع تبرير لذلك الموقف أن تقول السلطة التنفيذية أو التشريعية أن صناديق الاقتراع هي التي أتت بها من أجل ممارسة الحكم .
و في هذا السياق يمكن القول بأن الحديث عن الحالة المغربية ، يجب أن ينطلق من كون المخطط التشريعي الذي تنوي الحكومة تنفيذه خلال الولاية التشريعية الحالية ، مستمد من الدستور أساسا ، و خاصة الفصل 86 منه و الذي ينص على أنه : " تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. " و بالتالي فإن هذا الاختيار التشريعي الذي ستتولى السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية تنفيذه هو اختيار قسري و مفروض دستوريا و لا علاقة له بالبرنامج الانتخابي للفرقاء السياسيين و لو تم إدراجه بتلك البرامج .
و على هذا الأساس ؛ فإن القوانين المعنية بهذا المخطط التشريعي يمكن تصنيفها إلى صنفين ، قوانين تنظيمية و هي المعنية مباشرة بالمقتضى الدستوري ، و قوانين عادية مرتبطة بتلك القوانين التنظيمية . و كلا الصنفين يعتبر امتدادا للقاعدة الدستورية ؛ و من ثمة فإن النفس التشاركي و التوافقي الذي طبع صياغة القاعدة الدستورية يجب أن يسود عند صياغة القاعدة التشريعية سواء أكانت في صورة قوانين تنظيمية أو عادية .
إن الحديث عن القوانين التنظيمية إنما يعني أمرين ؛
إما أن تكون تلك القوانين التنظيمية متعلقة بالحقوق و الحريات كما هو الأمر بالنسبة لقانون الإضراب مثلا أو الحق في الطعن في دستورية القوانين ؛ فهذه الطائفة من القوانين التنظيمية يجب أن تسن بتوافق مطلق بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين و ليس السياسيين فقط ، ذلك أن مسألة الحقوق و الحريات لا يعنى بها السياسيون فقط و إنما عموم أفراد المجتمع . و لذلك فإن أي قانون تنظيمي لا يأخذ بهذا البعد لا يكون مؤسسا على تأويل ديمقراطي للدستور .
و إما أن تكون تلك القوانين التنظيمية متعلقة بسلطة أو اختصاص أو تنظيم مجموعة من السلطات أو المؤسسات الدستورية ، كما هو الأمر بالنسبة للمؤسسات المرتبطة بالسلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية . و هنا وجب التمييز بين حق السلطة التشريعية بمفهومها الواسع في سن قوانين تنظيمية دون مشاورات مع باقي الفرقاء الاجتماعيين كما هو الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان أو القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ( الفصل 87 من الدستور ) ؛ و بين واجبها في إيجاد صيغة توافقية على مضمون القاعدة التشريعية سواء أكانت تلك القاعدة متعلقة بقانون تنظيمي أن قانون عادي متى تعلقت بسلطة أخرى كالسلطة القضائية عند وضع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مثلا ، فمثل هذا القانون يجب أن يسن بتنسيق مطلق مع رجال القضاء حتى تضمن الاستقلالية المطلقة و المقررة دستوريا للسلطة القضائية ، وحتى لا تنتقص تلك السلطة بموجب هوى و رغبة السلطة التنفيذية في الاستمرار في احتكار الوظائف القضائية . وما ينطبق على السلطة القضائية ينطبق على كل المؤسسات و السلط التي حدد لها الدستور إمكانية استصدار قوانين تنظيمية من أجل تنظيم اختصاصاتها، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للمحكمة الدستورية .
إن الحديث عن مبدأ " التأويل الديمقراطي للدستور " يعني بكل اختصار أن تتأسس السياسة التشريعية على فكرة التشارك و التوافق و خاصة خلال الولاية التشريعية الحالية التي تتسم بوضع مجموع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور ؛ و لا مجال للاحتماء بنتيجة الانتخابات لأن المرحلة التي يمر منه المغرب في هذه الفترة تعتبر مرحلة دقيقة و تاريخية بكل المقاييس .




 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 التأويل الديمقراطي للدستور
التأويل الديمقراطي للدستور