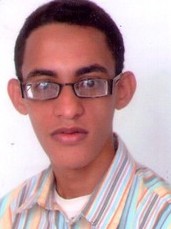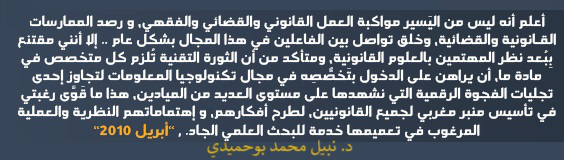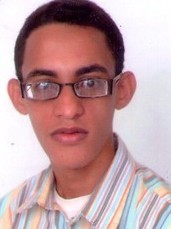
التعليق
أصدر المجلس الأعلى (سابقا) قراره عدد 181 بفاتح مارس 2006، في الملف الإجتماعي عدد 1229/5/1/2005[1]؛ المبني على أساس مدى اعتبار العقد المبرم مع الممارس لمهنة الصباغة عقد شغل ومدى امتثاله لظهير 6 فبراير 1963 بشأن التعويضات الممنوحة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وحوادث الطريق بناء على توفر علاقة التبعية أو عدم توفرها.
ولا يخفيكم ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة إن على المستوى العلمي وكذا العملي؛ فمن الناحية العلمية فإن انقسام الفقه في تحديد مفهوم علاقة التبعية كان له الأثر البالغ في التوجهات التشريعية وأيضا على المستوى العملي حيث من شأن القضاء أن يبني مقرراته على توجه يحرم فئة واسعة من المجتمع من امتيازات هامة يخولها لها القانون الإجتماعي.
وتتلخص وقائع هذا الملف في وفاة شخص جراء القيام بتنفيذ التزام متمثل في صباغة الواجهة الأمامية لمنزل الطالب في النقض؛ مما دفع ورثة الهالك (المطلوبون في النقض) لرفع دعوى بابتدائية تازة في تاريخ 4 مارس 2004 ملتمسين عدة تعويضات طبقا لظهير 6 فبراير 1963 المنظم للتعويضات الممنوحة عن حوادث الشغل...، وهو ما أيدته المحكمة بحكمها على الطالب بأداء إيراد عمري ومصروفات الجنازة لفائدة المطلوبين؛ نفس الحكم أيدته استئنافية تازة في 20 يونيو 2005 بعد استئنافه من قبل الطالب بحجة حصول الهالك على أجر من قبل الأخير وبالتالي كون الوفاة كانت جراء حادثة شغل؛ الحكم الذي نقضه المجلس الأعلى (سابقا) بعلة انعدام علاقة التبعية وهو الدفع الذي تقدم به الطالب بحجة أن الهالك مقاول محترف في نوع من الصباغة ويعتمد تقنية عالية، وأن قرار استئنافية تازة اعتمد على الأجر لتكييف العقد على أنه عقد شغل، بينما الأجر عنصر ثانوي لإثبات وجود علاقة تبعية مقارنة بعناصر الإشراف والرقابة والتوجيه والتأديب.
كل هذا يضعنا أمام التساؤل عن آراء الفقه بخصوص علاقة التبعية وأيها اعتمد عليه المشرع؟ ومدى ملاءمة موقف المجلس الأعلى (سابقا) لهذه التوجهات؟
مما يدفعنا إلى اعتماد الخطة الآتية:
أولا: موقف الفقه والمشرع من علاقة التبعية
ثانيا: تقييم قرار محكمة النقض على ضوء توجه الفقه والقانون
أولا: موقف الفقه والمشرع من علاقة التبعية
سنبرز في البداية اختلاف موقف الفقه بخصوص علاقة التبعية (أ) لنتبين على أيهم اعتمد المشرع (ب)
- موقف الفقه
وانقسم الفقه بخصوصها إلى اتجاهين، أول اعتمد على التبعية القانونية بمعنى هيمنة المشغل أثناء تنفيذ العقد على نشاط الأجير، فقوامها نوع من السلطة لأحد المتعاقدين على الآخر، تتجسد في حق المشغل في توجيه ومراقبة الأجير أثناء قيامه بالعمل، وفي التزامه بإطاعته والإمتثال له في هذا التوجيه والمراقبة، كما تظهر التبعية القانونية في تلك الإجراءات التي يمكن للمشغل عند المخالفة توقيعها على الأجير[3]؛ والتي بدورها انقسم فيها الفقه بحسب صورها حيث هناك من أخذ بمفهوم التبعية الفنية حيث أن المؤاجر يهيمن على عمل أجيره في أصول عمله وقواعده الكلية وأيضا في جزئياته بحيث يرسم خطة العمل ويوجهها ويشرف على أجيره في تنفيذها مع مراقبة مدى حسن أدائهم لها وتدخله كلما بدا له أي تقصير أو انحراف أو إهمال من جانبه، وتقتضي هذه الدرجة أن يكون المشغل على إلمام تام وكلي بتفاصيل العمل المنجز لحسابه[4]؛ وهناك من قال فقط بالتبعية الإدارية والتنظيمية وتعني إشراف المشغل على تحديد الشروط التي يتم العمل في ظلها وتنظيم الظروف الخاريجة التي تحيط بتنفيذه، وذلك مثل تقديم وتحديد مكان العمل وتحديد أوقاته، وتسليم المواد والأدوات اللازمة للعمل، وتقسيم العمل على الأجراء عند تعددهم، كما يقوم بالتفتيش عليهم بين الحين والآخر للتأكد من مراعاتهم لتعليماته، وكل هذا طبعا مع الخضوع للإجراءات التأديبية في حالة مخالفة هذه التعليمات[5]، وهذا حال المهندس على سبيل المثال.
أما الإتجاه الآخر من الفقه فيتزعمه الفقيه الفرنسي CUCHE والذي قال بالتبعية الإقتصادية وهي النظرية الحديثة في هذا الموضوع، والتي تقوم على أنه ليس من اللازم في تكييف عقد الشغل وخضوع الأجير لتوجيه وإداره ومراقبة المشغل، بل يكفي لقيامها وجود حاجة الأجير إلى الأجر، الذي يحصل عليه من المشغل واعتماده عليه في عيشه باعتباره مورد رزقه الوحيد كما يقضي في سبيل الحصول عليه جميع وقته فلا تكون له فرصة العمل في مجال آخر، رغم أن هذا النوع من التبعية حسب الرأي المخالف يبقى غير محدد البداية والنهاية، ويعلق تكييف القانون للعقد على عنصر أجنبي عنه هو المركز الإقتصادي والإجتماعي للأجير[6].
- موقف المشرع
ثانيا: تقييم قرار محكمة النقض على ضوء توجه الفقه والقانون
وقبل أن نعطي رأينا حول موقف هذه المحكمة (ب) سنتكلم عن توجه القضاء الغربي بهذا الخصوص (أ)
- توجه القضاء المغربي بخصوص علاقة التبعية
- تقييم موقف المجلس الأعلى (سابقا)
الهوامش
[1] - قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى؛ العدد 67؛ الإصدار الرقمي ماي 2007؛ عن مركز النشر والتوثيق القضائي؛ ص:240
[2] - عبد الكريم غالي؛ في القانون الإجتماعي المغربي طبعة 2005؛ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرباط؛ ص: 161.
[3] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛ الطبعة الأولى 2004؛ المطبعة والوراقة الوطنية؛ مراكش؛ ص: 350.
[4] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛ مرجع سابق؛ ص: 360.
[5] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛ مرجع سابق؛ ص: 361.
[6] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛مرجع سابق؛ ص: 352 – 353.
[7] - عبد الكريم غالي؛ في القانون الإجتماعي المغربي طبعة 2005؛ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع؛ الرباط؛ ص: 159.
[8] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛مرجع سابق؛ ص:355.
[9] - عبد اللطيف خالفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛مرجع سابق؛ ص: 356,
[10] - أنظر قرارات أوردها عبد اللطيف الفي؛ الوسيط في مدونة الشغل؛ الجزء الأول؛ علاقات الشغل الفردية؛مرجع سابق؛ ص:355 – 356.
[11] - أنظر قرارات أوردا بلال العشري؛ حوادث الشغل والأمراض المهنية؛ دراسة نظرية وتطبيقية؛ الطبع الولى؛ 2009 دار أبي رقراق للطباعة والنشر؛ الرباط؛ ص: 27 – 28.
[12] - Alain BENABENT ; Droit des Contrat Spéciaux : Civils et Commerciaux ; 10 Editin ; Août 2013 ; L.G.D.J ; P : 340 et 352.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 مدى إعتبار العقد المبرم مع الممارس لمهنة الصباغة عقد شغل ـ تعليق على قرار محكمة النقض عدد 181 الصادر في فاتح مارس 2006
مدى إعتبار العقد المبرم مع الممارس لمهنة الصباغة عقد شغل ـ تعليق على قرار محكمة النقض عدد 181 الصادر في فاتح مارس 2006