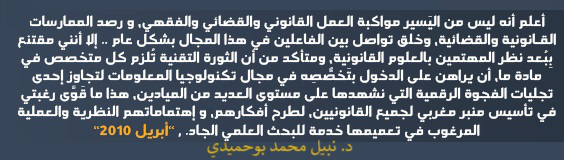رفقته نسخة للتحميل

تقديم:
إن الجريمة ظاهرة اجتماعية توجد حيث يوجد المجتمع وهي قديمة قدم التاريخ لا تزول الا بزواله، ووظيفة القانون هي ان يبين لكل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وبالتالي فوظيفته الأساسية هي تنظيم المجتمع تنظيما يحقق صيانة حريات الافراد ومصالحهم من جهة ويحفظ كيان المجتمع بإقرار النظام فيه وكفالة المصلحة العامة من جهة أخرى.
إلا ان استفحال الظاهرة الاجرامية في المجتمع وتنوعها وظهور فئات جديدة من الجرائم وهي جرائم الاحداث جعل من الصعب تطبيق القانون بصيغته الزجرية، وجعلنا نتساءل لماذا يجرم المجرم؟ وبدراسة بسيطة لعلم الاجرام نجمع على أن الظاهرة الاجرامية هي ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو اجتماعي علائقي وما هو نفسي وجداني وما هو سلوكي مكتسب، مما يجعلنا عاجزين عن تطبيق مفهوم الردع لمحاربة الظاهرة الاجرامية، وأصبح معه التفكير لدا علماء الاجرام منصبا على البحث في أسباب الجريمة لمعرفة طرق علاجها أو الاصح طرق التقليل منها.
وتعد المدرسة ذلك الفضاء الذي ينتقل اليه الطفل منذ نعومة أظافرة ليكتسب مبادئ المعرفة والتربية، حيث تحتل مكانة أساسية في بناء شخصية الطفل، لذا فالمدرسة تتحمل المسؤولية في تنشئته وتلعب دورا هاما في بناء شخصية ذلك الطفل في المستقبل، إذ يمكننا اعتبارها اللبنة الثانية بعد الاسرة في بناء الفرد داخل المجتمع فمتى ما كانت التنشئة قويمة أنتجت لدينا مجتمعا خاليا من الظواهر المنحرفة ومنها الجريمة،
ومن هنا تبدو العلاقة وطيدة بين الجريمة والمدرسة، وقد جاء طرحنا هذا لتبيان مكامن هذه العلاقة محاولين أن نوضح من خلال إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يمكن أن تساهم المدرسة في التقليل من الظاهرة الاجرامية؟
أي كيف يمكن للمدرسة أن تكون أولا سببا محتما في الانحراف وعلى النقيض، كيف يمكن لها ان تكون سببا في الوقاية من الانحراف؟ وهل يلعب التعليم دورا وقائيا من الجريمة؟ وهل يمكن له أن يكون له دور علاجي تقويمي بعد ارتكاب الجريمة؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال منهج تحليلي معتمدين التصميم التالي:
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية
إن التعليم هو سبب تطور الأمم ونهضتها، وهو سبب أيضا في هلاكها وتدهورها، فهي من العوامل الاساسية المؤثرة في صنع الانسان سواء كان ذلك عن طريق تحصيله العلمي او عن طريق مخالطته مع الأصدقاء في محيطه الدراسي، وإذا نظرنا الى اغلب مرتكبي الجرائم نجدهم من فئات عانت الفشل الدراسي أو الأمية أو الترسب أو الانحراف، وهذا الانحراف غالبا ما يكون ذا علاقة وطيدة بالمؤسسة التعليمية، فكيف يمكن للمؤسسة التعليمية أن تساهم في استفحال الظاهرة الاجرامية؟ أو بتعبير ءاخر هل تساهم المدرسة بشكل أو بآخر في انحراف الاحداث وتوجههم نحو الوقوع في الجرائم؟
إنه لمن الصعب تصور ذلك، لما تكتسيه المؤسسة التعليمية من مكانة مرموقة في المجتمع، وما تلقنه من قيم سامية للتلاميذ طيلة فترة تمدرسهم إلا ان الواقع يفرض نفسه، فنجد أن المؤسسة لها دور في صناعة مجرمي الغد بطريقة أو بأخرى وهو ما سنعالجه في (الفقرة الأولى)
وإننا باستقرائنا لمختلف النظريات الفكرية المنظرة لعلم الاجرام فإننا نجد تأصيلا فقهيا لعلاقة الظاهرة الاجرامية بالتعليم أو بالمؤسسة التعليمية، وهو ما نعالجه بالدراسة والتحليل في (الفقرة الثانية.)
الفقرة الأولى: علاقة المدرسة بالظاهرة الاجرامية.
إن المدرسة هي المجتمع الأصل الذي ينضم إليه الطفل بعد فترة طفولته الأولى التي يقتصر فيها على مجتمع الأسرة، وهي المكان الذي يمضي الحدث فيه جانبا كبيرا من يومه، تكون له فيه علاقات مع أساتذته ورفاقه، كما أنه يتلقى بها معلومات ودراسات تكون له عونا على شق طريق شريف لحياته في مستقبل أيامه، فإن سلوكه يتأثر بعدة عوامل تتعلق بالناحيتين الدراسية والتهذيبية.[1] فلا بد له من الولوج إليها و تلقي السلوك الحسن وقيم المواطنة، إلا أن عدم الولوج الى المدرسة يعد آفة خطيرة تسري بالحدث الى طريق الانحراف، وكذا إذا ما ولج الى المدرسة وتلقى معاملة مشحونة بالضغينة والبغضاء فسيكون المحيط المدرسي سببه الى سلوك طريق الانحراف.
أولا دراسة في الهدر المدرسي وعلاقته بالانحراف.
هذه شهادة لتلميذ سابق استقاها من أحد أصدقائه في الحي:''رغم أني كنت أحب الدراسة، إلا أني انقطعت عنها مبكرا دون أن أتجاوز مرحلة التعليم الابتدائي، توفيت والدتي في سن الرابعة، تزوج أبي امرأة أخرى، حاولت منحي الحنان، لكنه لن يصل إلى حنان الأم المفقود، ولا إلى قسوة الوالد الموجود، كان أبي في مشاداة لا تنتهي معي ومع زوجته، مشاداة لم يسلم منها حتى إخوتي البنات البالغ عددهن ثلاثة، والمال في أغلب الأحيان هو سبب هذا النزاع، فهو يرفض شراء الملابس والكتب بدعوى قلة ذات اليد، بدأت أحس أنه يكرهنا، وشيئا فشيئا بدأ تركيزي يقل، فتعذر بالتالي فهمي للدروس مما دفعني إلى الخروج من المدرسة؛
خارج أسوار المدرسة وجدت الضياع مع الإحساس بالغربة والوحدة بين أهلي، فكرت في الاشتغال بالمقاهي، تعرضت للاستغلال والقسوة من أرباب الشغل الذين لا يتوانون في تكليفي بمهام تفوق قدراتي الجسمية تعرفت على أصدقاء يتعاطون المخدرات، بدأوا يعترضون سبيل المارة ويعتدون عليهم، لم ترضني هذه التصرفات... ختم هذا الطفل حديثه لصديقه بتوجيه نداء إلى المجتمع من أجل إنقاذه وتقديم يد العون له. ''[2]
استأثرت ان ابدأ بهذه القصة لكي أبين كيف للهدر المدرسي من عواقب وخيمة على سلوكيات الفرد، وقد يقول قائل إن سبب الطفل في الهدر المدرسي هو الاب، من جهة نعم ومن جهة أخرى فهي مسؤولية الدولة بمقتضى دستور2011 حيث نص بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”
ونجد للهدر المدرسي أسباب تربوية أخرى منها:
ثانيا: دراسة في أسباب العنف المدرسي.
تعد المدرسة تلك الفضاء الذي ينتقل اليه الطفل من حنان حضن الام الى عالم متغير حيث يجد نفسه في أقسام دراسية مع الكثير من الغرباء عوض إخوانه، ومعلم عوض أمه، مما يجعله في محطة صراعه الأولى في الحياة وهي صراع الاندماج، وهنا بالتحديد تبدأ معالم التعثر عند الحدث عندما لا يجد مؤازرة سواء من طرف المعلم او الأطفال حوله، بشكل يسهل عليه الاندماج في محيطه الجديد، وهو ما ينعكس على بناء شخصيته السليمة، ويصبح معها الطفل يميل الى الانطوائية والعنف والحقد وجميع العقد النفسية التي قد تكون مكتسبة بالأساس من التعامل الخاطئ من الوهلة الأولى مع المحيط الدراسي، ويتطور الانحراف لدى التلاميذ مع تطور المستوى الدراسي وتطور البنية الجسدية والنفسية لدى التلاميذ بداية من التعليم الأولى مرورا بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وما بعده مما يساهم في جعل ذلك الطفل عرضة للانحراف.
فنجد أن الاطفال يجعلون من الروضة والمعلمة بديلا عن منازلهم واسرهم، فعندما يفكرون بان يجلبوا هدايا لمعلماتهم فان تفكيرهم هذا لم يأتي من فراغ انما من مدى تلمسهم لحب معلماتهم وهو سلوك لا يتوفر في شخصيات بعض المعلمات اللواتي لا تجمعهن مع الطلاب او الاطفال سوى المعلومات التي يحاولن تمريرها للطلاب،
ونقارن هنا بين طالب يصاب بوعكة صحية ولا يذهب لمدرسته فتبادر معلمته بالاتصال بوالدته للاطمئنان عليه وتطلب الحديث مع طالبها لتعبر له بكلمات تفرحه عن افتقادها له،
ومعلمة تتابع تقدم طالب بعد ان كان يعاني من ضعف ما في مادة دراسية وعندما يتمكن من احراز تقدم ملحوظ تصفق له امام زملائه بالصف تقديرا منها على ما انجزه.
وفي المقابل هناك معلمات منذ اللحظة التي يدخلن بها للصفوف لا يتوقفن عن الصراخ وبث الخوف في نفوس الطلاب او ينتهجن سلوكيات خاطئة مع الطلاب كالعقاب غير المبرر فتأخذ العلاقة التي تجمعهم بطلابهم شكلا غير سوي لأنهم لا يجدون مبررا لسلوكيات، لا تتسم الا بالعنف اللفظي والسلوكي.[4]
دون أن نغفل على العنف الجسدي الذي لازال سائدا في أوساط المدارس حيث، أن العقاب البدني لا يزال مستخدما على نطاق واسع في المدارس في أجزاء كثيرة من العالم بما يتبعه من عواقب وخيمة. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، فإن نصف الطلاب على الصعيد العالمي ممن تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما، أي نحو 150 مليون طالب، أبلغوا عن تعرضهم للعنف في المدرسة وحولها. فيما يُعاني أكثر من طالب واحد من كل ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما من التنمر.[5]
وهده الإساءة تكون مؤذية على عدة أصعدة. أولًا، قد تجعل الاطفال يشعرون بأنّهم يقومون بأمر خاطئ، أو أنّهم يعانون من مشكلة ما، حتى لمجرّد تعبيرهم عن نفسهم. ثانيًا، تجعلهم يقلقون حول نظرة الناس إليهم، مما يولّد لديهم الشعور بالحذر والخجل ويفقدهم حريّة التعبير. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى الحدّ من حريّتهم، ويجعلهم دائمي القلق من مراقبة الناس لما يقومون به، وتتشكل لديهم عقد نفسية منها: عقدة الذنب، الخجل والانطوائية: القلق الدائم، الفوقية أو الدونية...[6]
إن مثل هذه العقد النفسية التي تنمو مع الطفل طول مساره الدراسي تنعكس سلبا على تحصيله الدراسي حيث تنقص ليه القدرة على التحصيل والاستيعاب والاحساس بالفشل أمام أصدقائه والخوف من إبداء الرأي هربا من استهزاء أصدقائه فتتشكل له هواجس نفسية وقيود يمكن أن يعبر عليها إما بالانطوائية او بالتعصب والحقد على المجتمع مما يجعل منه يميل الى العدوانية وتفريغ شحناته الداخلية على زملائه وأصدقائه بغية إشباع رغباته الداخلية و حبا في الظهور للعلن، وهو ما يفسر تلك الظواهر المشينة في الوسط المدرسي من قبيل العنف المدرسي و التنمر أو الانسياق لأشياء أكثر خطورة منها استعمال المخدرات والهدر المدرسي.
ولابد لنا هنا أن نشير الى مضامين التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي حيث جاء فيه ما يلي:
(يبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، فتعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية، لقد صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبروا بألقاب مهينة، وأكد 55.9% من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية، والشتائم بدرجات مختلفة.
كما بين البحث الميداني حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2% من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب، و % 28.5 تعرضوا للدفع؛ أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح % 25.3 من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و37.4% منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.
علاوة على ذلك، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية. كما يتبين من خلال هذه الدراسة، أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي: %27.1 و % %38.6 من تلامذة الابتدائي والثانوي. أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم. أضف إلى ذلك أن % 61.7% من تلامذة الثانوي الإعدادي و%70.3 من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.
كما بينة الدراسة أنه في المدارس الابتدائية، تصدر عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني على يد أشخاص مختلفين، فمثلا مرتكبو أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، يأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم، بشكل أقل، الآباء والأمهات وأولياء الأمور. فيتبين أن التلامذة عرضة لأنواع مختلفة من العنف من طرف فاعلين متعددين في المدرسة، كما أن أعمال العنف التي يرتكبها أشخاص من خارج المؤسسة أقل وتيرة، إلا أنها أكثر حضورا في الوسط القروي.)[7]
إن هدا التقرير الذي عرى عن واقع المؤسسة التعليمية بالمغرب والذي سلط الضوء على مظاهر العنف داخل المؤسسة التعليمية و الذي بين أن العنف جاء بصفة انتقالية من المعلمين في المراحل الابتدائية إذ كان عنفا ممارسا من طرف المعلمين على التلاميذ ليصبح في المراحل المتقدمة عنفا ممارسا من طرف التلاميذ تجاه بعضهم وهو ما قابله رد فعل عنيف من قبل الإدارة التربوية والأساتذة خصوصا في المراحل الثانوية، والتي تتسم بمرور المتعلم في مرحلة المراهقة وما تعتريها من تغيرات سلوكية ونفسية وجسمانية تنعكس أيضا على سلوكه العنيف داخل المؤسسة [8]وبالتالي نكون أمام ظاهرة الانسياق تجاه الانحراف و الظواهر الاجرامية.
ونجد لهدا الطرح القائل بعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية تنظيرا فلسفيا نجمله في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: المدارس الفكرية المنظرة لعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية
إن محاولة الإجابة عن السؤال -لماذا يجرم المجرم.؟ - سواء كان راشدا أو حدثا جانحا وما علاقة المدرسة بالجريمة؟ وهل يمكن للمدرسة أن تجر الشخص للانحراف؟ يجرنا إلى السباحة في بحر النظريات المؤطرة لعلم الاجرام، وباستقرائنا لاهم النظريات الفلسفية التي تدرس الجريمة والمجرم فقد نتجاوز الحديث عن المدرسة البيولوجية بجميع تياراتها لنستقر في دراستنا على مدرسة الوسط الاجتماعي ومدرسة العوامل النفسية.
أولا: مدرسة الوسط الاجتماعي.
عاصرت مدرسة الوسط الاجتماعي نظريات المدرسة التكوينية، وكانت بذلك بمثابة رد فعل على آرائها التي اعتبرت متطرفة. [9]وقد تزعم هذا الاتجاه لا كاسني LA CASSAGNE أستاذ الطب الشرعي بمدينة ليون بفرنسا،
ويرجع لا كاساني دوافع الجريمة إلى الوسط الاجتماعي الذي يعد تربة صالحة لإنتاج الإجرام وفي نظره يعتبر المجرم شبيها بالميكروب، الذي لا يمكنه النمو إلا إذا توفرت الشروط الملائمة لذلك.[10]
إن مفهوم الوسط الاجتماعي يشمل العوامل الطبيعية، المناخية، والتكوينية والثقافية، إضافة إلى استهلاك المخدرات والإصابة ببعض الأمراض مثل السل والزهري.
ويرجع GABRIEL TARDE سبب السلوك الإجرامي إلى عامل الوسط الاجتماعي، إلا أنه قام بدراسة حجم ومدى تأثيره على الفرد، وكان أول من كشف عن نموذج المجرم المحترف، وفي نظر تارد، أن العدد الكبير من المجرمين لم يتلقوا أية تربية صالحة، بل تركوا للتأثيرات السلبية لثقافة الشارع، الذي اعتبره طارد مدرسة تلقن مبادئ الإجرام والانحراف بامتياز.
يستعرض طارد العوامل التي تؤثر في السلوك الإجرامي، فيتوقف عند المحيط الاجتماعي الذي يعتبره سببا مهما في تحديد هذا السلوك.
كما لفت انتباهه أن معظم المجرمين إنما عاشوا ومروا بطفولة تعيسة وأنهم عانوا من الحرمان العائلي ورقابة المحيط الأسري مما جعلهم يمتهنون الإجرام كوسيلة للعيش، وتركيزه على المجتمع بهذا الشكل جعل طارد لا يعير اهتماما للتكوين العضوي في تنمية وتعليل السلوك الإجرامي.[11]
وأهم مساهمات طارد هو بحثه المستمر عن الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجريمة والتي حصرها في تنشئة الفرد الاجتماعية ومعتقداته الثقافية ومحاكاته للآخرين، وذلك بدلا من الدخول في متاهات البحث عن أسبابا الجريمة ضمن العوامل المتعلقة بذات الجاني وسماته الطبيعية الجسدية، فعوامل انحراف الفرد وخروجه عن أنماط السلوك الاجتماعي إنما ترجع أساسا إلى عوامل يغلب عليها الطابع الاجتماعي، بل إن الإمكانيات والاختبارات الممنوحة والمتاحة للأفراد وحريتهم في التفضيل بين النهج السوي والنهج غير السوي تبقى هي المؤشر على استعداد بعض الأفراد وميولهم إلى اختيار طريق الجريمة.
ويعطي طارد وصفا دقيقا للمجرم القاتل حيث يصفه بأنه شخص عود نفسها منذ حداثة سنه على تخزين وتشرب جميع أنواع الحسد والكراهية مغلقا بذلك أبواب الرحمة والشفقة والعطف عن قلبه، كما مرن نفسه منذ الصغر على تقبل الصدمات وتحمل الشدائد ومختلف صنوف المعاناة، وعلى تبلد الحس والشفقة والرأفة لديه، مما يجعله يفقد جميع عناصر ومشاعر الرحمة نحو الآخرين، وبالتالي وكنتيجة لهذا التكوين البدني والنفسي - الاجتماعي ينمو هذا الفرد متحفزا لارتكاب الأفعال المميزة بالشر والعنف،[12]
وفي ختام استعراضنا لمضامين مدرسة الوسط الاجتماعي التي تركز على دور العوامل الاجتماعية في نمو الشخصية الاجرامية نجدها تتقاطع مع ما نلاحظه في المؤسسات التعليمية من تفشي ظواهر العنف سواء الجسدي او النفسي والذي غالبا ما يكون ناتجا عن خلفيات سابقة أي من مورس عليه العنف في الصغر سيسعى الى ان يمارس العنف على الاخرين إما لدوافع الانتقام أو أن ذلك التصرف يعده هو التصرف الصحيح إذن فالعوامل الاجتماعية يمكن أن تكون سببا في ظاهرة الانحراف و جنوح الاحداث ولا يمكننا فصل التنشئة داخل المدرسة عن العوامل الاجتماعية، إلا انها ليست الوحيدة التي تكون شخصية المجرم بل تتقاطع مع عوامل أخرى منها العوامل النفسية.
ثانيا: مدرسة العوامل النفسية.
أن فحوى هذه المدرسة هو البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم عن طريق تحليلها، لاسيما من حيث تأثير العوامل الاجتماعية والاضطرابات العاطفية والعلل والأمراض النفسية والتي يعد تحققها نتيجة للفاعل الاجتماعي أكثر مما هو نتيجة لعوامل الوراثة الطبيعية وذلك أنه لما كانت الجريمة من حيث الواقع ظاهرة اجتماعية وسلوكاً فردياً في نفس الوقت، فقد ظهر اتجاه جديد يتلاءم مع هذا الواقع فيضيف الى التكوين النفسي عوامل أخرى تدفع الى السلوك الاجرامي. فالجريمة تتحقق بالتفاعل الاجتماعي أكثر مما يلعبه العامل الوراثي.[13]
ونجد من أهم نظار المدرسة النفسية العالم سيكموند فرويد، حيث اعتمد في تقسيم النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام:
الذات، وهو ذلك الحيز من النفس الذي يعتبره فرويد مخزنا الميول الفطرية والنزعات الغريزية والاستعدادات الموروثة ... ويستقر كل ذلك في اللاشعور، والذات تتصرف إلى إخراج هذه الميول والرغبات إلى الظاهر، دون مبالاة بالقيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الذات تحتل ذلك الجانب السيء من النفس البشرية أو هي النفس الأمارة بالسوء.
الأنا، فهي تمثل النفس العاقلة التي تعمل على كبح جماح الذات. عاملة على إقامة الانسجام بين النزعات الغريزية، وما هو مقبول اجتماعيا حتى تعد سلوكا ترتضيه الجماعة لنفسها، وترضى عنه الأنا العليا، فإذا لم تتمكن عمدت إلى تصعيد النشاط الغريزي، أو إلى كبته في اللاشعور.
الأنا الأعلى، إذا لم تتمكن الأنا من كبح جماح الذات، تعمد إلى تصعيد النشاط الغريزي أو إلى كبته في اللاشعور. ومن الوسائل الأخرى التي قد تلجأ إليها الأنا للدفاع عن الأخطار الخارجية أو الداخلية.[14]
حقا، إن السلوك حسب فرويد سواء فيما يتعلق بطبيعته أو فيما يتعلق بطريقة تشكله تقتضي بداهة معرفة نوعية العلاقة الموجودة بين الأقسام الثلاثة المشار إليها أعلاه.
فإذا تغلب القسم الأول على القسمين الأخيرين، فإن السلوك سيكون سلوكا منحرفا، وإذا تغلبت الأقسام الأخيرة على القسم الأول فإننا نكون إزاء سلوك سوي.[15]
وبين (فروید) تفسيره للسلوك بأن الطفل يحمل نزعات غريزية تكون في البداية نزعات شعورية ثم ترتد إلى اللاشعور إثر اصطدامها بالبيئة لما تشمل من عادات وتقاليد واصول التربية.
وعليه فان كانت تربية الطفل قائمة على اسس متوازنة توافق بين الرغبات والميول وبين اصول التربية النفسية سيؤدي هذا الى تصعيد الرغبات بصورة صحيحة.
أما إذا كانت تربية الطفل قائمة على اسس غير سليمة لا توافق بين الرغبات واصول التربية فسيؤدي الى خلق حالة الكبت والمرض وتعرض الفرد مستقبلا للأمراض العصبية والاضطرابات النفسية مما يتسبب في نشأة العقد النفسية (كعقدة أوديب - اليكترا - النقص -التقمص - الذنب).[16]
وإننا لنجد لمضامين المدرسة النفسية جانبا الصحة في مقارنتها مع التقارير الدولية والوطنية التي تظهر أن العوامل النفسية قد تكون أكثر العوامل منطقية المسببة في الانحراف، حيث أن كيفية التعامل مع الأطفال في الوسط الدراسي ينعكس على شخصيتهم سواء بالسلب أو الايجاب فمتى ما كانت معاملة الاستاذ لتلامذته بنوع من الليونة والأخلاق انعكس ذلك على تعاملهم وتحصيلهم الدراسي والعكس صحيح.
من هنا يتضح جليا أن للمدرسة دور مهم في بناء شخصية الفرد داخل المجتمع وقادرة على ان تتخذ الوجهين إما أن تعكس صورة المدرسة السليمة التي تسعى الى تهذيب الاخلاق وتلقين التربية الحميدة والعادات السليمة وإما أن تعكس ولو عن غير قصد أو عن تهور جانبا مظلما يعمه الضغوط النفسية والمكبوتات تنعكس على أرض الواقع بإنشاء شخص عرضة للجنوح والانحراف،
فكيف يمكن للمدرسة أن تلعب دور الوقاية من الظاهرة الاجرامية؟
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية
لقد تعددت وظائف المدرسة وتعددت أدوارها بصفتها مؤسسة اجتماعية وتربوية وتعليمية تعمل على تنشئة الفرد واكسابه انماط السلوك المختلفة لذلك فإن المدرسة ليست فقط مكانا لتلقي مبادئ القراءة والكتابة بل يعتقد ان جوهر التربية والتعليم هو الوقاية من الجريمة وهو الامر الذي تسعى الدول المعاصرة الى تحقيقه من خلال بلورة كل ما يمكن للمدرسة ان تقدمه للفرد من تكوين علمي وسلوك واخلاقيات وقيم وثقافة تحول دون وقوع الفرد في الجريمة وجعله متشبعا بالقيم الإنسانية، وهذا ما سنحاول أن نعالجه في (الفقرة الأولى) من خلال تبيان دور مؤسسات التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية.
وفي ظل السياسة التقويمية العلاجية لا يمكننا أن نترك من وقع في كنف الانحراف وتهاوت به الاقدار الى غياهب السجن، عرضة لحالات العود، فلابد أن نضع خطط وبرامج تكوينية ودراسية خاصة بهؤلاء وهو ما تتكلف به المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وهو ما نعالجه في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دور مؤسسات التعليم العمومي في الوقاية من الظاهرة الاجرامية.
أنشئت المدرسة لتواجه حاجة اجتماعية ضرورية هي إعداد الأفراد للحياة الاجتماعية، والتي تعتبر عملية فردية اجتماعية، لما لها من انعكاسات ايجابية على الفرد نفسه ومجتمعه، في نفس الوقت والتربية أنواع كما جاءت عند جون لوك وهي:
التربية الجسمية، ترمي إلى تقوية الأبدان وحفظ نشاط الجسم.
التربية العقلية، تهدف إلى تزويد العقل بأنواع المعارف والعلوم.
التربية الخلقية، وتهدف إلى غرس الفضيلة في النفوس.[17]
من هذا المنطلق سنحاول تبيان دور المؤسسة التعليمية في الوقاية من الظاهرة الاجرامية من خلال الحديث عن التصدي للعنف المدرسي وبناء المشروع الشخصي للمتعلم،
وقد يعاتبنا البعض على إغفالنا الحديث عن الهدر المدرسي إلا أننا سنحاول أن نتطرق إليه في مضامين الفقرتين الاتيتين بشكل ضمني دون أن ننسى أن محاربة الهدر المدرسي يلقى أهمية بالغة تسعى الوزارة في خطوات جاهدة إلى إرسائها عبر فتح برنامج محو الامية وبرنامج الفرصة الثانية، والتربية غير النظامية...
أولا: التصدي للعنف المدرسي
يعتبر العنف ظاهرة عالمية تعاني منها معظم دول العالم، سواء المتقدمة منها أو التي في طريق النمو، والتي يمكن أن تمس جميع شرائح المجتمع خلال جميع مراحل حياتهم العمرية، مع الاشارة إلى أن الفئة الاكثر عرضة ليا هي فئة المراهقين الذين هم في طور التمدرس، إذ يشكل العنف في الوسط المدرسي تحديا كبيرا بالنسبة للتربية، والارتقاء بالفرد وتنمية المجتمع، فقصد الوقاية من إيذاء التلامذة وتعزيز المناخ المدرسي الذي يضمن الجودة والأمان، يتعين وضع تدابير فعالة لتحقيق ذلك. وهو ما أكدت عليه الوزارة في العديد من المذكرات وهي:
المذكرة رقم 2.15 المتعلقة ب التصدي للعنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي
المذكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي
المذكرة رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي
إن توالي صدور هذه المذكرات ما هو إلا دليل على استفحال هذه الظاهرة في الوسط المدرسي، وبدراستنا للمذكرة رقم 2.15 نلاحظ أنه يغلب عليها جانب الردع والتصدي على جانب الوقاية والعلاج وهو ما نلمسه في بعض بنوده نذكر منها:
''التعامل مع مختلف مظاهر وأشكال السلوكات العدوانية والمنحرفة بنفس الحزم المطلوب، سواء تعلق الأمر بالعنف الرمزي أو اللفظي أو البدني أو المادي، أو بالتحرش الجنسي، أو بالتعاطي للمخدرات، أو بغيرها من التصرفات والممارسات المشينة.
التعامل الفوري والحازم، من طرف النيابات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية، وإعمالها الحازم لمختلف الآليات الإدارية والقانونية المتاحة لها من أجل معالجة هذه الحالات.
إبلاغ مصالح الأمن والسلطات المحلية، بشكل فوري بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، أو التي يعاقب عليها القانون، مع تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع هذه المصالح، حتى تصبح المؤسسات التعليمية حصنا منيعا على كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والممتلكات.
تنصيب الإدارة لنفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية، وصونا لحرمة المنظومة التربوية، وتعزيزا لروح التضامن والتعاضد والتآزر داخلها'':[18]
وهذا الامر تكرر أيضا مع إصدار المذكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي التي أكدت أيضا على ما يلي:
انطلاقا من المبادئ السالفة الذكر، فإنه يتعين على مختلف المستويات الجهوية والإقليمية التحلي بأقصى درجات اليقظة والحزم والتفاعل الفوري من أجل معالجة جميع حالات العنف المدرسي، وفرض الضبط والانضباط بالمؤسسات التعليمية مع العمل على حث مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على الإعمال الفعال لمختلف التدابير المرتبطة بمحاربة العنف المدرسي، وفق نظرة منسجمة تستحضر طبيعة السلوك المرتكب، ومستوى التدخل اللازم للتصدي الفوري والفعال له.[19]
باستقراء هاتين المذكرتين نلاحظ أن العبارات المستعملة فيها تغلب عليها الطابع الزجري (التصدي، فرض الانضباط، محاربة، التصدي الفوري...) ونستنتج أن المقاربة التي كانت تنهجها الوزارة في التصدي لظاهرة العنف المدرسي هي مقاربة أمنية زجرية وتغيب إلى حد كبير المقاربة العلاجية ما عدى تنصيصها في بعض البنود على أهمية التوعية والإرشاد،
إلا ان المذكرة الأخيرة الصادرة عن الوزارة، رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي نلاحظ فيها نوعا من المرونة في استخدام الالفاظ التربوية والقيم النبيلة في التعامل مع العنف المدرسي والانحياز الى ما هو وقائي علاجي على حساب ما هو زجري حيث جاء فيها ما يلي:
''استحضارا للأدوار والوظائف النبيلة للمدرسة، باعتبارها فضاء للتعليم والتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم التفتح والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح، ومجالا لنشر ثقافة العيش المشترك والسلوك المدني والتصدي لجميع أشكال العنف، كيفما كان مصدره، وكيفما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي أو الرمزي أو المبني على النوع
واعتبارا لأهمية ونجاعة المقاربة الوقائية والتحسيسية في التصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي يشرفني أن أطلب منكم العمل على اتخاذ الإجراءات التالية لتفعيل هذه المقاربة... ''[20]
وبمقارنتنا لهذه المذكرات نلاحظ التطور الحاصل في المعاملة مع ظاهرة العنف واقتناع الوزارة بان السبيل الأنجع لمحاربتها هي من خلال تفعيل أدوار مدرسة التربية قبل مدرسة التعليم، أي بنهج سياسة استباقية وقائية خصوصا مع العنف الداخلي أي الصادر من داخل المؤسسة سواء عن طريق التلاميذ فيما بينهم أو عن طريق التلاميذ والاطر التربوية، وهذا ما نص عليه تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين حيث أكد أن مكافحة العقاب البدني، وهو شكل من أشكال العنف المستخدم من طرف بعض الأساتذة، من الأولويات، حيث لا يمكن بناء أي تعليم على الخوف والعقاب البدني، وأن هناك حاجة ماسة إلى تكوين وتدريب الأساتذة على التعامل مع السلوكات السلبية لبعض التلامذة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
ويشكل التكوين المناسب للأطر التربوية عنصرا أساسيا في التعامل الفعال مع العنف المدرسي إذ يمكن دمج المقاربات البيداغوجية في تكوين المديرين والأساتذة، لضمان تدبير أفضل وتعامل أنجع مع حالات العنف بين التلامذة. وكل هذا سيساعد في استباق بعض ردود الفعل العنيفة الصادرة عن الفاعلين التربويين وتبني أساليب لحل النزاعات بطرق سلمية، من أجل خلق بيئة تعليمية آمنة تساعد على تفتح التلامذة وتوفير أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تساهم في توجيه طاقة التلامذة بطريقة إيجابية وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم وتعزيز مناخ مدرسي مبني على الاحترام.[21]
حيث أقرت الوزارة ضرورة:
ثانيا: بناء المشروع الشخصي للمتعلم
يبدو الوعي بالعلاقة بين التعلم والمشروع الشخصي أو المهني، أمرا يتجاوز إدراك المتعلم، الذي غالبا ما يطرح السؤال “على المستوى الشخصي (ما الذي سأجنيه من التعلم بشكل خاص؟) وعلى المستوى المهني (ما الذي سيقدمه لي التعلم بالمدرسة، بخصوص توجيهي نحو مهنة وبخصوص الدراسات المواكبة لهذا التوجيه؟).[24]
وفي هذا الصدد فقد أصبح الوعي لدا الوزارة قائما على ضرورة مواكبة المتعلمين طيلة مسارهم الدراسي بغية توجيههم توجيها صحيحا يساعد في استكمالهم لمسارهم الدراسي ودمجهم في سوق الشغل أيضا، حيث أصدرت العديد من المذكرات أهمها:
القرار رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
المذكرة رقم 114.19 في شأن الاستاذ الرئيس في الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
المذكرة رقم 105.19 في شان الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
القرار رقم 07.22 في شان المصادقة على الإطار المرجعي للمواكبة التخصصية للمشروع الشخصي للمتعلم في الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
إن كثرة إصدار هذه القرارات والمذكرات ما دل إلا على أهمية هذا المشروع، فالمشروع الشخصي للمتعلم هي السيرورة التي ينخرط فيها المتعلم من أجل تحديد هدف مهني يطمح إلى تحقيقه، وتحديد المسارات الدراسية والتكوينية المؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة تعثره في الوصول إلى هذا المبتغى، وكل ذلك في إطار منطق تكامل استراتيجي بين الأداء الدراسي الماضي والحالي، وبين الطموحات والأهداف الدراسية والتكوينية والمهنية المستقبلية.
ويتدرج المشروع الشخصي للمتعلم عبر أربع مراحل تتم في فترات زمنية متفاوتة ومختلفة بحسب مستوى نضج ميول المتعلم، وهي مراحل مفصولة منهجيا، ومتداخلة إجرائيا، وهي:
مواكبة تربوية
تشمل مرحلة البناء والتوطيد دعم المتعلمين في تكاملهم في بيئة التعلم، وضمان نجاحهم في مساراتهم الدراسية. تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مساراتهم الشخصية واتخاذ القرارات التعليمية والمهنية المستقبلية.
وتشمل المواكبة التربوية مختلف الأنشطة المتعلقة بمعرفة الذات وتطوير قدراتها والانفتاح على المحيط الدراسي والتكوين المهني وتنمية الثقافة المقاولتية والحس الريادي والاعداد للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية.[26]
مواكبة تخصصية
تغطي مراحل البناء والتوطيد والتدقيق، وتشمل كلا من خدمة الإعلام المدرسي والمهني والجامعي، وخدمة الاستشارة، والتوجيه المدرسي، والمهني، والجامعي. وللمواكبة التخصصية وجهان مباشرة وغير مباشرة:
فبالنسبة للمواكبة المباشرة في تهتم ب بقديم خدمات الاعلام والتوجيه والاستشارة وتقديم المساعدة للمتعلمين بغيت تقويم مشاريعهم الشخصية
وبالنسبة للمواكبة غير المباشرة فتقوم على تعزيز بيئة العمل وذلك عن طريق الدعم التقني للمؤسسة وربط جسور للتنسيق والتواصل بين الأساتذة وأمهات وءاباء التلاميذ لتتبع مسار أولادهم داخل المؤسسة.[27]
مواكبة نفسية واجتماعية
وتقوم على رصد المتعلمين الذين قد يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، أو يظهرون سلوكات غير تربوية من شأنها أن تعيق تمدرسهم العادي وتحد من فرص نجاحهم الدراسي، ومن ثم تقلص فرص مواصلة مساراتهم الدراسية بنجاح ومن تحقيق مشاريعهم الشخصية،[28]
وبالنظر إلى ملفهم الشخصي، يوضع إطار مرجعي لتحديد معايير وصيغ التكيف الممكنة حسب كل نوع من أنواع المشاكل، كما توضع أطر مرجعية لتحديد ضوابط تقديم هذه الخدمات ومعايير جودتها مع تدبيرها اعتمادا على النظام المعلوماتي للوزارة وتيسير الاستفادة منها،
يعتمد بهذا الخصوص على خدمة الإعلام المدرسي والمهني والجامعي الذي يضع المعلومات الضرورية حول المسارات … رهن إشارة المتعلمين مع الحرص على إكساب المتعلمين كفاية الاستعلام الذاتي عوض الاعتماد على التلقي السلبي للمعلومات.[29]
من هذا كله يمكننا القول إن للمشروع الشخصي للتلميذ أهمية بالغة في تحديد مساره الدراسي والمهني وتوجيهه توجيها سليما بشكل يحيد به عن الوقوع في براثين الامراض النفسية والتشتت والخوف من المستقبل ولربما الاقتداء بمشاريع فاشلة ويجعل منها مسودة لمشروعه الشخصي وبالتالي يقع في معضلة الهدر المدرسي ولربما الانحراف.
إن بناء المشروع الشخصي للتلميذ ليس شيء وليد الصدفة بل هو ثمرة مجهود شخصي للتلميذ طيلة حياته فلربما تقع به الظروف ليجد نفسه بعيدا عن اسوار الدراسة ولربما يقع في طريق الانحراف أو خلف قضبان السجون فيحتاج الى تقويم جديد وهو ما تقوم به المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
الفقرة الثانية: دور المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في إعادة التأهيل الدراسي للنزلاء.
إذا كان التعليم حقا من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع فهو أيضا مكفول للسجناء بمجرد ولوجهم المؤسسة السجنية، فهو كذلك وسيلة من الوسائل التربوية التي لها بالغ الأثر في شخصيتهم. إذ يساهم في تهذيب سلوكهم، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية بصورة صحيحة.[30]
أولا: تفعيل برنامج محو الامية والتربية غير النظامية
يعتبر الجهل بالنتائج المترتبة عن ارتكاب جنحة أو جناية من أبرز العوامل التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب هذه الأفعال، لكونهم أميين أو من ذوي المستوى التعليمي الضعيف، وهو ما تعكسه المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالساكنة السجنية بشكل جلي، حيث لا تقل نسبة السجناء الأميين عن % 10.69 [31]من مجموع الساكنة السجنية.[32]
هذا المعطى دفع المندوبية العامة إلى مضاعفة جهودها في مجال محاربة ظاهرة الأمية في صفوف السجناء بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتنفيذ برنامجها المتعلق بمحو الأمية بالسجون على غرار البرنامج المعتمد بالمساجد، حيث ثم وضع برنامج "سجون بدون امية" بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهو برنامج يروم تكوين 11000 سجينا من الأمين المحكومين بشكل نهائي، ويعتمد على مبدأ التثقيف بالنظير من خلال تكون سجناء من طرف الوكالة المذكورة وحصولهم على شواهد تكونين في مجال محو الأمية وتأطيرهم لسجناء آخرين، وقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذا التكون 72 سجينا أشرفوا بدورهم على تكوين 2358 سجينا[33]، وفي هذا السياق فقد شهد الموسم الدراسي 2023.2022 استفادة ما مجموعه 7529 نزيل من دروس محو الامية،[34]
وهو ما يعكس توجه المديرية الى إعادة إصلاح الجانحين عن طريق ترسيخ قيم التعليم لديهم وإخراجهم من غياهب الجهل الى نور المعرفة من اجل عدم رجوعهم في حالة العود الى اسوار السجن فتعد هذه مقاربة علاجية ووقائية ناجعة.
ثانيا: تفعيل برامج التعليم بمختلف أطواره
تسهر المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على ضمان حق التعليم للسجناء المتوفرين على الشروط المطلوبة، بمختلف أطواره الإعدادي والثانوي، والجامعي:
فبالنسبة للمسلك الثانوي الإعدادي ومسالك الثانوي التأهيل يستفيد من برامج التعليم بجميع اسلاكه ثلاث فئات من السجناء:
الفئة الأولى هي فئة السجناء المسايرين، أي الذين كانوا يتابعون دراستهم بأحد الفصول الدراسية قبل اعتقالهم وكذا الحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو الإعدادية والذين تتوفر فيهم شروط القطاع الوصي، وهؤلاء يتم إلحاقهم مباشرة من العلم أن هذه المدرسة تابعة للخريطة التربوية ويشرف عليها منسق تربوي.
الفئة الثانية: هي فئة النزلاء المرشحين الأحرار المنقطعون عن الدراسة الراغبون في اجتياز الامتحانات الإشهادية بأحد الأسلاك التعليمية.
الفئة الثالثة وهي فئة المسجلين بالبرامج التعليمية غير المسايرين الذين يتم تسجيلهم ببرامج التعليم بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على أقسام دراسية، بعد البت في طلباتهم من طرف لجنة الانتقاء وفق المعايير والشروط المطلوبة للتسجيل تبعا للمقاعد الدراسية الشاعرة[35]
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء المسجلين ببرامج التعليم موسم الموسم الدراسي 2022/2023 هو: 6987[36] تزيل ونزيلة وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة ب السنوات الفارطة وهذه النتائج جاءت حصيلة الجهود المتظافرة لتحقيق مؤشرات جد إيجابية.
أما بخصوص السلك الجامعي يتم تسجيل المعتقلين الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمختلف كليات المملكة تبعا للقسم الجغرافي المعتمد لهذا الشأن ووفق الشروط التي تضعها الكليات المعنية، كما يستفيد منها السجناء الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية واعتقلوا والدين وافقت إدارة الكلية التي ينتسبون إليها على إعادة تسجيلهم.
وتساعد الإدارة المركزية. المعتقلين على التسجيل بالكليات التي تقوم بدورها، بإنشاء لجان من اجل الإشراف على الامتحانات داخل المؤسسات السجنية، كما تضع رهن إشارة الطلبة المعتقلين الكتب والمراجع التي تعينهم على متابعة دراستهم، كما يتم ربط الاتصال بين المؤسسات والكليات الموجودة في دائرتها، وخاصة الأساتذة الجامعيين للإشراف على البحوث الجامعية للمعتقلين المطالبين بإنجازها،[37]
ثالثا: تفعيل برامج التكوين المهني والحرفي.
كشف تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2017، عن تجاوب الساكنة السجنية مع برنامج التكوين المهني التي تقوم بها المندوبية في إطار تشاركي مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية، فقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني خلال الموسم التكويني 2022.2023 ما مجموعه 8113 مستفيدا و734 مستفيدا من برنامج التكوين الفلاحي.[38]
ومن جانب آخر، قامت المندوبية العامة بإطلاق برنامج "فرصة وابداع" بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الحرفية والفنية، وقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذا البرنامج491 سجينا في نسخته الأولى، منهم 69 نزيلة و 8 نزلاء من أصول افريقية، وقد سلمت شهادات المشاركة للسجناء المستفيدين في اطار هذا البرنامج في أفق إدماج البعض منهم كمؤطرين داخل الوحدات الإنتاجية التي تم إحداثها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما استفاد 169 سجينا من التشغيل في هذه الورشات [39]
وفي الأخير يمكننا القول إن الانسياق في طريق الانحراف ليس هو دمار للإنسان بل هو فرصة لتجديد حياته وفرصة لإعادة تقويم مشروعه الشخصي أو بنائه من جديد وفق توجيه محكم ونظرة أخرى أكثر شمولا وأكثر وضوحا تجعل من الشخص الجانح فاعلا في المجتمع.
خاتمة:
بناء على ما سبق نستنتج أن هناك علاقة مضطردة بين التعليم والظاهرة الاجرامية أي أن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادل، فمتى ما كانت المؤسسة التعليمية فضاء للرتابة والعنف في التلقين وفضاء غير مناسب للعملية التعليمية التعلمية سواء على المستوى البنيوي أي بنية المؤسسة أو على المستوى الوظيفي أي ما تقدمه المؤسسة من تعلمات نكون أمام آفات خطيرة في المجتمع منها الهدر المدرسي والعنف مما يؤدي لا محالة الى الوقوع في الجريمة.
وعلى النقيض من ذلك فمتى ما كانت المؤسسة التعليمية فضاء للتعليم الجيد وجعل الأستاذ قدوة حسنة للتلاميذ وبناء شخصيتهم بشكل جيد يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والاستقرار النفسي عبر انماء الحسن الوطني والانتماء للجماعة عبر تتبع الطفل من مراحله الأولى من خلال بناء مشروعه الشخصي، نكون أمام فرد صالح للمجتمع وقادر على إصلاحه وبذلك تكون المؤسسة التعليمية فضاء للتقليل من الوقوع في الظاهرة الاجرامية.
وهذا الطرح هو ما تحاول الوزارة الوصية على القطاع أن ترسخه داخل المؤسسات التعليمية عبر إقرار العمل بالمشروع الشخصي للتلميذ وإقرار وسائل بديلة تربوية للتعامل مع العنف المدرسي و الهدر المدرسي، دون ان تقف على هذا الحد بل وفي إطار مبدأ التعلم مدى الحياة وفي كل الظروف فإن التعليم يتخذ صيغة التقويم والعلاج من الظاهرة الاجرامية وهو ما تجسده المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عبد إقرار برامج لمحو الامية واستكمال الدراسة سواء النظامية و غير النظامية و كذا فتح فرص للولوج الى التكوين المهني والفلاحي. بغية جعل التعليم وسيلة توعية للفرد من أجل عدم الوقوع مجدد في حالات العود وجعله فردا صالحا داخل المجتمع.
لائحة المراجع.
الفهرسة.
تقديم: 1
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية. 2
الفقرة الأولى: علاقة المدرسة بالظاهرة الاجرامية. 2
أولا دراسة في الهدر المدرسي وعلاقته بالانحراف. 3
ثانيا: دراسة في أسباب العنف المدرسي. 4
الفقرة الثانية: المدارس الفكرية المنظرة لعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية. 7
أولا: مدرسة الوسط الاجتماعي. 8
ثانيا: مدرسة العوامل النفسية. 9
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية. 11
الفقرة الأولى: دور مؤسسات التعليم العمومي في الوقاية من الظاهرة الاجرامية. 12
أولا: التصدي للعنف المدرسي. 12
ثانيا: بناء المشروع الشخصي للمتعلم 16
الفقرة الثانية: دور المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في إعادة التأهيل الدراسي للنزلاء. 19
أولا: تفعيل برنامج محو الامية والتربية غير النظامية. 19
ثانيا: تفعيل برامج التعليم بمختلف أطواره 20
ثالثا: تفعيل برامج التكوين المهني والحرفي. 21
خاتمة: 22
لائحة المراجع. 23
الفهرسة. 25
إن الجريمة ظاهرة اجتماعية توجد حيث يوجد المجتمع وهي قديمة قدم التاريخ لا تزول الا بزواله، ووظيفة القانون هي ان يبين لكل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وبالتالي فوظيفته الأساسية هي تنظيم المجتمع تنظيما يحقق صيانة حريات الافراد ومصالحهم من جهة ويحفظ كيان المجتمع بإقرار النظام فيه وكفالة المصلحة العامة من جهة أخرى.
إلا ان استفحال الظاهرة الاجرامية في المجتمع وتنوعها وظهور فئات جديدة من الجرائم وهي جرائم الاحداث جعل من الصعب تطبيق القانون بصيغته الزجرية، وجعلنا نتساءل لماذا يجرم المجرم؟ وبدراسة بسيطة لعلم الاجرام نجمع على أن الظاهرة الاجرامية هي ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو اجتماعي علائقي وما هو نفسي وجداني وما هو سلوكي مكتسب، مما يجعلنا عاجزين عن تطبيق مفهوم الردع لمحاربة الظاهرة الاجرامية، وأصبح معه التفكير لدا علماء الاجرام منصبا على البحث في أسباب الجريمة لمعرفة طرق علاجها أو الاصح طرق التقليل منها.
وتعد المدرسة ذلك الفضاء الذي ينتقل اليه الطفل منذ نعومة أظافرة ليكتسب مبادئ المعرفة والتربية، حيث تحتل مكانة أساسية في بناء شخصية الطفل، لذا فالمدرسة تتحمل المسؤولية في تنشئته وتلعب دورا هاما في بناء شخصية ذلك الطفل في المستقبل، إذ يمكننا اعتبارها اللبنة الثانية بعد الاسرة في بناء الفرد داخل المجتمع فمتى ما كانت التنشئة قويمة أنتجت لدينا مجتمعا خاليا من الظواهر المنحرفة ومنها الجريمة،
ومن هنا تبدو العلاقة وطيدة بين الجريمة والمدرسة، وقد جاء طرحنا هذا لتبيان مكامن هذه العلاقة محاولين أن نوضح من خلال إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يمكن أن تساهم المدرسة في التقليل من الظاهرة الاجرامية؟
أي كيف يمكن للمدرسة أن تكون أولا سببا محتما في الانحراف وعلى النقيض، كيف يمكن لها ان تكون سببا في الوقاية من الانحراف؟ وهل يلعب التعليم دورا وقائيا من الجريمة؟ وهل يمكن له أن يكون له دور علاجي تقويمي بعد ارتكاب الجريمة؟
كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من خلال منهج تحليلي معتمدين التصميم التالي:
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية
إن التعليم هو سبب تطور الأمم ونهضتها، وهو سبب أيضا في هلاكها وتدهورها، فهي من العوامل الاساسية المؤثرة في صنع الانسان سواء كان ذلك عن طريق تحصيله العلمي او عن طريق مخالطته مع الأصدقاء في محيطه الدراسي، وإذا نظرنا الى اغلب مرتكبي الجرائم نجدهم من فئات عانت الفشل الدراسي أو الأمية أو الترسب أو الانحراف، وهذا الانحراف غالبا ما يكون ذا علاقة وطيدة بالمؤسسة التعليمية، فكيف يمكن للمؤسسة التعليمية أن تساهم في استفحال الظاهرة الاجرامية؟ أو بتعبير ءاخر هل تساهم المدرسة بشكل أو بآخر في انحراف الاحداث وتوجههم نحو الوقوع في الجرائم؟
إنه لمن الصعب تصور ذلك، لما تكتسيه المؤسسة التعليمية من مكانة مرموقة في المجتمع، وما تلقنه من قيم سامية للتلاميذ طيلة فترة تمدرسهم إلا ان الواقع يفرض نفسه، فنجد أن المؤسسة لها دور في صناعة مجرمي الغد بطريقة أو بأخرى وهو ما سنعالجه في (الفقرة الأولى)
وإننا باستقرائنا لمختلف النظريات الفكرية المنظرة لعلم الاجرام فإننا نجد تأصيلا فقهيا لعلاقة الظاهرة الاجرامية بالتعليم أو بالمؤسسة التعليمية، وهو ما نعالجه بالدراسة والتحليل في (الفقرة الثانية.)
الفقرة الأولى: علاقة المدرسة بالظاهرة الاجرامية.
إن المدرسة هي المجتمع الأصل الذي ينضم إليه الطفل بعد فترة طفولته الأولى التي يقتصر فيها على مجتمع الأسرة، وهي المكان الذي يمضي الحدث فيه جانبا كبيرا من يومه، تكون له فيه علاقات مع أساتذته ورفاقه، كما أنه يتلقى بها معلومات ودراسات تكون له عونا على شق طريق شريف لحياته في مستقبل أيامه، فإن سلوكه يتأثر بعدة عوامل تتعلق بالناحيتين الدراسية والتهذيبية.[1] فلا بد له من الولوج إليها و تلقي السلوك الحسن وقيم المواطنة، إلا أن عدم الولوج الى المدرسة يعد آفة خطيرة تسري بالحدث الى طريق الانحراف، وكذا إذا ما ولج الى المدرسة وتلقى معاملة مشحونة بالضغينة والبغضاء فسيكون المحيط المدرسي سببه الى سلوك طريق الانحراف.
أولا دراسة في الهدر المدرسي وعلاقته بالانحراف.
هذه شهادة لتلميذ سابق استقاها من أحد أصدقائه في الحي:''رغم أني كنت أحب الدراسة، إلا أني انقطعت عنها مبكرا دون أن أتجاوز مرحلة التعليم الابتدائي، توفيت والدتي في سن الرابعة، تزوج أبي امرأة أخرى، حاولت منحي الحنان، لكنه لن يصل إلى حنان الأم المفقود، ولا إلى قسوة الوالد الموجود، كان أبي في مشاداة لا تنتهي معي ومع زوجته، مشاداة لم يسلم منها حتى إخوتي البنات البالغ عددهن ثلاثة، والمال في أغلب الأحيان هو سبب هذا النزاع، فهو يرفض شراء الملابس والكتب بدعوى قلة ذات اليد، بدأت أحس أنه يكرهنا، وشيئا فشيئا بدأ تركيزي يقل، فتعذر بالتالي فهمي للدروس مما دفعني إلى الخروج من المدرسة؛
خارج أسوار المدرسة وجدت الضياع مع الإحساس بالغربة والوحدة بين أهلي، فكرت في الاشتغال بالمقاهي، تعرضت للاستغلال والقسوة من أرباب الشغل الذين لا يتوانون في تكليفي بمهام تفوق قدراتي الجسمية تعرفت على أصدقاء يتعاطون المخدرات، بدأوا يعترضون سبيل المارة ويعتدون عليهم، لم ترضني هذه التصرفات... ختم هذا الطفل حديثه لصديقه بتوجيه نداء إلى المجتمع من أجل إنقاذه وتقديم يد العون له. ''[2]
استأثرت ان ابدأ بهذه القصة لكي أبين كيف للهدر المدرسي من عواقب وخيمة على سلوكيات الفرد، وقد يقول قائل إن سبب الطفل في الهدر المدرسي هو الاب، من جهة نعم ومن جهة أخرى فهي مسؤولية الدولة بمقتضى دستور2011 حيث نص بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”
ونجد للهدر المدرسي أسباب تربوية أخرى منها:
- ضعف قدرة بعض التلاميذ على مواكبة وتيرة الدراسة؛
- سوء العلاقة بين المعلم والمتعلم؛
- غياب الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية؛
- عدم جاذبية الفضاء المدرسي وقلة الأنشطة المدرسية والترفيهية؛
- حالات الغياب المتكررة لدى بعض المدرسين، والتي تعود في الغالب إلى ظروف العمل الصعبة ولاسيما بالوسط القروي؛[3]
ثانيا: دراسة في أسباب العنف المدرسي.
تعد المدرسة تلك الفضاء الذي ينتقل اليه الطفل من حنان حضن الام الى عالم متغير حيث يجد نفسه في أقسام دراسية مع الكثير من الغرباء عوض إخوانه، ومعلم عوض أمه، مما يجعله في محطة صراعه الأولى في الحياة وهي صراع الاندماج، وهنا بالتحديد تبدأ معالم التعثر عند الحدث عندما لا يجد مؤازرة سواء من طرف المعلم او الأطفال حوله، بشكل يسهل عليه الاندماج في محيطه الجديد، وهو ما ينعكس على بناء شخصيته السليمة، ويصبح معها الطفل يميل الى الانطوائية والعنف والحقد وجميع العقد النفسية التي قد تكون مكتسبة بالأساس من التعامل الخاطئ من الوهلة الأولى مع المحيط الدراسي، ويتطور الانحراف لدى التلاميذ مع تطور المستوى الدراسي وتطور البنية الجسدية والنفسية لدى التلاميذ بداية من التعليم الأولى مرورا بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وما بعده مما يساهم في جعل ذلك الطفل عرضة للانحراف.
فنجد أن الاطفال يجعلون من الروضة والمعلمة بديلا عن منازلهم واسرهم، فعندما يفكرون بان يجلبوا هدايا لمعلماتهم فان تفكيرهم هذا لم يأتي من فراغ انما من مدى تلمسهم لحب معلماتهم وهو سلوك لا يتوفر في شخصيات بعض المعلمات اللواتي لا تجمعهن مع الطلاب او الاطفال سوى المعلومات التي يحاولن تمريرها للطلاب،
ونقارن هنا بين طالب يصاب بوعكة صحية ولا يذهب لمدرسته فتبادر معلمته بالاتصال بوالدته للاطمئنان عليه وتطلب الحديث مع طالبها لتعبر له بكلمات تفرحه عن افتقادها له،
ومعلمة تتابع تقدم طالب بعد ان كان يعاني من ضعف ما في مادة دراسية وعندما يتمكن من احراز تقدم ملحوظ تصفق له امام زملائه بالصف تقديرا منها على ما انجزه.
وفي المقابل هناك معلمات منذ اللحظة التي يدخلن بها للصفوف لا يتوقفن عن الصراخ وبث الخوف في نفوس الطلاب او ينتهجن سلوكيات خاطئة مع الطلاب كالعقاب غير المبرر فتأخذ العلاقة التي تجمعهم بطلابهم شكلا غير سوي لأنهم لا يجدون مبررا لسلوكيات، لا تتسم الا بالعنف اللفظي والسلوكي.[4]
دون أن نغفل على العنف الجسدي الذي لازال سائدا في أوساط المدارس حيث، أن العقاب البدني لا يزال مستخدما على نطاق واسع في المدارس في أجزاء كثيرة من العالم بما يتبعه من عواقب وخيمة. وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، فإن نصف الطلاب على الصعيد العالمي ممن تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما، أي نحو 150 مليون طالب، أبلغوا عن تعرضهم للعنف في المدرسة وحولها. فيما يُعاني أكثر من طالب واحد من كل ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13-15 عاما من التنمر.[5]
وهده الإساءة تكون مؤذية على عدة أصعدة. أولًا، قد تجعل الاطفال يشعرون بأنّهم يقومون بأمر خاطئ، أو أنّهم يعانون من مشكلة ما، حتى لمجرّد تعبيرهم عن نفسهم. ثانيًا، تجعلهم يقلقون حول نظرة الناس إليهم، مما يولّد لديهم الشعور بالحذر والخجل ويفقدهم حريّة التعبير. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى الحدّ من حريّتهم، ويجعلهم دائمي القلق من مراقبة الناس لما يقومون به، وتتشكل لديهم عقد نفسية منها: عقدة الذنب، الخجل والانطوائية: القلق الدائم، الفوقية أو الدونية...[6]
إن مثل هذه العقد النفسية التي تنمو مع الطفل طول مساره الدراسي تنعكس سلبا على تحصيله الدراسي حيث تنقص ليه القدرة على التحصيل والاستيعاب والاحساس بالفشل أمام أصدقائه والخوف من إبداء الرأي هربا من استهزاء أصدقائه فتتشكل له هواجس نفسية وقيود يمكن أن يعبر عليها إما بالانطوائية او بالتعصب والحقد على المجتمع مما يجعل منه يميل الى العدوانية وتفريغ شحناته الداخلية على زملائه وأصدقائه بغية إشباع رغباته الداخلية و حبا في الظهور للعلن، وهو ما يفسر تلك الظواهر المشينة في الوسط المدرسي من قبيل العنف المدرسي و التنمر أو الانسياق لأشياء أكثر خطورة منها استعمال المخدرات والهدر المدرسي.
ولابد لنا هنا أن نشير الى مضامين التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي حيث جاء فيه ما يلي:
(يبرز البحث الميداني التجليات المختلفة للإيذاء التي صرح بها التلامذة، فتعتبر أعمال العنف اللفظي مثل السخرية والنبز بالألقاب، والشتائم ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية، لقد صرح ما يناهز ثلث تلامذة الابتدائي أنهم نبروا بألقاب مهينة، وأكد 55.9% من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية، والشتائم بدرجات مختلفة.
كما بين البحث الميداني حضور العنف الجسدي في الوسط المدرسي، إذ صرح 25.2% من التلامذة المستجوبين بالسلك الابتدائي أنهم كانوا ضحايا للضرب، و % 28.5 تعرضوا للدفع؛ أما في مؤسسات التعليم الثانوي، فقد صرح % 25.3 من التلامذة أنهم تعرضوا للضرب، و37.4% منهم تعرض للدفع بقصد الأذى. ويتبين أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث.
علاوة على ذلك، يتعرض التلامذة لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستلاء على أغراضهم الشخصية. كما يتبين من خلال هذه الدراسة، أن هذه الأنواع من العنف منتشرة، وهي تعني على التوالي: %27.1 و % %38.6 من تلامذة الابتدائي والثانوي. أما السرقة تحت التهديد وإتلاف الأغراض الشخصية فهي تعني الذكور والإناث بنسب مماثلة على العموم. أضف إلى ذلك أن % 61.7% من تلامذة الثانوي الإعدادي و%70.3 من تلامذة الثانوي التأهيلي صرحوا أنهم سبق وكانوا شاهدين على أعمال تخريب المعدات المدرسية ارتكبها التلامذة. كما يتبين من خلال النتائج أن تلامذة المؤسسات الخصوصية الحضرية أقل عرضة للسرقة تحت التهديد مقارنة مع زملائهم في المدارس العمومية الحضرية.
كما بينة الدراسة أنه في المدارس الابتدائية، تصدر عدة أنواع من العنف اللفظي والبدني على يد أشخاص مختلفين، فمثلا مرتكبو أعمال العنف هم أساسا الذكور، ولكن سبق وصرح بعض التلامذة أنهم تعرضوا لأعمال عنف ارتكبها في حقهم الأساتذة. أما في التعليم الثانوي، فالتلامذة هم مرتكبو أعمال العنف اللفظي والرمزي، يأتي بعدهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة، ومجموعات الشباب في محيطها، والأطر التربوية، ثم، بشكل أقل، الآباء والأمهات وأولياء الأمور. فيتبين أن التلامذة عرضة لأنواع مختلفة من العنف من طرف فاعلين متعددين في المدرسة، كما أن أعمال العنف التي يرتكبها أشخاص من خارج المؤسسة أقل وتيرة، إلا أنها أكثر حضورا في الوسط القروي.)[7]
إن هدا التقرير الذي عرى عن واقع المؤسسة التعليمية بالمغرب والذي سلط الضوء على مظاهر العنف داخل المؤسسة التعليمية و الذي بين أن العنف جاء بصفة انتقالية من المعلمين في المراحل الابتدائية إذ كان عنفا ممارسا من طرف المعلمين على التلاميذ ليصبح في المراحل المتقدمة عنفا ممارسا من طرف التلاميذ تجاه بعضهم وهو ما قابله رد فعل عنيف من قبل الإدارة التربوية والأساتذة خصوصا في المراحل الثانوية، والتي تتسم بمرور المتعلم في مرحلة المراهقة وما تعتريها من تغيرات سلوكية ونفسية وجسمانية تنعكس أيضا على سلوكه العنيف داخل المؤسسة [8]وبالتالي نكون أمام ظاهرة الانسياق تجاه الانحراف و الظواهر الاجرامية.
ونجد لهدا الطرح القائل بعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية تنظيرا فلسفيا نجمله في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: المدارس الفكرية المنظرة لعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية
إن محاولة الإجابة عن السؤال -لماذا يجرم المجرم.؟ - سواء كان راشدا أو حدثا جانحا وما علاقة المدرسة بالجريمة؟ وهل يمكن للمدرسة أن تجر الشخص للانحراف؟ يجرنا إلى السباحة في بحر النظريات المؤطرة لعلم الاجرام، وباستقرائنا لاهم النظريات الفلسفية التي تدرس الجريمة والمجرم فقد نتجاوز الحديث عن المدرسة البيولوجية بجميع تياراتها لنستقر في دراستنا على مدرسة الوسط الاجتماعي ومدرسة العوامل النفسية.
أولا: مدرسة الوسط الاجتماعي.
عاصرت مدرسة الوسط الاجتماعي نظريات المدرسة التكوينية، وكانت بذلك بمثابة رد فعل على آرائها التي اعتبرت متطرفة. [9]وقد تزعم هذا الاتجاه لا كاسني LA CASSAGNE أستاذ الطب الشرعي بمدينة ليون بفرنسا،
ويرجع لا كاساني دوافع الجريمة إلى الوسط الاجتماعي الذي يعد تربة صالحة لإنتاج الإجرام وفي نظره يعتبر المجرم شبيها بالميكروب، الذي لا يمكنه النمو إلا إذا توفرت الشروط الملائمة لذلك.[10]
إن مفهوم الوسط الاجتماعي يشمل العوامل الطبيعية، المناخية، والتكوينية والثقافية، إضافة إلى استهلاك المخدرات والإصابة ببعض الأمراض مثل السل والزهري.
ويرجع GABRIEL TARDE سبب السلوك الإجرامي إلى عامل الوسط الاجتماعي، إلا أنه قام بدراسة حجم ومدى تأثيره على الفرد، وكان أول من كشف عن نموذج المجرم المحترف، وفي نظر تارد، أن العدد الكبير من المجرمين لم يتلقوا أية تربية صالحة، بل تركوا للتأثيرات السلبية لثقافة الشارع، الذي اعتبره طارد مدرسة تلقن مبادئ الإجرام والانحراف بامتياز.
يستعرض طارد العوامل التي تؤثر في السلوك الإجرامي، فيتوقف عند المحيط الاجتماعي الذي يعتبره سببا مهما في تحديد هذا السلوك.
كما لفت انتباهه أن معظم المجرمين إنما عاشوا ومروا بطفولة تعيسة وأنهم عانوا من الحرمان العائلي ورقابة المحيط الأسري مما جعلهم يمتهنون الإجرام كوسيلة للعيش، وتركيزه على المجتمع بهذا الشكل جعل طارد لا يعير اهتماما للتكوين العضوي في تنمية وتعليل السلوك الإجرامي.[11]
وأهم مساهمات طارد هو بحثه المستمر عن الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجريمة والتي حصرها في تنشئة الفرد الاجتماعية ومعتقداته الثقافية ومحاكاته للآخرين، وذلك بدلا من الدخول في متاهات البحث عن أسبابا الجريمة ضمن العوامل المتعلقة بذات الجاني وسماته الطبيعية الجسدية، فعوامل انحراف الفرد وخروجه عن أنماط السلوك الاجتماعي إنما ترجع أساسا إلى عوامل يغلب عليها الطابع الاجتماعي، بل إن الإمكانيات والاختبارات الممنوحة والمتاحة للأفراد وحريتهم في التفضيل بين النهج السوي والنهج غير السوي تبقى هي المؤشر على استعداد بعض الأفراد وميولهم إلى اختيار طريق الجريمة.
ويعطي طارد وصفا دقيقا للمجرم القاتل حيث يصفه بأنه شخص عود نفسها منذ حداثة سنه على تخزين وتشرب جميع أنواع الحسد والكراهية مغلقا بذلك أبواب الرحمة والشفقة والعطف عن قلبه، كما مرن نفسه منذ الصغر على تقبل الصدمات وتحمل الشدائد ومختلف صنوف المعاناة، وعلى تبلد الحس والشفقة والرأفة لديه، مما يجعله يفقد جميع عناصر ومشاعر الرحمة نحو الآخرين، وبالتالي وكنتيجة لهذا التكوين البدني والنفسي - الاجتماعي ينمو هذا الفرد متحفزا لارتكاب الأفعال المميزة بالشر والعنف،[12]
وفي ختام استعراضنا لمضامين مدرسة الوسط الاجتماعي التي تركز على دور العوامل الاجتماعية في نمو الشخصية الاجرامية نجدها تتقاطع مع ما نلاحظه في المؤسسات التعليمية من تفشي ظواهر العنف سواء الجسدي او النفسي والذي غالبا ما يكون ناتجا عن خلفيات سابقة أي من مورس عليه العنف في الصغر سيسعى الى ان يمارس العنف على الاخرين إما لدوافع الانتقام أو أن ذلك التصرف يعده هو التصرف الصحيح إذن فالعوامل الاجتماعية يمكن أن تكون سببا في ظاهرة الانحراف و جنوح الاحداث ولا يمكننا فصل التنشئة داخل المدرسة عن العوامل الاجتماعية، إلا انها ليست الوحيدة التي تكون شخصية المجرم بل تتقاطع مع عوامل أخرى منها العوامل النفسية.
ثانيا: مدرسة العوامل النفسية.
أن فحوى هذه المدرسة هو البحث عن عوامل الجريمة في شخصية المجرم عن طريق تحليلها، لاسيما من حيث تأثير العوامل الاجتماعية والاضطرابات العاطفية والعلل والأمراض النفسية والتي يعد تحققها نتيجة للفاعل الاجتماعي أكثر مما هو نتيجة لعوامل الوراثة الطبيعية وذلك أنه لما كانت الجريمة من حيث الواقع ظاهرة اجتماعية وسلوكاً فردياً في نفس الوقت، فقد ظهر اتجاه جديد يتلاءم مع هذا الواقع فيضيف الى التكوين النفسي عوامل أخرى تدفع الى السلوك الاجرامي. فالجريمة تتحقق بالتفاعل الاجتماعي أكثر مما يلعبه العامل الوراثي.[13]
ونجد من أهم نظار المدرسة النفسية العالم سيكموند فرويد، حيث اعتمد في تقسيم النفس البشرية إلى ثلاثة أقسام:
الذات، وهو ذلك الحيز من النفس الذي يعتبره فرويد مخزنا الميول الفطرية والنزعات الغريزية والاستعدادات الموروثة ... ويستقر كل ذلك في اللاشعور، والذات تتصرف إلى إخراج هذه الميول والرغبات إلى الظاهر، دون مبالاة بالقيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الذات تحتل ذلك الجانب السيء من النفس البشرية أو هي النفس الأمارة بالسوء.
الأنا، فهي تمثل النفس العاقلة التي تعمل على كبح جماح الذات. عاملة على إقامة الانسجام بين النزعات الغريزية، وما هو مقبول اجتماعيا حتى تعد سلوكا ترتضيه الجماعة لنفسها، وترضى عنه الأنا العليا، فإذا لم تتمكن عمدت إلى تصعيد النشاط الغريزي، أو إلى كبته في اللاشعور.
الأنا الأعلى، إذا لم تتمكن الأنا من كبح جماح الذات، تعمد إلى تصعيد النشاط الغريزي أو إلى كبته في اللاشعور. ومن الوسائل الأخرى التي قد تلجأ إليها الأنا للدفاع عن الأخطار الخارجية أو الداخلية.[14]
حقا، إن السلوك حسب فرويد سواء فيما يتعلق بطبيعته أو فيما يتعلق بطريقة تشكله تقتضي بداهة معرفة نوعية العلاقة الموجودة بين الأقسام الثلاثة المشار إليها أعلاه.
فإذا تغلب القسم الأول على القسمين الأخيرين، فإن السلوك سيكون سلوكا منحرفا، وإذا تغلبت الأقسام الأخيرة على القسم الأول فإننا نكون إزاء سلوك سوي.[15]
وبين (فروید) تفسيره للسلوك بأن الطفل يحمل نزعات غريزية تكون في البداية نزعات شعورية ثم ترتد إلى اللاشعور إثر اصطدامها بالبيئة لما تشمل من عادات وتقاليد واصول التربية.
وعليه فان كانت تربية الطفل قائمة على اسس متوازنة توافق بين الرغبات والميول وبين اصول التربية النفسية سيؤدي هذا الى تصعيد الرغبات بصورة صحيحة.
أما إذا كانت تربية الطفل قائمة على اسس غير سليمة لا توافق بين الرغبات واصول التربية فسيؤدي الى خلق حالة الكبت والمرض وتعرض الفرد مستقبلا للأمراض العصبية والاضطرابات النفسية مما يتسبب في نشأة العقد النفسية (كعقدة أوديب - اليكترا - النقص -التقمص - الذنب).[16]
وإننا لنجد لمضامين المدرسة النفسية جانبا الصحة في مقارنتها مع التقارير الدولية والوطنية التي تظهر أن العوامل النفسية قد تكون أكثر العوامل منطقية المسببة في الانحراف، حيث أن كيفية التعامل مع الأطفال في الوسط الدراسي ينعكس على شخصيتهم سواء بالسلب أو الايجاب فمتى ما كانت معاملة الاستاذ لتلامذته بنوع من الليونة والأخلاق انعكس ذلك على تعاملهم وتحصيلهم الدراسي والعكس صحيح.
من هنا يتضح جليا أن للمدرسة دور مهم في بناء شخصية الفرد داخل المجتمع وقادرة على ان تتخذ الوجهين إما أن تعكس صورة المدرسة السليمة التي تسعى الى تهذيب الاخلاق وتلقين التربية الحميدة والعادات السليمة وإما أن تعكس ولو عن غير قصد أو عن تهور جانبا مظلما يعمه الضغوط النفسية والمكبوتات تنعكس على أرض الواقع بإنشاء شخص عرضة للجنوح والانحراف،
فكيف يمكن للمدرسة أن تلعب دور الوقاية من الظاهرة الاجرامية؟
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية
لقد تعددت وظائف المدرسة وتعددت أدوارها بصفتها مؤسسة اجتماعية وتربوية وتعليمية تعمل على تنشئة الفرد واكسابه انماط السلوك المختلفة لذلك فإن المدرسة ليست فقط مكانا لتلقي مبادئ القراءة والكتابة بل يعتقد ان جوهر التربية والتعليم هو الوقاية من الجريمة وهو الامر الذي تسعى الدول المعاصرة الى تحقيقه من خلال بلورة كل ما يمكن للمدرسة ان تقدمه للفرد من تكوين علمي وسلوك واخلاقيات وقيم وثقافة تحول دون وقوع الفرد في الجريمة وجعله متشبعا بالقيم الإنسانية، وهذا ما سنحاول أن نعالجه في (الفقرة الأولى) من خلال تبيان دور مؤسسات التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية.
وفي ظل السياسة التقويمية العلاجية لا يمكننا أن نترك من وقع في كنف الانحراف وتهاوت به الاقدار الى غياهب السجن، عرضة لحالات العود، فلابد أن نضع خطط وبرامج تكوينية ودراسية خاصة بهؤلاء وهو ما تتكلف به المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وهو ما نعالجه في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: دور مؤسسات التعليم العمومي في الوقاية من الظاهرة الاجرامية.
أنشئت المدرسة لتواجه حاجة اجتماعية ضرورية هي إعداد الأفراد للحياة الاجتماعية، والتي تعتبر عملية فردية اجتماعية، لما لها من انعكاسات ايجابية على الفرد نفسه ومجتمعه، في نفس الوقت والتربية أنواع كما جاءت عند جون لوك وهي:
التربية الجسمية، ترمي إلى تقوية الأبدان وحفظ نشاط الجسم.
التربية العقلية، تهدف إلى تزويد العقل بأنواع المعارف والعلوم.
التربية الخلقية، وتهدف إلى غرس الفضيلة في النفوس.[17]
من هذا المنطلق سنحاول تبيان دور المؤسسة التعليمية في الوقاية من الظاهرة الاجرامية من خلال الحديث عن التصدي للعنف المدرسي وبناء المشروع الشخصي للمتعلم،
وقد يعاتبنا البعض على إغفالنا الحديث عن الهدر المدرسي إلا أننا سنحاول أن نتطرق إليه في مضامين الفقرتين الاتيتين بشكل ضمني دون أن ننسى أن محاربة الهدر المدرسي يلقى أهمية بالغة تسعى الوزارة في خطوات جاهدة إلى إرسائها عبر فتح برنامج محو الامية وبرنامج الفرصة الثانية، والتربية غير النظامية...
أولا: التصدي للعنف المدرسي
يعتبر العنف ظاهرة عالمية تعاني منها معظم دول العالم، سواء المتقدمة منها أو التي في طريق النمو، والتي يمكن أن تمس جميع شرائح المجتمع خلال جميع مراحل حياتهم العمرية، مع الاشارة إلى أن الفئة الاكثر عرضة ليا هي فئة المراهقين الذين هم في طور التمدرس، إذ يشكل العنف في الوسط المدرسي تحديا كبيرا بالنسبة للتربية، والارتقاء بالفرد وتنمية المجتمع، فقصد الوقاية من إيذاء التلامذة وتعزيز المناخ المدرسي الذي يضمن الجودة والأمان، يتعين وضع تدابير فعالة لتحقيق ذلك. وهو ما أكدت عليه الوزارة في العديد من المذكرات وهي:
المذكرة رقم 2.15 المتعلقة ب التصدي للعنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي
المذكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي
المذكرة رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي
إن توالي صدور هذه المذكرات ما هو إلا دليل على استفحال هذه الظاهرة في الوسط المدرسي، وبدراستنا للمذكرة رقم 2.15 نلاحظ أنه يغلب عليها جانب الردع والتصدي على جانب الوقاية والعلاج وهو ما نلمسه في بعض بنوده نذكر منها:
''التعامل مع مختلف مظاهر وأشكال السلوكات العدوانية والمنحرفة بنفس الحزم المطلوب، سواء تعلق الأمر بالعنف الرمزي أو اللفظي أو البدني أو المادي، أو بالتحرش الجنسي، أو بالتعاطي للمخدرات، أو بغيرها من التصرفات والممارسات المشينة.
التعامل الفوري والحازم، من طرف النيابات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية، وإعمالها الحازم لمختلف الآليات الإدارية والقانونية المتاحة لها من أجل معالجة هذه الحالات.
إبلاغ مصالح الأمن والسلطات المحلية، بشكل فوري بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، أو التي يعاقب عليها القانون، مع تكثيف قنوات وآليات التنسيق مع هذه المصالح، حتى تصبح المؤسسات التعليمية حصنا منيعا على كل الاعتداءات التي تطال الأشخاص والممتلكات.
تنصيب الإدارة لنفسها، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم بمناسبة القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية، وصونا لحرمة المنظومة التربوية، وتعزيزا لروح التضامن والتعاضد والتآزر داخلها'':[18]
وهذا الامر تكرر أيضا مع إصدار المذكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي التي أكدت أيضا على ما يلي:
انطلاقا من المبادئ السالفة الذكر، فإنه يتعين على مختلف المستويات الجهوية والإقليمية التحلي بأقصى درجات اليقظة والحزم والتفاعل الفوري من أجل معالجة جميع حالات العنف المدرسي، وفرض الضبط والانضباط بالمؤسسات التعليمية مع العمل على حث مديرات ومديري المؤسسات التعليمية على الإعمال الفعال لمختلف التدابير المرتبطة بمحاربة العنف المدرسي، وفق نظرة منسجمة تستحضر طبيعة السلوك المرتكب، ومستوى التدخل اللازم للتصدي الفوري والفعال له.[19]
باستقراء هاتين المذكرتين نلاحظ أن العبارات المستعملة فيها تغلب عليها الطابع الزجري (التصدي، فرض الانضباط، محاربة، التصدي الفوري...) ونستنتج أن المقاربة التي كانت تنهجها الوزارة في التصدي لظاهرة العنف المدرسي هي مقاربة أمنية زجرية وتغيب إلى حد كبير المقاربة العلاجية ما عدى تنصيصها في بعض البنود على أهمية التوعية والإرشاد،
إلا ان المذكرة الأخيرة الصادرة عن الوزارة، رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي نلاحظ فيها نوعا من المرونة في استخدام الالفاظ التربوية والقيم النبيلة في التعامل مع العنف المدرسي والانحياز الى ما هو وقائي علاجي على حساب ما هو زجري حيث جاء فيها ما يلي:
''استحضارا للأدوار والوظائف النبيلة للمدرسة، باعتبارها فضاء للتعليم والتنشئة الاجتماعية والتربية على قيم التفتح والمواطنة وحقوق الإنسان والتسامح، ومجالا لنشر ثقافة العيش المشترك والسلوك المدني والتصدي لجميع أشكال العنف، كيفما كان مصدره، وكيفما كانت طبيعته، سواء تعلق الأمر بالعنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي أو الرمزي أو المبني على النوع
واعتبارا لأهمية ونجاعة المقاربة الوقائية والتحسيسية في التصدي لظاهرة العنف بالوسط المدرسي يشرفني أن أطلب منكم العمل على اتخاذ الإجراءات التالية لتفعيل هذه المقاربة... ''[20]
وبمقارنتنا لهذه المذكرات نلاحظ التطور الحاصل في المعاملة مع ظاهرة العنف واقتناع الوزارة بان السبيل الأنجع لمحاربتها هي من خلال تفعيل أدوار مدرسة التربية قبل مدرسة التعليم، أي بنهج سياسة استباقية وقائية خصوصا مع العنف الداخلي أي الصادر من داخل المؤسسة سواء عن طريق التلاميذ فيما بينهم أو عن طريق التلاميذ والاطر التربوية، وهذا ما نص عليه تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين حيث أكد أن مكافحة العقاب البدني، وهو شكل من أشكال العنف المستخدم من طرف بعض الأساتذة، من الأولويات، حيث لا يمكن بناء أي تعليم على الخوف والعقاب البدني، وأن هناك حاجة ماسة إلى تكوين وتدريب الأساتذة على التعامل مع السلوكات السلبية لبعض التلامذة والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.
ويشكل التكوين المناسب للأطر التربوية عنصرا أساسيا في التعامل الفعال مع العنف المدرسي إذ يمكن دمج المقاربات البيداغوجية في تكوين المديرين والأساتذة، لضمان تدبير أفضل وتعامل أنجع مع حالات العنف بين التلامذة. وكل هذا سيساعد في استباق بعض ردود الفعل العنيفة الصادرة عن الفاعلين التربويين وتبني أساليب لحل النزاعات بطرق سلمية، من أجل خلق بيئة تعليمية آمنة تساعد على تفتح التلامذة وتوفير أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تساهم في توجيه طاقة التلامذة بطريقة إيجابية وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم وتعزيز مناخ مدرسي مبني على الاحترام.[21]
حيث أقرت الوزارة ضرورة:
- العناية بجاذبية المؤسسات التعليمية والرفع من مستوى أنشطة الحياة المدرسية بها، مع الحرص التام على إدماجها في مكونات مشروع المؤسسة المندمج باعتباره الآلية المنهجية المثلى للاشتغال.
- اعتماد المقاربة التشاركية للتحسيس بأهمية مناهضة مظاهر العنف وخاصة التمييز القائم على النوع بالوسط المدرسي والوقاية منها.
- العمل على الانفتاح والتواصل المستمرين مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والسلطات المحلية والأمنية وقطاع الصحة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة والخبراء والمهتمين.
- الحرص على التفعيل الأمثل للأندية التربوية التي تشتغل على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش، والرفع من جاذبيتها لدى التلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال تأطيرها المستمر وتمكينها من الوسائل اللوجيستيكية والتقنية الضرورية، وإدراج أنشطتها ضمن مشروع المؤسسة المندمج.
- الحرص على أن تتوفر جميع المؤسسات التعليمية على نظام داخلي يتضمن بنودا حول التصدي للعنف بالوسط المدرسي، يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية، والتعريف بمضامينه لدى شركاتها ومختلف الفاعلين داخلها.
- تشجيع التلميذات والتلاميذ على الانخراط في أنشطة الحياة المدرسية باعتبارها المجال الذي يمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم، والتعرف على واجباتهم وحقوقهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات الحياتية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم.
- تعزيز التربية على الحق في المشاركة لدى التلميذات والتلاميذ وتنمية مهارات الترافع والإقناع وقيم الديمقراطية عندهم، من خلال تفعيل المجالس التلاميذية، مع الحرص على إشراكهم في مختلف المجالس الأخرى بالمؤسسات التعليمية.[22]
ثانيا: بناء المشروع الشخصي للمتعلم
يبدو الوعي بالعلاقة بين التعلم والمشروع الشخصي أو المهني، أمرا يتجاوز إدراك المتعلم، الذي غالبا ما يطرح السؤال “على المستوى الشخصي (ما الذي سأجنيه من التعلم بشكل خاص؟) وعلى المستوى المهني (ما الذي سيقدمه لي التعلم بالمدرسة، بخصوص توجيهي نحو مهنة وبخصوص الدراسات المواكبة لهذا التوجيه؟).[24]
وفي هذا الصدد فقد أصبح الوعي لدا الوزارة قائما على ضرورة مواكبة المتعلمين طيلة مسارهم الدراسي بغية توجيههم توجيها صحيحا يساعد في استكمالهم لمسارهم الدراسي ودمجهم في سوق الشغل أيضا، حيث أصدرت العديد من المذكرات أهمها:
القرار رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
المذكرة رقم 114.19 في شأن الاستاذ الرئيس في الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
المذكرة رقم 105.19 في شان الارتقاء بالممارسة التربوية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
القرار رقم 07.22 في شان المصادقة على الإطار المرجعي للمواكبة التخصصية للمشروع الشخصي للمتعلم في الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
إن كثرة إصدار هذه القرارات والمذكرات ما دل إلا على أهمية هذا المشروع، فالمشروع الشخصي للمتعلم هي السيرورة التي ينخرط فيها المتعلم من أجل تحديد هدف مهني يطمح إلى تحقيقه، وتحديد المسارات الدراسية والتكوينية المؤدية إليه، وخطته الشخصية لبلوغه، والخيارات البديلة في حالة تعثره في الوصول إلى هذا المبتغى، وكل ذلك في إطار منطق تكامل استراتيجي بين الأداء الدراسي الماضي والحالي، وبين الطموحات والأهداف الدراسية والتكوينية والمهنية المستقبلية.
ويتدرج المشروع الشخصي للمتعلم عبر أربع مراحل تتم في فترات زمنية متفاوتة ومختلفة بحسب مستوى نضج ميول المتعلم، وهي مراحل مفصولة منهجيا، ومتداخلة إجرائيا، وهي:
- مرحلة الاستئناس بمفهوم المشروع الشخصي خلال السنتين النهائيتين من التعليم الابتدائي،
- مرحلة بناء المشروع الشخصي، خلال مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي،
- مرحلة توطيد المشروع الشخصي، خلال مرحلة التعليم الثانوي التأهيلي،
- مرحلة تدقيق المشروع الشخصي، خلال مرحلة التكوين المهني بمختلف أسلاكه، ومرحلة التعليم العالي[25]
مواكبة تربوية
تشمل مرحلة البناء والتوطيد دعم المتعلمين في تكاملهم في بيئة التعلم، وضمان نجاحهم في مساراتهم الدراسية. تهدف إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء مساراتهم الشخصية واتخاذ القرارات التعليمية والمهنية المستقبلية.
وتشمل المواكبة التربوية مختلف الأنشطة المتعلقة بمعرفة الذات وتطوير قدراتها والانفتاح على المحيط الدراسي والتكوين المهني وتنمية الثقافة المقاولتية والحس الريادي والاعداد للاندماج في الحياة الاجتماعية والمهنية.[26]
مواكبة تخصصية
تغطي مراحل البناء والتوطيد والتدقيق، وتشمل كلا من خدمة الإعلام المدرسي والمهني والجامعي، وخدمة الاستشارة، والتوجيه المدرسي، والمهني، والجامعي. وللمواكبة التخصصية وجهان مباشرة وغير مباشرة:
فبالنسبة للمواكبة المباشرة في تهتم ب بقديم خدمات الاعلام والتوجيه والاستشارة وتقديم المساعدة للمتعلمين بغيت تقويم مشاريعهم الشخصية
وبالنسبة للمواكبة غير المباشرة فتقوم على تعزيز بيئة العمل وذلك عن طريق الدعم التقني للمؤسسة وربط جسور للتنسيق والتواصل بين الأساتذة وأمهات وءاباء التلاميذ لتتبع مسار أولادهم داخل المؤسسة.[27]
مواكبة نفسية واجتماعية
وتقوم على رصد المتعلمين الذين قد يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، أو يظهرون سلوكات غير تربوية من شأنها أن تعيق تمدرسهم العادي وتحد من فرص نجاحهم الدراسي، ومن ثم تقلص فرص مواصلة مساراتهم الدراسية بنجاح ومن تحقيق مشاريعهم الشخصية،[28]
وبالنظر إلى ملفهم الشخصي، يوضع إطار مرجعي لتحديد معايير وصيغ التكيف الممكنة حسب كل نوع من أنواع المشاكل، كما توضع أطر مرجعية لتحديد ضوابط تقديم هذه الخدمات ومعايير جودتها مع تدبيرها اعتمادا على النظام المعلوماتي للوزارة وتيسير الاستفادة منها،
يعتمد بهذا الخصوص على خدمة الإعلام المدرسي والمهني والجامعي الذي يضع المعلومات الضرورية حول المسارات … رهن إشارة المتعلمين مع الحرص على إكساب المتعلمين كفاية الاستعلام الذاتي عوض الاعتماد على التلقي السلبي للمعلومات.[29]
من هذا كله يمكننا القول إن للمشروع الشخصي للتلميذ أهمية بالغة في تحديد مساره الدراسي والمهني وتوجيهه توجيها سليما بشكل يحيد به عن الوقوع في براثين الامراض النفسية والتشتت والخوف من المستقبل ولربما الاقتداء بمشاريع فاشلة ويجعل منها مسودة لمشروعه الشخصي وبالتالي يقع في معضلة الهدر المدرسي ولربما الانحراف.
إن بناء المشروع الشخصي للتلميذ ليس شيء وليد الصدفة بل هو ثمرة مجهود شخصي للتلميذ طيلة حياته فلربما تقع به الظروف ليجد نفسه بعيدا عن اسوار الدراسة ولربما يقع في طريق الانحراف أو خلف قضبان السجون فيحتاج الى تقويم جديد وهو ما تقوم به المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
الفقرة الثانية: دور المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في إعادة التأهيل الدراسي للنزلاء.
إذا كان التعليم حقا من الحقوق الأساسية المكفولة للجميع فهو أيضا مكفول للسجناء بمجرد ولوجهم المؤسسة السجنية، فهو كذلك وسيلة من الوسائل التربوية التي لها بالغ الأثر في شخصيتهم. إذ يساهم في تهذيب سلوكهم، وتزويدهم بالمعلومات والمعارف التي تمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية بصورة صحيحة.[30]
أولا: تفعيل برنامج محو الامية والتربية غير النظامية
يعتبر الجهل بالنتائج المترتبة عن ارتكاب جنحة أو جناية من أبرز العوامل التي تدفع بالفرد إلى ارتكاب هذه الأفعال، لكونهم أميين أو من ذوي المستوى التعليمي الضعيف، وهو ما تعكسه المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالساكنة السجنية بشكل جلي، حيث لا تقل نسبة السجناء الأميين عن % 10.69 [31]من مجموع الساكنة السجنية.[32]
هذا المعطى دفع المندوبية العامة إلى مضاعفة جهودها في مجال محاربة ظاهرة الأمية في صفوف السجناء بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتنفيذ برنامجها المتعلق بمحو الأمية بالسجون على غرار البرنامج المعتمد بالمساجد، حيث ثم وضع برنامج "سجون بدون امية" بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وهو برنامج يروم تكوين 11000 سجينا من الأمين المحكومين بشكل نهائي، ويعتمد على مبدأ التثقيف بالنظير من خلال تكون سجناء من طرف الوكالة المذكورة وحصولهم على شواهد تكونين في مجال محو الأمية وتأطيرهم لسجناء آخرين، وقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذا التكون 72 سجينا أشرفوا بدورهم على تكوين 2358 سجينا[33]، وفي هذا السياق فقد شهد الموسم الدراسي 2023.2022 استفادة ما مجموعه 7529 نزيل من دروس محو الامية،[34]
وهو ما يعكس توجه المديرية الى إعادة إصلاح الجانحين عن طريق ترسيخ قيم التعليم لديهم وإخراجهم من غياهب الجهل الى نور المعرفة من اجل عدم رجوعهم في حالة العود الى اسوار السجن فتعد هذه مقاربة علاجية ووقائية ناجعة.
ثانيا: تفعيل برامج التعليم بمختلف أطواره
تسهر المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء على ضمان حق التعليم للسجناء المتوفرين على الشروط المطلوبة، بمختلف أطواره الإعدادي والثانوي، والجامعي:
فبالنسبة للمسلك الثانوي الإعدادي ومسالك الثانوي التأهيل يستفيد من برامج التعليم بجميع اسلاكه ثلاث فئات من السجناء:
الفئة الأولى هي فئة السجناء المسايرين، أي الذين كانوا يتابعون دراستهم بأحد الفصول الدراسية قبل اعتقالهم وكذا الحاصلون على شهادة الدروس الابتدائية أو الإعدادية والذين تتوفر فيهم شروط القطاع الوصي، وهؤلاء يتم إلحاقهم مباشرة من العلم أن هذه المدرسة تابعة للخريطة التربوية ويشرف عليها منسق تربوي.
الفئة الثانية: هي فئة النزلاء المرشحين الأحرار المنقطعون عن الدراسة الراغبون في اجتياز الامتحانات الإشهادية بأحد الأسلاك التعليمية.
الفئة الثالثة وهي فئة المسجلين بالبرامج التعليمية غير المسايرين الذين يتم تسجيلهم ببرامج التعليم بالمؤسسات السجنية التي تتوفر على أقسام دراسية، بعد البت في طلباتهم من طرف لجنة الانتقاء وفق المعايير والشروط المطلوبة للتسجيل تبعا للمقاعد الدراسية الشاعرة[35]
وتجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء المسجلين ببرامج التعليم موسم الموسم الدراسي 2022/2023 هو: 6987[36] تزيل ونزيلة وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة ب السنوات الفارطة وهذه النتائج جاءت حصيلة الجهود المتظافرة لتحقيق مؤشرات جد إيجابية.
أما بخصوص السلك الجامعي يتم تسجيل المعتقلين الحاصلين على شهادة الباكالوريا بمختلف كليات المملكة تبعا للقسم الجغرافي المعتمد لهذا الشأن ووفق الشروط التي تضعها الكليات المعنية، كما يستفيد منها السجناء الذين كانوا يتابعون دراستهم الجامعية واعتقلوا والدين وافقت إدارة الكلية التي ينتسبون إليها على إعادة تسجيلهم.
وتساعد الإدارة المركزية. المعتقلين على التسجيل بالكليات التي تقوم بدورها، بإنشاء لجان من اجل الإشراف على الامتحانات داخل المؤسسات السجنية، كما تضع رهن إشارة الطلبة المعتقلين الكتب والمراجع التي تعينهم على متابعة دراستهم، كما يتم ربط الاتصال بين المؤسسات والكليات الموجودة في دائرتها، وخاصة الأساتذة الجامعيين للإشراف على البحوث الجامعية للمعتقلين المطالبين بإنجازها،[37]
ثالثا: تفعيل برامج التكوين المهني والحرفي.
كشف تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2017، عن تجاوب الساكنة السجنية مع برنامج التكوين المهني التي تقوم بها المندوبية في إطار تشاركي مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية، فقد بلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني خلال الموسم التكويني 2022.2023 ما مجموعه 8113 مستفيدا و734 مستفيدا من برنامج التكوين الفلاحي.[38]
ومن جانب آخر، قامت المندوبية العامة بإطلاق برنامج "فرصة وابداع" بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الحرفية والفنية، وقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذا البرنامج491 سجينا في نسخته الأولى، منهم 69 نزيلة و 8 نزلاء من أصول افريقية، وقد سلمت شهادات المشاركة للسجناء المستفيدين في اطار هذا البرنامج في أفق إدماج البعض منهم كمؤطرين داخل الوحدات الإنتاجية التي تم إحداثها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما استفاد 169 سجينا من التشغيل في هذه الورشات [39]
وفي الأخير يمكننا القول إن الانسياق في طريق الانحراف ليس هو دمار للإنسان بل هو فرصة لتجديد حياته وفرصة لإعادة تقويم مشروعه الشخصي أو بنائه من جديد وفق توجيه محكم ونظرة أخرى أكثر شمولا وأكثر وضوحا تجعل من الشخص الجانح فاعلا في المجتمع.
خاتمة:
بناء على ما سبق نستنتج أن هناك علاقة مضطردة بين التعليم والظاهرة الاجرامية أي أن هناك علاقة تأثير وتأثر متبادل، فمتى ما كانت المؤسسة التعليمية فضاء للرتابة والعنف في التلقين وفضاء غير مناسب للعملية التعليمية التعلمية سواء على المستوى البنيوي أي بنية المؤسسة أو على المستوى الوظيفي أي ما تقدمه المؤسسة من تعلمات نكون أمام آفات خطيرة في المجتمع منها الهدر المدرسي والعنف مما يؤدي لا محالة الى الوقوع في الجريمة.
وعلى النقيض من ذلك فمتى ما كانت المؤسسة التعليمية فضاء للتعليم الجيد وجعل الأستاذ قدوة حسنة للتلاميذ وبناء شخصيتهم بشكل جيد يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والاستقرار النفسي عبر انماء الحسن الوطني والانتماء للجماعة عبر تتبع الطفل من مراحله الأولى من خلال بناء مشروعه الشخصي، نكون أمام فرد صالح للمجتمع وقادر على إصلاحه وبذلك تكون المؤسسة التعليمية فضاء للتقليل من الوقوع في الظاهرة الاجرامية.
وهذا الطرح هو ما تحاول الوزارة الوصية على القطاع أن ترسخه داخل المؤسسات التعليمية عبر إقرار العمل بالمشروع الشخصي للتلميذ وإقرار وسائل بديلة تربوية للتعامل مع العنف المدرسي و الهدر المدرسي، دون ان تقف على هذا الحد بل وفي إطار مبدأ التعلم مدى الحياة وفي كل الظروف فإن التعليم يتخذ صيغة التقويم والعلاج من الظاهرة الاجرامية وهو ما تجسده المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عبد إقرار برامج لمحو الامية واستكمال الدراسة سواء النظامية و غير النظامية و كذا فتح فرص للولوج الى التكوين المهني والفلاحي. بغية جعل التعليم وسيلة توعية للفرد من أجل عدم الوقوع مجدد في حالات العود وجعله فردا صالحا داخل المجتمع.
لائحة المراجع.
- كتب
- أحمد محمد الزعبي. سيكولوجية المراهقة - النظريات -جوانب النمو- المشكلات وسبل علاجها. دار زهران للنشر والتوزيع. عمان. 2009.
- جمال إبراهيم الحيدري. علم الاجرام المعاصر. دار النهضة العربية. لبنان.الطبعة الأولى. 2009.
- عبد السلام بنحدو. مبادئ علم الاجرام دراسة في الشخصية الاجرامية. مطبعة الوراقة الوطنية مراكش. الطبعة الثانية 1999.
- محمد أحداف. علم الاجرام النظريات العلمية والسلوك الاجرامي. مطبعة وراقة سجلماسة. الطبعة الثالثة. 2018.
- محمد الازهر. مبادئ في علم الاجرام. مطبعة دار النشر المغربية. الدار البيضاء. الطبعة الخامسة.
- محمد شفيق. الجريمة والمجتمع. مطبعة محطة الرمل. الإسكندرية.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي -التصدي للهدر المدرسي. - مصوغة تكوينية. تكوين رؤساء المؤسسات التعليمية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 2008.
- رسائل جامعية
- حسناء الغوتي. دور المؤسسة السجنية في التأهيل وإعادة الادماج. رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية. جامعة ابن زهر. اكادير. 2020.
- عبد الجليل عيسوني. البرامج الإصلاحية بمؤسسات حماية الطفولة بالمغرب. التكوين المهني نموذجا. رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية. كلية علوم التربية. الرباط. 2006.
- مقالات ورقية
- قنطازي كريمة-مراد فاطمة الزهراء. دور المدرسة في الحد من الجريمة عبر مناهجها الدراسية. مجلة الاسرة والمجتمع. المجلد 8 العدد الثاني. 2020.
- مبـــارك مزيــــن. استراتيجية وزارة التربية الوطنية بالمغرب لمناهضة العنف بالوسط المدرسي والوقاية منه. المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي. العدد الثاني/أكتوبر .2019
- مقالات الكترونية
- أروى نجيب. عواقب نفسية واجتماعية وخيمة.. كيف يمكن أن يدمر العنف المدرسي حياة الطفل في المستقبل؟ مقال منشور ب الجزيرة نت. https://2u.pw/j98TQ
- سهير بشناق. أثر سلوكيات المعلم على الأطفال. جريدة الرأي.https://2u.pw/fpxOs
- عبد الرحيم الدلال. خطوات إرساء المشروع الشخصي للمتعلم حسب الأسلاك الدراسية. مقال منشور بموقع أدلال. https://adellal.com/author/iamdellal/
- محمد الصديقي. تقرير حول سياسات محاربة الهدر المدرسي بالمغرب منتدى العمق المغربي: https://al3omk.com/802970.html
- ما الذي يسبّب العقد النفسية عند الطفل؟ مقال منشور بموقع صحتي. https://2u.pw/MDnff
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج https://www.dgapr.gov.ma
- تقارير
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسف. تقرير حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. 2022.
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. تقرير الأنشطة 2023.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تقرير الأنشطة 2017.
- المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تقرير الأنشطة 2022.
- قرارات ومذكرات
- القرار رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
- المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
- المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
- ذكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي
- ذكرة رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي
- المذكرة رقم 2.15 المتعلقة ب التصدي للعنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي
الفهرسة.
تقديم: 1
المطلب الأول: التعليم والظاهرة الاجرامية. 2
الفقرة الأولى: علاقة المدرسة بالظاهرة الاجرامية. 2
أولا دراسة في الهدر المدرسي وعلاقته بالانحراف. 3
ثانيا: دراسة في أسباب العنف المدرسي. 4
الفقرة الثانية: المدارس الفكرية المنظرة لعلاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية. 7
أولا: مدرسة الوسط الاجتماعي. 8
ثانيا: مدرسة العوامل النفسية. 9
المطلب الثاني: دور التعليم في الوقاية من الظاهرة الاجرامية. 11
الفقرة الأولى: دور مؤسسات التعليم العمومي في الوقاية من الظاهرة الاجرامية. 12
أولا: التصدي للعنف المدرسي. 12
ثانيا: بناء المشروع الشخصي للمتعلم 16
الفقرة الثانية: دور المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج في إعادة التأهيل الدراسي للنزلاء. 19
أولا: تفعيل برنامج محو الامية والتربية غير النظامية. 19
ثانيا: تفعيل برامج التعليم بمختلف أطواره 20
ثالثا: تفعيل برامج التكوين المهني والحرفي. 21
خاتمة: 22
لائحة المراجع. 23
الفهرسة. 25
[1] محمد شفيق. الجريمة والمجتمع. مطبعة محطة الرمل. الإسكندرية. ص111
[2] التصدي للهدر المدرسي. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - قطاع التعليم المدرسي - مصوغة تكوينية. تكوين رؤساء المؤسسات التعليمية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. 2008. ص 7
[3] محمد الصديقي. تقرير حول سياسات محاربة الهدر المدرسي بالمغرب منتدى العمق المغربي: https://al3omk.com/802970.html تم الاطلاع عليه في 05.04.2025 على الساعة 21:45
[4] سهير بشناق. أثر سلوكيات المعلم على الأطفال. جريدة الرأي. تاريخ النشر: الاثنين12:00 2014-3-10 https://2u.pw/fpxOs تم الاطلاع عليه في 28.03.2025.13.56
[5] أروى نجيب. عواقب نفسية واجتماعية وخيمة.. كيف يمكن أن يدمر العنف المدرسي حياة الطفل في المستقبل؟ مقال منشور ب الجزيرة نت. https://2u.pw/j98TQ تم الاطلاع عليه في 28.03.2025. 14:30
[6] ما الذي يسبّب العقد النفسية عند الطفل؟ مقال منشور بموقع صحتي. https://2u.pw/MDnff تم الاطلاع عليه في 28.03.2025.على الساعة 14:16
[7] تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. بشراكة مع منظمة اليونيسف. 2022 ص 2
[8] أحمد محمد الزعبي. سيكولوجية المراهقة - النظريات -جوانب النمو- المشكلات وسبل علاجها. دار زهران للنشر والتوزيع. عمان. 2009 ص 90
[9] ترجع المدرسة التكوينية الجريمة إلى صفات جسدية وخلقية لدى المجرم أي ان المجرم يولد لكي يكون مجرما ونشأ معها مفهوم المجرم بالميلاد.
[10] محمد أحداف. علم الاجرام النظريات العلمية والسلوك الاجرامي. مطبعة وراقة سجلماسة. الطبعة الثالثة. 2018 ص 287
[11] جمال إبراهيم الحيدري. علم الاجرام المعاصر. دار النهضة العربية. لبنان. الطبعة الأولى. 2009. ص 79
[12] عبد السلام بنحدو. مبادئ علم الاجرام دراسة في الشخصية الاجرامية. مطبعة الوراقة الوطنية مراكش. الطبعة الثانية 1999. ص114
[13] جمال إبراهيم الحيدري. علم الاجرام المعاصر. مرجع سابق. ص 60
[14] محمد الازهر. مبادئ في علم الاجرام. مطبعة دار النشر المغربية. الدار البيضاء. الطبعة الخامسة. 2002. ص 69
[15] محمد أحداف. علم الاجرام النظريات العلمية والسلوك الاجرامي. مرجع سابق. ص270
[16] جمال إبراهيم الحيدري. علم الاجرام المعاصر. مرجع سابق. ص 65
[17] قنطازي كريمة-مراد فاطمة الزهراء. دور المدرسة في الحد من الجريمة عبر مناهجها الدراسية. مجلة الاسرة والمجتمع. المجلد 8 العدد الثاني. 2020. ص 117
[18] المذكرة رقم 2.15 المتعلقة ب التصدي للعنف والسلوكيات المشينة بالوسط المدرسي
[19] إصدار المدكرة رقم 116.17 المتعلقة ب التصدي للعنف بالوسط المدرسي
[20] المدكرة رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي
[21] تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. بشراكة مع منظمة اليونيسف. 2022 ص 4
[22] المذكرة رقم 146.24 المتعلقة ب مناهضة العنف بالوسط المدرسي
[23] أنضر أيضا: مبـــارك مزيــــن. استراتيجية وزارة التربية الوطنية بالمغرب لمناهضة العنف بالوسط المدرسي والوقاية منه. المجلة المغربية للتقييم والبحث التربوي. العدد الثاني/أكتوبر .2019
[24] عبد الرحيم الدلال. خطوات إرساء المشروع الشخصي للمتعلم حسب الأسلاك الدراسية. مقال منشور بموقع أدلال. https://adellal.com/author/iamdellal/ تم الاطلاع عليه في 07.04.2025 على الساعة 20:39
[25] القرار رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. المادة 8
[26] المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
[27] المذكرة رقم 106.19 في شان إرساء العمل بالمشروع الشخصي للمتعلم بالثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية.
[28] القرار رقم 62.19 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والجامعي. المادة 18
[29] عبد الرحيم الدلال. خطوات إرساء المشروع الشخصي للمتعلم حسب الأسلاك الدراسية. مرجع سابق
[30] عبد الجليل عيسوني. البرامج الإصلاحية بمؤسسات حماية الطفولة بالمغرب. التكوين المهني نموذجا. رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في علوم التربية. كلية علوم التربية. الرباط. 2006. ص 33
[31] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. تقرير الأنشطة 2023. ص 31
[32] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_menu=62 تم الاطلاع عليه في .06.04.2025 على الساعة 21:23
[33] حسناء الغوتي. دور المؤسسة السجنية في التأهيل وإعادة الادماج. رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية. جامعة ابن زهر. اكادير. 2020. ص 49
[34] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. تقرير الأنشطة 2023. ص 77
[35] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. https://www.dgapr.gov.ma/articles.php?id_menu=63 تم الاطلاع عليه في 06.04.2025 على الساعة 22:15
[36] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. تقرير الأنشطة 2023. ص 73
[37] المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تقرير الأنشطة 2022. صفحة 78
[38] المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج. تقرير الأنشطة 2023. ص 80
[39] المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. تقرير الأنشطة 2017. صفحة 41



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 علاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية
علاقة التعليم بالظاهرة الاجرامية