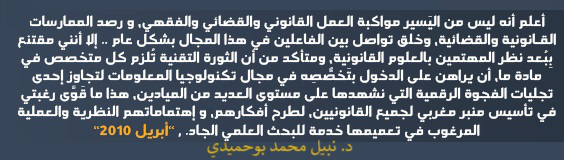التقرير الصادر
عن المؤتمر السادس
لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية
_____
بيروت 30/5 – 01/06/2016
الموافق 23 – 25 شعبان 1438 هـ
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1044/د30 المتعلّق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2016 والذي يتضمن من بين بنوده عقد المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية (مجالس شورى الدولة، مجلس الدولة، مجلس شورى الدولة، ديوان المظالم...) في الدول العربية.
حدّد المركز الفترة ما بين 30/5 – 1/6/2016 لانعقاد هذا المؤتمر في مقرّ المركز في بيروت، حيث تناول هذا المؤتمر مناقشة المحاور العلمية التالية:
1. عقود إلتزامات المرافق العامة أو المؤسسات العامة (BOT) وأنواعها وطرق الإستفادة منها.
2. القضاء الإداري في الدول العربية: أنواعه وصلاحياته.
(عرض واقع القضاء الإداري في الدول العربية)
3. المستجدات الحديثة في قضاء الإلغاء وقضاء التعويض في الدول العربية.
4. ما يستجدّ من أعمال.
مدى فاعلية إستحداث قضاء إداري مستقلّ (مجلس دولة) (مقترح ليبيا).
عن المؤتمر السادس
لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية
_____
بيروت 30/5 – 01/06/2016
الموافق 23 – 25 شعبان 1438 هـ
تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم 1044/د30 المتعلّق بإقرار برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2016 والذي يتضمن من بين بنوده عقد المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية (مجالس شورى الدولة، مجلس الدولة، مجلس شورى الدولة، ديوان المظالم...) في الدول العربية.
حدّد المركز الفترة ما بين 30/5 – 1/6/2016 لانعقاد هذا المؤتمر في مقرّ المركز في بيروت، حيث تناول هذا المؤتمر مناقشة المحاور العلمية التالية:
1. عقود إلتزامات المرافق العامة أو المؤسسات العامة (BOT) وأنواعها وطرق الإستفادة منها.
2. القضاء الإداري في الدول العربية: أنواعه وصلاحياته.
(عرض واقع القضاء الإداري في الدول العربية)
3. المستجدات الحديثة في قضاء الإلغاء وقضاء التعويض في الدول العربية.
4. ما يستجدّ من أعمال.
مدى فاعلية إستحداث قضاء إداري مستقلّ (مجلس دولة) (مقترح ليبيا).
في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الإثنين 30/5/2016 في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية افتتح الجلسة السفير عبد الرحمن الصلح بكلمة جاء فيها:
" بمناسبة إنعقاد المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية [مجلس شورى الدولة، مجالس الدولة، المحاكم الإدارية، ديوان المظالم] أن أعبّر عن خالص السعادة والإعتزاز بلقائنا اليوم في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية الذي يؤكّد مدى حرصه على النهوض بالمستوى العام للمجتمعات العربية ومؤسساتها وعلى إرساء دعائم العمل العربي المشترك.
كما يشرّفني أن أنقل إلى الأخوة المشاركين في المؤتمر ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة هذه النخبة المختارة من رجال القانون والقضاء متمنياً لأعمالكم الخير والفلاح.
وبدوري أتوجّه إلى المشاركين في هذا اللقاء لما أبدوه من إهتمام لدفع عجلة العمل الإداري بإنتقالهم إلى بيروت شعوراً منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومن هنا كان للمركز العربي دوره ومساهمته من خلال برامجه وندواته ومؤتمراته في النهوض بهذه الأعباء تحديثاً للتشريعات والقوانين والعمل معكم على توحيدها.
إن التعاون والتكامل العربي على أكثر من صعيد أصبح ضرورة بقاء وليس رفاهية إختيار وبدون ذلك لن نستطيع النهوض بهذه الأمة ومواجهة أسباب التشرذم والتخلّف.
إن جامعة الدول العربية حريصة أشدّ الحرص على إحتضان المبادرات البنّاءة والهادفة لتوحيد الصفّ وهو نهج اتّبعته وليس شعاراً رفعته، فالإجماع العربي على إنشاء إتحاد المحاكم الإدارية العربية هو إجراء هامّ يعود بالفائدة والخير على جميع الأقطار العربية خاصة في تطوير الفكر والقضاء الإداري.
وفي هذا المجال فإن الإهتمامات السابقة كانت لقاءات الإنجازات العامة ومن هنا تأتي أهميتها التي تسمح بمواكبة العصر واحتواء مستجدّاته ومتغيّراته.
وبهذه المناسبة أتوجّه بخالص الشكر والإمتنان لكل من ساهم في الإعداد لأوراق العمل، مع تمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح ودوام التقدّم.
وفّقكم الله وسدّد خطاكم".
وتمّ اختيار المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية ورئيس الإتحاد العربي للمحاكم الإدارية، لرئاسة جلسات أشغال المؤتمر.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
أودّ في البداية أن أرحّب بالسادة الحضور ممن يمثلون مجالس الدولة والقضاء الإداري في الدول العربية وتحية للسفير الصلح وأشكره على ما ذكره في كلمته فهي تمسّ الهدف من هذا المؤتمر والكيانات التي ولدت في أحضان هذا المؤتمر على مدى السنتين السابقتين رؤي أن تتنوّع الموضوعات ومنها الموضوعات التي يشملها هذا المؤتمر وأرحب بسلطنة عمان لحضورها ومشاركتها في هذا الملتقى آمل أن تنضمّ سلطنة عمان للكيان الذي نشأ مؤخّراً لتكتمل الحلقة ونتمنى أن تشاركنا جيبوتي بعد إطلاعها على أهداف هذا الكيان للعمل من أجل الصالح التشريعي العربي.
نبدأ بالمحور الثاني: القضاء الإداري في الدول العربية (أنواعه وصلاحياته).
القاضي حاتم بن خليفة – تونس:
يمكن إرجاع نشأة القضاء الإداري في تونس إلى عام 1861 حين صدر أول دستور حيث فوّضت السلطة القضائية إلى مجلس أكبر عام 1881 مع توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا وتونس ظهرت بوادر إزدواجية قضائية فأحدثت محاكم فرنسية إلى جانب محاكم تونسية شرعية ومدنية.
عام 1888 صدر أمر علي يتعلّق بالخصام الإداري الذي أوكل للمحاكم المدنية للنظر في النزاعات الإدارية إلى عام 1956 مع إستقلال تونس وصدور الدستور عام 1959 إقتضى أن المحكمة الإدارية تنظر في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والدولة والجهات العمومية.
ومع صدور قانون رقم 40 لسنة 1972 يتعلّق بالمحكمة الإدارية مما أدّى إلى ترسيخ نظامين قضائيين عدلي وإداري وقد زاد هذا التوجّه مع صدور قانونيّ 38 و39 لسنة 1996 لتنقيح شمل القانون الصادر لعام 1972 تمّ بمقضى هذا التنقيح إسناد دعاوى التعويض للمحكمة الإدارية بعد نزعه من المحاكم المدنية. وتمّ إنشاء مجلس تنازع الإختصاص بين المحاكم العدلية والإدارية.
عام 2014 صدر الدستور التونسي الجديد فأصبح القضاء الإداري يتكوّن من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية إستئنافية ومحاكم إبتدائية وأسند إلى القضاء الإداري صلاحية إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز حدّ السلطة وممارسة وظيفة إستشارية وتمّ ضبط الإجراءات لدى هذا القضاء والقانون لم يصدر بعد.
بعد ذلك تناول هيكلة القضاء الإداري في تونس وصلاحياتها فتحدّث في فرع أول عن القضاء الإداري الممثّل أساساً في المحكمة الإدارية ثم في فرع ثاني تناول موضوع توحيد القضاء الإداري صلب جهاز قضائي كامل ولا مركزي وفي الجزء الثاني تحدّث عن صلاحيات القضاء الإداري في تونس حول إعتماد المعيار المادة الإدارية ثم التطور المستمرّ في النزاعات المعروضة على القضاء الإداري.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
عرض السيد حاتم بن خليفة مراحل تطوّر القضاء الإداري في تونس وقال أن قضاء التعويض إنتزع من القضاء العدلي وأسند إلى القضاء الإداري. هناك بعض التشريعات تعدّد إختصاصات القضاء الإداري ثم نذكر قاعدة وسائر النزاعات الإدارية الأخرى وأشار إلى ذكره حول سلطة رئيس المحكمة الإدارية في إيقاف القرار وصلاحية إبداء المشورة في مشروعات القوانين.
المستشار محمد رسلان – مصر:
ما مصير الطعن على قرار رئيس المحكمة في إيقاف تنفيذ قرار إداري؟
القاضي حاتم بن خليفة - تونس:
الدستور الجديد جاء بمحاكم إبتدائية ومحاكم إستئنافية إدارية وهذا ينظّم السلطة التشريعية والتنفيذية والدستور يضمن إستقلال القضاء تماماً لم يعد للسلطة التنفيذية أي تدخل في القضاء ولمجلس القضاء الأعلى ميزانية مستقلّة يناقشها أمام مجلس النواب وسوف يتمّ إصدار القوانين الأساسية للقضاء الإداري بعد تركيز مجلس الأعلى للقضاء ثم يلي ذلك تركيز المحاكم الإبتدائية في الجهات لم يتحدّث الدستور عن إختصاص المحاكم ونصّ على الوظيفة الإستشارية قد يتمّ توسيع هذه الصلاحية وليس هناك إتجاه لتوسيع هذه الصلاحية كثيراً ستحافظ على إستشارة هذا القضاء بالقوانين والمراسيم والأوامر. إقتراحات القوانين من النواب تحال إلى المحكمة الإدارية للإستشارة لتحرير النصوص وصيانتها.
إختصاص تنفيذ المحاكم إلغاء وتعويض واستشاري.
صلاحية إيقاف تنفيذ القرار أسندت إلى رئيس المحكمة الذي يعين تقديرياً من السلطة التنفيذية وهي صلاحية إستثنائية ؟ الآن الأمور متجهة نحو سحب هذا الإختصاص الأخير وإعطاءه لرئيس قسم في المحكمة الإدارية.
كانت السلطة التنفيذية تعيّن رئيس المحكمة الإدارية من قضاة محكمة التعقيب.
بالنسبة للدستور يعين رئيس المحكمة من قبل فرع القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى برأي وإقتراح ملزم.
قرار رئيس المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري لا يقبل الطعن وهو مؤقت حتى إصدار الحكم بالدعوى بالأساس.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
علينا أن نستفيد مما يجري هنا ويجب إفراد قسم لكل إختصاص قسم قضائي وقسم فتوى وقسم تشريع لإبداء الرأي والمشورة وهذا في سعينا للتقارب إن لم نستطع الوحّد وأقترح أن يكون إيقاف التنفيذ من صلاحية المحكمة وليس من صلاحية شخص واحد.
د. سوسن شندب – السودان:
أوضح أن الفتوى الصادرة عن المحكمة الإدارية تتعارض مع صلاحية القضاء في الرقابة التي تمارسها المحكمة على قرارات الإدارة في السودان الفتوى تصدرها وزارة العدل رأيي قصدي القضاء يكون مستقلّ عن عمل الوزارات.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
ألا ترى أنه أفضل فصل القضاء عن الفتوى والتشريع تماماً وأن تكون هذه الأخيرة لدى وحدات إدارية عندنا الفتوى والتشريع من صلاحية وزارة الشؤون القانونية.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
المهمة الإستشارية لمجلس الدولة لا تتعارض مع مهمته القضائية وقدم رئيس مجلس النواب الرئيس الحسيني مشروع قانون لإلغاء الغرفة الإستشارية في القضاء الإداري. وهذا العمل يجنّب عمل الإدارة من الطعن لاحقاً.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
في البداية أريد أن أسأل حول إختصاص القضاء الإداري في التعويض هل هو مانع؟
والمحكمة الإدارية العليا في تونس هل هو مشروع أم واقع الآن؟
أنا أنضمّ إلى السودان في فصل القضاء عن الفتوى والتشريع.
المستشار محمود رسلان – مصر:
هناك خلط بين قضاء إداري ومجلس الدولة السودان تتكلم عن تعارض ريما يصدر قاضٍ رأي ثم ينظر بدعوى في هذه الحالة يتنحى. من مصلحة القضاء الإداري لتقليل الدعاوى أن يبصِّر الإدارة بالطريق الصحيح فإذا اتبعت رأيه قلت الدعاوى وقلت حالات الطعن ويمكن إعتبارها إدارات تُساهم في تحقيق حالات الطعن كما هو الحال في التظلّم أمام نفس الهيئة مصدرة القرار.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
أعتقد أنه أشغال القاضي في أكثر من مجال يخلق لديه مشكلة كبيرة جداً حتى في الإعارات تخلق مشكلة كبيرة جداً لأجل هذا أتوقّع فصل عمل القاضي تماماً أفضل على رغم المنهج الذي اتبعه مجلس الدولة الفرنسي.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
لا خلاف بيننا نهائياً المسميات خلفت مشكلة وكلها تندرح تحت القضاء الإداري. إنتداب القاضي لدى الإدارة وإبداء الرأي كلها تقلّل النزاعات أمام القضاء الإداري. نحن إقتربنا من المفاهيم.
وأبدى القاضي حاتم بن خليفة ردوداً حسب القانون التونسي.
د. سوسن شندي – السودان:
ناقشت مع الرئيس موضوع إتحاد المحاكم الإدارية وتمنت التوفيق وأبدت رغبة السودان للإنضمام وأنها لم تدعى وتمنّت أن يفعّل الإتحاد.
اعتبرت أنه يفترض في القرار الإداري صحته ومشروعيته وعليه فمن يدع عدم صحة قرار إداري فيتقدّم بدعوى إلغاء القرار الإداري وإثبات ما يدعيه وهي دعوى شكلية لها شروط شكلية معدّدة الأسباب والعيوب على أساس أن الدعوى وسيلة وضعت بين يديّ صاحب المصلحة باللجوء إلى القضاء لحماية حقّه. مقرّرة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإداري في ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته.
والسودان يتبع نظام القضاء الموحّد. ويضمن القضاء الإداري الموحّد للمتقاضين مميّزات النظام الآخر وضمان تخصّص قضاة المحاكم الإدارية وخضوعهم للتدريب قبل وأثناء الخدمة وعرضت لآراء بعض الفقهاء في تفضيل النظام المزدوج فيما أيّدت هي النظام الموحّد القائم.
ثم تحدّثت عن مراحل تطوّر القانون حتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005 الذي رسم كيفية الطعن ضد القرار الإداري غير المشروع مبيّناً إجراءات رفع الطعن ومشتملات العريضة وتحديد ميعاد الطعن وأسبابه وكيفية إصدار الحكم والطعن فيه وكيفية تنفيذ الحكم.
ومن المعروف أن قواعد القانون الإداري جميعها غير مقننة ويرجع ذلك إلى تشعّب مجالاته وسرعة تطوّره لذلك ترك الأمر للقضاء ومن خلال التطبيق كشف القصور وإيجاد الحلول.
والقضاء السوداني ليس قضاءً إدارياً كاملاً بل هو قضاء إلغاء وتعويض.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
الأقرب أن العقد الإداري هو إختصاص إداري.
د. سوسن شندي – السودان:
هي عقود بين طرفين أعطي للقضاء العدلي نتمنى أن يتمّ إنشاء قضاء إداري في السودان.
المستشار محمود رسلان – مصر:
هناك نصّ في القانون يجرم الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام المحكمة هل هناك وجود لمثل هذا النص في قوانين السودان؟
د. سوسن شندي – السودان:
الدستور ينصّ على إلزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء هناك نصّ دستوري لكن السلطة العامة تتذرّع بأسباب المصلحة العامة هناك مشاكل لكن نحن نعتمد حسن النيّة أنا أنادي أن يكون هناك تشريعات تلزم بتنفيذ أحكام المحكمة.
أ. حاتم خليفة – تونس:
نظام قضائي موحّد وهناك قضاة إداريين في دوائر مختصة وهذا يعارض النظام القضائي الموحدّ؟
ثم تحدّث عن أن النظام القضائي السوداني بين المتقاضين إنما القاضي الإداري يحمل الإدارة مسؤوليات أكثر لأنها تملك السلطة والوثائق.
د. سوسن شندي – السودان:
في السودان نظام قضائي موحّد وهناك محاكم إدارية متخصّصة فيها قضاة إداريون متخصّصون.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
المتقاضون متساوون أمام المحكمة لكن بالنسبة للإثبات، فالإدارة لأنها الطرف الأقوى، فهي ملزمة أكثر.
وجرى نقاش حول صلاحيات القضاء الإداري في السودان حيث أكّدت د. سوسن أن كل القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة تخضع للطعن.
المستشار عقيل باعلوي - سلطنة عُمان:
واقع القضاء الإداري في سلطنة عُمان.
إعتبر أن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثّراً في تاريخ الشعوب ليصل إلى أن القضاء الشرعي صاحب الولاية العامة حيث اعتبر أن عام 1970 نقطة تحوّل في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السلطنة ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 26/75 حيث صدر أول تنظيم قانوني للمحاكم الشرعية وأسند بموجبه إلى وزارة العدل إختصاصات هي:
- الإشراف على المحاكم الشرعية ورفع كفاءة أدائها وسرعة فصلها في القضايا.
- النظر في الإستئنافات ضد أحكام المحاكم الشرعية.
- الإشراف على شؤون القضاة وموظفي المحاكم.
- الإشراف على أية محاكم أو أنظمة قضائية تنشأ مستقبلاً.
ثم تحدّث عن التنظيم القانوني والإداري في سلطنة عُمان وعدّد القوانين التي نظّمت الجهاز الإداري للدولة وقانون الجزاء العُماني وقانون العمل وقانون تنظيم القضاء الجزائي وقانون الشركات التجارية وقانون المحكمة التجارية وتحدّث عن الدعاوى التجارية والضريبية والدعاوى الجزائية ودعاوى الإيجارات ودعاوى شؤون الأراضي ودعاوى الموظفين ليصل إلى الحديث عن القضاء الإداري في تلك المرحلة حيث اعتبر أنه من عام 1970 وحتى عام 1999 لا يمكن أن يقال بوجود قضاء إداري وفقاً لمفهومه الحديث كما أنه لا يمكن القول أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر الخصومات الإدارية خلال المرحلة السابقة.
ومع صدور قانون السلطة القضائية عام 1999 الذي نصّ في المادة 67 على وضع حجر أساس لقضاء إداري يكفل حماية الحقوق والحريات العامة.
ثم تناول فكرة اعتناق السلطنة للقضاء المزدوج معرّجاً على تجربة فرنسا ومصر ليصل إلى الحديث عن الأساس الدستوري والقانوني للقضاء الإداري ليتناول بعد ذلك محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان مع صدور المرسوم السلطاني رقم 91/99 حيث تحدّث عن تشكيل وترتيب المحكمة بدائرتها الإبتدائية ودائرتها الإستئنافية واختصاصاتها وتوسيع هذا الإختصاص بالمرسوم السلطاني رقم 3/2009 ليحدّد ما يخرج عن سلطان هذه المحكمة.
بالنسبة للفتوى والتشريع عندنا في سلطنة عُمان وزارة الشؤون القانونية مختصّة بإبداء الرأي والمشورة وليس من إختصاص القضاء الإداري.
يأتي بعد السلطان وزير الديوان لكن الآن أستقلّ القضاء الإداري يتبع للسلطان مباشرة والقضاء العادي خرج من سلطة وزارة العدل له مجلس قضاء أعلى يرأسه السلطان نائبه رئيس المحكمة العليا وله مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
جميع الخصومات الإدارية ترفع أمام القضاء الإداري حتى الأعمال المادية وكذلك العقود الإدارية.
د. محمد رسلان – مصر:
فكرة المقاصة عن التعويض نرجو شرح هذه النقطة وإعطائنا أمثلة.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
أحياناً تأتي مؤسسة لإنشاء مشروع مرفق عام بالتعاون مع مؤسسة لا يوجد لوائح تنظّم هذه العملية فلا يمكن مطالبته، فأخضعت المنازعات لصلاحية القضاء الإداري.
الوزير الذي لا ينفّذ حكم قضائي يمكن مقاضاته والموظف إذا تعرّض لإهانة من مسؤوله يمكن تقديم شكوى أمام الإدّعاء العام ومقاضاته.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
أثرت موضوعاً حول المسؤولية عن المخاطر والمسؤولية الموضوعية دون خطأ وقد وردت في القانون الدولي يتعيّن أن نوليها إهتماماً والعناية بها أو حتى بأن يكون محوراً وتعاني منه الدول النامية كالأضرار التي تعاني منها الدول بسبب التجارب النووية.
القاضي عدنان الشعيبي – فلسطين:
إعتبر أن القضاء يمثّل الركيزة الأساسية للحفاظ على الحريّات العامة ومع تطوّر القوانين وتشابك العلاقات ظهرت الحاجة لنشوء قضاء متخصّص ويختصّ بفضّ المنازعات الناشئة بين الأفراد والسلطة الإدارية كونه قضاء يتميّز بأنه قضاء إنشائي فدوره لا يقتصر على تطبيق القواعد القانونية بل يتعدّى لإنشاء مبادئ قانونية.
ثم تناول مفهوم القضاء الإداري واعتبره هيئة قضائية مستقلّة واعتبر أن بداياته ظهرت في فرنسا ونشأت فكرته مع الثورة الفرنسية عام 1789 واعتبر أن بعض الدول العربية كمصر والعراق والأردن إتّجهت نحو القضاء الإداري ثم تحدّث عن القضاء الإداري تاريخياً بادئاً منذ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ليتحدّث عن القضاء الإداري خلال حقبة الإنتداب البريطاني والفرنسي في فلسطين التي تسير بالنظام القضائي الموحّد حيث أصدرت بريطانيا قانون المحكمة العليا الفلسطينية وجعل لها إختصاص المنازعات ذات الطابع الإداري ثم في ظلّ الخضوع للحكم الأردني حيث ساد قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 1952، ثم تحدّث عن القضاء الإداري في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تمّ تأسيس مجلس القضاء الأعلى واتّجه المشرع إلى الأخذ بنظام القضاء المزدوج لكنه عاد وأبقى لمحكمة العدل العليا صلاحية النظر بالمنازعات الإدارية.
ثم تناول صلاحيات محكمة العدل العليا الفلسطينية وفق قانون رقم 5 لسنة 2001 وعدّدها وعرض لبعض التوصيات في الخاتمة.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
نشكرك على هذا العرض التفصيلي.
د. سوسن شندي – السودان:
إتّضح لنا توسّع في صلاحية القضاء الإداري ولكن جعل هذه الصلاحية من إختصاص المحكمة العليا وهذا يشغل القضاء.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
بالنسبة للإدارة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
الحقيقة هناك العديد من القرارات التي تُعنى بهذا الموضوع.
ولدينا موقع إلكتروني يمكن البحث فيه وكل سنة نطبع في كتاب خلاصة القرارات الصادرة عن القضاء الإداري.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
إعتبر أن الدول تمارس مهامها عبر نشاط تقوم به وحدات متخصّصة بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها التي تمنحها صلاحيات وامتيازات لتقوم بوظائفها في حدود المشروعية. وليس للأفراد من ملجأ لإسترجاع حقوقهم إلاّ باللجوء إلى القضاء ونظراً لإختلاف طبيعة النشاطات كان لا بدّ من وجود قضاء متخصّص لفضّ المنازعات ومن هذا الإطار كان لا بدّ من وجود قضاء مهمته سماع الدعاوى المتعلّقة بنشاط الإدارة المتمثّل في صورة قرارات وأنشطة وعقود إدارية.
وفي فصل أول تناول نشأة القضاء الإداري في ليبيا معتبراً أن ليبيا لم تعرف نظام القضاء الإداري بمفهومه المعاصر خلال فترة الحكم العثماني ولا أيام الإحتلال الإيطالي ولا في عهد الإدارة البريطانية الفرنسية وفي عام 1951 أسند المشرّع الليبي للمحكمة العليا مهمة الفصل في المنازعات الإدارية وأسندت إلى إحدى دوائر المحكمة حيث اقتبس المشرّع الليبي الإختصاصات الممنوحة من المشرّع المصري لمجلس الدولة، حتى صدور القانون رقم 88 لسنة 1971 حيث تمّ إنشاء دوائر خاصة في محاكم الإستئناف تتولّى الفصل في المنازعات الإدارية يتمّ الطعن بأحكامها أمام المحكمة العليا.
ثم تناول المنازعات التي تتولاها هذه المحاكم واختصاصاتها والدعاوى التي يتناولها القضاء الإداري وهي دعاوى الإلغاء ودعاوى التسويات الوظيفية وتلك المتعلّقة بالعقود الإدارية.
ثم تناول مراجع الطعن وأسبابه كعيب عدم الإختصاص وعيب الشكل وعدّد حالات بطلان القرارات الإدارية لعيب الشكل وعيب مخالفة القانون أو عيب محل القرار الإداري وعيب السبب أو إنعدامه كعيب إساءة السلطة.
ثم تناول في الفصل الثاني مميّزات وعيوب القضاء الإداري في ظلّ وحدة القضاء كما في ليبيا فاعتبر أن المميّزات أهمها:
- التوسّع الأفقي في جهاز القضاء الإداري.
- التوسّع رأسياً في جهاز القضاء الإداري.
- أفسح المجال أمام بناء وخلق قضاء إداري مستقلّ.
أما العيوب فهي:
- أن المنازعات الإدارية عهدت إلى دوائر القضاء على سبيل الحصر.
- جعل محاكم القضاء الإداري مجرّد دوائر مشتقّة من محاكم القضاء المدني.
- عدم خلق كوادر قضائية متخصّصة بالمنازعات الإدارية.
- عدم تطوّر قواعد وأحكام القانون الإداري.
ثم عالج إمكانات تطوّر نظام القضاء الإداري في ظلّ القضاء الموحّد مقترحاً خلق قضاء إداري إبتدائي ثم إستئناف ونيابات إدارية لتوفير ضمانات أكبر يتمّ به تلافي عيوب النظام القائم في حين أخذ جانب كبير من الفقه نظام إزدواج القضاء داعين إلى الأخذ بنظام مجلس الدولة تناول موضوع مدى الحاجة إلى قضاء إداري مستقلّ ليصل إلى مدى قدرة المنظومة القضائية الليبية لإنشاء قضاء إداري مستقلّ.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
نبدأ بالمحور الرابع حول مدى فاعلية إستحداث قضاء إداري مستقلّ.
المستشار محمد رسلان – مصر:
إنطلق في مقدمته أن الدول إنقسمت في إعتناق النظام القضائي الذي يحقّق لها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
ثم إنتقل للحديث عن نظام القضاء الموحّد الذي يقوم على فكرة مؤدّاها أن تتولّى المحاكم العادية على إختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات الإدارية بالإضافة إلى باقي المنازعات. وتابع متحدّثاً عن نشأة هذا النظام والعمل به في الدول الأنكلوساكسونية حيث باشر القضاة في أميركا وبريطانيا رقابة واسعة على أعمال الإدارة. وذكر أن هذا النظام يتميّز في أنه لا تثور فيه إشكاليات تنازع الإختصاص وتطبيق ذات الإجراءات المطبّقة على الدعاوى المدنية والتجارية وأن أحكامها تخضع لرقابة محكمة النقض بالإضافة إلى الإستفادة من ميزة القرب من المتقاضين.
ثم أكّد على أن التجارب التاريخية تنطق بالعجز عن أعمال رقابة فعّالة ومرنة بالإضافة إلى عدم توفّر النشأة والبيئة والقدرات الفنّية والتأهيل اللازم للقضاة لذلك ظلّت الرقابة بعيدة عن تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق والحريّات العامة للأفراد ومقتضيات المصلحة العامة.
ثم إنتقل للحديث عن نظام القضاء المزدوج معتبراً أن هذا النظام نشأ كنتيجة لظروف سياسية وتاريخية متحدّثاً عن هذه الظروف في فرنسا حتى أنشأ نابوليون مجلس الدولة عام 1799 ومنحه الإختصاص بإعداد مشروعات القوانين ولوائح الإدارة وحلّ المشكلات في المجال الإداري.
واعتبر أن هذا المجلس تميّز ببراعته في أداء إختصاصاته حتى غدا حصناً للحقوق والحريّات العائدة للفرنسيين وتجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات حتى أصبح باعثاً لتأخذ بهذا النظام العديد من الدول.
ثم إنتقل للحديث عن التجربة المصرية التي أخذت بنظام القضاء الموحّد زمناً ليس قصيراً ثم عرض لهذه التجربة زمن الإحتلال البريطاني حتى صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة المصري. معتبراً أن إختصاصات هذا المجلس لو أسندت للقضاء العادي لما تطوّرت نظريات القانون الإداري في مصر ولا كان المجتمع المصري إستفاد من تطبيقات هذا المجلس ثم تحدّث عن أقسام وإختصاصات المجلس ليصار إلى ضرورة تطوّر الحركة الوطنية وإقرار السلطة الحاكمة بتحقّق واقع جديد وثبات إرادة عامة على إقرار مبدأ سيادة القانون وختم بمقولة للفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
شكراً للأستاذ محمد رسلان على هذا العرض وعرض مجدّداً لفكرة القضاء الإداري المستقلّ وجدواه والحاجة لقضاء إداري متخصّص وذكر أن أمهر القضاة يعملون في قسم الفتوى. نفتح باب المناقشة.
السيد حاتم بنخليفة – تونس:
أردت الإستفسار حول بعض الإختصاصات. هل إخراج الطعن بالأمور المتعلّقة بالسيادة هل فيه نصّ؟
ما الجدوى من إحداث محاكم تأديبية طالما القرارات التأديبية هي قرارات إدارية؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
بالنسبة للقرارات المتعلّقة بالسيادة هي سوابق قضائية وليس موجوداً بالنص هو فقه قضائي مصري. المسألة تضيق وتتوسّع حسب الظروف وهي في مصر ضاقت إلى أقصى حدّ جميع القرارات الصادرة عن السلطة بجميع أجهزتها وتخضع لرقابة القضاء.
أما القرارات التأديبية فهي أما رئاسي أما إداري. القضاء المصري إتّجه إلى جعل بعض الصلاحيات من إختصاص المحكمة وليس الرئيس ولذلك أسّست محاكم تأديبية.
لدينا محاكم إدارية ومحاكم قضاء إداري بسبب توزيع العمل.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
ما المُراد من هذا التوزيع أو التقسيم؟ هل يرتّب فائدة معيّنة؟ وقراراتها قابلة للطعن؟
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
هي عملية تنظيمية لا أكثر، وقراراتهم تقبل الطعن.
المستشار محمد رسلان – مصر:
هو تقسيم ضروري وبالغ الأهمية خاصة إذا علمتم أن هناك ستة ملايين موظف، فتخيّلوا حجم القضايا.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
بالإضافة إلى ما يتحمّله مجلس الدولة من قضايا في أمور أخرى هناك محاكم مختصّة بالجامعات وأخرى مختصّة بمراكز البحوث وغيره.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
علاقة القاضي بالإدارة ليست علاقة خصومة. نحن نراقب حتى العقود مراقبة مسبقة وأخبرني زملائي أنهم بواسطة هذه الرقابة قد وفّروا ضياع مليارات الدولارات.
القاضي محمد الحافي – ليبيا:
إدارة الفتوى والتشريع عندنا كانت جهة مستقلّة تابعة لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
هل الإدارة ملزمة برأي دائرة الفتوى وبالإستشارة التي يصدرها مجلس الدولة؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
أبداً، هي غير ملزمة.
القاضي عدنان شعبي – فلسطين:
إذا أخذت الإدارة برأي وإستشارة مجلس شورى الدولة وطعن بالتشريع أمام المجلس الدستوري؟ فما هو موقف مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
لم يحدث مطلقاً أن طعن بتشريع أخذت فيه الإدارة برأي واستشارة مجلس الدولة.
المستشار نويري عبد العزيز – الجزائر:
الجزائر كانت عبارة عن مستعمرة فرنسية، وكان شبيه ما يجري في فرنسا يطبّق في الجزائر. بالنسبة للقضاء الإداري بعد الإستقلال تمّ إستحداث هيئة قضائية عليا سمي مجلس القضاء الأعلى ثم المحكمة العليا وظلّت ثلاث محاكم موروثة من الإحتلال تمارس عملها حتى عام 1966 حيث صدر قانون التنظيم القضائي وأنشئت غرفة إدارية في جسم القضاء الموحّد وظلّ ذلك حتى 1998 حتى أنشىء مجلس الدولة ولكن ظلت الغرف الإدارية في الجسم القضائي تعمل حتى عام 2009 أنشئت المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ونحن بصدد مشروع إنشاء محاكم إستئناف إدارية ويتحوّل مجلس الدولة إلى هيئة عليا بدل أن يكون جهة إستئناف. ولقد إستعنا بقضاة الغرف الإدارية في القضاء لملء الشواغر كما أنه سابقاً تمّ تعيين طلبة الحقوق في السنة الثانية قضاة وكذلك كتاب الضبط.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
الإتحاد العربي للقضاء الإداري سوف يقوم بإعداد دورات تدريبية لتأهيل القضاة ومفوّض الدولة له دور هامّ غير تحضير الدعوى وإبداء رأي فيها وحتى لو قدمت أمام مجسل الدولة وله عرض الصلح على الأطراف.
يرجى تحضير أعداد القضاة الذين يرغبون بالمشاركة بالتأهيل في الدورات التدريبية.
ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
اعتبر أن السيادة آخذة في الإنكماش أمام إحترام مبدأ سيادة القانون وتوسّع رقابة القضاء في الدول الديمقراطية التي أصبحت مقيّدة سيادتها بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ثم ميّز بين مفهوميّ الإرتباط والتبعية وتأثيرهما على الإستقلال بالنسبة لعمل الإدارة.
ثم إنتقل للحديث عن أهمية دور القضاء المستقلّ الذي يحقّق التوازن بين السلطة الحاكمة ومعارضة وأفراد بحاجة لحماية القضاء ليصل بعد ذلك للحديث عن التطوّر التاريخي للقضاء الإداري فتحدّث عن واقعة في العصر الإسلامي ونشأته الحديثة في فرنسا والمراحل التي مرّ بها والقوانين التي صدرت وكفاح هذا القضاء حتى أصبح مثلاً يُحتذى فاتبعته دول كثيرة.
بعد ذلك تحدّث عن القضاء المزدوج والقضاء الموحّد مؤيّداً فكرة الأخذ بنظام القضاء المزدوج معتبراً أن الإنتقادات الموجهة للنظام المزدوج قد تخطّاها الزمن ذاكر العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام متحدّثاً عن تجربة القضاء في مصر وسوريا ولبنان والقوانين الصادرة في هذا الشأن تاريخياً حتى استقرّت على القضاء المزدوج.
المستشار نويري عبد العزيز – الجزائر:
في ورقة عمل مقدّمة منه عن عقود إلتزامات المرافق العامة (BOT):
إعتبر أن عقود البناء والإستغلال والتحويل الـ BOT تجد مصدرها في القوانين الأنكلوساكسونية بينما الدول اللاتينية والتي تأخذ بنظام إزدواجية القضاء كفرنسا والدول التي تسير في فلكها لا تتضمن هذه العبارة بالإضافة إلى القانون الأنجلوسكسوني لا يعترف بوجود عقود إدارية متميّزة عن العقود العادية وذلك من عدم إعترافه بوجود قانون إداري وقضاء إداري مستقلين.
وأن هذه الدراسة تطرح إشكالية تكمن في تحديد مفهوم الـ BOT ومدى نجاعته كوسيلة للتنمية الإقتصادية في الدول النامية.
فتناول أولاً ماهية عقود الـ BOT فتناول تعريفها عند الفقه القانوني وما جاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ثم تناول الصور المختلفة لعقود الـ BOT من جهتي الصور التعاقدية المنصبة على مشاريع جديدة وتلك المنصبة على مشاريع قائمة.
ليصل إلى الحديث عن فوائد المشاريع الإقتصادية عبر وسيلة الـ BOT فعدّدها:
- إقامة مشاريع جديدة.
- مساهمة الرأسمال الخاص في حلّ مشكلة المديونية للدولة.
- إستفادة الدولة من التطوّر التكنولوجي والتقنيات الحديثة.
- خلق مناصب شغل جديدة.
- إستغلال رأسمال القطاع الخاص.
- تفادي سلبيات الإقتراض.
- خلق نوع من المنافسة.
- تنشيط وتطوير مجالات إقتصادية كانت مهمّشة.
ليتناول بعد ذلك فوائد هذه العقود.
وفي ثالثاً تحدّث عن الطبيعة القانونية لعقود الـ BOT على أنها عقود ذات طابع إداري وفق التشريع الجزائري ومن الناحية الفقهية أنها تحتل موقعاً وسطاً بين عقود الإمتياز وعقود تفويض المرفق العام ومع ذلك فهو يعتبرها عقد إداري بصفة أساسية.
ثم تناول الإلتزامات المتبادلة بين أطراف عقد الـ BOT والعقود المشابهة له مثل عقد الإمتياز وعقد الأشغال العامة وعقد الخصخصة وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تفويض المرفق العام وتحدّث عن النقاط المشتركة ونقاط الخلاف مع عقود الـ BOT في كل منها.
ثم تحدّث عن طريق تسوية المنازعات الناتجة عن عقود إلتزامات المرافق العامة BOT فعالج الطرق الودّية والتحكيم ثم التقاضي وما اعتمده المشرّع الجزائري في القانون الجزائري.
وفي الخلاصة هي لم تكن سكسونية وكانت موجودة في القوانين اللاتينية لكن التسمية وجدت في القوانين الأنكلوسكسونية.
د. عبد اللطيف نايف – العراق:
عقود إلتزام المرافق العامة BOT البناء والتشغيل والتمويل (نقل الملكية).
إعتبر أن الدول تسعى إلى إستخدام أسلوب جديد في إدارة مشاريعها لا سيما المشاريع الضخمة وذلك مع أشخاص القطاع الخاص عن طريق إبرام عقود وهو ما عُرف بنظام الـ BOT وقد نشأت هذه الفكرة لخدمة أغراض التنمية وانحدرت هذه الفكرة من نظريات القانون الإداري كتطوّر تاريخي لعقد إلتزام المرافق العامة. وهو من ثلاث مراحل مرحلة تحضيرية ومرحلة تنفيذ المشروع بناءه وتشغيله وإدارته والمرحلة الثالثة يتمّ فيها نقل ملكية المشروع للدولة مانحة الإمتياز. وترتّب هذه العقودآثار مباشرة إيجابية وتحدّ من الآثار السلبية وتكمن أهميتها أنها أحد نماذج الإستثمار الدولي.
ثم إنتقل إلى تعريف عقد الـ BOT ليتحدّث بعد ذلك عن خصائص هذا العقد كما يلي:
- أحد وسائل تمويل المشاريع العامة.
- إنشاء مرافق عامة لإشباع حاجات عامة وتقديم خدمات ذات نفع عام.
- فيه تتولى الدولة مهمة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد.
- ملكية المشروع تعود إلى الدولة.
ثم إنتقل إلى الحديث عن أهمية عقود الـ BOT في أنها تجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتخفّف العبء عن الموارد المالية الحكومية المحدودة وتساعد في إقامة مشاريع ومرافق جديدة وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الإقتصادية وتمكّن الحكومات من الإستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمكين المستثمرين من تحقيق أرباح كبيرة تفتح الباب أمام مؤسسات التمويل عن طريق تحريك أموالهم.
ثم عالج التكييف القانوني لعقود الـ BOT واعتبر أنه عقد إداري ذو طابع دولي وأنه يخضع لنظام قانوني واحد ليصل إلى تناول مجالات إستخدام مثل هذه العقود واعتبر أنه تستخدم في:
- مشروعات البنية الأساسية.
- المجمعات الصناعية.
- تنمية واستغلال الأراضي المملوكة للدولة.
ثم عدّد مخاطر هذه العقود ومراحل تنفيذ المشروعات في هذه العقود وصور وأشكال عقود الـ BOT فعدّدها كما يلي:
1. عقد البناء والتملّك والتشغيل والإعادة (B.O.O.T)
2. عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (D.B.F.O)
3. عقد البناء والتمليك والتأجير والتمويل (B.O.L.T)
4. عقد التأجير والتجديد والتشغيل ونقل الملكية (L.R.O.T)
5. عقد البناء ونقل المليكة والتشغيل (B.T.O)
6. عقد البناء والملكية والتشغيل (B.O.O)
7. عقد التحديث والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (M.O.O.T)
ثم عالج الآثار القانونية لهذه العقود فتناول:
- الرقابة على تنفيذ العقد.
- تعديل العقد.
- إتباع الجزاءات.
- إلتزامات الدولة.
كما عالج حقوق وإلتزامات المستثمر أو الشركة والإمتيازات والضمانات التي يتمتّع بها ليصل إلى الحديث عن تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود.
د. سوسن شندي – السودان:
حول عقود الـ BOT.
اعتبرت في مقدمتها أن الجميع في الدولة يخضع للقانون وعلى الدولة والعاملين لديها أن يكون عمله في حدود القانون وهذا ما يعرف بمبدأ المشروعية ولذلك لا بدّ من وجود رقابة قضائية لرفع الظلم عن الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وبين حماية حقوق الأفراد. وقرّرت أن الشرعية الإدارية المقصود بها خلو القرار الإداري من العيوب التي تمسّ بشرعيته ثم تناولت الضوابط التي وضعها المشرّع لممارسة الرقابة.
وفي حديثها عن عقود إلتزامات المرافق العامة اعتبرت أن القضاء الإداري في فرنسا وضع أسسها وصاغ خصائصها معرِّفة العقد الإداري حسبما إستقرّ عليه القضاء. وأن عقود الـ BOT من العقود الإدارية التي شهدت إنتشاراً في كثر من الدول وأن له دور مهمّ في إنشاء مشروعات البنية الأساسية والتنمية وأنه إمتياز تمنحه الدولة. ثم ذكرت تعريف الأوسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) لتعتبر أنه عقد ذو طبيعة خاصة وقواعده من قواعد الإدارة العامة إلاّ أن له طبيعة قانونية خاصة تميّزه عن غيره من العقود وأنه في السودان يخضع للقضاء العادي لأن القضاء الإداري في السودان ليس قضاءً كاملاً وإنما قضاء إلغاء إنما دعوى التعويض ترفع أمام القضاء الإداري تبعاً لدعوى الإلغاء. مشيرة إلى أن القانون الإداري لسنة 2005م عرَّف القرار الإداري بأنه يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معيّن متعلّق بحقّ أو واجب شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتّخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتّخاذه.
المستشار عقيل باعلوي - سلطنة عُمان:
كثر اللجوء إلى أسلوب العقد كوسيلة للدولة للحصول على ما تحتاجه من أغراض وخدمات ومواد وكوسيلة لتنفيذ السياسة الإقتصادية للدولة.
ثم تحدّث عن أهمية العقد الإداري حيث اعتبره أنه الأسلوب الأول في الحياة القانونية والإجتماعية والإقتصادية للدولة لحاجتها لمتعاقدين يساعدونها في الوفاء بحاجاتها وتنفيذ برامجها وخططها مشيراً إلى أن الفقهاء يعتبرون العقد الإداري أسلوب من أساليب ممارسة الإدارة لنشاطها وأن أهميته سوف تزداد بسبب الإنتقال من إقتصاد التخطيط إلى إقتصاد السوق، حيث أصبح العقد الأسلوب الأمثل لتحقيق أهداف الدولة.
ثم إنتقل للحديث عن تطوّر العقد الإداري وفقاً لنظام الـ BOT نظراً لإنتهاج الدولة سياسة الإقتصاد الحرّ بأسلوب الخصخصة عن طريق بيع شركات القطاع العام بهدف مشاركة القطاع الخاص لإنشاء مشروعات النفع العام وتمويلها متحدّثاً عن نظام الـ BOT بأنه إختصار لمصطلح الإنشاء ثم التشغيل ثم نقل الملكية للدولة.
ثم قدّم نبذة تاريخية عن عقود الـ BOT وخلفيتها الإقتصادية واعتبره من أهم آليات تنشيط الإقتصاد واستثماراته التي لاقت تأييداً ومساندة من قبل البنك الدولي.
ليصل إلى الحديث عن ماهية عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية معتبراً إياها عقود إمتياز لبناء وتشييد وإدارة مشروعات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص معدّداً المنافع والمزايا التي تستفيد منها الدولة:
1. بناء المشروعات الأساسية.
2. عدم اللجوء للصرف من الميزانية العامة.
3. الحصول على التقنية العالمية الحديثة اللازمة للمشروعات.
ثم تحدّث عن تعريف عقود الـ BOT وعناصرها الأساسية وعدّد الإتفاقيات التي يشتمل عليها هذا النظام وأنها تبرم بموافقة الحكومة وبشروطها. بعد ذلك عدد أشكال عقود الـ BOT:
- البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)
- البناء والتملّك والتشغيل (BOT)
- البناء والإيجار والتشغيل ونقل الملكية (BLT)
- الإيجاد والتجديد والتشغيل ونقل الملكية (LBOT)
- البناء ونقل الملكية والتشغيل (BOT)
ليصل إلى الحديث عن التكييف القانوني لعقد الـ BOT ثم يتناول عقود BOT في سلطنة عُمان.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
اعتبر في المقدمة أن عقود الـ BOT هي إحدى الطرق المتّبعة من قبل الإدارة لإدارة المرافق العامة التي يتبع في إدارتها أسلوب الإدارة المباشرة على النقيض من المرافق العامة الصناعية والتجارية التي يتبع في إدارتها أسلوب الإدارة غير المباشرة.
وطريقة الإدارة الـ BOT لم تكن متّبعة في لبنان حتى بداية التسعينات حيث بدأ مع شركات الهاتف الخليوي وشركة البريد.
ثم تحدّث عن أنواعها:
- عقد الـ BOT
- عقد الـ BOOT
- عقد الـ BLT
متحدّثاً عن تسميتها ووظائفها وأطرافها وخصائصها وإلتزامات الأطراف. مشيراً في الخاتمة إلى أن المرفق العام وفقاً لنظرة بعض الدول ليس سوى مشروع يتمّ من خلاله الدخول إلى المنظومة الدولية في سبيل تحقيق أهداف مالية وإقتصادية.
د. سوسن شندي – السودان:
المحور الثالث: المستجدّات في قضاء الإلغاء والتعويض:
لما كان القضاء الإداري في تطوّر مستمرّكان لا بدّ من تطوير آليات قضاء الإلغاء والتعويض لإجبار الإدارة على إحترام القانون خاصة وأن هذا النوع من القضاء أقلّ كلفة من القضاء العادي لأنه وضع من أجل ضمان حقوق وحريّات المواطن وبناء دولة القانون ولا يمكن ذلك إلاّ بخضوع الإدارة وتنفيذ أحكام المحاكم ولما كان القضاء الإداري السوداني يغلب عليه طابع الإلغاء فإن كثيراً من المحاكم لا تصدر غير الأمر بالإلغاء للقرار الإداري غير المشروع وتخطر به الإدارة وتتوقّع من الإدارة أن تستيجب وتعيد الحال إلى ما كانت عليه إلاّ أن الإدارة في معظم الأحوال لا تستجيب لذلك فإن الإصلاح التشريعي أتى بفرض غرامات تهديدة على الموظف الممتنع عن التنفيذ. وقد تتذرّع الإدارة بعدّة أسباب لعدم التنفيذ منها السياسة العامة للمؤسسة الإدارية أو الصالح العام. ومن المستجدّات الوصول إلى إتفاق عام على قواعد الإثبات الحرّ في الدعوى الإدارية ويحقّق الإثبات مصلحة إجتماعية عامة هي حسم المنازعات ورغبة من القضاء الإداري في تحقيق العدالة في ظلّ عدم التوازن بين أطراف الخصومة الإدارية فقد منح القاضي دوراً إيجابياً في الدعوى الإدارية وهو ما يُعرف بالإثبات الحرّ فلا يكون القاضي ملتزماً بطرق معيّنة في الإثبات فللقاضي حقّ الإستعانة بالخبرة للبحث عن الحقيقة والإستعانة بوسائل إثبات لم يطلبها الخصوم وله حقّ إستنباط وقائع مجهولة من وقائع معلومة واللجوء إلى القرائن.
لتصل إلى خاتمة تقرّر فيها تعزيز دور القضاء الإداري في السودان وضرورة التعديل المستمرّ للقانون الإداري وفقاً للتطوّرات كما أن هناك ضرورة أن تزيل الدولة المعوقات التي تواجه القضاء في إطار الرقابة على القرارات.
وقد أثار بعض الأعضاء تساؤلات عن أهمية وجود مركز تحكيمي تابع للإتحاد العربي للقضاء الإداري للنظر في كل ما يتعلّق بنشوء المنازعات الخاصة بالإستثمارات في البلاد العربية.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
تحدّث عن عقود الـ BOT ومميّزاتها وأسباب النزاعات بشأنها وحلّ النزاعات الناشئة عنها وتحدّث عن التحكيم في عقود الـ BOT وجهة التحكيم واعتبر أنه يجب إيجاد جهة للتحكيم تؤمّن الضمانات اللازمة للدول العربية سيما وأن الطرف الأجنبي في عقود الـ BOT دائماً يشترط أن يكون التحكيم لدى مركز أجنبي. وأضاف أنه إذا لم يتمّ الإتفاق في العقد على مكان للتحكيم فيتمّ تنظيم مشارطة تحكيم.
أثير في هذا الشأن إلى أن هناك مركز تحكيم يتمّ النظر في إنشائه بالتعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة وهو ما تمّ عقد بروتوكول تعاون معها منذ شهرين للنظر في معظم أوجه التعاون مع الإتحاد في عدد من الحالات ومنها هذا المجال.
د. سوسن شندي – السودان:
توصية بمراجعة عقود الـ BOT قبل إبرامها من لجان متخصّصة. هل هناك ما يمنع في الإتحاد العربي من إنشاء كيان تنظيمي لمراجعة مثل هذه العقود؟
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
هذا أمر يتعلّق بالسيادة وأنا أقدّم إستشارة فيما يتعلّق بهذه العقود ونظام الأكاديمية العربية للعلوم البحرية أقرّ هذا النظام بحضور عدد كبير من الوزراء والفقهاء القانونيين أن يعتمد هذا المركز كبيت خبرة يقدّم الإستشارة لمن يرغب من الدول.
د. حسن شاهين – لبنان:
بعنوان الضمانات الإدارية والقضائية للموظف الدولي.
اعتبر أن العلاقات بين الدول تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتأخذ أحياناً صورة المرفق العام الدولي الذي يخضع في أعماله للسياسة التي يضعها ممثلو هذه الدول، وهكذا لا يخضع الموظفون الدوليون لأية سلطة إقليمية ليتمكّن من العمل على تحقيق الغاية التي أنشىء من أجلها. فالموظف الدولي يستمدّ وضعه القانوني من إتفاقية دولية وليس من نصوص القانون الداخلي.
ثم إنتقل للحديث عن الضمانات الإدارية للموظف الدولي فقرّر أنه يقتضي وجود جهاز محايد يستطيع توفير الحماية للموظف من التصرّفات الإدارية التعسّفية وهو ما أكّدت عليه عصبة الأمم المتحدة حول حقّ التظلّم من قرارات الفصل أمام مجلس العصبة ولكن الموظفين اعتبروا أن هذه الطريق لا توفّر الضمانات الكافية وخاصة أن جهة الطعن في عصبة الأمم ومكتب العمل الدولي لم يكن لها إختصاص قضائي بل يغلب عليه الطابع السياسي وقراراتها تتأثّر بالإعتبارات السياسية ومع إزدياد إستخدام الموظفين الدوليين ثم إنشاء أجهزة إدارية مختلطة تضمّ ممثلين عن الإدارة والموظفين الدوليين كأجهزة إستشارية قبل صدور القرارات وأخرى تصدر رأيها بناء على طلب الموظفين بالقرارات الإدارية الدولية.
فتناول في مطلبين الضمانات السابقة على صدور القرار الإداري والضمانات اللاحقة على صدور القرار الإداري وتحدّث عن تشكيل هذه الأجهزة واللجان وصلاحياتها ومدة عملها مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية سارت على نفس النهج ليتحدّث بعد ذلك عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتشكيلها ومواعيد إنعقادها وسبل إقامة الدعوى أمامها.
الجلسة الختامية
__________
لقد بدأت الجلسة بمناقشة مشاريع التوصيات المنبثقة عن المداولات والمناقشات التي دارت أثناء جلسات العمل طيلة فترة المؤتمر حيث أقرّ المجتمعون بالإجماع التوصيات الصادرة عن المؤتمر بالصيغة المرفقة.
كما توجّهوا بالشكر والإمتنان الكبيرين للمستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية على رئاسته لهذا المؤتمر وحسن إدارته له والتي تجلّت بالحكمة والدراية والكفاءة ومساهمته عبر أخلاقه القيّمة النابعة من العلم والمعرفة والتجربة مما أوصل المؤتمر إلى النتائج والتوصيات الهامة، مؤكّدين دعمهم وتأييدهم له في رئاسته للإتحاد العربي للقضاء الإداري.
كما يثمّنون ويقدّرون جهوده التي يبذلها في سبيل إعلاء شأن الإتحاد من خلال بروتوكولات التعاون التي ينظّمها ويعقدها مع المنظمات العربية والدولية في سبيل إعلاء وتطوير عمل القضاء الإداري في الدول العربية ويقدمون له الدعم الكامل في سعيه هذا.
وإنهم أيضاً إذ يتوجهون بالشكر إلى جميع الذين تقدموا لهذا المؤتمر بأوراق العمل التي أعدّوها حول محاوره والشكر موصول إلى جميع المشاركين على إسهاماتهم ومداخلاتهم العلمية مما أضفى على هذه المسيرة جواً بنّاءً وإيجابياً غنياً بالعلم والمعرفة في محاولة لتطوير العمل القضائي الإداري في الدول العربية يُضاف إلى بنيان مسيرة المركز ومسيرة العمل العدلي العربي المشترك.
كما يتوجهون بالتقدير والإحترام لسعادة السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي وإلى جميع مساعديه على الجهود التي بذلوها لإعداد وإنجاح وإدارة هذا المؤتمر، متمنين لهم دوام التقدّم والعمل على الإرتقاء بالمسيرة القانونية والقضائية التي يتولاها المركز على الصعيد العربي.
السفير عبد الرحمن الصلح المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا
الأمين العام المساعد رئيس مجلس الدولة/مصر
رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رئيس إتحاد القضاء العربي
" بمناسبة إنعقاد المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية [مجلس شورى الدولة، مجالس الدولة، المحاكم الإدارية، ديوان المظالم] أن أعبّر عن خالص السعادة والإعتزاز بلقائنا اليوم في مقرّ المركز العربي للبحوث القانونية الذي يؤكّد مدى حرصه على النهوض بالمستوى العام للمجتمعات العربية ومؤسساتها وعلى إرساء دعائم العمل العربي المشترك.
كما يشرّفني أن أنقل إلى الأخوة المشاركين في المؤتمر ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة هذه النخبة المختارة من رجال القانون والقضاء متمنياً لأعمالكم الخير والفلاح.
وبدوري أتوجّه إلى المشاركين في هذا اللقاء لما أبدوه من إهتمام لدفع عجلة العمل الإداري بإنتقالهم إلى بيروت شعوراً منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ومن هنا كان للمركز العربي دوره ومساهمته من خلال برامجه وندواته ومؤتمراته في النهوض بهذه الأعباء تحديثاً للتشريعات والقوانين والعمل معكم على توحيدها.
إن التعاون والتكامل العربي على أكثر من صعيد أصبح ضرورة بقاء وليس رفاهية إختيار وبدون ذلك لن نستطيع النهوض بهذه الأمة ومواجهة أسباب التشرذم والتخلّف.
إن جامعة الدول العربية حريصة أشدّ الحرص على إحتضان المبادرات البنّاءة والهادفة لتوحيد الصفّ وهو نهج اتّبعته وليس شعاراً رفعته، فالإجماع العربي على إنشاء إتحاد المحاكم الإدارية العربية هو إجراء هامّ يعود بالفائدة والخير على جميع الأقطار العربية خاصة في تطوير الفكر والقضاء الإداري.
وفي هذا المجال فإن الإهتمامات السابقة كانت لقاءات الإنجازات العامة ومن هنا تأتي أهميتها التي تسمح بمواكبة العصر واحتواء مستجدّاته ومتغيّراته.
وبهذه المناسبة أتوجّه بخالص الشكر والإمتنان لكل من ساهم في الإعداد لأوراق العمل، مع تمنياتي الخالصة بالتوفيق والنجاح ودوام التقدّم.
وفّقكم الله وسدّد خطاكم".
وتمّ اختيار المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية ورئيس الإتحاد العربي للمحاكم الإدارية، لرئاسة جلسات أشغال المؤتمر.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
أودّ في البداية أن أرحّب بالسادة الحضور ممن يمثلون مجالس الدولة والقضاء الإداري في الدول العربية وتحية للسفير الصلح وأشكره على ما ذكره في كلمته فهي تمسّ الهدف من هذا المؤتمر والكيانات التي ولدت في أحضان هذا المؤتمر على مدى السنتين السابقتين رؤي أن تتنوّع الموضوعات ومنها الموضوعات التي يشملها هذا المؤتمر وأرحب بسلطنة عمان لحضورها ومشاركتها في هذا الملتقى آمل أن تنضمّ سلطنة عمان للكيان الذي نشأ مؤخّراً لتكتمل الحلقة ونتمنى أن تشاركنا جيبوتي بعد إطلاعها على أهداف هذا الكيان للعمل من أجل الصالح التشريعي العربي.
نبدأ بالمحور الثاني: القضاء الإداري في الدول العربية (أنواعه وصلاحياته).
القاضي حاتم بن خليفة – تونس:
يمكن إرجاع نشأة القضاء الإداري في تونس إلى عام 1861 حين صدر أول دستور حيث فوّضت السلطة القضائية إلى مجلس أكبر عام 1881 مع توقيع معاهدة الحماية بين فرنسا وتونس ظهرت بوادر إزدواجية قضائية فأحدثت محاكم فرنسية إلى جانب محاكم تونسية شرعية ومدنية.
عام 1888 صدر أمر علي يتعلّق بالخصام الإداري الذي أوكل للمحاكم المدنية للنظر في النزاعات الإدارية إلى عام 1956 مع إستقلال تونس وصدور الدستور عام 1959 إقتضى أن المحكمة الإدارية تنظر في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والدولة والجهات العمومية.
ومع صدور قانون رقم 40 لسنة 1972 يتعلّق بالمحكمة الإدارية مما أدّى إلى ترسيخ نظامين قضائيين عدلي وإداري وقد زاد هذا التوجّه مع صدور قانونيّ 38 و39 لسنة 1996 لتنقيح شمل القانون الصادر لعام 1972 تمّ بمقضى هذا التنقيح إسناد دعاوى التعويض للمحكمة الإدارية بعد نزعه من المحاكم المدنية. وتمّ إنشاء مجلس تنازع الإختصاص بين المحاكم العدلية والإدارية.
عام 2014 صدر الدستور التونسي الجديد فأصبح القضاء الإداري يتكوّن من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية إستئنافية ومحاكم إبتدائية وأسند إلى القضاء الإداري صلاحية إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز حدّ السلطة وممارسة وظيفة إستشارية وتمّ ضبط الإجراءات لدى هذا القضاء والقانون لم يصدر بعد.
بعد ذلك تناول هيكلة القضاء الإداري في تونس وصلاحياتها فتحدّث في فرع أول عن القضاء الإداري الممثّل أساساً في المحكمة الإدارية ثم في فرع ثاني تناول موضوع توحيد القضاء الإداري صلب جهاز قضائي كامل ولا مركزي وفي الجزء الثاني تحدّث عن صلاحيات القضاء الإداري في تونس حول إعتماد المعيار المادة الإدارية ثم التطور المستمرّ في النزاعات المعروضة على القضاء الإداري.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
عرض السيد حاتم بن خليفة مراحل تطوّر القضاء الإداري في تونس وقال أن قضاء التعويض إنتزع من القضاء العدلي وأسند إلى القضاء الإداري. هناك بعض التشريعات تعدّد إختصاصات القضاء الإداري ثم نذكر قاعدة وسائر النزاعات الإدارية الأخرى وأشار إلى ذكره حول سلطة رئيس المحكمة الإدارية في إيقاف القرار وصلاحية إبداء المشورة في مشروعات القوانين.
المستشار محمد رسلان – مصر:
ما مصير الطعن على قرار رئيس المحكمة في إيقاف تنفيذ قرار إداري؟
القاضي حاتم بن خليفة - تونس:
الدستور الجديد جاء بمحاكم إبتدائية ومحاكم إستئنافية إدارية وهذا ينظّم السلطة التشريعية والتنفيذية والدستور يضمن إستقلال القضاء تماماً لم يعد للسلطة التنفيذية أي تدخل في القضاء ولمجلس القضاء الأعلى ميزانية مستقلّة يناقشها أمام مجلس النواب وسوف يتمّ إصدار القوانين الأساسية للقضاء الإداري بعد تركيز مجلس الأعلى للقضاء ثم يلي ذلك تركيز المحاكم الإبتدائية في الجهات لم يتحدّث الدستور عن إختصاص المحاكم ونصّ على الوظيفة الإستشارية قد يتمّ توسيع هذه الصلاحية وليس هناك إتجاه لتوسيع هذه الصلاحية كثيراً ستحافظ على إستشارة هذا القضاء بالقوانين والمراسيم والأوامر. إقتراحات القوانين من النواب تحال إلى المحكمة الإدارية للإستشارة لتحرير النصوص وصيانتها.
إختصاص تنفيذ المحاكم إلغاء وتعويض واستشاري.
صلاحية إيقاف تنفيذ القرار أسندت إلى رئيس المحكمة الذي يعين تقديرياً من السلطة التنفيذية وهي صلاحية إستثنائية ؟ الآن الأمور متجهة نحو سحب هذا الإختصاص الأخير وإعطاءه لرئيس قسم في المحكمة الإدارية.
كانت السلطة التنفيذية تعيّن رئيس المحكمة الإدارية من قضاة محكمة التعقيب.
بالنسبة للدستور يعين رئيس المحكمة من قبل فرع القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى برأي وإقتراح ملزم.
قرار رئيس المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار الإداري لا يقبل الطعن وهو مؤقت حتى إصدار الحكم بالدعوى بالأساس.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
علينا أن نستفيد مما يجري هنا ويجب إفراد قسم لكل إختصاص قسم قضائي وقسم فتوى وقسم تشريع لإبداء الرأي والمشورة وهذا في سعينا للتقارب إن لم نستطع الوحّد وأقترح أن يكون إيقاف التنفيذ من صلاحية المحكمة وليس من صلاحية شخص واحد.
د. سوسن شندب – السودان:
أوضح أن الفتوى الصادرة عن المحكمة الإدارية تتعارض مع صلاحية القضاء في الرقابة التي تمارسها المحكمة على قرارات الإدارة في السودان الفتوى تصدرها وزارة العدل رأيي قصدي القضاء يكون مستقلّ عن عمل الوزارات.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
ألا ترى أنه أفضل فصل القضاء عن الفتوى والتشريع تماماً وأن تكون هذه الأخيرة لدى وحدات إدارية عندنا الفتوى والتشريع من صلاحية وزارة الشؤون القانونية.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
المهمة الإستشارية لمجلس الدولة لا تتعارض مع مهمته القضائية وقدم رئيس مجلس النواب الرئيس الحسيني مشروع قانون لإلغاء الغرفة الإستشارية في القضاء الإداري. وهذا العمل يجنّب عمل الإدارة من الطعن لاحقاً.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
في البداية أريد أن أسأل حول إختصاص القضاء الإداري في التعويض هل هو مانع؟
والمحكمة الإدارية العليا في تونس هل هو مشروع أم واقع الآن؟
أنا أنضمّ إلى السودان في فصل القضاء عن الفتوى والتشريع.
المستشار محمود رسلان – مصر:
هناك خلط بين قضاء إداري ومجلس الدولة السودان تتكلم عن تعارض ريما يصدر قاضٍ رأي ثم ينظر بدعوى في هذه الحالة يتنحى. من مصلحة القضاء الإداري لتقليل الدعاوى أن يبصِّر الإدارة بالطريق الصحيح فإذا اتبعت رأيه قلت الدعاوى وقلت حالات الطعن ويمكن إعتبارها إدارات تُساهم في تحقيق حالات الطعن كما هو الحال في التظلّم أمام نفس الهيئة مصدرة القرار.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
أعتقد أنه أشغال القاضي في أكثر من مجال يخلق لديه مشكلة كبيرة جداً حتى في الإعارات تخلق مشكلة كبيرة جداً لأجل هذا أتوقّع فصل عمل القاضي تماماً أفضل على رغم المنهج الذي اتبعه مجلس الدولة الفرنسي.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
لا خلاف بيننا نهائياً المسميات خلفت مشكلة وكلها تندرح تحت القضاء الإداري. إنتداب القاضي لدى الإدارة وإبداء الرأي كلها تقلّل النزاعات أمام القضاء الإداري. نحن إقتربنا من المفاهيم.
وأبدى القاضي حاتم بن خليفة ردوداً حسب القانون التونسي.
د. سوسن شندي – السودان:
ناقشت مع الرئيس موضوع إتحاد المحاكم الإدارية وتمنت التوفيق وأبدت رغبة السودان للإنضمام وأنها لم تدعى وتمنّت أن يفعّل الإتحاد.
اعتبرت أنه يفترض في القرار الإداري صحته ومشروعيته وعليه فمن يدع عدم صحة قرار إداري فيتقدّم بدعوى إلغاء القرار الإداري وإثبات ما يدعيه وهي دعوى شكلية لها شروط شكلية معدّدة الأسباب والعيوب على أساس أن الدعوى وسيلة وضعت بين يديّ صاحب المصلحة باللجوء إلى القضاء لحماية حقّه. مقرّرة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإداري في ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته.
والسودان يتبع نظام القضاء الموحّد. ويضمن القضاء الإداري الموحّد للمتقاضين مميّزات النظام الآخر وضمان تخصّص قضاة المحاكم الإدارية وخضوعهم للتدريب قبل وأثناء الخدمة وعرضت لآراء بعض الفقهاء في تفضيل النظام المزدوج فيما أيّدت هي النظام الموحّد القائم.
ثم تحدّثت عن مراحل تطوّر القانون حتى صدور قانون القضاء الإداري لسنة 2005 الذي رسم كيفية الطعن ضد القرار الإداري غير المشروع مبيّناً إجراءات رفع الطعن ومشتملات العريضة وتحديد ميعاد الطعن وأسبابه وكيفية إصدار الحكم والطعن فيه وكيفية تنفيذ الحكم.
ومن المعروف أن قواعد القانون الإداري جميعها غير مقننة ويرجع ذلك إلى تشعّب مجالاته وسرعة تطوّره لذلك ترك الأمر للقضاء ومن خلال التطبيق كشف القصور وإيجاد الحلول.
والقضاء السوداني ليس قضاءً إدارياً كاملاً بل هو قضاء إلغاء وتعويض.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
الأقرب أن العقد الإداري هو إختصاص إداري.
د. سوسن شندي – السودان:
هي عقود بين طرفين أعطي للقضاء العدلي نتمنى أن يتمّ إنشاء قضاء إداري في السودان.
المستشار محمود رسلان – مصر:
هناك نصّ في القانون يجرم الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام المحكمة هل هناك وجود لمثل هذا النص في قوانين السودان؟
د. سوسن شندي – السودان:
الدستور ينصّ على إلزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء هناك نصّ دستوري لكن السلطة العامة تتذرّع بأسباب المصلحة العامة هناك مشاكل لكن نحن نعتمد حسن النيّة أنا أنادي أن يكون هناك تشريعات تلزم بتنفيذ أحكام المحكمة.
أ. حاتم خليفة – تونس:
نظام قضائي موحّد وهناك قضاة إداريين في دوائر مختصة وهذا يعارض النظام القضائي الموحدّ؟
ثم تحدّث عن أن النظام القضائي السوداني بين المتقاضين إنما القاضي الإداري يحمل الإدارة مسؤوليات أكثر لأنها تملك السلطة والوثائق.
د. سوسن شندي – السودان:
في السودان نظام قضائي موحّد وهناك محاكم إدارية متخصّصة فيها قضاة إداريون متخصّصون.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
المتقاضون متساوون أمام المحكمة لكن بالنسبة للإثبات، فالإدارة لأنها الطرف الأقوى، فهي ملزمة أكثر.
وجرى نقاش حول صلاحيات القضاء الإداري في السودان حيث أكّدت د. سوسن أن كل القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة تخضع للطعن.
المستشار عقيل باعلوي - سلطنة عُمان:
واقع القضاء الإداري في سلطنة عُمان.
إعتبر أن القضاء يمارس دوراً هاماً ومؤثّراً في تاريخ الشعوب ليصل إلى أن القضاء الشرعي صاحب الولاية العامة حيث اعتبر أن عام 1970 نقطة تحوّل في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السلطنة ومع صدور المرسوم السلطاني رقم 26/75 حيث صدر أول تنظيم قانوني للمحاكم الشرعية وأسند بموجبه إلى وزارة العدل إختصاصات هي:
- الإشراف على المحاكم الشرعية ورفع كفاءة أدائها وسرعة فصلها في القضايا.
- النظر في الإستئنافات ضد أحكام المحاكم الشرعية.
- الإشراف على شؤون القضاة وموظفي المحاكم.
- الإشراف على أية محاكم أو أنظمة قضائية تنشأ مستقبلاً.
ثم تحدّث عن التنظيم القانوني والإداري في سلطنة عُمان وعدّد القوانين التي نظّمت الجهاز الإداري للدولة وقانون الجزاء العُماني وقانون العمل وقانون تنظيم القضاء الجزائي وقانون الشركات التجارية وقانون المحكمة التجارية وتحدّث عن الدعاوى التجارية والضريبية والدعاوى الجزائية ودعاوى الإيجارات ودعاوى شؤون الأراضي ودعاوى الموظفين ليصل إلى الحديث عن القضاء الإداري في تلك المرحلة حيث اعتبر أنه من عام 1970 وحتى عام 1999 لا يمكن أن يقال بوجود قضاء إداري وفقاً لمفهومه الحديث كما أنه لا يمكن القول أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر الخصومات الإدارية خلال المرحلة السابقة.
ومع صدور قانون السلطة القضائية عام 1999 الذي نصّ في المادة 67 على وضع حجر أساس لقضاء إداري يكفل حماية الحقوق والحريات العامة.
ثم تناول فكرة اعتناق السلطنة للقضاء المزدوج معرّجاً على تجربة فرنسا ومصر ليصل إلى الحديث عن الأساس الدستوري والقانوني للقضاء الإداري ليتناول بعد ذلك محكمة القضاء الإداري في سلطنة عُمان مع صدور المرسوم السلطاني رقم 91/99 حيث تحدّث عن تشكيل وترتيب المحكمة بدائرتها الإبتدائية ودائرتها الإستئنافية واختصاصاتها وتوسيع هذا الإختصاص بالمرسوم السلطاني رقم 3/2009 ليحدّد ما يخرج عن سلطان هذه المحكمة.
بالنسبة للفتوى والتشريع عندنا في سلطنة عُمان وزارة الشؤون القانونية مختصّة بإبداء الرأي والمشورة وليس من إختصاص القضاء الإداري.
يأتي بعد السلطان وزير الديوان لكن الآن أستقلّ القضاء الإداري يتبع للسلطان مباشرة والقضاء العادي خرج من سلطة وزارة العدل له مجلس قضاء أعلى يرأسه السلطان نائبه رئيس المحكمة العليا وله مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
جميع الخصومات الإدارية ترفع أمام القضاء الإداري حتى الأعمال المادية وكذلك العقود الإدارية.
د. محمد رسلان – مصر:
فكرة المقاصة عن التعويض نرجو شرح هذه النقطة وإعطائنا أمثلة.
المستشار عقيل باعلوي – سلطنة عُمان:
أحياناً تأتي مؤسسة لإنشاء مشروع مرفق عام بالتعاون مع مؤسسة لا يوجد لوائح تنظّم هذه العملية فلا يمكن مطالبته، فأخضعت المنازعات لصلاحية القضاء الإداري.
الوزير الذي لا ينفّذ حكم قضائي يمكن مقاضاته والموظف إذا تعرّض لإهانة من مسؤوله يمكن تقديم شكوى أمام الإدّعاء العام ومقاضاته.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
أثرت موضوعاً حول المسؤولية عن المخاطر والمسؤولية الموضوعية دون خطأ وقد وردت في القانون الدولي يتعيّن أن نوليها إهتماماً والعناية بها أو حتى بأن يكون محوراً وتعاني منه الدول النامية كالأضرار التي تعاني منها الدول بسبب التجارب النووية.
القاضي عدنان الشعيبي – فلسطين:
إعتبر أن القضاء يمثّل الركيزة الأساسية للحفاظ على الحريّات العامة ومع تطوّر القوانين وتشابك العلاقات ظهرت الحاجة لنشوء قضاء متخصّص ويختصّ بفضّ المنازعات الناشئة بين الأفراد والسلطة الإدارية كونه قضاء يتميّز بأنه قضاء إنشائي فدوره لا يقتصر على تطبيق القواعد القانونية بل يتعدّى لإنشاء مبادئ قانونية.
ثم تناول مفهوم القضاء الإداري واعتبره هيئة قضائية مستقلّة واعتبر أن بداياته ظهرت في فرنسا ونشأت فكرته مع الثورة الفرنسية عام 1789 واعتبر أن بعض الدول العربية كمصر والعراق والأردن إتّجهت نحو القضاء الإداري ثم تحدّث عن القضاء الإداري تاريخياً بادئاً منذ هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ليتحدّث عن القضاء الإداري خلال حقبة الإنتداب البريطاني والفرنسي في فلسطين التي تسير بالنظام القضائي الموحّد حيث أصدرت بريطانيا قانون المحكمة العليا الفلسطينية وجعل لها إختصاص المنازعات ذات الطابع الإداري ثم في ظلّ الخضوع للحكم الأردني حيث ساد قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 1952، ثم تحدّث عن القضاء الإداري في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تمّ تأسيس مجلس القضاء الأعلى واتّجه المشرع إلى الأخذ بنظام القضاء المزدوج لكنه عاد وأبقى لمحكمة العدل العليا صلاحية النظر بالمنازعات الإدارية.
ثم تناول صلاحيات محكمة العدل العليا الفلسطينية وفق قانون رقم 5 لسنة 2001 وعدّدها وعرض لبعض التوصيات في الخاتمة.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
نشكرك على هذا العرض التفصيلي.
د. سوسن شندي – السودان:
إتّضح لنا توسّع في صلاحية القضاء الإداري ولكن جعل هذه الصلاحية من إختصاص المحكمة العليا وهذا يشغل القضاء.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
بالنسبة للإدارة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
الحقيقة هناك العديد من القرارات التي تُعنى بهذا الموضوع.
ولدينا موقع إلكتروني يمكن البحث فيه وكل سنة نطبع في كتاب خلاصة القرارات الصادرة عن القضاء الإداري.
المستشار محمد الحافي – ليبيا:
إعتبر أن الدول تمارس مهامها عبر نشاط تقوم به وحدات متخصّصة بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها التي تمنحها صلاحيات وامتيازات لتقوم بوظائفها في حدود المشروعية. وليس للأفراد من ملجأ لإسترجاع حقوقهم إلاّ باللجوء إلى القضاء ونظراً لإختلاف طبيعة النشاطات كان لا بدّ من وجود قضاء متخصّص لفضّ المنازعات ومن هذا الإطار كان لا بدّ من وجود قضاء مهمته سماع الدعاوى المتعلّقة بنشاط الإدارة المتمثّل في صورة قرارات وأنشطة وعقود إدارية.
وفي فصل أول تناول نشأة القضاء الإداري في ليبيا معتبراً أن ليبيا لم تعرف نظام القضاء الإداري بمفهومه المعاصر خلال فترة الحكم العثماني ولا أيام الإحتلال الإيطالي ولا في عهد الإدارة البريطانية الفرنسية وفي عام 1951 أسند المشرّع الليبي للمحكمة العليا مهمة الفصل في المنازعات الإدارية وأسندت إلى إحدى دوائر المحكمة حيث اقتبس المشرّع الليبي الإختصاصات الممنوحة من المشرّع المصري لمجلس الدولة، حتى صدور القانون رقم 88 لسنة 1971 حيث تمّ إنشاء دوائر خاصة في محاكم الإستئناف تتولّى الفصل في المنازعات الإدارية يتمّ الطعن بأحكامها أمام المحكمة العليا.
ثم تناول المنازعات التي تتولاها هذه المحاكم واختصاصاتها والدعاوى التي يتناولها القضاء الإداري وهي دعاوى الإلغاء ودعاوى التسويات الوظيفية وتلك المتعلّقة بالعقود الإدارية.
ثم تناول مراجع الطعن وأسبابه كعيب عدم الإختصاص وعيب الشكل وعدّد حالات بطلان القرارات الإدارية لعيب الشكل وعيب مخالفة القانون أو عيب محل القرار الإداري وعيب السبب أو إنعدامه كعيب إساءة السلطة.
ثم تناول في الفصل الثاني مميّزات وعيوب القضاء الإداري في ظلّ وحدة القضاء كما في ليبيا فاعتبر أن المميّزات أهمها:
- التوسّع الأفقي في جهاز القضاء الإداري.
- التوسّع رأسياً في جهاز القضاء الإداري.
- أفسح المجال أمام بناء وخلق قضاء إداري مستقلّ.
أما العيوب فهي:
- أن المنازعات الإدارية عهدت إلى دوائر القضاء على سبيل الحصر.
- جعل محاكم القضاء الإداري مجرّد دوائر مشتقّة من محاكم القضاء المدني.
- عدم خلق كوادر قضائية متخصّصة بالمنازعات الإدارية.
- عدم تطوّر قواعد وأحكام القانون الإداري.
ثم عالج إمكانات تطوّر نظام القضاء الإداري في ظلّ القضاء الموحّد مقترحاً خلق قضاء إداري إبتدائي ثم إستئناف ونيابات إدارية لتوفير ضمانات أكبر يتمّ به تلافي عيوب النظام القائم في حين أخذ جانب كبير من الفقه نظام إزدواج القضاء داعين إلى الأخذ بنظام مجلس الدولة تناول موضوع مدى الحاجة إلى قضاء إداري مستقلّ ليصل إلى مدى قدرة المنظومة القضائية الليبية لإنشاء قضاء إداري مستقلّ.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
نبدأ بالمحور الرابع حول مدى فاعلية إستحداث قضاء إداري مستقلّ.
المستشار محمد رسلان – مصر:
إنطلق في مقدمته أن الدول إنقسمت في إعتناق النظام القضائي الذي يحقّق لها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة.
ثم إنتقل للحديث عن نظام القضاء الموحّد الذي يقوم على فكرة مؤدّاها أن تتولّى المحاكم العادية على إختلاف أنواعها ودرجاتها الفصل في المنازعات الإدارية بالإضافة إلى باقي المنازعات. وتابع متحدّثاً عن نشأة هذا النظام والعمل به في الدول الأنكلوساكسونية حيث باشر القضاة في أميركا وبريطانيا رقابة واسعة على أعمال الإدارة. وذكر أن هذا النظام يتميّز في أنه لا تثور فيه إشكاليات تنازع الإختصاص وتطبيق ذات الإجراءات المطبّقة على الدعاوى المدنية والتجارية وأن أحكامها تخضع لرقابة محكمة النقض بالإضافة إلى الإستفادة من ميزة القرب من المتقاضين.
ثم أكّد على أن التجارب التاريخية تنطق بالعجز عن أعمال رقابة فعّالة ومرنة بالإضافة إلى عدم توفّر النشأة والبيئة والقدرات الفنّية والتأهيل اللازم للقضاة لذلك ظلّت الرقابة بعيدة عن تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق والحريّات العامة للأفراد ومقتضيات المصلحة العامة.
ثم إنتقل للحديث عن نظام القضاء المزدوج معتبراً أن هذا النظام نشأ كنتيجة لظروف سياسية وتاريخية متحدّثاً عن هذه الظروف في فرنسا حتى أنشأ نابوليون مجلس الدولة عام 1799 ومنحه الإختصاص بإعداد مشروعات القوانين ولوائح الإدارة وحلّ المشكلات في المجال الإداري.
واعتبر أن هذا المجلس تميّز ببراعته في أداء إختصاصاته حتى غدا حصناً للحقوق والحريّات العائدة للفرنسيين وتجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات حتى أصبح باعثاً لتأخذ بهذا النظام العديد من الدول.
ثم إنتقل للحديث عن التجربة المصرية التي أخذت بنظام القضاء الموحّد زمناً ليس قصيراً ثم عرض لهذه التجربة زمن الإحتلال البريطاني حتى صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة المصري. معتبراً أن إختصاصات هذا المجلس لو أسندت للقضاء العادي لما تطوّرت نظريات القانون الإداري في مصر ولا كان المجتمع المصري إستفاد من تطبيقات هذا المجلس ثم تحدّث عن أقسام وإختصاصات المجلس ليصار إلى ضرورة تطوّر الحركة الوطنية وإقرار السلطة الحاكمة بتحقّق واقع جديد وثبات إرادة عامة على إقرار مبدأ سيادة القانون وختم بمقولة للفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
شكراً للأستاذ محمد رسلان على هذا العرض وعرض مجدّداً لفكرة القضاء الإداري المستقلّ وجدواه والحاجة لقضاء إداري متخصّص وذكر أن أمهر القضاة يعملون في قسم الفتوى. نفتح باب المناقشة.
السيد حاتم بنخليفة – تونس:
أردت الإستفسار حول بعض الإختصاصات. هل إخراج الطعن بالأمور المتعلّقة بالسيادة هل فيه نصّ؟
ما الجدوى من إحداث محاكم تأديبية طالما القرارات التأديبية هي قرارات إدارية؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
بالنسبة للقرارات المتعلّقة بالسيادة هي سوابق قضائية وليس موجوداً بالنص هو فقه قضائي مصري. المسألة تضيق وتتوسّع حسب الظروف وهي في مصر ضاقت إلى أقصى حدّ جميع القرارات الصادرة عن السلطة بجميع أجهزتها وتخضع لرقابة القضاء.
أما القرارات التأديبية فهي أما رئاسي أما إداري. القضاء المصري إتّجه إلى جعل بعض الصلاحيات من إختصاص المحكمة وليس الرئيس ولذلك أسّست محاكم تأديبية.
لدينا محاكم إدارية ومحاكم قضاء إداري بسبب توزيع العمل.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
ما المُراد من هذا التوزيع أو التقسيم؟ هل يرتّب فائدة معيّنة؟ وقراراتها قابلة للطعن؟
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
هي عملية تنظيمية لا أكثر، وقراراتهم تقبل الطعن.
المستشار محمد رسلان – مصر:
هو تقسيم ضروري وبالغ الأهمية خاصة إذا علمتم أن هناك ستة ملايين موظف، فتخيّلوا حجم القضايا.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
بالإضافة إلى ما يتحمّله مجلس الدولة من قضايا في أمور أخرى هناك محاكم مختصّة بالجامعات وأخرى مختصّة بمراكز البحوث وغيره.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
علاقة القاضي بالإدارة ليست علاقة خصومة. نحن نراقب حتى العقود مراقبة مسبقة وأخبرني زملائي أنهم بواسطة هذه الرقابة قد وفّروا ضياع مليارات الدولارات.
القاضي محمد الحافي – ليبيا:
إدارة الفتوى والتشريع عندنا كانت جهة مستقلّة تابعة لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي عدنان شعيبي – فلسطين:
هل الإدارة ملزمة برأي دائرة الفتوى وبالإستشارة التي يصدرها مجلس الدولة؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
أبداً، هي غير ملزمة.
القاضي عدنان شعبي – فلسطين:
إذا أخذت الإدارة برأي وإستشارة مجلس شورى الدولة وطعن بالتشريع أمام المجلس الدستوري؟ فما هو موقف مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية؟
المستشار محمد رسلان – مصر:
لم يحدث مطلقاً أن طعن بتشريع أخذت فيه الإدارة برأي واستشارة مجلس الدولة.
المستشار نويري عبد العزيز – الجزائر:
الجزائر كانت عبارة عن مستعمرة فرنسية، وكان شبيه ما يجري في فرنسا يطبّق في الجزائر. بالنسبة للقضاء الإداري بعد الإستقلال تمّ إستحداث هيئة قضائية عليا سمي مجلس القضاء الأعلى ثم المحكمة العليا وظلّت ثلاث محاكم موروثة من الإحتلال تمارس عملها حتى عام 1966 حيث صدر قانون التنظيم القضائي وأنشئت غرفة إدارية في جسم القضاء الموحّد وظلّ ذلك حتى 1998 حتى أنشىء مجلس الدولة ولكن ظلت الغرف الإدارية في الجسم القضائي تعمل حتى عام 2009 أنشئت المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ونحن بصدد مشروع إنشاء محاكم إستئناف إدارية ويتحوّل مجلس الدولة إلى هيئة عليا بدل أن يكون جهة إستئناف. ولقد إستعنا بقضاة الغرف الإدارية في القضاء لملء الشواغر كما أنه سابقاً تمّ تعيين طلبة الحقوق في السنة الثانية قضاة وكذلك كتاب الضبط.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
الإتحاد العربي للقضاء الإداري سوف يقوم بإعداد دورات تدريبية لتأهيل القضاة ومفوّض الدولة له دور هامّ غير تحضير الدعوى وإبداء رأي فيها وحتى لو قدمت أمام مجسل الدولة وله عرض الصلح على الأطراف.
يرجى تحضير أعداد القضاة الذين يرغبون بالمشاركة بالتأهيل في الدورات التدريبية.
ورقة عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
اعتبر أن السيادة آخذة في الإنكماش أمام إحترام مبدأ سيادة القانون وتوسّع رقابة القضاء في الدول الديمقراطية التي أصبحت مقيّدة سيادتها بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية ثم ميّز بين مفهوميّ الإرتباط والتبعية وتأثيرهما على الإستقلال بالنسبة لعمل الإدارة.
ثم إنتقل للحديث عن أهمية دور القضاء المستقلّ الذي يحقّق التوازن بين السلطة الحاكمة ومعارضة وأفراد بحاجة لحماية القضاء ليصل بعد ذلك للحديث عن التطوّر التاريخي للقضاء الإداري فتحدّث عن واقعة في العصر الإسلامي ونشأته الحديثة في فرنسا والمراحل التي مرّ بها والقوانين التي صدرت وكفاح هذا القضاء حتى أصبح مثلاً يُحتذى فاتبعته دول كثيرة.
بعد ذلك تحدّث عن القضاء المزدوج والقضاء الموحّد مؤيّداً فكرة الأخذ بنظام القضاء المزدوج معتبراً أن الإنتقادات الموجهة للنظام المزدوج قد تخطّاها الزمن ذاكر العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام متحدّثاً عن تجربة القضاء في مصر وسوريا ولبنان والقوانين الصادرة في هذا الشأن تاريخياً حتى استقرّت على القضاء المزدوج.
المستشار نويري عبد العزيز – الجزائر:
في ورقة عمل مقدّمة منه عن عقود إلتزامات المرافق العامة (BOT):
إعتبر أن عقود البناء والإستغلال والتحويل الـ BOT تجد مصدرها في القوانين الأنكلوساكسونية بينما الدول اللاتينية والتي تأخذ بنظام إزدواجية القضاء كفرنسا والدول التي تسير في فلكها لا تتضمن هذه العبارة بالإضافة إلى القانون الأنجلوسكسوني لا يعترف بوجود عقود إدارية متميّزة عن العقود العادية وذلك من عدم إعترافه بوجود قانون إداري وقضاء إداري مستقلين.
وأن هذه الدراسة تطرح إشكالية تكمن في تحديد مفهوم الـ BOT ومدى نجاعته كوسيلة للتنمية الإقتصادية في الدول النامية.
فتناول أولاً ماهية عقود الـ BOT فتناول تعريفها عند الفقه القانوني وما جاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ولدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ثم تناول الصور المختلفة لعقود الـ BOT من جهتي الصور التعاقدية المنصبة على مشاريع جديدة وتلك المنصبة على مشاريع قائمة.
ليصل إلى الحديث عن فوائد المشاريع الإقتصادية عبر وسيلة الـ BOT فعدّدها:
- إقامة مشاريع جديدة.
- مساهمة الرأسمال الخاص في حلّ مشكلة المديونية للدولة.
- إستفادة الدولة من التطوّر التكنولوجي والتقنيات الحديثة.
- خلق مناصب شغل جديدة.
- إستغلال رأسمال القطاع الخاص.
- تفادي سلبيات الإقتراض.
- خلق نوع من المنافسة.
- تنشيط وتطوير مجالات إقتصادية كانت مهمّشة.
ليتناول بعد ذلك فوائد هذه العقود.
وفي ثالثاً تحدّث عن الطبيعة القانونية لعقود الـ BOT على أنها عقود ذات طابع إداري وفق التشريع الجزائري ومن الناحية الفقهية أنها تحتل موقعاً وسطاً بين عقود الإمتياز وعقود تفويض المرفق العام ومع ذلك فهو يعتبرها عقد إداري بصفة أساسية.
ثم تناول الإلتزامات المتبادلة بين أطراف عقد الـ BOT والعقود المشابهة له مثل عقد الإمتياز وعقد الأشغال العامة وعقد الخصخصة وعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تفويض المرفق العام وتحدّث عن النقاط المشتركة ونقاط الخلاف مع عقود الـ BOT في كل منها.
ثم تحدّث عن طريق تسوية المنازعات الناتجة عن عقود إلتزامات المرافق العامة BOT فعالج الطرق الودّية والتحكيم ثم التقاضي وما اعتمده المشرّع الجزائري في القانون الجزائري.
وفي الخلاصة هي لم تكن سكسونية وكانت موجودة في القوانين اللاتينية لكن التسمية وجدت في القوانين الأنكلوسكسونية.
د. عبد اللطيف نايف – العراق:
عقود إلتزام المرافق العامة BOT البناء والتشغيل والتمويل (نقل الملكية).
إعتبر أن الدول تسعى إلى إستخدام أسلوب جديد في إدارة مشاريعها لا سيما المشاريع الضخمة وذلك مع أشخاص القطاع الخاص عن طريق إبرام عقود وهو ما عُرف بنظام الـ BOT وقد نشأت هذه الفكرة لخدمة أغراض التنمية وانحدرت هذه الفكرة من نظريات القانون الإداري كتطوّر تاريخي لعقد إلتزام المرافق العامة. وهو من ثلاث مراحل مرحلة تحضيرية ومرحلة تنفيذ المشروع بناءه وتشغيله وإدارته والمرحلة الثالثة يتمّ فيها نقل ملكية المشروع للدولة مانحة الإمتياز. وترتّب هذه العقودآثار مباشرة إيجابية وتحدّ من الآثار السلبية وتكمن أهميتها أنها أحد نماذج الإستثمار الدولي.
ثم إنتقل إلى تعريف عقد الـ BOT ليتحدّث بعد ذلك عن خصائص هذا العقد كما يلي:
- أحد وسائل تمويل المشاريع العامة.
- إنشاء مرافق عامة لإشباع حاجات عامة وتقديم خدمات ذات نفع عام.
- فيه تتولى الدولة مهمة الرقابة والإشراف على تنفيذ العقد.
- ملكية المشروع تعود إلى الدولة.
ثم إنتقل إلى الحديث عن أهمية عقود الـ BOT في أنها تجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية وتخفّف العبء عن الموارد المالية الحكومية المحدودة وتساعد في إقامة مشاريع ومرافق جديدة وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الإقتصادية وتمكّن الحكومات من الإستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمكين المستثمرين من تحقيق أرباح كبيرة تفتح الباب أمام مؤسسات التمويل عن طريق تحريك أموالهم.
ثم عالج التكييف القانوني لعقود الـ BOT واعتبر أنه عقد إداري ذو طابع دولي وأنه يخضع لنظام قانوني واحد ليصل إلى تناول مجالات إستخدام مثل هذه العقود واعتبر أنه تستخدم في:
- مشروعات البنية الأساسية.
- المجمعات الصناعية.
- تنمية واستغلال الأراضي المملوكة للدولة.
ثم عدّد مخاطر هذه العقود ومراحل تنفيذ المشروعات في هذه العقود وصور وأشكال عقود الـ BOT فعدّدها كما يلي:
1. عقد البناء والتملّك والتشغيل والإعادة (B.O.O.T)
2. عقد التصميم والبناء والتمويل والتشغيل (D.B.F.O)
3. عقد البناء والتمليك والتأجير والتمويل (B.O.L.T)
4. عقد التأجير والتجديد والتشغيل ونقل الملكية (L.R.O.T)
5. عقد البناء ونقل المليكة والتشغيل (B.T.O)
6. عقد البناء والملكية والتشغيل (B.O.O)
7. عقد التحديث والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (M.O.O.T)
ثم عالج الآثار القانونية لهذه العقود فتناول:
- الرقابة على تنفيذ العقد.
- تعديل العقد.
- إتباع الجزاءات.
- إلتزامات الدولة.
كما عالج حقوق وإلتزامات المستثمر أو الشركة والإمتيازات والضمانات التي يتمتّع بها ليصل إلى الحديث عن تسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود.
د. سوسن شندي – السودان:
حول عقود الـ BOT.
اعتبرت في مقدمتها أن الجميع في الدولة يخضع للقانون وعلى الدولة والعاملين لديها أن يكون عمله في حدود القانون وهذا ما يعرف بمبدأ المشروعية ولذلك لا بدّ من وجود رقابة قضائية لرفع الظلم عن الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة وبين حماية حقوق الأفراد. وقرّرت أن الشرعية الإدارية المقصود بها خلو القرار الإداري من العيوب التي تمسّ بشرعيته ثم تناولت الضوابط التي وضعها المشرّع لممارسة الرقابة.
وفي حديثها عن عقود إلتزامات المرافق العامة اعتبرت أن القضاء الإداري في فرنسا وضع أسسها وصاغ خصائصها معرِّفة العقد الإداري حسبما إستقرّ عليه القضاء. وأن عقود الـ BOT من العقود الإدارية التي شهدت إنتشاراً في كثر من الدول وأن له دور مهمّ في إنشاء مشروعات البنية الأساسية والتنمية وأنه إمتياز تمنحه الدولة. ثم ذكرت تعريف الأوسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي) لتعتبر أنه عقد ذو طبيعة خاصة وقواعده من قواعد الإدارة العامة إلاّ أن له طبيعة قانونية خاصة تميّزه عن غيره من العقود وأنه في السودان يخضع للقضاء العادي لأن القضاء الإداري في السودان ليس قضاءً كاملاً وإنما قضاء إلغاء إنما دعوى التعويض ترفع أمام القضاء الإداري تبعاً لدعوى الإلغاء. مشيرة إلى أن القانون الإداري لسنة 2005م عرَّف القرار الإداري بأنه يقصد به القرار الذي تصدره أي جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معيّن متعلّق بحقّ أو واجب شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتّخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً باتّخاذه.
المستشار عقيل باعلوي - سلطنة عُمان:
كثر اللجوء إلى أسلوب العقد كوسيلة للدولة للحصول على ما تحتاجه من أغراض وخدمات ومواد وكوسيلة لتنفيذ السياسة الإقتصادية للدولة.
ثم تحدّث عن أهمية العقد الإداري حيث اعتبره أنه الأسلوب الأول في الحياة القانونية والإجتماعية والإقتصادية للدولة لحاجتها لمتعاقدين يساعدونها في الوفاء بحاجاتها وتنفيذ برامجها وخططها مشيراً إلى أن الفقهاء يعتبرون العقد الإداري أسلوب من أساليب ممارسة الإدارة لنشاطها وأن أهميته سوف تزداد بسبب الإنتقال من إقتصاد التخطيط إلى إقتصاد السوق، حيث أصبح العقد الأسلوب الأمثل لتحقيق أهداف الدولة.
ثم إنتقل للحديث عن تطوّر العقد الإداري وفقاً لنظام الـ BOT نظراً لإنتهاج الدولة سياسة الإقتصاد الحرّ بأسلوب الخصخصة عن طريق بيع شركات القطاع العام بهدف مشاركة القطاع الخاص لإنشاء مشروعات النفع العام وتمويلها متحدّثاً عن نظام الـ BOT بأنه إختصار لمصطلح الإنشاء ثم التشغيل ثم نقل الملكية للدولة.
ثم قدّم نبذة تاريخية عن عقود الـ BOT وخلفيتها الإقتصادية واعتبره من أهم آليات تنشيط الإقتصاد واستثماراته التي لاقت تأييداً ومساندة من قبل البنك الدولي.
ليصل إلى الحديث عن ماهية عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية معتبراً إياها عقود إمتياز لبناء وتشييد وإدارة مشروعات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص معدّداً المنافع والمزايا التي تستفيد منها الدولة:
1. بناء المشروعات الأساسية.
2. عدم اللجوء للصرف من الميزانية العامة.
3. الحصول على التقنية العالمية الحديثة اللازمة للمشروعات.
ثم تحدّث عن تعريف عقود الـ BOT وعناصرها الأساسية وعدّد الإتفاقيات التي يشتمل عليها هذا النظام وأنها تبرم بموافقة الحكومة وبشروطها. بعد ذلك عدد أشكال عقود الـ BOT:
- البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)
- البناء والتملّك والتشغيل (BOT)
- البناء والإيجار والتشغيل ونقل الملكية (BLT)
- الإيجاد والتجديد والتشغيل ونقل الملكية (LBOT)
- البناء ونقل الملكية والتشغيل (BOT)
ليصل إلى الحديث عن التكييف القانوني لعقد الـ BOT ثم يتناول عقود BOT في سلطنة عُمان.
القاضي يوسف الجميّل – لبنان:
اعتبر في المقدمة أن عقود الـ BOT هي إحدى الطرق المتّبعة من قبل الإدارة لإدارة المرافق العامة التي يتبع في إدارتها أسلوب الإدارة المباشرة على النقيض من المرافق العامة الصناعية والتجارية التي يتبع في إدارتها أسلوب الإدارة غير المباشرة.
وطريقة الإدارة الـ BOT لم تكن متّبعة في لبنان حتى بداية التسعينات حيث بدأ مع شركات الهاتف الخليوي وشركة البريد.
ثم تحدّث عن أنواعها:
- عقد الـ BOT
- عقد الـ BOOT
- عقد الـ BLT
متحدّثاً عن تسميتها ووظائفها وأطرافها وخصائصها وإلتزامات الأطراف. مشيراً في الخاتمة إلى أن المرفق العام وفقاً لنظرة بعض الدول ليس سوى مشروع يتمّ من خلاله الدخول إلى المنظومة الدولية في سبيل تحقيق أهداف مالية وإقتصادية.
د. سوسن شندي – السودان:
المحور الثالث: المستجدّات في قضاء الإلغاء والتعويض:
لما كان القضاء الإداري في تطوّر مستمرّكان لا بدّ من تطوير آليات قضاء الإلغاء والتعويض لإجبار الإدارة على إحترام القانون خاصة وأن هذا النوع من القضاء أقلّ كلفة من القضاء العادي لأنه وضع من أجل ضمان حقوق وحريّات المواطن وبناء دولة القانون ولا يمكن ذلك إلاّ بخضوع الإدارة وتنفيذ أحكام المحاكم ولما كان القضاء الإداري السوداني يغلب عليه طابع الإلغاء فإن كثيراً من المحاكم لا تصدر غير الأمر بالإلغاء للقرار الإداري غير المشروع وتخطر به الإدارة وتتوقّع من الإدارة أن تستيجب وتعيد الحال إلى ما كانت عليه إلاّ أن الإدارة في معظم الأحوال لا تستجيب لذلك فإن الإصلاح التشريعي أتى بفرض غرامات تهديدة على الموظف الممتنع عن التنفيذ. وقد تتذرّع الإدارة بعدّة أسباب لعدم التنفيذ منها السياسة العامة للمؤسسة الإدارية أو الصالح العام. ومن المستجدّات الوصول إلى إتفاق عام على قواعد الإثبات الحرّ في الدعوى الإدارية ويحقّق الإثبات مصلحة إجتماعية عامة هي حسم المنازعات ورغبة من القضاء الإداري في تحقيق العدالة في ظلّ عدم التوازن بين أطراف الخصومة الإدارية فقد منح القاضي دوراً إيجابياً في الدعوى الإدارية وهو ما يُعرف بالإثبات الحرّ فلا يكون القاضي ملتزماً بطرق معيّنة في الإثبات فللقاضي حقّ الإستعانة بالخبرة للبحث عن الحقيقة والإستعانة بوسائل إثبات لم يطلبها الخصوم وله حقّ إستنباط وقائع مجهولة من وقائع معلومة واللجوء إلى القرائن.
لتصل إلى خاتمة تقرّر فيها تعزيز دور القضاء الإداري في السودان وضرورة التعديل المستمرّ للقانون الإداري وفقاً للتطوّرات كما أن هناك ضرورة أن تزيل الدولة المعوقات التي تواجه القضاء في إطار الرقابة على القرارات.
وقد أثار بعض الأعضاء تساؤلات عن أهمية وجود مركز تحكيمي تابع للإتحاد العربي للقضاء الإداري للنظر في كل ما يتعلّق بنشوء المنازعات الخاصة بالإستثمارات في البلاد العربية.
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
تحدّث عن عقود الـ BOT ومميّزاتها وأسباب النزاعات بشأنها وحلّ النزاعات الناشئة عنها وتحدّث عن التحكيم في عقود الـ BOT وجهة التحكيم واعتبر أنه يجب إيجاد جهة للتحكيم تؤمّن الضمانات اللازمة للدول العربية سيما وأن الطرف الأجنبي في عقود الـ BOT دائماً يشترط أن يكون التحكيم لدى مركز أجنبي. وأضاف أنه إذا لم يتمّ الإتفاق في العقد على مكان للتحكيم فيتمّ تنظيم مشارطة تحكيم.
أثير في هذا الشأن إلى أن هناك مركز تحكيم يتمّ النظر في إنشائه بالتعاون مع الجامعة الألمانية في القاهرة وهو ما تمّ عقد بروتوكول تعاون معها منذ شهرين للنظر في معظم أوجه التعاون مع الإتحاد في عدد من الحالات ومنها هذا المجال.
د. سوسن شندي – السودان:
توصية بمراجعة عقود الـ BOT قبل إبرامها من لجان متخصّصة. هل هناك ما يمنع في الإتحاد العربي من إنشاء كيان تنظيمي لمراجعة مثل هذه العقود؟
د. جمال ندا – مصر – الرئيس:
هذا أمر يتعلّق بالسيادة وأنا أقدّم إستشارة فيما يتعلّق بهذه العقود ونظام الأكاديمية العربية للعلوم البحرية أقرّ هذا النظام بحضور عدد كبير من الوزراء والفقهاء القانونيين أن يعتمد هذا المركز كبيت خبرة يقدّم الإستشارة لمن يرغب من الدول.
د. حسن شاهين – لبنان:
بعنوان الضمانات الإدارية والقضائية للموظف الدولي.
اعتبر أن العلاقات بين الدول تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتأخذ أحياناً صورة المرفق العام الدولي الذي يخضع في أعماله للسياسة التي يضعها ممثلو هذه الدول، وهكذا لا يخضع الموظفون الدوليون لأية سلطة إقليمية ليتمكّن من العمل على تحقيق الغاية التي أنشىء من أجلها. فالموظف الدولي يستمدّ وضعه القانوني من إتفاقية دولية وليس من نصوص القانون الداخلي.
ثم إنتقل للحديث عن الضمانات الإدارية للموظف الدولي فقرّر أنه يقتضي وجود جهاز محايد يستطيع توفير الحماية للموظف من التصرّفات الإدارية التعسّفية وهو ما أكّدت عليه عصبة الأمم المتحدة حول حقّ التظلّم من قرارات الفصل أمام مجلس العصبة ولكن الموظفين اعتبروا أن هذه الطريق لا توفّر الضمانات الكافية وخاصة أن جهة الطعن في عصبة الأمم ومكتب العمل الدولي لم يكن لها إختصاص قضائي بل يغلب عليه الطابع السياسي وقراراتها تتأثّر بالإعتبارات السياسية ومع إزدياد إستخدام الموظفين الدوليين ثم إنشاء أجهزة إدارية مختلطة تضمّ ممثلين عن الإدارة والموظفين الدوليين كأجهزة إستشارية قبل صدور القرارات وأخرى تصدر رأيها بناء على طلب الموظفين بالقرارات الإدارية الدولية.
فتناول في مطلبين الضمانات السابقة على صدور القرار الإداري والضمانات اللاحقة على صدور القرار الإداري وتحدّث عن تشكيل هذه الأجهزة واللجان وصلاحياتها ومدة عملها مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية سارت على نفس النهج ليتحدّث بعد ذلك عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتشكيلها ومواعيد إنعقادها وسبل إقامة الدعوى أمامها.
الجلسة الختامية
__________
لقد بدأت الجلسة بمناقشة مشاريع التوصيات المنبثقة عن المداولات والمناقشات التي دارت أثناء جلسات العمل طيلة فترة المؤتمر حيث أقرّ المجتمعون بالإجماع التوصيات الصادرة عن المؤتمر بالصيغة المرفقة.
كما توجّهوا بالشكر والإمتنان الكبيرين للمستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية على رئاسته لهذا المؤتمر وحسن إدارته له والتي تجلّت بالحكمة والدراية والكفاءة ومساهمته عبر أخلاقه القيّمة النابعة من العلم والمعرفة والتجربة مما أوصل المؤتمر إلى النتائج والتوصيات الهامة، مؤكّدين دعمهم وتأييدهم له في رئاسته للإتحاد العربي للقضاء الإداري.
كما يثمّنون ويقدّرون جهوده التي يبذلها في سبيل إعلاء شأن الإتحاد من خلال بروتوكولات التعاون التي ينظّمها ويعقدها مع المنظمات العربية والدولية في سبيل إعلاء وتطوير عمل القضاء الإداري في الدول العربية ويقدمون له الدعم الكامل في سعيه هذا.
وإنهم أيضاً إذ يتوجهون بالشكر إلى جميع الذين تقدموا لهذا المؤتمر بأوراق العمل التي أعدّوها حول محاوره والشكر موصول إلى جميع المشاركين على إسهاماتهم ومداخلاتهم العلمية مما أضفى على هذه المسيرة جواً بنّاءً وإيجابياً غنياً بالعلم والمعرفة في محاولة لتطوير العمل القضائي الإداري في الدول العربية يُضاف إلى بنيان مسيرة المركز ومسيرة العمل العدلي العربي المشترك.
كما يتوجهون بالتقدير والإحترام لسعادة السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي وإلى جميع مساعديه على الجهود التي بذلوها لإعداد وإنجاح وإدارة هذا المؤتمر، متمنين لهم دوام التقدّم والعمل على الإرتقاء بالمسيرة القانونية والقضائية التي يتولاها المركز على الصعيد العربي.
السفير عبد الرحمن الصلح المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا
الأمين العام المساعد رئيس مجلس الدولة/مصر
رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية رئيس إتحاد القضاء العربي
بمشاركة كل من:
وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
- السيد حاتم بنخليفة، رئيس دائرة إستشارية بالمحكمة الإدارية/تونس
- الدكتور نويري عبد العزيز، مستشار دولة – مجلس الدولة/الجزائر
- السيد محمد يعقوب آدم، مستشار في المحكمة الإدارية/جيبوتي
- السيد أحمد حالاتو، رئيس محكمة الإستئناف ومستشار في المحكمة الإدارية/جيبوتي
- الدكتورة سوسن سعيد شندى، قاضي المحكمة العليا ورئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي – السلطة القضائية/السودان
- المستشار عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي، مستشار – محكمة القضاء الإداري/سلطنة عُمان
- القاضي مرداس بن إبراهيم بن علي البوسعيدي، قاضٍ – محكمة القضاء الإداري/سلطنة عُمان
- القاضي عدنان عبد الكريم محمد شعيبي، قاضي المحكمة العليا – المحكمة العليا/فلسطين
- المستشار محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء – المحكمة العليا/ليبيا
- القاضي يوسف الجميّل، قاضٍ لدى مجلس شورى الدولة/لبنان
- المستشار الدكتور جمال طه إسماعيل ندا، رئيس مجلس الدولة، رئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري /مصر
- المستشار محمود إسماعيل رسلان مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع – مجلس الدولة/مصر
- المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة – مجلس الدولة/مصر
وحضر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية:
- السفير عبد الرحمن الصـلح رئيس المركز
- السفير بشّار ياغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي نائب رئيس المركـــــــــــــــــز
- الأستاذ جوزيف رحمــــــــــــــــــــــة محامٍ، خبير في المركز
- الأستاذ يحيى الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــن خبير قانونـي بالمركـــــــــــز



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 التقرير الصادر عن المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين 30/5 – 01/06/2016
التقرير الصادر عن المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد ببيروت في الفترة الممتدة بين 30/5 – 01/06/2016