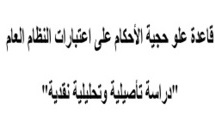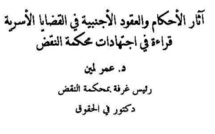بقلم:د. فريد السموني, أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية

لقد كثر الحديث عن إصلاح جهاز العدالة عموما والعدالة الجنائية على الخصوص، ولا أحد منا ينكر المجهودات التي تبذلها الوزارة المعنية من أجل إخراج منظومتنا القضائية من بعض المشاكل التي تعاني منها، سواء على المستوى البنيوي أو الوظيفي. ومع ذلك تبقى هذه المجهودات على أهميتها، مجرد عملية أولى تمهد لتدشين ورش الإصلاح الحقيقي، الذي بنظرنا المتواضع، لا يتطلب فقط تصحيح بعض المفاهيم وتحريرها، ما قد يحول دون اشتغالها وفق التأويل السليم، ولا حتى اعتماد بعض الآليات الجديدة من أجل تحديث المنظومة المذكورة وجعلها في مستوى مواكبة التطور الذي يعرفه المجال القضائي، بل يستوجب بالأساس ضرورة التفكير فيما ينتظر قضاء المستقبل من تحديات وطنية ودولية كذلك.
وحتى لا نذهب بعيدا في رصد المشاكل المطروحة، يكفي أن نقول وربما نؤكد، على أن أكبر المشاكل التي تواجهها أغلب الدول – بما فيها الأكثر ديمقراطية – الحجم المقلق الذي عليه ظاهرة الجريمة، وكثيرا ما تم إرجاع تفاقم هذه الأخيرة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى الثقافية التي تعاني منها بعض الدول، وباعتقادنا يكفي استحضار الطبيعة المنظمة التي أصبحت عليها ظاهرة الجريمة والمستوى المعقد الذي أصبحت تعرفه طرق إنجازها والفضاءات الأكثر ديمقراطية التي بدأت تفضل أن تحيا فيها، ليتوفر لدينا المبرر الموضوعي للتشكيك في المعطيات التي تربط بين تخلف الدولة و تنامي ظاهرة الجريمة.
صحيح أن مستويات الإجرام، طبيعته و طرق إنجازه، تختلف بحسب تقدم الدولة ومدى قدرتها على توفير معطيات العيش الضرورية للحد من إكراهات التناقضات الاجتماعية. إلا أن صعوبة ضبط آليات العيش داخل المجتمع المنظم، كانت وستبقى الحقيقة الدالة على وجود هامش من الاختلال، لابد وأن تحيا فيه ظاهرة الجريمة على الأقل باعتبارها ظاهرة اجتماعية تفرض وبشكل دائم ضرورة الانتباه إليها، بل و تكريس واجب الترقب لمستويات تطورها خصوصا بعدما أصبحت لا تعرف حدودا وطنية و أخطارها بدأت تهدد المجتمع الدولي في كل مكوناته.
ومن دون الدخول في تفاصيل هذه الإشكالية المعقدة والمتمثلة في ما أصبحت تحمله ظاهرة الجريمة من بعد دولي، نفضل أن نلتزم بفكرة إصلاح العدالة الجنائية أو بشكل مبسط جدا طرح التساؤلات التالية:
أولا: من أين تبدأ فكرة الإصلاح؟
ثانيا: ما هي الأهداف المتوخاة منه؟
ثالثا: كيف يمكن تصوره على مستوى البنية و الوظائف؟
من أين تبدأ فكرة الإصلاح؟
لا بد من الاعتراف بداية، بأن المشكل الأساسي الذي يواجه العدالة الجنائية، النوعية الخاصة التي تتميز بها القضايا المعروضة عليها. فبغض النظر عن كثرتها وتنامي الوتيرة التي تتزايد بها، فهي تعكس أيضا – وهذا الجانب لا يطرح كثيرا – مستوى معينا من الاختلال المجتمعي، الذي بنظرنا لا يرجع فقط إلى اتساع هامش التمرد على القيم التي ينبغي أن يقوم عليها التعايش الاجتماعي، ولكن يمكن أن يعزى كذلك، وعلى الخصوص، إلى الصعوبة التي تواجهها العدالة الجنائية في امتصاص هذا التمرد، حيث ظلت الآليات الموضوعة بيد العدالة المذكورة غير قادرة على مواجهة كل تجليات الظاهرة الإجرامية، فبالأحرى احتوائها والخروج بيسر من تفكيك تعقيداتها المتعددة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تصادم شبه تام بين الرغبة في استئصال الظاهرة المذكورة والخطاب الزجري المخصص لذلك.
وبنظرنا المتواضع، فكرة الإصلاح ينبغي أن تنطلق من حل هذا الإشكال وذلك بتنويع الخطاب الزجري وتدريج سلوك منطق القسوة فيه بكل الدقة التي تتطلب وفي نفس الآن البحث عن تكثير فرص إعادة الإدماج من دون إغفال منطق الردع الذي ينسجم وبكل موضوعية، مع خطورة الإجرام المنظم.
وهنا لا بد أن نؤكد على مدى فعالية الدور البيداغوجي الذي ينبغي أن تلعبه القاعدة الجنائية على المستوى العقابي، حتى تصبح هذه الأخيرة آلية لها من التأثير ما يكفي لتوعية المواطن بنماذج السلوك التي يستهدف الخطاب الزجري تكريسها داخل المجتمع، ومن ثم كلما كان المشرع واعيا بهذا الدور وباحثا عن أهم الصيغ المساعدة على توفيره، كلما نجح في النفاذ إلى عمق الظاهرة الإجرامية، وهو ما يعتبر بنظرنا بداية مشجعة على احتوائها وبخاصة الحد من إعادة انتشارها.
إصلاح النظام العقابي، لا يمكن أن يكون مجديا من دون إعادة النظر في موضوع المصالح المجتمعية واجبة الحماية جنائيا. ومن دون الادعاء أننا ننوي هنا وضع قائمة حصرية للمصالح المذكورة، لا بد من الاعتراف بأن الأسلوب الذي سلكته التشريعات الجنائية، غالبا ما هيمن عليه الطابع الاحتوائي – أي غير الانتقائي – لكل ما من شأنه أن يمس بالقيم والضوابط التي تميز النظام المجتمعي، بل وإلى هنا تتجه ملاحظتنا، حاولت التشريعات المذكورة وبمنطق حمائي مشروع، أن تؤسس توجهها الاحتوائي على مفاهيم جد موسعة وصيغ أكثر عمومية، الشيء الذي أثقل الخطاب الزجري بكثير من التأويلات لم يتمكن القضاء من الخروج بشأنها بتطبيقات حاسمة، وهو ما ندعو إلى تفاديه على الأقل للحفاظ لتقنيات التجريم على هامش الاختيار النوعي لمواجهة الإجرام المنظم.
من أجل ذلك نقترح أولا الرجوع بتقنيات التجريم إلى الضوابط المتحكمة فيها وبالأساس الاحتكام إلى منهجية الدقة والوضوح في الصياغة، ولعلها الحكمة المتوخاة من إقرار مبدأ الشرعية الذي لا يمانع حسب اعتقادنا المتواضع، من إعادة النظر في التقنيات المعتمدة كلما أصبحت غير مستجيبة للتطور النوعي الذي تعرفه ظاهرة الجريمة وباستمرار.
ثم لا بد من التأكيد ثانيا، على أن انطلاق فكرة الإصلاح الحقيقي تستوجب إعادة النظر كذلك في تحديد القيم والضوابط التي يقوم عليها النظام المجتمعي، صحيح أن الكثير منها ليس مثار جدل، بل أصبح أمر التأكيد عليها يحوز أهمية قصوى، خصوصا ما يرجع منها إلى حماية الدولة، نظامها وأمنها ومؤسساتها، و إن كنا هنا نطالب بتكريس الخطاب الزجري في الاتجاه، الذي يدفع إلى توعية المواطن بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار واجب وطني ومطلب حضاري يعمق فكرة الانتماء ويمتن أسس التعايش الاجتماعي. إلا أنه مازال على التشريعات الجنائية الوطنية أن تبذل مجهودا إضافيا، ليس فقط لتحقيق نوع من الانسجام مع الضوابط والمعايير الدولية، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص، من أجل تمكين تقنيات التجريم من الانفتاح على واقع الظاهرة الإجرامية واحتواء تجلياتها الحقيقية في إطار سياسة جنائية توفق وبحكمة تشريعية بين الاستجابة لردود الفعل المجتمعية الحقيقية التي تتطلب تدخلا حاسما على مستوى التجريم والعقاب وبين مجرد استثمار الخطاب الزجري في الاتجاه الذي يجعل منه ضابطا مؤصلا لنماذج السلوك الواجبة الاتباع، ولعل غياب هذه السياسة التوفيقية عن تقنيات التجريم الخاصة هو الذي ساهم في توسيع الهوة بين الرغبة في استئصال الظاهرة الإجرامية وتصاعد وتيرتها من حيث الواقع.
نعتقد أن موضوع مكافحة الجريمة ولو أنه يدخل في صميم مسؤولية الدولة التي عليها أن تضع له سياسة جنائية متجددة و متطورة، يجب أن لا يقفز على ما يضطلع به القضاء الجنائي من دور في هذا المضمار، باعتباره المؤسسة المؤهلة التي تضمن للدولة الهامش المطلوب للمحافظة على حيادها في تدبير التناقضات المجتمعية. وبنظرنا المتواضع، لا يمكن أن يتأتى ذلك من دون هيكلة، قوتها تظهر بالأساس في مدى استجابتها للطبيعة المركبة التي يعرفها مفهوم الدعوى في المجال الجنائي، مع استحضار بعض مظاهر التعقيد التي قد تفرزها خصوصية الحسم في بعض الجرائم.
وفي هذا الصدد، لا نرى ما يمنع من أن تشغل النيابة العامة دور المفعل والمطبق لسياسة الحكومة في مكافحة ظاهرة الجريمة، كل ذلك في إطار علاقة واضحة ومسؤولة مع السلطة السياسية المسؤولة عن القطاع. فالتبعية هنا، لا تعني المساس بمبدأ استقلال القضاء بقدر ما تهدف إلى تحصين الجهاز، الذي أنشئ في الأصل ليكون مؤتمنا على تجسيد الحق العام في مفهومه الحضاري، أي المستجيب لما تفرضه دولة الحق والمؤسسات من أمن واستقرار يحفظ للدولة مكانتها ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها ويؤمن للمجتمع حقوقه الواجبة.
مع ذلك، لا بد أن نثير الانتباه، إلى أن تمتين هيكلة القضاء في المجال الجنائي يصبح غير ذي معنى، إذا لم يسترجع قضاء التحقيق مكانته الطبيعية التي تجعل منه فعلا صمام الأمان الذي يحصن مفهوم الدعوى العمومية ضد كل المشاكل المحتملة، والتي غالبا ما يكون سببها عدم الاحتكام لهذه المرحلة المهمة. فقاضي التحقيق باعتباره قاضيا ورجل بحث واستدلال، نعتبره المؤهل أكثر من غيره ليلعب دور الوسيط المؤتمن على مصير الأشخاص المقدمين للعدالة. فالمتابعة لا تعني حتما الإدانة، ووضعية الشاهد يمكن أن تحمل بين طياتها ما يستدل به على التورط في ارتكاب الجريمة، إذا أضفنا لهذا وذاك ما توفره مرحلة التحقيق من ظروف نفسية ملائمة، من شأنها أن تلطف من بعض ردود الفعل السلبية المرتبطة فقط بطبيعة القضايا في المجال الجنائي، نستطيع أن نرد على المشككين في الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به قاضي التحقيق، بأنه لم يعد اليوم مستساغا اختزال هذا الدور في بعض القضايا، كثيرا ما ساد الاعتقاد بأن تعقيدها يكمن في مدى جسامة عقوبتها، ولعلها المغالطة التشريعية والفقهية، التي كثيرا ما تساهلت مسطريا مع بعض الجنح مع أن خطورتها ليست مثار جدل.
حتى لا نطيل في هذا الجانب، يكفي القول بأن توزيع العدل الجنائي بين عدة مؤسسات وجهات قضائية هو في أمس الحاجة اليوم إلى منهجية عقلانية تبحث عن إضفاء مزيد من الثقة في العدالة الجنائية، و لا يمكن أن تتأتى سوى بتوسيع هامش الاقتناع بأن موقع العدالة الجنائية لا يتعزز فقط بإصدار الأحكام وعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم – مع اعتبارنا لأهمية ذلك – بل أيضا بما تبثه من ثقة في نفسية المواطنين وما تكرسه من وعي بالتمسك بالقيم الحضارية، التي اختارها المجتمع و قبل السير وفقها.
أما على مستوى الوظائف، فمع اعتبار التحسين الواضح الذي أدخله القانون الجديد للمسطرة الجنائية، الذي حاول به من خلاله تحديث منهجية التعامل القضائي مع ظاهرة الجريمة بتكريس المقاربة النوعية للحسم في بعض القضايا، نعتقد أنه مازال على المشرع أن يبذل مجهودا إضافيا خصوصا في الجانب الذي يعترف فيه للعدالة الجنائية و بشكل حاسم وجريء باستثمار مجالها الخاص لخوض تجربة التخصص، مادام أن الواقع أصبح يؤشر وبشكل غير مسبوق على تطور مقلق لتجليات السلوك الإجرامي، الذي أخذت فيه الخطورة والتعقيد أقصى درجاتهما، بحيث لم يعد مقبولا اليوم التخلي عن الخصوصية التي تحوزها المادة الجنائية وتبرير ذلك بعقلنة الموارد البشرية. وهنا لابد أن نستحضر المنحى المتطور، الذي سلكه القانون الجديد للمسطرة الجنائية باستحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، ونحن نرى في هذه المنهجية السليمة اعترافا تشريعيا بمدى تجذر الخصوصية التي تحوزها الوظائف القضائية في المجال الجنائي، التي بنظرنا، تنطلق من واجب مكافحة الجريمة والحد من إعادة انتشارها إلى أن تصل إلى تكريس المستوى المطلوب من الثقة في أجهزة العدل مرورا بتأصيل الوعي بالاحترام الواجب للدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع ما يهدد أمنه واستقراره وضمان الحقوق والحريات، ولعل في تكرار هذه الأمور الحيوية فائدة منهجية لتوجيه فكرة الإصلاح.
إن إصلاح العدالة الجنائية على مستوى الوظائف لا يمكن اختزاله أو تحجيم أهميته في ضمانات المحاكمة العادلة، فأهمية احترام هذا المبدأ الإستراتيجي لا يمكن أن تظهر سوى في إطار فلسفة تشريعية جديدة، تستثمر مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، في ما يشعر كل مؤسسة قضائية بأن نجاح عملها يرتبط وظيفيا بما تساهم به في تسهيل القيام بالوظائف الأخرى، وهنا لابد أن نؤكد على فكرة وحدة الملف في المادة الجنائية بالرغم من تعدد الجهات القضائية المتدخلة فيه – والمرشحة للارتفاع – . فمبدأ المراقبة المتبادلة لا تعني التشكيك في مصداقية المهام المنجزة سابقا، ولا حتى إقامة حدود مسطرية فاصلة، غالبا ما ساهمت في تقليص فرص التعاون بين المؤسسات القضائية المتدخلة. بل إن المقصود من المراقبة هنا بذل مزيد من الحرص والتريث بالحسم في الإدانة. ولعلها القيمة المسطرية المثلى التي يحوزها مبدأ البراءة الأصلية الذي أصبح المشرع المغربي يتصدر به مواد المسطرة الجنائية. وإلا كيف يمكن أن نقبل منطقا وقانونا استمرار أغلب التشريعات في تسخير كل هذه الوسائل المادية و البشرية للحسم في النازلة الواحدة؟
أيضا لا يمكن للوظائف القضائية، أن تعرف تطورا نوعيا في المجال الجنائي من دون تحريرها من الانغلاق، أي بجعلها عدالة قريبة من المواطن في تواصل دائم معه، مستجيبة لردود فعله، عاكسة لتصوراته وتطلعاته، باحثة عن تقدمه وتحضره. فوظائف العدالة الجنائية، وعلى خلاف ما يعتقده البعض، نجاعتها تقاس بمدى قدرتها على استثمار فرصة المحاكمة من أجل احتواء مظاهر التوتر والاضطراب التي يتسبب فيها السلوك الإجرامي، وهذا لا يمكن أن يتم سوى بتحريك الخطاب الزجري في الاتجاه الذي لا يقف عند حدود الردع، بل يتعداه إلى إشعار كل المخاطبين به بأن للحقوق والحريات حدودا، فلسفتها تنبني بالأساس على قبول العيش ضمن المجتمع بكل مكوناته، وأن لا سبيل لإضفاء الشرعية على الانحراف عن الثوابت والقيم الحضارية باعتبارها مكتسبات مجتمعية، لا محيد عن تكريس الوعي بضرورة الحفاظ عليها، ولعلها بنظرنا المتواضع، النتيجة المثلى التي ينبغي أن تستهدفها إستراتيجية الإصلاح.
ختاما، ونحن ننتظر بكل تفاؤل توصيات الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، واثقين في تكلل أعمالها بالنجاح المنشود بعد المباركة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس،لابد من التأكيد على أن إصلاح العدالة لابد وأن يرتبط في روحه وفلسفته باستشراف مستقبل كلية الحقوق ببلادنا، حتى يرتبط تحديث منظومة العدالة بتطويرالجهة التي كانت ولاتزال تزودها بالأطر المؤهلة.
وحتى لا نذهب بعيدا في رصد المشاكل المطروحة، يكفي أن نقول وربما نؤكد، على أن أكبر المشاكل التي تواجهها أغلب الدول – بما فيها الأكثر ديمقراطية – الحجم المقلق الذي عليه ظاهرة الجريمة، وكثيرا ما تم إرجاع تفاقم هذه الأخيرة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بل وحتى الثقافية التي تعاني منها بعض الدول، وباعتقادنا يكفي استحضار الطبيعة المنظمة التي أصبحت عليها ظاهرة الجريمة والمستوى المعقد الذي أصبحت تعرفه طرق إنجازها والفضاءات الأكثر ديمقراطية التي بدأت تفضل أن تحيا فيها، ليتوفر لدينا المبرر الموضوعي للتشكيك في المعطيات التي تربط بين تخلف الدولة و تنامي ظاهرة الجريمة.
صحيح أن مستويات الإجرام، طبيعته و طرق إنجازه، تختلف بحسب تقدم الدولة ومدى قدرتها على توفير معطيات العيش الضرورية للحد من إكراهات التناقضات الاجتماعية. إلا أن صعوبة ضبط آليات العيش داخل المجتمع المنظم، كانت وستبقى الحقيقة الدالة على وجود هامش من الاختلال، لابد وأن تحيا فيه ظاهرة الجريمة على الأقل باعتبارها ظاهرة اجتماعية تفرض وبشكل دائم ضرورة الانتباه إليها، بل و تكريس واجب الترقب لمستويات تطورها خصوصا بعدما أصبحت لا تعرف حدودا وطنية و أخطارها بدأت تهدد المجتمع الدولي في كل مكوناته.
ومن دون الدخول في تفاصيل هذه الإشكالية المعقدة والمتمثلة في ما أصبحت تحمله ظاهرة الجريمة من بعد دولي، نفضل أن نلتزم بفكرة إصلاح العدالة الجنائية أو بشكل مبسط جدا طرح التساؤلات التالية:
أولا: من أين تبدأ فكرة الإصلاح؟
ثانيا: ما هي الأهداف المتوخاة منه؟
ثالثا: كيف يمكن تصوره على مستوى البنية و الوظائف؟
من أين تبدأ فكرة الإصلاح؟
لا بد من الاعتراف بداية، بأن المشكل الأساسي الذي يواجه العدالة الجنائية، النوعية الخاصة التي تتميز بها القضايا المعروضة عليها. فبغض النظر عن كثرتها وتنامي الوتيرة التي تتزايد بها، فهي تعكس أيضا – وهذا الجانب لا يطرح كثيرا – مستوى معينا من الاختلال المجتمعي، الذي بنظرنا لا يرجع فقط إلى اتساع هامش التمرد على القيم التي ينبغي أن يقوم عليها التعايش الاجتماعي، ولكن يمكن أن يعزى كذلك، وعلى الخصوص، إلى الصعوبة التي تواجهها العدالة الجنائية في امتصاص هذا التمرد، حيث ظلت الآليات الموضوعة بيد العدالة المذكورة غير قادرة على مواجهة كل تجليات الظاهرة الإجرامية، فبالأحرى احتوائها والخروج بيسر من تفكيك تعقيداتها المتعددة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى تصادم شبه تام بين الرغبة في استئصال الظاهرة المذكورة والخطاب الزجري المخصص لذلك.
وبنظرنا المتواضع، فكرة الإصلاح ينبغي أن تنطلق من حل هذا الإشكال وذلك بتنويع الخطاب الزجري وتدريج سلوك منطق القسوة فيه بكل الدقة التي تتطلب وفي نفس الآن البحث عن تكثير فرص إعادة الإدماج من دون إغفال منطق الردع الذي ينسجم وبكل موضوعية، مع خطورة الإجرام المنظم.
وهنا لا بد أن نؤكد على مدى فعالية الدور البيداغوجي الذي ينبغي أن تلعبه القاعدة الجنائية على المستوى العقابي، حتى تصبح هذه الأخيرة آلية لها من التأثير ما يكفي لتوعية المواطن بنماذج السلوك التي يستهدف الخطاب الزجري تكريسها داخل المجتمع، ومن ثم كلما كان المشرع واعيا بهذا الدور وباحثا عن أهم الصيغ المساعدة على توفيره، كلما نجح في النفاذ إلى عمق الظاهرة الإجرامية، وهو ما يعتبر بنظرنا بداية مشجعة على احتوائها وبخاصة الحد من إعادة انتشارها.
إصلاح النظام العقابي، لا يمكن أن يكون مجديا من دون إعادة النظر في موضوع المصالح المجتمعية واجبة الحماية جنائيا. ومن دون الادعاء أننا ننوي هنا وضع قائمة حصرية للمصالح المذكورة، لا بد من الاعتراف بأن الأسلوب الذي سلكته التشريعات الجنائية، غالبا ما هيمن عليه الطابع الاحتوائي – أي غير الانتقائي – لكل ما من شأنه أن يمس بالقيم والضوابط التي تميز النظام المجتمعي، بل وإلى هنا تتجه ملاحظتنا، حاولت التشريعات المذكورة وبمنطق حمائي مشروع، أن تؤسس توجهها الاحتوائي على مفاهيم جد موسعة وصيغ أكثر عمومية، الشيء الذي أثقل الخطاب الزجري بكثير من التأويلات لم يتمكن القضاء من الخروج بشأنها بتطبيقات حاسمة، وهو ما ندعو إلى تفاديه على الأقل للحفاظ لتقنيات التجريم على هامش الاختيار النوعي لمواجهة الإجرام المنظم.
من أجل ذلك نقترح أولا الرجوع بتقنيات التجريم إلى الضوابط المتحكمة فيها وبالأساس الاحتكام إلى منهجية الدقة والوضوح في الصياغة، ولعلها الحكمة المتوخاة من إقرار مبدأ الشرعية الذي لا يمانع حسب اعتقادنا المتواضع، من إعادة النظر في التقنيات المعتمدة كلما أصبحت غير مستجيبة للتطور النوعي الذي تعرفه ظاهرة الجريمة وباستمرار.
ثم لا بد من التأكيد ثانيا، على أن انطلاق فكرة الإصلاح الحقيقي تستوجب إعادة النظر كذلك في تحديد القيم والضوابط التي يقوم عليها النظام المجتمعي، صحيح أن الكثير منها ليس مثار جدل، بل أصبح أمر التأكيد عليها يحوز أهمية قصوى، خصوصا ما يرجع منها إلى حماية الدولة، نظامها وأمنها ومؤسساتها، و إن كنا هنا نطالب بتكريس الخطاب الزجري في الاتجاه، الذي يدفع إلى توعية المواطن بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار واجب وطني ومطلب حضاري يعمق فكرة الانتماء ويمتن أسس التعايش الاجتماعي. إلا أنه مازال على التشريعات الجنائية الوطنية أن تبذل مجهودا إضافيا، ليس فقط لتحقيق نوع من الانسجام مع الضوابط والمعايير الدولية، ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص، من أجل تمكين تقنيات التجريم من الانفتاح على واقع الظاهرة الإجرامية واحتواء تجلياتها الحقيقية في إطار سياسة جنائية توفق وبحكمة تشريعية بين الاستجابة لردود الفعل المجتمعية الحقيقية التي تتطلب تدخلا حاسما على مستوى التجريم والعقاب وبين مجرد استثمار الخطاب الزجري في الاتجاه الذي يجعل منه ضابطا مؤصلا لنماذج السلوك الواجبة الاتباع، ولعل غياب هذه السياسة التوفيقية عن تقنيات التجريم الخاصة هو الذي ساهم في توسيع الهوة بين الرغبة في استئصال الظاهرة الإجرامية وتصاعد وتيرتها من حيث الواقع.
نعتقد أن موضوع مكافحة الجريمة ولو أنه يدخل في صميم مسؤولية الدولة التي عليها أن تضع له سياسة جنائية متجددة و متطورة، يجب أن لا يقفز على ما يضطلع به القضاء الجنائي من دور في هذا المضمار، باعتباره المؤسسة المؤهلة التي تضمن للدولة الهامش المطلوب للمحافظة على حيادها في تدبير التناقضات المجتمعية. وبنظرنا المتواضع، لا يمكن أن يتأتى ذلك من دون هيكلة، قوتها تظهر بالأساس في مدى استجابتها للطبيعة المركبة التي يعرفها مفهوم الدعوى في المجال الجنائي، مع استحضار بعض مظاهر التعقيد التي قد تفرزها خصوصية الحسم في بعض الجرائم.
وفي هذا الصدد، لا نرى ما يمنع من أن تشغل النيابة العامة دور المفعل والمطبق لسياسة الحكومة في مكافحة ظاهرة الجريمة، كل ذلك في إطار علاقة واضحة ومسؤولة مع السلطة السياسية المسؤولة عن القطاع. فالتبعية هنا، لا تعني المساس بمبدأ استقلال القضاء بقدر ما تهدف إلى تحصين الجهاز، الذي أنشئ في الأصل ليكون مؤتمنا على تجسيد الحق العام في مفهومه الحضاري، أي المستجيب لما تفرضه دولة الحق والمؤسسات من أمن واستقرار يحفظ للدولة مكانتها ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها ويؤمن للمجتمع حقوقه الواجبة.
مع ذلك، لا بد أن نثير الانتباه، إلى أن تمتين هيكلة القضاء في المجال الجنائي يصبح غير ذي معنى، إذا لم يسترجع قضاء التحقيق مكانته الطبيعية التي تجعل منه فعلا صمام الأمان الذي يحصن مفهوم الدعوى العمومية ضد كل المشاكل المحتملة، والتي غالبا ما يكون سببها عدم الاحتكام لهذه المرحلة المهمة. فقاضي التحقيق باعتباره قاضيا ورجل بحث واستدلال، نعتبره المؤهل أكثر من غيره ليلعب دور الوسيط المؤتمن على مصير الأشخاص المقدمين للعدالة. فالمتابعة لا تعني حتما الإدانة، ووضعية الشاهد يمكن أن تحمل بين طياتها ما يستدل به على التورط في ارتكاب الجريمة، إذا أضفنا لهذا وذاك ما توفره مرحلة التحقيق من ظروف نفسية ملائمة، من شأنها أن تلطف من بعض ردود الفعل السلبية المرتبطة فقط بطبيعة القضايا في المجال الجنائي، نستطيع أن نرد على المشككين في الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به قاضي التحقيق، بأنه لم يعد اليوم مستساغا اختزال هذا الدور في بعض القضايا، كثيرا ما ساد الاعتقاد بأن تعقيدها يكمن في مدى جسامة عقوبتها، ولعلها المغالطة التشريعية والفقهية، التي كثيرا ما تساهلت مسطريا مع بعض الجنح مع أن خطورتها ليست مثار جدل.
حتى لا نطيل في هذا الجانب، يكفي القول بأن توزيع العدل الجنائي بين عدة مؤسسات وجهات قضائية هو في أمس الحاجة اليوم إلى منهجية عقلانية تبحث عن إضفاء مزيد من الثقة في العدالة الجنائية، و لا يمكن أن تتأتى سوى بتوسيع هامش الاقتناع بأن موقع العدالة الجنائية لا يتعزز فقط بإصدار الأحكام وعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم – مع اعتبارنا لأهمية ذلك – بل أيضا بما تبثه من ثقة في نفسية المواطنين وما تكرسه من وعي بالتمسك بالقيم الحضارية، التي اختارها المجتمع و قبل السير وفقها.
أما على مستوى الوظائف، فمع اعتبار التحسين الواضح الذي أدخله القانون الجديد للمسطرة الجنائية، الذي حاول به من خلاله تحديث منهجية التعامل القضائي مع ظاهرة الجريمة بتكريس المقاربة النوعية للحسم في بعض القضايا، نعتقد أنه مازال على المشرع أن يبذل مجهودا إضافيا خصوصا في الجانب الذي يعترف فيه للعدالة الجنائية و بشكل حاسم وجريء باستثمار مجالها الخاص لخوض تجربة التخصص، مادام أن الواقع أصبح يؤشر وبشكل غير مسبوق على تطور مقلق لتجليات السلوك الإجرامي، الذي أخذت فيه الخطورة والتعقيد أقصى درجاتهما، بحيث لم يعد مقبولا اليوم التخلي عن الخصوصية التي تحوزها المادة الجنائية وتبرير ذلك بعقلنة الموارد البشرية. وهنا لابد أن نستحضر المنحى المتطور، الذي سلكه القانون الجديد للمسطرة الجنائية باستحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، ونحن نرى في هذه المنهجية السليمة اعترافا تشريعيا بمدى تجذر الخصوصية التي تحوزها الوظائف القضائية في المجال الجنائي، التي بنظرنا، تنطلق من واجب مكافحة الجريمة والحد من إعادة انتشارها إلى أن تصل إلى تكريس المستوى المطلوب من الثقة في أجهزة العدل مرورا بتأصيل الوعي بالاحترام الواجب للدولة ومؤسساتها وتحصين المجتمع ما يهدد أمنه واستقراره وضمان الحقوق والحريات، ولعل في تكرار هذه الأمور الحيوية فائدة منهجية لتوجيه فكرة الإصلاح.
إن إصلاح العدالة الجنائية على مستوى الوظائف لا يمكن اختزاله أو تحجيم أهميته في ضمانات المحاكمة العادلة، فأهمية احترام هذا المبدأ الإستراتيجي لا يمكن أن تظهر سوى في إطار فلسفة تشريعية جديدة، تستثمر مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية، في ما يشعر كل مؤسسة قضائية بأن نجاح عملها يرتبط وظيفيا بما تساهم به في تسهيل القيام بالوظائف الأخرى، وهنا لابد أن نؤكد على فكرة وحدة الملف في المادة الجنائية بالرغم من تعدد الجهات القضائية المتدخلة فيه – والمرشحة للارتفاع – . فمبدأ المراقبة المتبادلة لا تعني التشكيك في مصداقية المهام المنجزة سابقا، ولا حتى إقامة حدود مسطرية فاصلة، غالبا ما ساهمت في تقليص فرص التعاون بين المؤسسات القضائية المتدخلة. بل إن المقصود من المراقبة هنا بذل مزيد من الحرص والتريث بالحسم في الإدانة. ولعلها القيمة المسطرية المثلى التي يحوزها مبدأ البراءة الأصلية الذي أصبح المشرع المغربي يتصدر به مواد المسطرة الجنائية. وإلا كيف يمكن أن نقبل منطقا وقانونا استمرار أغلب التشريعات في تسخير كل هذه الوسائل المادية و البشرية للحسم في النازلة الواحدة؟
أيضا لا يمكن للوظائف القضائية، أن تعرف تطورا نوعيا في المجال الجنائي من دون تحريرها من الانغلاق، أي بجعلها عدالة قريبة من المواطن في تواصل دائم معه، مستجيبة لردود فعله، عاكسة لتصوراته وتطلعاته، باحثة عن تقدمه وتحضره. فوظائف العدالة الجنائية، وعلى خلاف ما يعتقده البعض، نجاعتها تقاس بمدى قدرتها على استثمار فرصة المحاكمة من أجل احتواء مظاهر التوتر والاضطراب التي يتسبب فيها السلوك الإجرامي، وهذا لا يمكن أن يتم سوى بتحريك الخطاب الزجري في الاتجاه الذي لا يقف عند حدود الردع، بل يتعداه إلى إشعار كل المخاطبين به بأن للحقوق والحريات حدودا، فلسفتها تنبني بالأساس على قبول العيش ضمن المجتمع بكل مكوناته، وأن لا سبيل لإضفاء الشرعية على الانحراف عن الثوابت والقيم الحضارية باعتبارها مكتسبات مجتمعية، لا محيد عن تكريس الوعي بضرورة الحفاظ عليها، ولعلها بنظرنا المتواضع، النتيجة المثلى التي ينبغي أن تستهدفها إستراتيجية الإصلاح.
ختاما، ونحن ننتظر بكل تفاؤل توصيات الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، واثقين في تكلل أعمالها بالنجاح المنشود بعد المباركة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس،لابد من التأكيد على أن إصلاح العدالة لابد وأن يرتبط في روحه وفلسفته باستشراف مستقبل كلية الحقوق ببلادنا، حتى يرتبط تحديث منظومة العدالة بتطويرالجهة التي كانت ولاتزال تزودها بالأطر المؤهلة.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 












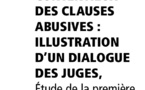




 أي إستراتيجية لإصلاح العدالة الجنائية؟
أي إستراتيجية لإصلاح العدالة الجنائية؟