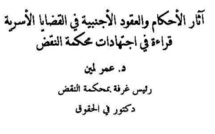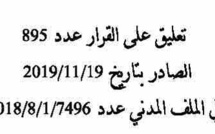لا أريد أن أقنع نفسي أنني كنت على خطأ في موضوع استقلال السلطة القضائية أو غيري كان كذلك، كما أنه يمكن أن أكون جازما في أن زملائي القضاة تطرقوا إلى الموضوع بنوع من حماس مهني أكثر من رزانة القضاء وهدوئه، ربما لأن الموضوع يهمهم وظيفيا وذاتيا فافتقدوا إلى الكثير من الموضوعية، بل إن الحماس المفرط أسدل على عيونهم نوعا من الغشاوة التي أحجبت عنهم تلك الموضوعية التي هي منارة اشتغالهم، فدعونا نناقش الموضوع من خلال انفصالنا عن دواتنا ونتحدث بصدق قد ينفعنا في صنع قانونا لأجيالنا المقبلة أو ربما نساهم في بناء شيء من بعض الدولة.
إنه من الطبيعي أن يكون للوجل و للخوف سلطة على الإنسان وهو يناقش هذا النوع من القوانين، لأنها تهم مؤسسة هامة في الدولة، والدولة ضمان وجودنا وسلامتنا، لذلك فالتريث والتدقيق يجب أن يسبق الاختلاف، ومشروعية هذا الأخير لا تستند إلا على الموضوعية في التعامل مع الفصول القانونية ومع الأطراف، فالذي يناقش هذا القانون من خلال طبيعة وظيفته المهنية وينطلق من مواقف مسبقة سرعان ما يقوم بهدم أسس الدولة لبناء قوة لها من السلطة ما لا يمكن لجمه، فنصبح أمام نوع من الدكتاتورية، والدكتاتور كما يعلم الجميع يكون دائما جبانا وجاهلا، وعليه فلا نريد أن نؤسس سلطة بهذه المواصفات، كما أننا لا نريد أن نؤسسها بنظرة طهرانية للوظيفة القضائية تنسينا أن الذي يملك إدارتها هو الإنسان بعقده وبانهزامياته و بردود فعله التي لا يمكن إدارتها في لحظات عصبية، فلا نريد أن نؤسس سلطة لمن يشتغلون بها، كما لا نريد أن نؤسس سلطة لمن قد يستعملونها كهراوة لجلد الأبرياء، فقط نريدها جزء من الدولة وداخل الدولة وفي إطار الدولة وليس بانفصال عنها.
لذلك فالموضوع له حساسيته ويفرض علينا نوعا من الجرأة الفكرية والنزاهة في القرار وفي الاختيار، بل يفرض علينا قبل كل هذا وذاك، أن نكون صرحاء فيما بيننا، متنزهين على بعضنا، فهذا القانون لا يهم مرحلة بذاتها ولا وزير بعينه ولا الخضوع لانتماء أو قرار حزبي معين، ولا حتى ذاتية القضاة بجلال قدرهم، ولكنه قانون يهم فضيلة العدالة وسموها وعنفوانها، لذلك لا الإسهال الفكري ولا احتلال صفحات الجرائد قد تقنعنا أو قد تضغط علينا من هذه الجهة أو من تلك، بل ما سينفعنا هو مقارعة الحجة بالحجة وقبله تجارب الآخرين، فالإنسانية تستفيد من تراكمات عبر امتدادات جغرافية وفي آخر المطاف مدى قدرتنا على بناء حلم شعبنا في عدالة نزيهة نظيفة عادلة و مسؤولة، وهذا كله متعب للفكر وممزق للضمير ومعذب في مواجهة الأفكار المضادة، وضغط لعنف الشعور بالمسؤولية.ولنعد إلى القانون الذي بين أيدينا "قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، فحينما نناقش السلطة القضائية ونتحدث عن إشكالية استقلالية النيابة العامة.
قد يغامر البعض بسوء النية أو بحسنها، فيخلط استقلال النيابة العامة باستقلال السلطة القضائية الجالسة وشتان بينهما، إذ لا يختلف اثنان أن استقلالية السلطة القضائية موضوع محسوم في أمره، ليس من خلال الدستور فقط أو خلال قناعاتنا المتبادلة فحسب، ولكن لكونها أرقى اختيار بلغته الإنسانية في وجودها بعد فكرة إنشاء الدولة، فلماذا إذا سنتواجه مع ما حسمته الإنسانية فيما هو ضمان لأمنها وسلامتها وحسن وجودها؟.
وهنا لنتفرع عن هذه الاستقلالية، إذ هي لا تهم قضاء جالسا أو قضاء واقفا، بل تهم القضاء ككل، فالقاضي الجالس أو القاضي الواقف عند تطبيقهم للقانون عند القيام بمهامهم هي قرارات تتم وفق قناعاتهم دائما وأبدا وتساير حسن تطبيق القانون، غير أن هذه الاستقلالية تختلف في مدلولها بين طرفي القضاء، لكونها في آخر المطاف تختلف من حيث طبيعتها ومدى توسعها بين القاضي الواقف والقاضي الجالس، فالذي يحد من استقلالية القاضي الجالس هو القانون لكونه هو الإطار العام الذي يشتغل في إطاره القضاة الجالسون، فهم لا يحكمون بعلمهم و لا يمكنهم أن ينكروا العدالة، ويقومون بتنفيذ وحسن استعمال النصوص القانونية والاجتهاد في إعمال غاية المشرع، وهذا الإطار القانوني هو الذي يمنحهم الشرعية لنقل الحق من هذا الطرف إلى ذاك، أو في حرمان المواطنين من الحق في الحرية وغيرها من الحقوق عقابا لهم على تجاوز القانون اتجاه مواطنين آخرين أو عند مساسهم بالنظام العام، وهذه الأحكام تصبح ملزمة للجميع وتضمن الحق لمن كان الحكم لجانبه.
أما القضاء الواقف فقراراته ظرفية تخضع للرقابة القضائية وتخضع لتوجيهات السلطة التسلسلية، وهذان الوضعان يفرضان على المشرع أن يفصل النيابة العامة عن القضاء الجالس في إعمال مبدأ الاستقلالية وتحديد مفهومها، وهذا ما يفرض علينا أن نعود إلى طبيعة مهام القضاء بالتدقيق. فالقضاء الجالس يحسم في النزاعات وليس له غير ذلك، لذا فهو مستقل مسؤول على حقوق الأفراد وعن توازنها مع النظام العام ومع مصلحة الدولة، بينما القضاء الواقف فهو أداة للسهر على النظام العام بواسطة القانون وتصرفاته تخضع للرقابة من طرف القضاء الجالس على المستوى القانوني والواقعي، و تخضع للسلطة الإدارية على مستوى التسلسل الإداري، ولأن قراراته لا ترقى إلى مستوى قرار القضاء الجالس فإنه يبقى مقيدا باعتباره أداة لتنفيذ السياسة الجنائية، ولأنه أداة لتنفيذ هذه السياسة فإنه يجب أن يكون خاضعا للرقابة، وهذه الرقابة إما أن تكون ممن له الحق في وضع هذه السياسة والذي يكون خاضعا بدوره إلى الرقابة البرلمانية، أو تكون من من يترأس هذا القضاء الواقف، أي من جهة يجب أن تخضع للرقابة البرلمانية، ومن هنا علينا أن نخلص إلى ما يلي:
نحن متفقون على أن القضاء الجالس غير قابل للرقابة إلا على مستوى رقابة الضمير ورقابة حسن تطبيق القانون، أما القضاء الواقف فيخضع لرقابة رئيسه التسلسلي أو رقابة القضاء الجالس، علما أن لكل منهما دور ولكل منهما مجال، غير أن القضاء الجالس بقوة الأشياء وطبيعتها يعلو القضاء الواقف، فالأسياد يظلوا جالسين وغيرهم يستمرون في الوقوف.
فإلزامية هذه الرقابة للقضاء الواقف تأتي بسبب ما يملكه من سلطات في إدارة بعض مؤسسات الدولة التي هي وسيلة بين يديه، و تخضع إداريا وتسلسليا للسلطة التنفيذية، و من الحكمة أن تمارس الرقابة عليه بواسطة من منحه الدستور هذا الحق وهو البرلمان، الأمر الذي يفرض أن يمثل المسؤول أمام البرلمان، ولأن الدستور منح صفة القضاء إلى النيابة العامة ولأن الوكيل العام بمحكمة النقض يستمر قاضيا، فهذه الصفة تمنع على البرلمان أن يأمر بمتوله أمامه، علما أنه يساهم في تنفيذ السياسة الجنائية، هذه السياسة التي هي من الشأن العام والتي هي جزء من البرنامج السياسي للسلطة التنفيذية الذي هو اختيار في إدارة السلطة، وعليه فوجود الوزير في إطار هذا التسلسل يظل هو المنفذ الوحيد لمراقبة عمل جهاز يملك من الوسائل ما يتوجب معه مراقبتها، وإلا أصبحنا استنادا إلى مفهوم الاستقلالية نتناقض مع ما لهذا الجهاز من وسائل الدولة ما تتقاطع بين مؤسسات السلطة التنفيذية وفي غياب أية رقابة.
فهل نتصور أن هذا الكم الهائل من الوسائل القانونية والبشرية والمادية سنجعلها بين يدي جهاز دون رقابة؟ في مواجهة جهاز يحسم في الخلاف فقط ولا يملك وفقا للقانون المغربي أية سلطة قضائية عليه إلا بإعلان بطلان مساطره أو الحد من مفعولها دون أن يخضع أفرادها للمحاسبة أو ترتيب النتائج المسؤولية على تصرفاتهم؟ وفي هذه الحالة ودون أن ندرك سنجعل حتى القضاء الجالس ضعيفا أمامه ثم خاضعا نفسيا له.
لنعد إلى الموضوع بشكل أكثر اختزالا و عليه نجد أن هناك رأيين في هذا الموضوع، رأي يقول باستمرارية تبعية قضاة النيابة العامة لوزير العدل ورأي ثان يقول بخضوعهم للوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى لمحكمة النقض، دعونا نفكك مفهوم الاستقلالية من خلال هاتين الرئاستين التسلسليتين وزير العدل والوكيل العام:
من حيث السيد وزير العدل:
أولا: يخضع السيد وزير العدل دستوريا لجلالة الملك باعتباره رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس الوزراء ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن ورئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثانيا : السيد وزير العدل ليس عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ثالثا : السيد وزير العدل يملك سلطة التعليمات من خلال المكتوب.
رابعا : السيد وزير العدل لا يقرر في التأديب بشكل مباشر إلا من خلال بعض من مراسلاته إلى المجلس وتقاريره التقييمية لعمل النيابة العامة.
خامسا : السيد وزير العدل تخضع تقاريره التقييمية لرقابة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
سادسا : السيد وزير العدل يخضع لرقابة السلطة البرلمانية في علاقته مع النيابة العامة.
سابعا: السيد وزير العدل يخضع لسلطة رئيس الحكومة على اعتبار أن كل ما يقوم به يستند على مبدأ التفويض.
من حيث السيد الوكيل العام للملك:
أولا: السيد الوكيل العام للملك يخضع لجلالة الملك بصفته رئيسا للدولة وكرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثانيا: السيد الوكيل العام للملك عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثالثا: السيد الوكيل العام للملك هو الرئيس التسلسلي للنيابة العامة .
رابعا: السيد الوكيل العام للملك يساهم في التأديب بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
دعونا نقوم الآن بمقارنة بسيطة:
1) على مستوى الخضوع لرئيس الدولة:
فوزير العدل يخضع دستوريا إلى جلالة الملك كرئيس للدولة وكرئيس للمجلس الوزاري وكرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكرئيس للمجلس الأعلى للأمن، وأي تصرف يصدر عن وزير العدل عند ممارسته لمهامه لا يمكن أن يخرج عن هذه الاختصاصات الأربعة التي يخضع فيها دستوريا لجلالة الملك كمكلف بتدبير قطاع من قطاعات الدولة، وكوزير بمجلس الوزراء وكفاعل في المجال القضائي لرئيس السلطة القضائية ثم كعضو بالمجلس الأعلى للأمن ينفذ توجيهات هذا المجلس الأمنية من خلال السياسة الجنائية ثارة وثارة أخرى من خلال التوجيهات التي تصدر من جلالته إلى وزير العدل استنادا إلى ما يملكه جلالته من سلطات كمسؤول أول على أمن وسلامة المواطنين.
أما الوكيل العام للملك فهو يخضع لجلالة الملك دستوريا كرئيس للدولة باعتباره جزء من هيكل من هياكل الدولة، ثم يخضع دستوريا لجلالة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته عضوا بهذا المجلس (رغم أن المشروع غيب مفهوم هذه الرئاسة).
إذن نحن أمام وزير للعدل يخضع لعدة سلطات بواسطة مؤسسات دستورية تتوفر على ضمانات المراقبة والافتحاص السياسي وعند رئاسته للنيابة العامة يصبح وجوده بالمجلس الأعلى للأمن ذا جدوى، لكونه سيكون فاعلا في تنفيذ السياسة الأمنية التي يدبرها المجلس الأعلى للأمن. كما أن هذا الخضوع الرقابي تكون فيه وضعية وزير العدل خاضعة لرئاسة رباعية لجلالة الملك "رئاسة جلالته لكل من الدولة، ولمجلس الوزراء، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وللمجلس الأعلى للأمن" وهذه المؤسسات الدستورية وسيلة مثلى لضبط عمل وزير العدل في ممارسته سلطته التسلسلية على النيابة العامة.
أما الوكيل العام فخضوعه للسلطات الدستورية لجلالة الملك يكون على مستويين فقط باعتبار جلالة الملك رئيسا للدولة ورئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أي سلطة التعيين والإقالة وسلطة تتبع أعمال المجلس وهي سلطات عامة بعيدة عن التفاصيل قريبة من التوجيهات.إن المقارنة البسيطة على ضوء هذه الأفكار تسمح للوكيل العام بالإفلات من الرقابات المتعددة التي على وزير العدل من طرف رئيس الدولة وما يرسمه هذا الأخير من علاقات محددة بين هذين الجهازين والمهام المحددة دستوريا لرئيس الدولة.
2) على مستوى رقابة السلطات:
يخضع وزير العدل من خلال رقابة السلطات إلى رقابتين أساسيتين هما رقابة رئيس الحكومة و رقابة البرلمان.فمن حيث رئيس الحكومة يعلم الجميع أن الدستور الجديد قد حدد العلاقة بين رئيس الحكومة والوزراء بدقة وقد نجح المجلس الدستوري بتفوق كبير في تحديد هذه العلاقة عندما ناقش موضوع التنصيب الحكومي حيث اعتبر رئيس الحكومة هو العمود الفقري للحكومة و وجوده مرتبط بشرعية النتائج الانتخابية وبالحصول على التعيين الملكي والتنصيب البرلماني، واستمراره مرهون بمدى تنفيذه للبرنامج الحكومي، والوزراء في هذا الوضع يفوض لهم السلطات القطاعية رئيس الحكومة الذي يملكها ويساءل عنها من خلال برنامجه الحكومي أو أثناء مناقشته في السياسة العامة أمام البرلمان، ويبقى الوزير مسؤول عن قطاعه أمام رئيس الحكومة ويفوض للأخير الحق في إدارته والدفاع عنه باعتباره سياسة قطاعية، كما يمكن لرئيس الحكومة إذا ارتأى أن السياسة القطاعية المنتهجة من طرف وزير ما لا تلاءم مع توجيهات برنامجه الحكومي يمكنه إقالة الوزير المعني، وحتى سحب التفويض منه أو التقليص من حجمه بواسطة مراسيم تنظيمية علما أن استمرار الوزير مرهون باستمرارية رئيس الحكومة والعكس غير صحيح، لذلك فسياسة العدل يمارسها وزير العدل تحت السلطة السياسية والتنظيمية لرئيس الحكومة، وهي رقابة يومية وتفصيلية تخضع للمساءلة المباشرة باعتبار رئيس الحكومة هو الرئيس الفعلي المباشر للوزير يمارسها مباشرة أو من خلال اجتماعات مجلس الحكومة.
أما الرقابة الثانية فهي الرقابة البرلمانية، وهذه الرقابة يمكن ممارستها عبر عدة وسائل من السؤال الشفوي إلى السؤال الكتابي، مرورا بالاستدعاء إلى اجتماعات اللجان أو حتى خلق لجان نيابية لتقصي الحقائق أو اللجان الموضوعاتية أو حتى الاستناد عليها لتقديم ملتمس الرقابة. ومن خلال هذين الرقابتين يتبين أن وزير العدل سيراقب عند ممارسة كل سلطاته، وبالتالي إذا لم تمنح له سلطة رئاسة النيابة العامة فسنفقد ليس رقابة رئيس الحكومة فقط ولكن كذلك الرقابة البرلمانية وهذا يتنافى مع مسؤولية البرلمان في حماية الحريات و استعمال العنف المشروع.
هذا بالنسبة لوزير العدل أما الوكيل العام للملك فيمكن أن نختزل رقابته في جملة واحدة وهي: (خارج سلطات جلالة الملك التي غالبا ما تكون توجيهية أو عامة فإنه لا حول و لا قوة لأي أحد في مراقبته)، فهو يملك وسائل الدولة ويستعمل أجهزة السلطة التنفيذية وتوضع بين يديه الإمكانيات القانونية والمادية للمساس بالحقوق الدستورية للمواطنين كالحريات والحياة الخاصة والحياة الحميمية ووسائل الاتصال وضمانة حق الملكية وغيرها من الحقوق، لكنه لا يخضع لأي رقابة مؤسساتية في الدولة، إنه إشكال كبير يفقد للدولة توازن سلطاتها ويلغي مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل أنه يعدم الفصل الأول من الدستور ويلغيه. وهنا نطرح سؤالا إضافيا بغض النظر عن كل ما أسلفناه هو : أين ضمان استقلالية أعضاء النيابة العامة عن كل من هذين الجهازين؟. إن أخطر وسيلة للمساس باستقلالية القاضي هو امتلاك السلطة التأديبية، وإذا اجتمعت السلطة التأديبية مع سلطة البث في الطعن إضافة إلى سلطة البحث في يد واحدة، نكون قد أفرغنا مفهوم الاستقلالية من محتواها، بناء على ما تملك كل جهة من وسائل.
فالوكيل العام للملك هو رئيس تسلسلي وله رأي في أعضاء النيابة العامة بشكل شخصي ومؤسساتي، يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويؤثر في القرار التأديبي، وفي حالة رئاسته للنيابة العامة له الحق في أن يقدم تقريرا عن كل عضو، تم يبث فيه وعند ما يحال على المجلس التأديبي يتتبع إجراءات البحث ونتائجه كعضو في المجلس ويساهم في بلورة قرار المجلس، وعند ما يتم الطعن يقدم رأيه كمحام عام، بل من سخرية القدر يحضر في مداولات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وخاتمتها مسك عندما نعلم أنه يترأس اجتماعات المجلس عند غياب الرئيس المنتدب، فتصوروا معي أن مسؤولا باسم الحفاظ على استقلالية النيابة العامة يقوم بمهمة الرئيس التسلسلي ويحضر التأديب ويحضر الطعن ثم نتحدث عن الإستقلالية؟ يملك سلطات إصدار التعليمات و إذا ثم الاختلاف حولها فإنه يملك سلطة التأديب ونتكلم عن الاستقلالية؟.
لنعد إلى صلاحيات وزير العدل، فلنفترض أنه رئيسا تسلسليا للنيابة العامة فهو ليس عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقط يوجه رسائل للتقييم غير إلزامية لأعضاء المجلس، فهو لا يحضر التأديب و لا يحضر الطعن، أي لا يملك سلطة الإجبار في تنفيذ توجيهاته. وبالتالي عن أي استقلالية نتحدث؟ الاستقلالية في الشكل أم في الموضوع؟ أم أننا نريد فقط أن نصنع جزيرة داخل بحر الدولة؟.
إن الموضوع ليس بالحماس أو بالاستهلاك اللغوي الذي ينحوه البعض، ولكنه موضوع تتعقد فيه التفاصيل، فهل نضمن فعلا استقلالية النيابة العامة مع خضوع قضاتها للوكيل العام للملك؟ و هل يجوز أن نتحدث عن استقلالية النيابة العامة في إطار الدولة بالشكل الذي يتهافت فيه البعض؟ أم أن الدولة تملك وسائل يصبح القضاء الواقف حاجزا أمامها؟ ثم من جهة أخرى نطرح سؤال آخر لمن تخضع الضابطة القضائية؟ و الجميع يعرف أن من يملك سلطة البحث و التحري يملك سلطة التأثير المطلق على النتيجة؟ بل يملك القدرة على إدارة سلطة الملائمة و التكييف الذي للنيابة العامة من بعيد عبر جمل و تفاصيل لغوية و واقعية تتضمنها المحاضر؟.
إن الدولة لا تسير بالقوانين و لكن تسير كذلك بممارسات واقعية تتم في لجاج ظلام دامس يحكمها مبدأ حماية النظام العام و حسن سير الدولة، لأن السرية جزأ من العمل السياسي، بل هي التي تصنع تلك الأسطورة التي نركع لها تحت يافطة أسرار الدولة وحينما تفقدها الدولة فإنها تفقد تلك السلطة الروحية التي لها على المواطنين و هي أن الدولة تنين متعدد الأرجل والأيادي لا يرى منه إلا تلك الابتسامة التي نتخيلها بشكل افتراضي كلما ربطنا استقرارنا و أمننا بوجودها، أعتقد أن الإنسانية صنعت هذا التنين و منحته السلطة و منحته كل ما تملك من حريات و حقوق فقط لأنها تعتقد أنها ستعيش بما تبقى لها من ضمانات بشكل أفضل، فهل سيؤدي هذا التصور المغلوط للاستقلالية إلى وئد التنين الذي يحمينا جميعا؟.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 















 رسالة إلى زملائي القضاة
رسالة إلى زملائي القضاة